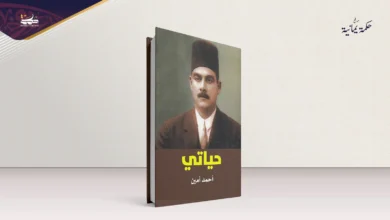هل يُعقَل أن يُخلّدَ اللهُ في النار أولئك “الهيّنين الليّنين وأصحاب القلوب الرقيقة ومن يساعدون الناس” كما يقول الشيخ بسّام جرار؟
وتلك المرأة التي جاءت من أقصى الغرب لتنصر قضايا المسلمين العادلة، كقضية فلسطين، وماتت تحت جرّافة عسكرية، أليس من الظلم أن تَخلد في النار لمجرّد كفرها بربّ العزّة؟
هذه تساؤلات كثرتْ في عصرنا هذا، وعلينا أن نقرّ بأنّها تشكّل أزمة فكرية وشعورية لدى الكثير من أبناء هذا الجيل والأجيال السابقة في مرحلة ما بعد الاستعمار. وسأحاول في هذا المقال معالجتها بعناية ومن مختلف الجوانب، تفكيكا للإشكال وبيانا لوجه الحقّ فيها.
علينا أولا أن نقرر أمرين لإزاحة إشكال مهم، وهو الزعم بأنّ المسلمين قساة القلوب يريدون إدخال الناس في العذاب الأليم خالدين فيه أبدًا، بغير رحمة أو رأفة. والواقع أنّ هذا وهم، والحقيقة بخلافه تماما لسببين:
الأول: أنّ نبأ الخلود في النار هدفه دعوي وليس قضائيا، فالمسلمون ليسوا هم من يتولّى إدخال الناس الجنّة أو النّار، ولكنّ الله عز وجل وحده من يقضي بخلود فلان من الكفار في النار أو عذره إن كان يجد له عذرا من عدم بلوغ الرسالة. والله سبحانه هو الذي أبلغنا بخلود الكافر في النار، في عدد كبير من الآيات قطعية الدلالة.
الثاني: الواقع أنّ إبلاغ المسلمين حقيقة خلود الكفّار والمشركين في النار هو دليل على أنّ أّمة الإسلام أرحم الناس بالخَلْق، فهم يبلّغون البشرية بخطورة المصير المشؤوم للكفر، رحمةً بهم وإشفاقًا عليهم من هذا المصير، وهدف إبلاغهم هذا تحذير الناس وبيان جدّية أمر الآخرة وضرورة إعمال العقل في هذه الدنيا ومآلها. فكيف يقال عن هؤلاء إنّهم قساة القلوب ولا يعرفون الرحمة؟!
دعونا نتساءل الآن: هل يتنافى تخليد الكافر في النار مع العدل؟
في الواقع فإنّ تخليد الكافر أو المشرك في النار هو قمّة العدل، حتى لو كان “مسالِما” مع الخَلْق في حياته، وحتى لو قام ببعض الأعمال الصالحة ونصر القضايا العادلة، فهو قد قام بهذه الأعمال لأجل الدنيا ونال جزاءه فيها من إشادة وتقدير وتخليد ذكرٍ فيها حتى فنائها، ولم يقم بها إيمانًا بالأجر المترتّب عليها في الجنّة وحبّا لطاعة الله وطلب رضوانه.
هل يظلم الله سبحانه وتعالى الكفار عند تخليدهم في النار؟
ثم إنّ الظالم هو الذي يعاقِب دون أن ينذر، ولكن الله سبحانه قد أنذر بعقاب الآخرة المترتّب على الكفر به والإعراض عنه في الدنيا، فالمسؤولية ملقاة على الإنسان الذي كرّمه الله بالعقل وحرية الإرادة، وقد سمع من أمّة المسلمين بخطورة العقاب الأخروي المترتّب على الكفر والشرك (الخلود في عذاب النار) فكيف يبقى على إعراضه ولا مبالاته؟ إنّ الإعراض هو الجريمة الإنسانية الكبرى التي يرتكبها الناس بكثرة، وقد أخبر الله عز وجل بهذا المعنى، قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (السجدة: 22). يقول الطبري في تفسيرها: “وأيّ الناس أظلم لنفسه ممن وعظه الله بحججه، وآي كتابه، ورسله، ثم أعرض عن ذلك كله، فلم يتعظ بمواعظه، ولكنه استكبر عنها”. فالمسؤولية الكبرى واقعة على الإنسان المعرض عن كل الآيات الدالّة على الله في الأنفس والآفاق والرسالات، مع إمهال الله له عمرًا مديدا، فقد ظلم نفسه وأوردها العذاب المهين حين اغترّ بالدنيا التي علمَ أنها فانية يقينًا، ولم يتناول أمر الحياة الحقيقية الدائمة بجدية، ولهذا فإنّ جزاءه القاسي هو نتيجة عمله. ويقول سبحانه: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} (طه: 124-126). فنسيان الآيات الدالّة على الله والآخرة والانغماس في أفق الدنيا الضيّق هو الجريمة الكبرى التي يرتكبها الإنسان.

فلا ظُلمَ في تخليده في العذاب، والله سبحانه هو الذي خلقه، فهو مملوك لله والخلق كله في قبضته، لو شاء لَما خلقه وأبقاه في العدم المحض، ولكنه خلقه ووهبه ذاتا تعي وتفكر وتفرح وتتناول ملذات الدنيا، ووعده على التوحيد والعمل الصالح في هذه الدنيا الفانية جنّة عرضها السماوات والأرض، لا نصب فيها ولا لغوب، مع نعيم دائم وأمن واطمئنان دائم، وأنذره نارًا تلظّى وعذابا خالدًا إنْ هو أعرض وكذّب وتولّى عن رسالة الله وحقيقة الخلْق، فلم يكن الوعيد بالعذاب منفردًا، بل قدّم سبحانه الوعد بالجنّة، ومهّد لها الآيات والدلائل، وسهّل طرق بلوغها، وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان.
هل سيخلد الموحدون العصاة في النار؟
ومن يقرأ نصوص الرحمة للموحّدين رغم ذنوبهم الفظيعة يشعر بعظيم رحمة الله للبشرية، فقد كلّف الإنسان بالأعمال الصالحة واجتناب المحرّمات، ولكنه لم يخلّده في العذاب لأدنى معصية، ولا حتى بارتكاب الكبائر، ولو كان من القتلة المجرمين. بل بلغنا في الأخبار عفوه ومغفرته للكثير من الذنوب، حتى أنّ ذنوب العبد قد تُمحى لقوة ما لكلمة التوحيد التي كانت في صدره وأثرها في حياته. ولا يخلد في النار إلا من ارتكب الجريمة الكبرى، وهي الكفر أو الشرك بالله العظيم، الذي خلقه بعد أنْ لم يكن، وصوّره وأحسن خلقه وأعطاه من النعم والآفاق ما لو أنفق عمره كله ومليون عمر معه لم يوفّ شكره سبحانه، فكيف تكون جريمة الكفر بهذا المنعم المتفضّل بنعمة الخلق والإيجاد والحياة والإمداد أهون الجرائم في حسّ الإنسان؟ بل إنّها الجريمة الوحيدة التي تستحقّ رفع الرحمة عن الإنسان في الآخرة وتخليده في النار.
هل من القسوة أن يخلد الكفار في النار؟
وزعْم القسوة في هذا المصير شبيه بمن يزعم قسوة تحطّم إنسان عاقل وهلاكه حين يلقي نفسه بإرادته من شاهق، ويلوم الطبيعة على “قسوتها”. فالله الذي خلق هذه القوانين الطبيعية التي تبدو “قاسية” عند سوء التعامل معها هو نفسه الذي وضع ميزان العدل في الآخرة وأخبر به وأكثر من ذكره، فكما أنه غلّب جوانب التنعّم والانتفاع في الطبيعة للإنسان، فكذلك غلّب دلائل الهداية والإمهال والتجاوز في الآخرة، فمن أعرض عن آياته سبحانه وانغلق على الدنيا الفانية هو المسؤول الوحيد عن جزائه في الآخرة الذي يراه الناس “قاسيًا”. والقسوة لا تُنكر إلا إذا كانت بغير حقّ، ألا ترى أن الناس يهشّون للقسوة في حقّ الظالم ويبغضونها في حقّ المظلوم؟ فكيف بمن فرّط بأول الحقوق، وهو حقّ الله على عباده “أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا”؟ ما الذي يبقى من غاية وجود الإنسان بعد كفره بالله الذي خلقه للآخرة وابتلاه بالدنيا اختبارا؟ الواقع أنّ الإنسان الذي يكفر بالله خالقه هو الذي ظلم نفسه وأوردها المهالك، وهو المسؤول الوحيد عن هذه القسوة التي حلّت به.
والآن دعونا نفكّر، ما الذي جعل هذا الشعور بظلم مصير الخلود في النار ينشأ بقوة في عصرنا هذا؟
إنّهما في الواقع مفهومان هيمنا على العالَم مع هيمنة الحضارة الغربية العلمانية، وهما “مركزية الإنسان” و”مركزية الدنيا”. وسأبيّن كيف أثّر هذان المفهومان في تصوّراتنا، فجعلانا – إلا من رحم ربّك – نفكّر بطريقة نافرة عن طريقة التفكير التي أرشدنا إليها كتاب الله، والتي تجعل التفكير في الآخرة ومصير الإنسان بعد الموت هو الأهم، وتجعل الله أعظم الناظرين إلى العبد، وتمنع الإنسان من الفرعنة والغطرسة ومن أن يتوهّم أنّه محور الوجود حتى بعد فناء هذا الوجود!

مركزية الإنسان
أما مركزية الإنسان فقد ترسّخ هذا المبدأ شيئا فشيئا في الحضارة الغربية المعاصرة، حتى صارت كل أهواء الإنسان مقدّسة ومحترمة طالما أنها تعبّر عن اختياره الحر. نحن نمتلك في آفاق هذه الحضارة الغربية ومفرزاتها الثقافية والتربوية والإعلامية شعورًا مضاعفًا بأهمية ذواتنا، شعورًا قتل في أنفسنا بقايا التواضع التي كانت تمثّل جهاز توازن يمنعنا من نسيان حقيقة ضعفنا وعوزنا وافتقارنا الدائم إلى الله عز وجل. لقد نسينا أنّ الله سبحانه خلقنا بعد عدم وأنّه بعد زوال هذا العالَم، الذي سخّره الله للإنسان، سوف يتجرّد الإنسان من مركزيته المبنية على جناح بعوضة، فالدنيا التي كان هو محور قضيّتها أهون على الله من جناح بعوضة.
هل الإنسان مسؤول عن مصيره؟
نعم، لقد عظّم الله شأن الإنسان، ووهبه من القدرات المتفرّدة كالوعي والحرية والإرادة، وقدّره ومنحه من العطايا وأمهله وأعد له من النعيم الخالد الوفير ما يدل على عظيم شأنه عند الله. ولكن هذا التكريم للإنسان كان له ثمنه الباهظ، وهو تحميل الإنسان – الواعي الحرّ المريد – مسؤولية اختياراته في هذه الدنيا، وهي دار الابتلاء، بعد إخباره بالنتائج. وكلّما عظُم شأن المخلوق عظُمتْ مسؤوليّته وعظُم مصيره. ومن هنا نفهم أن أعظم ما يجعل الإنسان مخلوقًا متفردًا ومهمّا وعظيم القيمة، وهو الذي صنع مركزيّته في حسّ نفسه، هو نفسه الذي ينبغي أن يبصّرنا بعدالة مصائره الواقعة بين الخلود في الفردوس الأعلى والخلود في الدرك الأسفل من النار، فمثل هذه المصائر عظيمة الخطر لا تليق إلا بالإنسان المكرّم، فهي لا تليق بالحيوان الذي لا يمتلك إرادة واعية حرّة، والذي يفتقد الكثير من خصائص الإنسان التي تفرّد بها.
إنّ الإنسان متألّم على الدوام في هذه الدنيا، وألمه هذا ينبع من كونه لا يجد آفاق الدنيا كافية له كما يجد الحيوان. إنّه يطمع بالخلود ويشفق من الفناء المطلق الذي تفنى معه ذاته، فهو يريد لهذه الذات التي بين جنبيه أن تبقى، وأن تكون آمنة مطمئنة على الدوام، حيث لا نصب ولا لغوب. ودار الشقاء هذه هي دار تقلّب وتعب دائم رغم ما حُشيَ فيها من النعيم، فهي إلى النقص دومًا وإلى الفناء. وإذا كان الإنسان لا يتصوّر نفسه إلا خالدًا، وهو مكلّف مبتلى في هذه الدنيا، فلأنّ الله سبحانه قد فطره على هذا الشعور، وهو شعور يبصّره بالآخرة دار البقاء، وإنّ جمال الشعور بالخلود الآمن المطمئنّ الهانئ الرغيد لا بدّ أن يقابله خوف الخلود المعذَّب المهين الأليم، فهذا هو ميزان العدل الإلهي. وقد غلّب سبحانه الطرق إلى الأول وضيّق الطرق إلى الثاني، فأبى الظالمون لأنفسهم إلا الطريق الضيّق المفضي إلى الخلود في العذاب!
إنّ قيمة الإنسان تعلو بقدر ما يرتبط بالله ويؤمن بكل ما أخبر به وأمر به من غيوب وشرائع، وحين يهدر الإنسان كل ذلك فلا أهون على الله من نسيانه كما نسي كل ذلك.

مركزية الدنيا
أما مركزية الدنيا فهي نابعة عن غفلة الحضارة العلمانية المعاصرة عن أمر الغيب والآخرة، فالعلمانية قائمة على الاهتمام المطلق بالدنيا وشؤونها، وهي أحرى بأن تسمّى “الدنيوية”، وهذه هي ترجمتها الأدق. ولهذا يسعى الإنسان في ظلّها إلى تحسين الدنيا وتعميرها وترفيهها، وتصبح قيمة الأعمال نابعة من كونها تُصنع لأجل قضايا هذه الدنيا الفانية، لا من كونها تُصنع لأجل غيب لا تعبأ به العلمانية. ومن هنا تأخذ الأعمال “الجيّدة” التي صُنعت لأجل الدنيا قيم الفضيلة طالما أنها تخدم الإنسان وقضاياه، فهي المستحقّة للمكافأة والتقدير والتبجيل في حسّ المنغلقين على الدنيا، الذين لا يرون شيئا سواها. ولهذا يتعجب الغافلون من أن يكون مصير من قام بهذه الأعمال ذلك المصير المهين الأليم، وهو الخلود في النار، لأجل ارتكابه شيئا لا علاقة له بالدنيا بل بالغيب، وهو الكفر بالله. فما زالوا يقيسون هذا المصير بمعايير الدنيا رغم أنه لا ينتمي إليها! وهذا هو الخلل الأكبر الذي ينشئ شعور الاستنكار لتخليد الكافر في النار.
وحين يتخلّص المسلم من هذه المركزية للدنيا، ويتذكّر – كما يذكّره القرآن دومًا – أنّ قيمة الفعل لا تنبع من علاقته بالدنيا ونفعه للإنسان فيها فقط، بل هناك خالق عظيم وجنّة أعدّها للموحّدين الذين يعملون الصالحات ونار أعدّها للكافرين والمشركين، ومن ثمّ يكون المعيار الأول والأهم للأعمال هو رضى الله سبحانه عنها، وأن تكون خالصة لوجهه عزّ وجلّ. وأنّ مصائر الناس في الآخرة مبنية على هذه المنظومة التي قرّرها الله سبحانه في خلْقه، وليست مبنية على منظومة الدنيا الضيّقة وهي معزولة عن الحقيقة الأكبر المتمثّلة بزوالها وبكونها ومضة في عمر البشرية الممتدّ إلى الآخرة التي خُلق الناس لأجلها. ولهذا وجدنا أولى وصايا العبد الصالح لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: 13)، ثم تلتْها الوصايا المرتبطة بالدنيا كالإحسان إلى الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تصعير الخدّ وعدم الاختيال والغضّ من الصوت وغير ذلك من الأخلاقيات؛ يُعْلِمنا أنّ كل عمل صالح لا يُبنى على التوحيد فهو كالهباء المنثور الذي لا ينفع في الآخرة. قال سبحانه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} (الفرقان: 23).
وأخيرا، هل يتعارض التخليد في النار مع رحمة الله؟
من يقول ذلك إذا كان مسلمًا يُردّ بكتاب الله، وبما جاء من صفته سبحانه أنّه “شديد العقاب” في آيات كثيرة. ومع ذلك، فلا بأس أن يفهم المسلم الحكمة في ذلك، والهذيان في تصوّر إله الرحمة الدائمة التي لا يقابلها ما يضادّها.
إنّنا في ميزان العدل بين البشر لا نقبل رحمة المجرمين، بل نفرح حين ينالون جزاءهم المستحقّ لهم من العذاب، حتى لو كان إعدامًا، وهو إنهاء لوجود الإنسان في هذه الدنيا، فلمَ نريد من الله أن يكون رحيمًا على الدوام حتى مع المجرمين ومن انتهكوا أعظم ما خُلقوا من أجله وهو التوحيد: {وما خلقتُ الجنّ والإنسَ إلا ليعبدونِ} (الذاريات: 56).
إنّ الرحمة المطلقة في حقّ الإله منقصة عظيمة، فمع انعدام ما يضادها يختلّ ميزان العدل وتفقد أفعال العفو والتجاوز والمغفرة قيمتها، فسوف يستحقّها المؤمن الذي آمن بالله وبآفاق الآخرة الرحبة ولكنه ارتكب بعض الكبائر، كما يستحقّها الكافر المجرم الذي أنكر خالقه وأعرض عن هداياته وانغلق على الدنيا التي هي أهون عند الله من جناح بعوضة وأمعن في الإفساد. والله سبحانه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، ولا المصلحين كالمفسدين.
فإذا قيل: إننا لا نقصد انتفاء العقاب والعذاب، ولكنّا نرى في تخليد العذاب انتقاصًا من الرحمة، إذ لا بدّ أن ينتهي عذاب الإنسان بعد أن يأخذ جزاءه كما يحدث في سجون الدنيا! وليكنْ العدل متحقّقا في المدة الزمنية للعذاب، فالكافر الذي كان حسن السلوك في الدنيا يعذّب لمدّة تطول أو تقصر ولكنها تنتهي، ومن كان أعظم جرمًا يعذّب مدّة أطول وهكذا..
نقول: أفأنتم بعقولكم القاصرة تُمْلون على الله ما ينبغي وما لا ينبغي؟! وهل قلّدكم الله سبحانه مهمّة وضع ميزان العدل؟! أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا تؤمنون أنّه سبحانه لا يظلم مثقال ذرّة؟
إنّه هو سبحانه الذي قال لنا في محكم كتابه: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ} (البقرة: 161-162)، وقال عزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} (فاطر: 36-37) ومثل ذلك في آيات أخرى قطعية الدلالة في خلود الكفّار في النار، لم يختلف حول دلالتها هذه أحد من علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر الأئمّة عبر القرون.
هل يُقاس عذاب الله وأفعاله بما تواضع عليه البشر؟
وهل يَقدر البشر على الحكم بالتخليد في العذاب وامتنعوا عن ذلك؟ وهل تُقاس سجون الدنيا وعقوباتها التي غايتها التربية والإصلاح (زعموا) وكفّ الأذى عن الناس من خلال حجْر العناصر المؤذية بعقوبة الله عزّ وجلّ التي لا تهدف إلى شيء من ذلك، بل هو “الجزاء الأوفى” الذي ليس من ورائه إصلاح أو كفٌّ لأذى أحد، بل هو المصير النهائي للإنسان، والذي اختاره بإرادته. فمن يستنكر هذا العذاب وقع مجدّدا في قياس أفعال الله على أفعال البشر في الدنيا، فالدنيا هي محور تفكيره، لا يستطيع الفكاك من أفقها الضيّق الذي جعلتْه العلمانية الأفق الوحيد والغاية العظمى!
وأخيرا، قبل أن يستشكل المسلم شيئا ممّا في دينه عليه أن يفكّر في منطلقات هذا الاستشكال، فكثير من تلك المنطلقات – كما في هذه الحالة – هي منطلقات عاطفية ممزوجة بمزاج حضارة أخرى لها معايير أخرى مغايرة كلّ المغايرة لمعايير الشريعة؛ فمعايير الشريعة تحدّد للإنسان مكانة كريمة عالية، ولكنّها لا تجعله مركز كل شيء ولا تجعل كل اختياراته في الحياة محتَرَمة، وهي تجعل الدنيا دار اختبار لا دار بقاء، والعمل الذي ينتقل إلى الآخرة وينفع الإنسان هناك هو الصالح الخالص لله سبحانه، والرحمة في الشريعة لا تتعارض مع العذاب، بل لا معنى لوجودها من غير وجود العذاب.
إنّ التفكير من غير استحضار هذه الأسس والمعايير هو الذي ينشئ مشاعر الحرج والارتباك والتشويش، وحين يدرك الإنسان تمام الإدراك قيمة نفسه وغاية وجوده في الحياة، وقيمة الدنيا وهوانها وأنّها دار ممر، وماذا يحدث للبشرية بعد الموت، حين يدرك ذلك ويؤمن به قلبُه؛ تبدو مسألة خلود الكافر في النار متّسقةً تماما في منطقه الذي استقاه من القرآن، وهو المنطق الذي جلّى له الحقائق الكبرى التي يكون فيها الله والإيمان به وعبادته أعظم ما في الوجود، ولم يتركه أسير تفكير ضيّق لا يرى سوى الدنيا وأخلاق الإنسان المنقطعة عن امتدادها الجدير بها إلى الآخرة، ملاذ البشرية الدائم الأخير.
17 ذو القعدة 1433 – إسطنبول