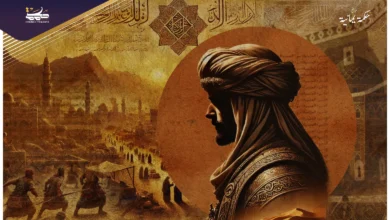الخلفية التاريخية:
ثمة قضايا مرجعية تمثل خلفية تاريخية – ينبغي لنا حين نقرأ قصة الأسود العنسي أن تظل أعيننا وأذهاننا مشدودة إليها. وهذه القضايا تتمثل في ثلاثة أمور: الأول: الوضع العام لليمن، والثاني: دخول اليمن الإسلام، والثالث: التحولات الإدارية في اليمن منذ مجيء الإسلام. [مادة الخلفية التاريخية مأخوذة بتصرف من كتاب د/ عبد الرحمن الشجاع: (تاريخ اليمن في الإسلام)].
الوضع العام لليمن:
كانت اليمن قبل الإسلام تعاني من تفكك سياسي كبير، فبعد احتلال الأحباش نحو 525م (وهم ممثلو الدولة الرومية)، ثم قضاء الفرس عليهم، واحتلالهم لليمن بعد نحو 50 عاما (تقريبا 575 م)، بعد إدخال سيف بن ذي يزن الحميري لهم، وقبوله بدفع خراج سنوي للفرس، ثم بعد مقتله حكموا الفرس اليمن مباشرة. وعشية مجيء الإسلام لم يعد النفوذ الفارسي يتجاوز صنعاء وما حواليها، وربما عدن. وسائر اليمن متوزعة بين القبائل اليمنية، وهي: حمير وهمدان (بفرعيها الكبيرن: حاشد وبكيل)، ومذحج وخولان (عاصمتهم صعدة)، وحضرموت (قبائل حضرموت، وكندة، ومهرة)، وقبائل بلاد السراة (عامتهم من الأزد)، وقبائل تهامة، وقبائل نجران (في الوادي: بنو الحارث بن كعب من مذحج، وفي المدينة: قبائل من مذحج وهمدان).
أما الوضع العقدي فقد كانت في اليمن اليهودية (في حمير وكندة وبني الحارث بن كعب بوادي نجران، وحضرموت)، والمسيحية (في نجران وحضرموت وحمير)، – وكلاهما أديان محرفة، وكذلك الوثنية، وهي الأكثر انتشارا، وكانت لهم أصنام يعبدونها، ومن ذلك (عَمي أنس لخولان، وذي الكفين لدوس، ويعوق في همدان وخولان، وكذلك بين ذي الخلصة لخثعم وزبيد وبجيلة.
ومن الناحية الاقتصادية فقد كانت اليمن في القرن السادس الميلادي ومطلع القرن السابع تعاني من أوضاع اقتصادية هشة، ولا سيما مع كثرة النزاعات والحروب بين القبائل اليمنية من جهة، وكذلك تحول التجارة الدولية البحرية إلى طرق أخرى بسبب المنافسة مع الإمبراطورية الرومية، وقد أدى ذلك إلى هجرات عديدة للقبائل اليمنية. كما أن انهيار سد مأرب (الذي مر بانهيارات عديدة) أثر سلبا على الزراعة والإنتاج الزراعي والتجاري في اليمن.
وكان الوضع المالي والاقتصادي العام في صنعاء وعدن (الأرض ذات النفوذ الفارسي) يخضع للنظام الفارسي في الجباية ومعاملة الناس بالسخرة والقسوة لتوفير الخراج للبلاط الفارسي. أما في مناطق النفوذ القبلي؛ فقد كان زعيم القبيلة والنخبة التي حوله – إضافة إلى الكهان – يمثلون طبقة أرستقراطية، ويستخدمون القبيلة لتحقيق مصالحهم، بما في ذلك إعلان الحروب على القبائل الأخرى أو تجهيز جيش لقطع الطريق على قافلة تجارية…
دخول اليمن الإسلام:
تعد قصة انتشار الإسلام في اليمن نموذجًا فريدًا يعكس التنوع في أساليب الدعوة والقبول. فقد دخل الإسلام إلى اليمن عبر مراحل متعددة وأساليب متباينة، مما أسهم في تشكيل هوية إسلامية تجمع بين التقاليد المحلية والنظام الإسلامي. وسنتناول في هذا النص القضايا المرجعية المتعلقة بإسلام اليمن، والتحولات الإدارية التي صاحبت ذلك.
أما تعدد أساليب دخول الإسلام إلى اليمن، فيظهر من خلال 5 نماذج:
الأول: الإسلام بدعوة أفراد وقبائل لبعضهم البعض؛ فتهامة: أسلمت قبائل الأشاعرة وعك بدعوة أبي موسى الأشعري. ودوس: أسلمت بدعوة الطفيل بن عمرو الدوسي.
الثاني: الإسلام بالتواصل المباشر مع النبي ﷺ؛ فالأبناء: أسلموا عقب كتاب النبي إلى كسرى وتواصلهم مع باذان (والي اليمن الفارسي). وقد خاطب النبي باذان قائلاً: “إنك إن أسلمت أعطيت لك ما تحت يدك، وملكتك على قومك من الأبناء”.. وقد عُيّن باذان واليًا بعد إسلامه، وأرسل النبي وبر بن يحنس الخزاعي ليعلمهم أمور الدين وبنى لهم مسجد صنعاء، الذي سبق مسجد الجند بسنتين.
الثالث: مراسلات القبائل الكبرى؛ فقبيلة حمير أرسل إليهم النبي إليهم أولاً المهاجر بن أبي أمية في السنة السابعة للهجرة، ثم مالك بن مرارة الرهاوي في السنة التاسعة للهجرة، وخيرهم بين الإسلام والجزية. وقد أسلم ملوك حمير طوعًا، واستقبل النبي مبعوثيهم في المدينة. وأبرز ملوكهم: الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل ذي رعين. كما قام مالك الرهاوي بدعوة عديد من قبائل اليمن أيضا، في وسط همدان وحمير. ولاحقا حين أرسل النبي معاذ بن جبل (9 هـ) استقر في الجند وسط قبائل حمير، وجمع تحت إدارته قبائل المخلاف الأعلى. وكذلك قبائل إقليم حضرموت (أقيال حضرموت بقيادة وائل بن حجر، وملوك كندة بقيادة الأشعث بن قيس الكندي)، راسلهم النبي عام 7 هـ، ووفدوا عليه مسلمين عام 10 هـ.، وجمع النبي زياد بن لبيد الإباضي واليا على الإقليم كله. وكذلك عامة تهامة يبدو أنهم دخلوا الإسلام بدعوة ابي موسى الأشعري حين أرسله النبي مع معاذ بعد تبوك، عام (9هـ)، ومنهم: سعد العشيرة، وقبائل لحج (ومنهم الأصابح، الذين صاهرهم أبو موسى؛ إذ زوج ابنته من زعيمهم: أبي شمر بن أبرهة).
الرابع: البعوث والسرايا، فقد كانت البعوث أداة لتثبيت الإسلام، وخاصة في المناطق التي لم تستجب لدعوة النبي مباشرة. ومن ذلك:
– سرية خالد بن الوليد (ذو القعدة 8 ه) إلى منطقة همدانية بمشارف بلاد السراة وتهامة، وتسكنها من قبائل همدان: (يام، وشاكر، وخارف). وظل ستة أشهر يدعوهم للإسلام. ثم جاء علي فأسلموا على يديه (جمادى الآخرة، 9 ه).
– سرية خالد بن الوليد وعددها 400 (10ه)، إلى بني الحارث بن كعب في وادي نجران، فأسلموا وجاء بوفدهم، وفيهم بنو عبد المدان.
– إلى شمال سرو مذحج (وفيهم عنس وزُبيد وبعض خولان)، سرية بقيادة خالد بن سعيد بن العاص (10 ه)، وبمساعدة فروة بن مسيك الذي ولاه على مذحج. وأمره أن يقاتل بمن أسلم من لم يسلم، ولا يقاتل حتى يدعو على الإسلام. وفيها اصطدم خالد مع بني زبيد وهزمهم.
– وإلى شمال سرو مذحج أيضا، بقيادة علي بن ابي طالب، (رمضان 10 هـ)، في (300 فارس)، وفيها حدثت معركة مع بعض القبائل المذحجية التي رفضت الإسلام، ثم تجمعوا مرة ثانية فدعاهم إلى الإسلام فاسلموا. (وكانت مهمته تعزيزية لخالد بن سعيد، وأيضا الحكم بين تلك القبائل وتعليمهم، ويقال إنه دخل صنعاء. ثم المرور على نجران وأخذ الالتزامات المالية. ثم عاد وقابله في الحج.
– صُداء (شمال نجران في بيشة)، بقيادة قيس بن سعد، لكن زياد بن الحارث الصدائي ضمن طاعة قومه، فجاء بهم. ولم تذهب السرية
– إلى خثعم، سرية بقيادة قطبة بن عامر الأنصاري، (9 ه)، وحدث قتال، وعاد بالغنائم. ثم بعد حجة الوداع أرسل النبي سرية بقيادة جرير البجلي، إلى بجيلة وخثعم، لهدم صنمهم (ذي الخلصة)، ودعوة خثعم وإلا فالقتال. فأسلموا.
– إلى الأزد وجُرش، بقيادة: صُرَد بن عبد الله الأزدي، الذي أسلم فكلفه النبي بمقاتلة من يليه من المشركين.
الخامس: وبعض قبائل اليمن يبدو أنهم بادروا إلى الإسلام، فأرسلوا وفودهم، ومنهم: مأرب، والمهرة، وبنو نهد، وغامد، وبارق، وغافق، والرهاويين، وحوشب ذي ظليم.
وهنا نشير إلى أسلوب آخر تعامل به النبي مع نصارى نجران، فبعد مراسلة النبي ﷺ، حضر وفدهم للمباهلة، ثم اختاروا دفع الجزية، وأصبح ولاؤهم للمدينة. وقد أرسل النبي معهم أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة؛ لتثبيت هذا الارتباط.

دخول اليمن الإسلام:
قبل الإسلام، لم يكن لليمن نظام إداري مركزي؛ إذ عبر تعدد الوفود إلى النبي عن كيانات مستقلة. وقد هدف الإسلام إلى جمع القبائل على أساس العقيدة بدلاً من العصبية الجاهلية، وكذلك إيجاد نظام مركزي يجمع بين المركزية واللامركزية بنظام دقيق متوازن.
وبالنظر في اليمن في عهد النبي، فقد حدث لها تحول كبير من التمزق والتفرق إلى التوحد، وكان ذلك بثلاث خطوات:
– الأولى: إقرار زعماء القبائل على مناطقهم، مع مراعاة أن يكون مقبولا عند قومه. وأولهم باذان الذي أقره على الأبناء في صنعاء. ومنهم فروة على مراد وزبيد من مذحج، والطفيل الدوسي على قومه.
– الثانية: التنظيم الإداري في وحدات كبيرة، بشرط ألا ترتبط بالعشيرة، بهدف تذويب العصبية القبلية. مع مراعاة ألا يولي عليها أحدا بصفته القبلية. بل على أساس الكفاءة والقبول. مع مراعاة التقسيم الجغرافي لليمن. وتبدأ هذه الخطوة من بعد تبوك. وقد أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وضم تحتهما اليمن باستثناء حضرموت. وجعلها مخلافين: (في البخاري: بعث النبي أيا موسى ومعاذ، وجعل كلا منهما على مخلاف، واليمن مخلافان).
o المخلاف الأعلى، ويضم المناطق الجبلية الممتدة من شمال نجران حتى عدن جنوبا. وامر عليهم معاذ بن جبل.
o المخلاف الأسفل، (تهامة اليمن بدءا من جازان شمالا حتى عدن جنوبا). وأمر عليهم أبا موسى، ليس لأنه من أبناء المخلاف، بل لكفاءته ومكانته
– الثالثة: التنظيم الإداري الدقيق. وبدأها بعد حجة الوداع. ولم يعتد بزعيم القبيلة كمقوم إداري، بل أصبح بمثابة العريف ضمن سلسلة إدارية. واليمن أصبح ولاية كولاية مكة وغيرها من الأقطار. وأميرها معاذ بن جبل، وعاصمته: الجند. واختيرت الجند لأنها وسط قبائل حمير أكبر قبائل اليمن، ولها وزنها التاريخي عند اليمنيين. وقسمت اليمن على خمسة مخاليف في هذه المرحلة:
o مخلاف الجند، وأميره معاذ، وهو أمير المخاليف كلها.
o مخلاف صنعاء، واميره: شهر بن باذام. وقيل خالد بن سعيد. وقيل لما قتل الأسود شهر بعث النبي على صنعاء أبان بن سعيد بن العاص. وبعد وفة النبي ارتد قيس بن مكشوح لأنه توقع أن يكون هو الأمير.
o مخلاف حضرموت (وضم كندة والمهرة واقيال حضرموت)، وأميره: زياد بن لبيد البياضي. وكان النبي ولى المهاجر بن أبي أمية المخزومي، ولكنه مرض فجعل زياد مكانه.
o مخلاف تهامة، وأميره: الطاهر بن أبي هالة التميمي الأسدي، أخو هند، ربيب النبي.
o مخلاف مأرب، وأميره أبو موسى الأشعري. وقد ضم قبائل مذحج وغيرهم.
[في الإصابة: قال أبو موسى: بعثني النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم خامس خمسة على مخاليف اليمن أنا ومعاذ وطاهر بن أبي هالة، وخالد بن سعيد، وعكاشة بن ثور.]
– وإضافة إلى ذلك فقد قام النبي بتحويل في الارتباط التنظيمي، فكل وحدة إدارية لها واليها وقاضيها، ولها من يجمع الصدقات ويفرقها.
– ولاحقا في عهد الخلفاء أصبحت اليمن ثلاثة مخاليف فقط: الجند وصنعاء وحضرموت. وفي عهد أبي بكر صارت صنعاء هي عاصمة اليمن بدلا من الجند. وأصبحت اليمن في عهد أبي بكر تحت ولاية المهاجر بن أبي أمية، الذي قام بالقضاء على فلول المرتدين، كما في طبقات فقهاء اليمن.
هل كان النبي يولي أشخاصا مغمورين؟
وأشير هنا إلى زعم د نزار الحديثي أن النبي ﷺ ولّى على القبائل اليمنية أشخاصًا مغمورين، ليسوا من سادتها أو زعمائها، مثل وائل بن حجر وفروة بن مسيك وغيرهما. وهذه دعوى ضعيفة، وتتناقض مع الأدلة التاريخية والسياسات النبوية الحكيمة؛ لأن الأدلة التاريخية تؤكد أن النبي ﷺ اختار بعناية القيادات المؤثرة من السادة والزعماء المعروفين في قبائلهم، لضمان الاستقرار والولاء للدولة الإسلامية.
فمثلا: فروة المرادي مثلا كان سيد مراد، ويشهد على ذلك أيضا ما ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب أن فروة كان غاضبًا من قبائل كندة يوم الرزم، لأنهم لم ينصروه ضد همدان. هذا يعكس دوره القيادي وارتباطه بتحالفات قبلية كبرى.
ووائل بن حجر كان من أقيال حضرموت، وهو رئيس وفدهم الذي قدم إلى النبي ﷺ. هذا يدل على مكانته كزعيم يمثل قومه. وأبوه كان قيلاً في حضرموت، وقد استقبله النبي ﷺ بحفاوة خاصة، وبشّره بأن ذريته ستظل من الملوك في قومه، مما يعكس إدراك النبي لمكانته وتأثيره في قومه.
وقد اتبع النبي ﷺ منهجًا سياسيًا حكيمًا في تولية القادة، حيث كان يولي الشخصيات ذات التأثير في قومها، كما فعل مع زعماء حمير الذين ولاهم على قومهم، ومع أبي موسى الأشعري الذي ولاه على تهامة. وحتى عندما اختار أشخاصًا من خارج القبائل اليمنية، كما في حالة خالد بن سعيد بن العاص وغيره، فقد كانوا من القيادات الإسلامية البارزة، التي تمتعت بالكفاءة والخبرة اللازمة للقيادة.
ومن ناحية أخرى؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم – كما هو منهجه – كان يمكن أيضا للقيادات المستقبلية، ولا يعني أنه اختار المغمورين، بل يعني أنه اختار شخصيات يرى أهليتها للقيادة، فيدفعهم لتولي المسؤولية، لإعداد جيل قادر على إدارة الدولة في المستقبل. وهكذا فعامة أصحابه الذين حكموا العالم وأداروا شؤون، وأسقطوا الامبراطوريات هم من أولئك الأشخاص الذين تربوا على يديه، وظل يؤهلهم في المواقع القيادية المختلفة.
وحين طعن قوم في تولية النبي أسامة بن زيد قال: والله إنه لخليق للإمارة كما كان أبوه خليقا لها؛ مما يوضح أن اختياراته كانت مبنية على الكفاءة والجدارة.
والملاحظ أن الأشخاص الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن – سواء من أبناء تلك القبائل أو من غيرهم – قد ثبتوا وقت الردة، وهم الذين واجهوا الأسود وعامة المرتدين، فكانوا عامل استقرار لا انشقاق، مما يؤكد صحة سياسة النبي ﷺ، ودقة وكفاءة اختياره.