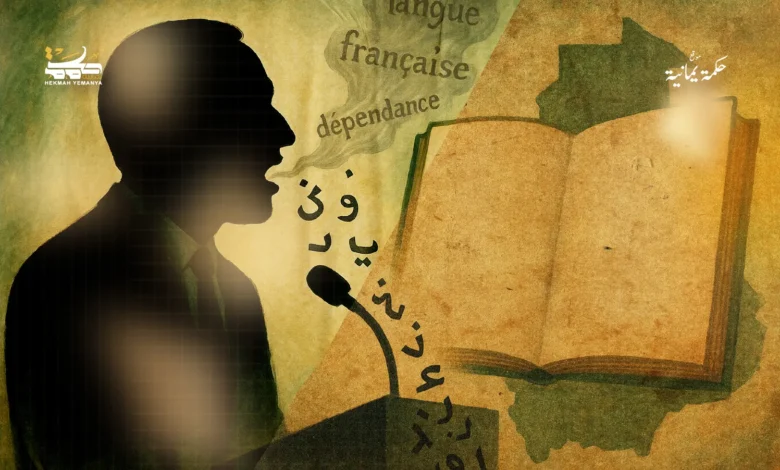
ليس من دأبي أن أتابع الإعلام الموريتاني، ولا خطب الرؤساء والوزراء والنواب؛ لأن المرات القليلة التي قُدِّر لي فيها أن أسمع خطبهم سبَّبت لي أوجاعا، ما أحب أن تتجدَّد، فقد كانت مؤسفة شكلا ومضمونا، وتنذر بأن البلاد تسير على غير هدى، وأن مسؤوليها لا يتصورون كيف تبنى الدول وكيف تساس، ويقول لسان المقال إنهم لا يستطيعون أكثر من العامية الهجين، ومن عجز عن القول، فهو عن العمل أعجز.، ويقول لسان الحال إنهم يحرصون على المناصب لينالوا ما فيها من المنافع، لا ليبنوا دولة، وآية ذلك أن المحسن منهم من يغادر منصبه كما وجده، وأنهم يرون الدستور والقوانين التي هي ضوابط، تدار بها الدول والعلاقات بين الشعب، وبين الشعب والحكومة نصوصا، وضعت ليُتمَّ بها جانب شكلي من جوانب الدولة، ولم توضع ليعمل بها. واستنتجتُ بعض ذلك من اعتراض أحد النواب على وزير، تكلم يوما بالفرنسية؛ لأنها ليست لغة رسمية، وكان مصيبا فيما قال، لولا عنف في لفظه، وعدم رفق في أسلوبه. ثم تدخلت رفيقته في المجلس، فخطَّأته، ودعت الوزير إلى أن يتكلم بالفرنسية، وبما شاء من اللغات؛ لأنها لا ترى بأسا بذلك. وكانت هي وسائر من سمعت من النواب يتكلمون بالعامية؛ فعلمت أن هيئات الدولة التشريعية والتنفيذية إما لا تفهم مقتضى بعض التشريع، وإما ترى أنْ لا بأس بترك العمل به. وعلى أي الوجهين حمل عملها كان مؤسفا.
ومن خطب الرئيس النادرة التي قُدِّر لي أن أسمع شيئا منها خطبته في كيفة، وكلامه بين يدي عبد المجيد تبون، بلغة، نسيتُ ما كانت، ألفصحى، أم الحسانية، أم مزيج منهما، لكني أتذكر أنه لما أحسَّ أن اللغة التي تكلم بها لا تُبلِّغه ما أراد، عدل عنها إلى الفرنسية، فما أطقت الاستماع إليه! أما خطبته في البيت الأبيض، فما أعلمني بها إلا صديق، أرسل إليَّ مقالة، كتبها أحدهم، يقول فيها: “حين شاهدت ولد الغزواني، رئيس موريتانية، يتلعثم في نطق الفرنسية أمام الرئيس الأمريكي، شعرت أن المشهد لا يخص موريتانية وحدها، بل يمتدُّ كنُدْبة (وصْمة) في جبين الأمة كلها. لم يكن مجرد خطأ بروتوكولي، بل لحظة مكثفة لفقدان المعنى، والهوية، والكرامة في آن! كيف لرئيس عربي، في قلْب مؤسسة دولية أن يتهجَّى لغة لا يتقنها، وليست حتى لغته، ليخاطب بها رئيسا، لا يفهمها؟! مشهد سريالي: المتكلم لا يجيد، والمخاطب لا يفهم، والجمهور ينظر إلى الغرابة وكأنها أمر طبيعي!”. وختمها، وهي طويلة شيئا، بقوله: “القادة الذين لا ينطقون بلغات شعوبهم لا يمثلونها، بل يمثلون عليها”.
ولما رجعت إلى دستور البلاد، ألتمس محل ما فعل الرئيس منه، وجدت المادة السادسة منه تنص على أن العربية هي لغة البلاد الرسمية، وتقول المادة الرابعة والعشرون إن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، وهو الذي يجسد الدولة، وتقول المادة التاسعة والعشرون إن صيغة القسم الدستوري الذي يُقْسمه الرئيس بعد أن ينتخب: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص، وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور، وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية”. لكني قلت: لعل الرئيس ومستشاريه لا يعرفون معنى أن تكون اللغة رسمية، فلم ير في الكلام بالفرنسية مخالفة للدستور. ومعنى أن تكون اللغة رسمية أن تكون هي وحدها لغة شؤون الدولة كلها، وألا يتحرك شيء في البلد إلا بها، من التعليم إلى لافتات المحالِّ التجارية، وكل استعمال للغة غيرها يعدُّ مخالفة دستورية، ولو كان المستعمَل لغة، ينص الدستور على أنها وطنية؛ لأن للغة الوطنية مقامات غير مقامات اللغة الرسمية. ومن نافلة القول أن الفرنسية ليست بوطنية، ولا رسمية، وكذلك العامية، وإن كانت أداء من أداءات العربية، فاستعمالهما في شأن من شؤون الدولة مخالف للدستور. وكلام الرئيس بغير العربية مخالف لما يوجب عليه الدستور من حماية اللغة الرسمية، وتجسيد الدولة، والبر بقسميه في الولايتين، أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. وكذلك خطبة الوزير بالفرنسية في مجلس النواب، وكلام النائبة التي أذنت له أن يخطب بها. على أن تعطيل المادة السادسة من الدستور مما عمت به البلوى، فالعامية هي أكثر ما يتكلم به الرؤساء والوزراء والموظفون السامون في المقامات كلها، وتستعمل الفرنسية في بعض الإدارات، مع أن الشعب لا يعرفها، ويقسم التعليم والحياة العامة بينها وبين العربية، ولا ترى كلمة أو عبارة بالعربية في ورقة رسمية، أو إعلان رسمي أو شبه رسمي، أو لوح إرشادي، أو لافتة، إلا وتحتها أو بجانبها مرادفتها بالفرنسية. ومن سار في شارع من شوارع نواكشوط خيل إليه أنه في بلد يسكنه شعبان: عربي وفرنسي!

واللسان دليل على القلب، والتكلم بالفرنسية حيث لا ينبغي أن يتكلم بها يدل على ما يجنُّ القلب من تعلُّق الثقافة الفرنسية، والإعجاب بالفرنسيين، والحرص على مماثلتهم. واللغات أصوات طبيعية (فيزيائية)، تنتجها أعضاء النطق بتصرفها في الهواء الخارج من الصدر، وهي متساوية في الماهية، ومتكافئة في التعبير عن المراد، ولا تتفاضل، فالعدول عن بعضها إلى غيره إنما يفعله من يعظم من يتكلم بها، وتعظيمه مسألة نفسية ثقافية خارجة عن ماهية اللغة، ولا تعني أن اللغة المعدول إليها خير من المعدول عنها.
واللغات الأجنبية لا تجاد إلا بعد عمرٍ واطلاعٍ كبير على آدابها وثقافتها، وهذا لم يتح لأكثر المغرمين بالفرنسية من أبناء المستعمرات، وإن خُيِّل إليهم غير ذلك، فهم لا يعرفون منها إلا ما يعرف الهنود العاملون في الخليج العربي من العربية، والفرنسية التي يتكلمون بها ليست بأحسن من لغة “فيه معلوم”، وهي لغة، هجَّنها عمال العجم في الخليج العربي من العربية واللغات الهندية، يذكَّر فيها المؤنث، ويؤنث المذكر، وتوضع الضمائر في غير موضعها، وتحذى الجملة على الجملة الهندية، وتنطق الحروف نطقا غير صحيح، فتجعل الضاد دالا، والطاء تاء، والصاد سينا، والسين صادا، إلخ، وظنُّ من يتكلم بها أنها عربية، وأنه يجيد العربية، إذ يتكلم بها، وهْمٌ، صنعه الجهل بالعربية. وإذا سولت للمرء قلة علمه باللغة أن يتكلم بها مع غير أهلها؛ لأنه لا يفطن لما يأتي من أخطاء، ولا يرى به بأسا، إن فطن له، فليزعْه عقله وما يقوله العالمون عن التكلم بها عند أهلها، وإلا كان ضُحْكة، وليتكلم بلغته ما استطاع، ولا سيما إذا كان يمثل دولة، ما يسره أن يسقطها من الأعين.
ومن كان معجبا بالفرنسيين فليتأسَّ بهم في حب لغتهم وثقافتهم، وصيانتهما، والاعتزاز بهما، فيعتزّ بلغته وثقافته، ويصونهما، لا أن يعشق الفرنسية كما يعشقها الفرنسيون، ويحتقر لغته كما يحتقرونها. لقد أصدر الفرنسيون عام 1794 م قانونا، ينص على أن “الفرنسية هي الأمة الفرنسية”، وأصدروا في القرن الماضي قوانين عدة، تحرم استعمال كلمة من غيرها، وتغرمه، ولذلك لا يجرؤ رئيس ولا وزير فمن دونهما أن يستعمل كلمة غير فرنسية في مقام رسمي، أو يلحن، فإن فعل شنَّ عليه الشعب هجوما، كما شنت الصحافة هجوما على جاك شيراك أن تكلم بجملة إنجليزية، وهو في زيارة لأمريكة، وثار الطلاب الفرنسيون في وجه وزير الثقافة أن نطق بكلمة إنجليزية عفواً، في خطبة له في السربون، وظلوا يصرخون مقاطعين حتى اعتذر. وانتقدت الصحافة على وزيرة في حكومة ساركوزي؛ أن جمعت banal على banaux؛ فشهَّرت بها، وقالت إنها أساءت إلى الفرنسيين، حتى أقرَّت بخطئها، وأصلحته في التلفزة، واعتذرت من لحنها. ولما تكلم إيرنست أنطوان سيلييه بالإنجليزي، وكان يتكلم باسم التجار الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل في 25/3/2006 ، قاطعه جاك شيراك بعد أول جملة، قائلا: لماذا -بربك- تتكلم بالإنجليزية؟ فردَّ عليه: “لأنها لغة التجارة”، فخرج هو ووزيرا خارجيته وماليته من المؤتمر مغاضِبينَ، وقال -لما سئل عن سبب خروجه-: لقد ساءني أن أرى فرنسيا، يتكلم بغير الفرنسية؛ فخرجتُ؛ لكيلا أستمع إلى امرئ لا يحترم لغته. وفي مونتريال، عاصمة كيبيك الناطق بالفرنسية في كندة، شرطة تسمى شرطة اللغة، تغيِّر أسماء المحالِّ والشوارع من الإنجليزية إلى الفرنسية، وقد بلغ ما أنفقت على تغيير إشارة stop الإنجليزية إلى arrêter الفرنسية 600 ألف دولار. والأمثلة جد كثيرة، وهذا يبين عما أردت.
فليقتدِ أهل شنقيط بالفرنسيين في تعظيم لغتهم وصونها، وبأهل مونتريال في تخليص شوارعهم من الإنجليزية، فذلك أليق بهم، وبمكانتهم التاريخية والحضارية والعلمية من التعلق بالفرنسية. ثم إن الفرنسية غدت لغة متخلفة، يوشك أهلها الذين رأينا تعظيمهم لها يظعنون عنها إلى الإنجليزية، ويخلُّون بينها وبين حكومتهم، ترغم عليها مستعمراتها في إفريقية، كموريتانية، وتوهمهم أنها هي سبيل التنمية، وتخطط لأن تجعل 86% منهم يتكلمون بها عام 2050، ليكونوا أرحاما مصطنعة للفرنسية، بعد أن غدت فرنسة غير صالحة لحملها، مع أن الأفارقة ما أفادوا منها شيئا، منذ استعملوها قبل أكثر من قرن. لقد صارت الإنجليزية هي لغة مدارس فرنسة العليا ومعاهدها التجارية، و30٪ من كلياتها الهندسية، وينشر بها 90٪ من بحوث الرياضيات والفيزياء والطب، ومستعملوها يزيدون على نصف الباحثين الفرنسيين في المختبرات الطبية. ولا يزيد ما ينتج بالفرنسية من المعرفة العالمية على 5ر2٪، ولا يزيد ما ينشر بها من البحوث العلمية على 4٪، ويأتي ما ينشر بها من الكتب كل عام في المرتبة العاشرة. وصار بعض اللغات أهم منها وأكثر انتشارا في العالم، كالعربية، واليابانية، والألمانية، والإسبانية. وإذا كان تعلُّمها يوما رمزا للحداثة، فقد غدا ضربا من الوقوف على الأطلال، (وتلك الأيام نداولها بين الناس).

