
ليس كلُّ فضيلةٍ طُويت يُتاحُ لها لسانُ حسودٍ؛ فقد يُتاحُ لها قلمُ محبٍّ، أو اهتمامٌ شغوف. وفي عالم الكتب يُغمر الكثير منها، وتتجاهله الأجيال، حتى إذا هيَّأ اللهُ له من يبعثه، كان مبعثُه له لا يقلُّ أهميةً عن تأليف مؤلفه له. والأمثلة كثيرة؛ وأين كانت مقدمةُ ابن خلدون منطويةً في غياهب التاريخ، حتى هيَّأ اللهُ لها من يبعثها، وذلك على يد المستشرق الفرنسي كاترومير(1857)، ثم تبِعه نصر الهويريني (1874) فنقلها إلى العربية، فصارت ملءَ سمعٍ وبصرٍ للدنيا، تتناهبها أقلامُ كبار علماء الأرض، مسلمٍ وغيرِ مسلم، في فنونٍ كثيرةٍ من فنون العلم كالتاريخ والاجتماع والأدب.
وقُل مثل ذلك في الموافقات للشَّاطبي، على يد الأستاذ الإمام محمد عبده (1905). لكنَّ بعثَ كتابٍ أو كاتبٍ من جديدٍ يخضع لظروف الزمان والمكان، ومتطلباتٍ كثيرةٍ من ظهور فكرةٍ، أو نشوء جماعةٍ، أو تسَيُّدِ فنٍّ من الفنون.
ظلَّ العلامة ابنُ عبيد الله السقاف (1375هـ) متواريًا في صحراء حضرموت، لا يعرفه سوى القلَّة القليلة من المرتبطين به فكرًا أو جغرافيا، ولم تجد كتبه منفذًا إلى النور طيلة نصف قرنٍ مضت، حتى شاء الله أن يهدي أحدُهم كتابَه العود الهندي للشيخ الدكتور الأديب عائض القرني في دولة الكويت.
يقول الدكتور عائض: أخذتُ أتصفَّح الكتاب، فأعجبني فانهمكتُ فيه حتى التهمتُه، فوجدتُ تأليفًا من طرازٍ آخر، فكتبتُ عنه تغريدةً طارت بها الريح، وسارت بها الركبان، حتى نُفدت طبعات الكتاب من المكتبات، فطُبع من جديد، وتمَّ بعدها البحثُ والتنقيبُ عن ابن عبيد الله فقيهًا ومؤرخًا وشاعرًا… إلخ.
سألتُ مسؤولَ مكتبة المنهاج في جدة عن كتاب العود الهندي، فقال لي: ظلَّ الكتاب معنا في المخازن سنوات، لم نبعْ منه سوى نُسَخ معدودة، حتى تكلَّم عنه الدكتور القرني، فنفدت جميع النسخ في وقتٍ قياسي.
ابنُ عبيد الله تعرَّض لتغييبٍ متعمَّدٍ وممنهج، ومن قرأ ابنَ عبيد الله في جميع كتبه أدرك سببَ هذا التغييب، وليس هذا بموضوعنا، وإنما نتكلم عنه كأديبٍ من خلال كتابه العود الهندي، وانطباعاتِ قارئٍ سكر من أريج عوده الهندي حتى ثمل، وقرأ الكتاب مرتين قراءةَ فاحصٍ مدقّق، فلم يشبعْ ولم يرتو منه، بل ازداد ظمأً على ظمأٍ، وجوعًا له على جوعٍ.
العود الهندي على أمالي الكندي ستةَ عشرَ مجلسًا في شرح أبياتٍ مختارةٍ للمتنبي، أملاها ابن عبيد الله في دكَّةِ جامعٍ في السوق بعد صلاة العشاء.
وحضرموتُ ولَّادةٌ بأفذاذٍ من العباقرة، فابنُ خلدون منسوبٌ إليها، والمتنبي كِنديٌّ منها، وقبله امرؤُ القيس مقدَّمُ الشعراء بلا منازع، وفي الطريق تجد عليَّ باكثير روائيًّا، وابنَ عبيد الله موسوعيًّا. والعجيب أن المتنبي حضرمي، وشارحه في العود الهندي حضرمي، وناشره في دار المنهاج حضرمي — وهذه مسروقةٌ من مقدمة الدكتور عائض.

ابنُ عبيد الله تقرأه وأنت على حذرٍ منه؛ يُطربك أديبًا، ويبهرك حافظًا، ويُعجبك ثائرًا، وقد يصرعك صوفيًّا، وله فيها شطحاتٌ، لكنه غيرُ راضٍ ولا آبهٌ بما عليه قومُه؛ يحذر منهم أشدَّ الحذر، ويَنهال على معتقداتهم الباطلة، وموروثاتهم الاجتماعية، وأخلاقهم غير المرضية، ناقدًا لاذعًا، وهذه من أسباب تغييبه المتعمد.
بالعودة إلى العود الهندي، فقد كانت لي معه مسامراتٌ ومعانقاتٌ، بل واحتضانٌ كاحتضان الحبيب للحبيب، وشغفٌ كشغف المراهق بالجديد، ووَلَهٌ كولَه الأرملة بالوحيد.
الكتابُ الوحيد الذي تمزَّق بين يديَّ، كنتُ أقرأ في العود الهندي فأقلِّب الصفحات كم بقي منها، فإذا تقلَّصت توقفتُ عن القراءة حتى تطول صحبتي له؛ أرتشف ورقاته ارتشافَ متلذّذٍ، وأستمتع بوقتي معه استمتاعَ عاشق. كنَّ بناتي يقلن لي: “يا حبَّك لهذا الكتاب! أخذَك علينا هذا الكتاب!”، وإذا تحدَّثنا عن الكتب قُلن لي: “كتابُك المفضَّل”، ومرةً مرضتُ فقلن لي: “وش نجيب لك؟” فقالت إحداهن: “كتابُه المفضَّل!”
ظهر ابنُ عبيد الله في العود الهندي كموسوعةٍ أدبيةٍ، ينقلك من الشاهد الشعري إلى النكتة الممتعة، ومن المقولة الأدبية إلى القصة الطريفة. لا يكتفي بمجرد ذكر طرائف الأدب، بل تتنقل معه بين مباحث الفكر وغوامض النفس ومسائل الفقه، ثم يعود بك إلى نكتةٍ تجعلك تضحك وحيدًا كالمجنون.
ومن شواهد تبحُّر ابن عبيد الله في الأدب أنه لا يكتفي بدور الناقل، وإنما يقوم بدور الناقد، وليس الناقد الناقل للنقد، بل المبتكر له والمعترض بالدليل والشاهد.
تكلَّم عن قول المتنبي: هنَّ أحلى عندي من التوحيد، فأشفى وأكفى، فنقد النصَّ ونقدَ النقدَ للنص.
ومن شواهد قوة حفظه أنه أملى الكتاب كله من حفظه، ولم يكن لديه إلا ديوان المتنبي بشرح العكبري، فسماه الأمالي. ولا أُبالغ إن قلتُ إن أماليه خاتمةُ الأمالي، ومجلسه على الطراز الأول من أمالي كبار فقهاء اللغة أمثال ابن قتيبة والمبرِّد والقالي.
أحصيتُ ما يقارب خمسين موضعًا في الكتاب يقول فيها: “ولا يحضرني المرجع الآن.”
ابنُ عبيد الله شخصياتٌ متعددة في شخصٍ واحد: فهو الأديب غيرُه السياسي، غيرُه الصوفي، غيرُه الناقد، غيرُه المشاغب على الموروث.
وأقربُ ما يمكن الاستشهادُ به عليه قولُ المتنبي:
هو البحرُ غُصْ فيه إذا كان ساكنًا
على الدُّرِّ واحذرْه إذا كان مُزبِدَا
وإلى العود الهندي، وهذا كل ما عندي.

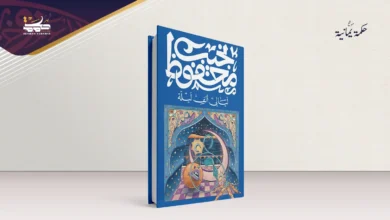
أفصح الله لسانك
يا شيخ عبدالله النهيدي
شوقتنا لقراءة الكتاب