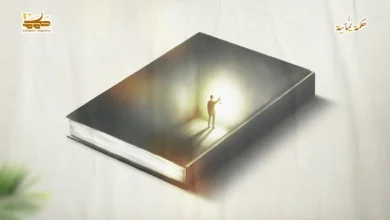لطالما شكلّت الوقائعُ مرايا لتصوّراتِ النّاسِ، ولطالما برزت من خلالها أفكارهم ومعتقداتهم عن الوجود والحياةِ، وكلّما كانت الوقائعُ أشدّ كان انعكاسُ التّصوراتِ أوضحَ..
لعلّ من أبرزِ هذه الوقائعِ مُكاشفةَ لنفوسِ النّاسِ وتصوّراتِهم: الكوارثُ الطّبيعيّةُ كالزلازلِ والأعاصيرِ، أو الأحداثُ المُفاجئةِ والمقصودُ بها التّحوّلاتُ الاجتماعيّةُ أو الثقافيّةُ أو السّياسيّةُ أو العسكريّةُ الكبيرةُ الّتي تأتي خلافَ كلّ التّوقعاتِ والقراءاتِ الماديّةِ البحتةِ…
الكوارثُ الطّبيعيّةُ
إنّه من أكثرِ التّصوراتِ بروزًا عند حدوثِ كوارثَ طبيعيّةٍ ما، هي علاقة القدرِ بالإيمانِ، وهل ما يحدثُ من زلازل وأعاصير هو عقوبةٌ إلهيّةٌ أم هو امتحانٌ، وهل حدوثه في ديار الإسلام كما حدوثه في ديار الكفر؟؟
قبل الخوضِ في جوابِ هذه الأسئلة التي من العجيب أنّها صارت اليومَ مُربكةً لتصوّراتِ عديد النّاسِ رغم شدّة وضوحها في أزمنةٍ مضت، لِزامٌ علينَا تفكيكُ بعضُ التّصوّراتِ المُعاصرةِ الّتي تمنع الاهتداء بنورِ الوحيّ الأوّلِ، والّتي بتفكيكها يجدُ المرءُ نفسه أما الجوابِ واضحًا..
إنّه من أكثرِ التّصوراتِ بروزًا عند حدوثِ كوارثَ طبيعيّةٍ ما، هي علاقة القدرِ بالإيمانِ، وهل ما يحدثُ من زلازل وأعاصير هو عقوبةٌ إلهيّةٌ أم هو امتحانٌ، وهل حدوثه في ديار الإسلام كما حدوثه في ديار الكفر؟؟
قبل الخوضِ في جوابِ هذه الأسئلة التي من العجيب أنّها صارت اليومَ مُربكةً لتصوّراتِ عديد النّاسِ رغم شدّة وضوحها في أزمنةٍ مضت، لِزامٌ علينَا تفكيكُ بعضُ التّصوّراتِ المُعاصرةِ الّتي تمنع الاهتداء بنورِ الوحيّ الأوّلِ، والّتي بتفكيكها يجدُ المرءُ نفسه أما الجوابِ واضحًا..
إنّه ممّا انتشرَ اليومَ باطلًا بين النّاسِ تفريقهم بين البلاءِ والابتلاءِ، أنّ الأوّل يكون بالشّرّ أو في معنى العقوبة، وأنّ الثّاني يكونُ تربيةً للمؤمنين. والغريبُ أنّه ما من عالمٍ أو مفسّرِ ذهبَ هذا المذهبَ في التّفريقِ، بل كلّهم في هذه الجهةِ على عدمِ التّفريقِ بينَ المعنيين، يقولُ اللّه تعالى:” فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ“، فهذا الابتلاءُ بالمعنيينِ، يقولُ اللّهُ تعالى:” وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ”، ويقول تعالى:” وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا”، فهذا البلاءُ على المعنين أيضا..
وإنّما أجمع السّابقون على اجتماعِ البلاء والابتلاءِ في معنى الاختبارِ واشتراكهما في الخير والشّرّ، وعلى قاعدة أنّ كلّ زيادةٍ في المبنى زيادةُ في المعنى فرّقوا بين المعنيين من جهاتٍ أخرى… قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: “لما كان الاختبار يوجب الضجر والتعب سُمي بلاء، كأنه يُخلِق النفس، ثم شاع في اختبار الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس، وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر، فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح .. فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل بالعبد لأن بها يختبر مقدار الصبر والأناة.”
وقال أيضا: “الابتلاء افتعال من البلاء، وصيغة الافتعال هنا للمبالغة، والبلاء الاختبار”
وإنّه ممّا يمكنُ أن يُضيفَ المرءُ في هذا البابِ -وماذا ترك الأوّلُ للآخر؟- أنّه بتتبّع مادّةِ البلاءِ والابتلاءِ في القرآن الكريمِ وفي كلام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، المُلاحظُ أنّ البلاء دائما يأتي في سياق ذكر الفعل في ذاته موصوفا في جنسه أو أنواعه أو درجته أو كلّ ما تعلّق بالفعلِ في نفسه، أمّا الابتلاءُ فيأتي في سياق ذكرِ الفعلِ متعلّقا بالمفعولِ أي في وصف علاقة المُبتلِي بالمُبتلَى أي اللّه بالإنسانِ أو ما تؤول إليه أو حال المُبتلى فيه، وهذا المعنى قد يتّفقُ مع معاني الأوزانِ الصرفيّةِ بين الفعلِ والافتعالِ، واللّه أعلم..
هذا عن الغبش الذّي طال معنيي البلاء والابتلاء، ويلي هذا مسألةُ أخرى مهمّة، وهي علاقة الأقدارِ بالذنوبِ والمعاصي، وهي كذلك مسألة يتلجلج فيها كثيرٌ من النّاس، فبعض النّاس اليوم تحت قصف فلسفاتِ الغرب لم يعد يدرك في الأقدارِ شيئًا من الغيبِ إلا القولَ الإجماليّ بأنّ اللّه هو المقدّرُ… فلا يقرأ أيّ حدثٍ إلّا من زاوية ماديّةٍ بحتة، فالزلازل ليست إلا ناتجةً عن حركةِ صفائح الأرضِ والأعاصيرُ ليست إلا نتيجة استمرار صعود الهواءِ السّاخن وتكثّفه… ولكن أين يدُ اللّهِ؟ أمقتصرةٌ أنّ هذا أثر الخلقِ؟
إنّ ممّا يُشكل على أصحابِ هذه القراءةِ أنّ القولَ بارتباطِ القدرِ بالذّنبِ يقتضي عندهم مقتضياتٍ هي في حقيقتها غير لازمةٍ، وهي أن القول بارتباط القدرِ بالدّنوبِ يقتضى ذمّ المقدّر عليه، وأنّ هذا مطعن في سلوكه، وهذا غير صحيح البتّة، فالإنسانُ عموما كائنٌ مذنبٌ وليس يختلفُ هذا عن قولنا بإنسانيّة هذا الإنسانِ، وليس ربطُ القدر بالذنب بمعيب أو منقصةٌ إنّما هو قراءةٌ إيمانيّةٌ تربطُ أسبابَ الشهادةِ بأسبابِ الغيبِ، قال تعالى :”وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير”، وقال تعالى :”أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”، وهذه الآيةُ في المؤمنين الّذين حاربوا مع رسول اللّه في أحد، وعصوا الأمر ونزلوا من جبل الرّماةِ، وهي آيةُ تربية وتعليمٍ، ولم يتلقّاها أي من علماء المسلمين بهذا الفهمِ المعاصر في معنى الذّم والطعن… فالذنبُ قدرٌ والأقدارُ تُسبّبُ الأقدارَ، فإن كانت بعض الأقدارِ الماديّةِ تظهر فإنّ بعض الأقدار الأخرى تخفى، وليس في ارتباط القدر بالقدرِ ارتباطَ الأسباب بالمسببات بحاكمٍ على المُقدّرِ عليه ذمًا أو مدحًا، إنّما يُنظرُ في شيءٍ آخرٍ، وهو المسألةُ التاليةُ التي يجبُ بيانُها وهو متى يكونُ القدرُ تربيةً ومتى يكونُ عقابا..
إنّه لا يمكنُ مقاربةُ معرفةِ إذا ما كانَ القدرُ الواقعُ تربيةً أو عقابا -وأقول مقاربة لأنّه أمر لا يمكنُ البتُّ فيه بشكلٍ قطعيٍّ- إلّا بأثرٍ رجعيٍّ، ذلك أنّ أهمّ محدّداتِ ذلك هو حال المقدورِ عليهِ عند القدر وعمله إزاءه، أي أنّ الصّابرَ المحتسب ابتلاؤه تربيةٌ وأنّ السّاخط القانط ابتلاءه عقوبةٌ، وهذا لا يُعرفُ إلّا بعد انقضاء القدرِ…
هذا من جهةِ الفردِ أما من جهةِ المجتمعِ والأقدار العامّةِ، فإنّ النّظرَ إليها يكونُ من جهتينِ، من جهة العموم، ومن جهة الخصوص، أمّا من جهةِ العموم، فالأقدارُ تكونُ على حسبِ الحكمِ العامِ على النّاسِ الواقعِ عليهم القدرُ، فإن كان حكمهم الإيمان فهم أقربُ إلى الصّبر وإن كان حكمهم الكفر فهم أقربُ إلى السّخط، وهذا كما في حديث: “أنهلك وفينا الصالحون؟” فهذا هو الحكم ُ العامّ، أما الحكم الخاصّ، فهو أنّ البلاء العامَ من جهةٍ لا يمنع اختلاف مراتبِ النّاسِ فيه، فهمنهم الصّابر ومنهم السّاخطُ، ومثل هذا ما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها أيضا بلفظ:” إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ،أَنْزَلَ اللهُ بَأسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ كَانَ فِيهِ صَالِحُونَ, يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ.”
كان كثيرٌ من السّلفِ يكرهون الخوض في القدرِ، وما هذا إلّا لفقههم أنّ الاستغراقَ في هذه الأسئلةِ المحيّرة لا يصلُ بالإنسان مهما نما عقله إلى جوابٍ قطعيّ باتّ من جهةٍ، كما أنّه من جهةِ أخرى قد يؤدّي بالمرء إلى ذهولِه عن المطلوبِ إزاءَه، فيستغرقه النّظرُ في محتمل مآلاتِ القدر عمّا شُرعَ من الفعلِ حال وقوعه وهو المطلوب، فوقوع القدرِ يقتضي العملَ بالمشروعِ له لا محاولة معرفةِ الأسرارِ الغيبيّة وراءه..
الخلاصةُ من كلّ هذا أنّ وقوع الكارثةِ الطّبيعيةِ، آيةٌ من آياتِ اللّه الّتي تُرسلُ لمقاصدَ ربّانيةٍ مختلفةٍ كالتربيّةِ والتّمحيص والتّخويفِ والعقابِ.. وقراءةُ الآيةِ قراءةً إيمانيّة صحيحة تربطُ الشّهادة بالغيب كاعتبار أثر الذّنوبِ والمعاصي قراءةٌ صحيحةٌ تعزّز من إمكانيّة قيام الإنسانِ بالفعلِ الصّحيح تجاه القدر، إذ استحضار وقوع الانسان في المعصيّة وأثر ذنبه أدعى لتوبته وإخباته، فهو أدعى لصبره وتصرّفه الصّحيح المشروعِ حال وقوعه، أمّا القراءةُ الماديّةُ بصنفيها، الصّنفُ الّذي يُلغي الغيبَ ولا يعتبرُه، والصّنفُ الّذي يتعسّفُ عليه ويُحاول سبرَ أسراره بأدواتِ الشّهادةِ، فكلاهما قراءتان باطلتان مُهلكتان…

الأحداثُ المفاجئةُ
تجاه كثيرٍ من الأحداثِ المفاجئة الّتي تقعُ على غرّة من النّاسِ، وخلافًا لكلّ الحساباتِ والتّوقعاتِ، يبرز من خلال مواقف النّاس إطاران تحليليان، المؤامرة والمعجزة..
نظريّةُ المؤامرة.
تبنِّي النّاسِ لنظريّاتِ المؤامرةِ والاعتقادُ في صحّتِها عائدٌ بالأساسِ إلى أسبابٍ نفسيّةٍ عميقةٍ، خلافًا للآراءِ الّتي يعزُو أصحابُها مثل تلك النّظريّاتِ إلى السّذاجةِ والجهلِ أو الغباءِ…
يقول جان ويليم فان بروجين في كتاب “سيكولوجيّة نظريّات المؤامرة” :” وتشتركُ كلُّها في منحِ الفردِ ضربًا من الأمانِ داخلَ الجماعةِ الّتي ينتمِي إليها، وتقيه كلَّ ما يستهدفُه من عناصرٍ خارجيّةٍ، متوهّمةٍ أو محتملةٍ، وتتّخذُ لها عادةً قاعًا إيديولوجيًا يضمنُ بقاءَها وتماسكَها.
يمكنُنا القولُ إنَّ نظريّاتِ المؤامرةِ ليست في محصّلِ أمرِها إلّا ردَّ فعلٍ طبيعيٍّ، ذا منحَى دفاعيِّ، لِما يعتملُ في الذّاتِ من مشاعرِ الخوفِ وعدمِ اليقينِ، ومن تذمّرٍ وامتعاضٍ إزاءَ ما يبدرُ عن الآخرين من مواقفَ صادمةٍ وغير متوقّعةٍ بشأنِ ما يحدثُ.”
ممّا تنبني عليه هذه النّظريّاتُ ثلاثةُ مرتكزاتٍ مهمّةٍ:
النّظرةُ المثاليّة: عادةً ما يكونُ معتنقو هذه النّظرياتِ أصحابَ نظرةٍ مثاليّةٍ للأشخاصِ أو الجماعاتِ، فالشّخصُ الجيّدُ أو الجماعةُ الجيّدةُ دائمًا كذلك والشّريرُ دائمًا كذلك، بمعنى أنّهم لا يستحضرون حقيقةَ أنّ النّفسَ البشريّةَ مركبّةٌ من الخيرِ والشّرِ، فالخيِّرُ لا يقومُ بعملٍ مُشينٍ، والشّريرُ لا يُمكنُه أن يقومَ بعملٍ جيّدٍ، لهذا تُسبّبُ نظرتُهم الحديّةُ هذه اضطرابًا كبيرًا لهم في معايشةِ الواقعِ المركّب، الّذي يختلطُ فيه الخيرُ بالشّرِّ والحقُّ بالباطلِ، فتدفعُ بهم أنفسُهم إلى نظريّاتِ المؤامرةِ كإطارٍ تفسيريٍّ لما يحدثُ يُعزّزُ معتقداتِهم ويحميها، ليُهاجمَ من يُبغض ويُدافعَ عمن يُحبُّ..
النّزعةُ إلى التّبسيطِ والنّفرةُ من التّعقيدِ: عادةَ ما تروجُ نظريّاتُ المؤامرةِ حولَ الأحداثِ المعقدّةِ والمركّبةِ، وتكونُ هذه الأحداثُ في مستوى معيّنٍ من التّركيبِ يصعبُ على غيرِ المتابعِ أو المختصِّ الإحاطةُ بتفاصيلِها، هنا تبرزُ حالةُ الكسلِ أو العجزِ المعرفيّ لتكونَ محفّزًا لمثلِ هذه النّظريّاتِ، حيثُ يُعفي الإنسانُ نفسَهُ من مجهودِ البحثِ وتبعاتِ التّخصصِ، فالتّعقيدُ يحتاجُ جُهدًا في الفهمِ كما يحتاجُ جُهدًا للإفهامِ، وهذا مكلفٌ، فتنزعُ نفوسهم إلى تسطيحِ كثيرٍ من المفاهيمِ واختزالِها بشكلٍ مُخلّ يسمحُ بتأسيسِ نظريّاتٍ كهذهِ، وعادةً ما نسمعُ في مثل هذه النّظريّاتِ من يقولُ أنّه ببساطةٍ حدثَ الأمرُ أ فحدثَ الأمرُ ب، ولكنّكم لا تفهمون..
التّعالمُ ووهمُ المعرفةِ: قد سبقَ أنَّ هذه النّظريّاتِ تروجُ حولَ الأحداثِ المعقدّةِ والمركّبةِ، لذلك فإنّ كثيرًا من تفاصيلِها تبقى مجهولةً يكتنفُها الغموضُ، حيثُ يجدُ النّاسُ في هذهِ النّظريّاتِ ملجأً وتفسيرًا لما غابَ ويغيبُ عن أذهانِ الكثيرينِ من التّفاصيلِ دونَ الحاجةِ إلى كثيرٍ من التّعبِ، إذ تُوفّرُ لهم هذه النّظريّاتِ وهمًا معرفيًّا يُشعرِهم بأنّهم أفهمُ النّاسُ، ويسدُّ عندهم فجوةَ جهلِهم، ليبرزوا في صورةِ النّاقدِ الفاهمِ الّذي لا تغيبُ عنه شاردةٌ ولا واردةٌ، والمتفطنُ اليقظ..
هذه المرتكزاتُ النّفسيّةٌ وغيرُها تتظافرُ لإنتاجِ مثل هذه النّظرياتِ.
والعجيب أنّ مثل هذه النّظريّات قد تروج حتّى في تفسير كوارث طبيعيّة مثل ما حصل في “جائحة كورونا”…
نظريّة المعجزة.
في تعليقِ النّاسِ على بعضِ الأحداثِ، وفي لحظةِ انبهارٍ مفعمةٍ بالإيمانِ، يصفُ النّاسُ كثيرًا من الأحداثِ أنّها أشبهُ بالمعجزاتِ وأنّها بلا شكٍّ تدخّلٌ ربّانيٌّ.
وإن كانت هذه التّعاليقُ تُشيرُ إلى بقيةٍ من إيمانٍ في نفوسِ النّاسِ إلّا أنّها كذلك تُشيرُ إلى نقصٍ فيه من جهةٍ أخرى، وإلى فسادِ تصوّرهم في القدرٍ والشّرعِ.
أمّا من جهةِ القدرِ، فقد درجَ النّاسُ على لفظِ “المُعجزةِ” يُريدون به ما كان خلافَ العادةِ والسّنةِ وما كان من خوارقِ الأمورِ، ولو تأمّلَ النّاسُ في هذه الأحداثِ التّي يصفونها بالإعجازِ لَوجدوها على نقيضِ ذلكِ، ولكنّ نظرَ النّاسِ لحظيٌّ، لا يُبصرُ ما يسبقُ لحظةَ النّظرِ، ولَوجدوا أنَّ هذا الحدثَ إنّما هو سلسلةُ أحداثٍ كثيرةٍ مترابطةٍ بأسبابٍ، وأنَّ ما جرى ما هو إلّا تدرّجٌ قدريٌّ تُوّجَ في لحظةِ الحدثِ الّتي أبهرت أبصارَ النّاسِ، أي أنّ ما حدثَ إنّما هو النّقيضُ تمامًا للمعجزةِ، إنّها السّننُ، إنّها سنةُ اللّهِ في الخفضِ والرّفعِ، وسُنّةُ اللّهُ في إهلاكِ الظّالمينِ ونزعِ المُلكِ..
أمّا من جهةِ الشّرعِ، فإنّ هذه اللّحظةَ ليست لحظةَ إعجازِ تدخّلٍ ربانيٍّ بقدرِ ما هي لحظةُ شهودٌ ومكاشفةٍ لفعلِ اللّهِ في الكونِ والوجودِ. إنّ الكونَ كلَّه يسيرُ بأمرِ اللّهِ، فالحدثُ الّذي يوصفُ بأنّه تدخّلٌ ربّانيٌّ، لا يعني أنَّ غيره من الأحداثِ كانت تسيرُ سُدًى بلا حكمةٍ، لكنَّ يدَ اللّه الفاعلةَ في الوجودِ في كلِّ وقتٍ صفتُها اللُّطفٌ الخفيُّ، ومثلُ هذه الأحداثِ الّتي تظهرُ فيها الحقائقُ والّتي يُسمّيها بعضهم بالتّجلّي ويُسمّيها بعضهم بحقائق الإظهارِ أي إظهارِ أثرِ أسماءِ اللّهِ وصفاتِه في الوجودِ هي الّتي يشهدُها الإنسانُ مبهورًا مذهولًا..
الحقيقُ بهذهِ اللّحظةِ أن تكونَ لحظةَ تذكّرٍ وإدراكٍ ومراجعةٍ وتوبةٍ، لكنَّ جلالَ لحظةِ الشّهودِ يُذهلُ الإنسانَ فتستغرقُه اللّحظةُ الرّاهنةُ، إنّ لحظةَ الشّهودِ والمكاشفةِ هي لحظةٌ يجبُ أن يتذكّرَ فيها الإنسانُ من بعد نسيانِه أنّ كلَّ الكونِ بيدِ اللّهِ، لا أن يتذكّر اللّهَ فقط في تلك اللّحظةِ، وأنّ هذه اللّحظةَ التّي شهدَ فيها تجلِّي صفاتِه يجبُ أن يمتدَّ بمعناها إلى ما سبقَ من الأحداثِ وما سيأتي، وأنّ معاني لحظةِ الشّهودِ كانت سابقةَ الوجودِ..
هذه السّننُ في لحظاتِ ظهورِها هي تجلّي أثارِ أسماءِ اللّهِ وصفاتِه في الوجودِ، وهذا التّصوّرُ القدريُّ الشّرعيُّ هو التّصورُ الصّحيحُ لها، وهو الّذي يربطُ سُننيّةَ عملَ الإنسانِ في الدّنيا بمعاني الإيمانِ بالغيبِ و رجاءِ الدّارِ الآخرةِ ومعرفةِ اللّهِ..