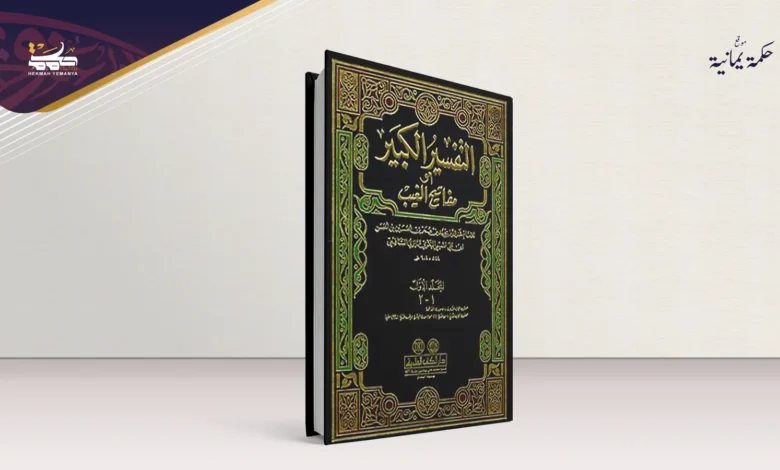
تفسير “مفاتيح الغيب”، أو التفسير المعروف بـ”التفسير الكبير”، والمنسوب أيضًا لاسم صاحبه “تفسير الرازي”؛ أحد أعظم وأجلّ مُدوَّنات التفسير القرآني على مدى الزمن .. والإمام الرازي هو فخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن. ولقبه “الرازيّ” نسبة إلى مدينة “الريّ”. وهي مدينة في إيران حاليًّا، ويُنسب إليها الكثير من الروازي؛ منهم: أبو بكر الرازي الطبيب المعروف (ت 311ه )، وأبو بكر الرازي الجَصَّاص (ت 370هـ) صاحب كتاب “أحكام القرآن”، والفخر الرازي صاحب كتابنا.
• عن الرازي الإمام العلَّامة
وُلد الفخر الرازي عام 544هـ، وتوفي 606هـ. وهو أحد أهم العلماء والمفكرين المسلمين إطلاقًا في كل العصور؛ حتى صار لقبه “فخر المِلَّة والدين”. برع في علوم جمَّة، وألَّف فيها جميعًا. ومن أجلّ تآليفه: التفسير المبسوط له هنا، وتفسيره الصغير (مجلَّدان كبيران) بعنوان “أسرار التنزيل وأنوار التأويل”، وكتاب “نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز” في البلاغة والتركيب القرآني المُعجز. وكتاب “المحصول في أصول الفقه” وهو من عُمَد العلم إطلاقًا. ومن كتبه في علم الكلام: “معالم أصول الدين” (الذي شُرح مرات)، وكتابه القيِّم “أساس التقديس” أو “تأسيس التقديس” في رفع مُشكلات الفهم لبعض قضايا العقيدة، و”الأربعون في أصول الدين”، و”الخمسون في أصول الدين”. وكتبه كثيرة في الفلسفة، منها “المطالب العالية” و”المباحث المَشرقيَّة”، وشروح كثيرة لكتب ابن سينا، وغيره، وتآليف في المنطق. غير أن له اهتمامًا بالفيزياء والطب والفلك، وألف فيها الكثير.
وقد كان تأثير الفخر الرازي بالغًا على مسار العلم الإسلامي؛ ومن أجلى تأثيراته أنه كان مُفتتحًا لمدرسة أو اتجاه سُمي بـ”مدرسة الأعاجم”؛ حيث جمع بين مباحث علم الكلام الصرفة ومباحث الفلسفة. وتوالت بعده الجهود في هذا الشأن، لتمثل مرحلة هامة في تاريخ الفكر الإسلامي العقديّ وغير العقديّ.
وقد أحدث أثرًا تداوليًّا هائلًا في المحيط العلمي، داخل دائرة أهل السنة العامة وخارجها، وفي دوائر الفلاسفة. وما ذلك إلا لاستقلاليَّة رأيه وثقته في علمه وما يصل إليه، حتى في مخالفته لمستقرّ مذهبه الفقهي والكلامي. وقد عاش عمره في حراك فكري مع المعتزلة والحشوية والشيعة والفلاسفة. وقد ناله أذى كثير من جراء هذا الحراك الفكري الواسع. ومن أبرز أعدائه المتربصين به اثنان، أحدهما سُنِّي والآخر شيعي، هما: الشيخ ابن تيمية (ت 728هـ)، والخواجه نصير الدين الطوسي (ت 672هـ). كلاهما قعد له مترصدًا كل مرصد، وألَّفا التآليف الطويلة لنقض ما يقول وما ذهب إليه. لكنْ أبت الأقدار إلا أن يثبت بعد موته، وتبقى آثاره ناصعة البيان كرائعة النهار.
• مَوطئ إلى تفسيره
أما تفسيره فقد برز عَلَمًا في تاريخ التفسير، ومَعلمًا وحدًّا له. وهو من أدنى كتب التفسير وُرُودًا على ذهن المُستحضِر لمُصطلح “التفسير القرآني”. وتفسيره من عُمَد اتجاه التفسير بالرأي. ولم يكمله الرازي نفسه، بل خلفه فيه بعض تلامذته (وهم أعلام مثله في العلم، لا في الشُّهرة) واستطاعوا النسج على منواله دون تفاوت ضخم. وقد طُبع مرات منذ دخلت الطباعة، ولكنه لم يشهد اهتمامًا لائقًا بمركزيته في تحقيق علمي يوازي ضخامة الكتاب حتى الآن. ونسخة “دار الغد العربي” التي أملكها جيدة في العموم، لا بأس بها. بل من مزاياها إفساح المساحات للعناوين العامة والخاصة على سطور الكتاب. وغالب طبعاته في ستة عشر مجلدًا، وهناك نسخة عدتها اثنا عشر مجلدًا، وهناك نسخة ثمانية مجلدات -على ما أذكر-. لكن الجيد رصفها في 16 في كل مجلد جزآن.

• سمتُ تفسير الرازي وفلسفتُه
سمتُ هذا التفسير سمتُ صاحبه؛ والأستاذ الرازي عالم دقيق جدًّا، مُتفنن، مُتوسِّع، ليس من أصحاب العلم الإجماليّ القشريّ، بل هو من الذين يفقهون دقائق الأمور. ولعل هذا ما أهَّله للبراعة في علم الأصلَيْن (أصول الدين، وأصول الفقه). وقد كتب الله له هذا السمت الدقيق في الفهم والإفهام، وهو صاحب نظر فارِق بل من ألمع مَن حصَّلوا هذه الهبة العزيزة. فكان نادرةً في الموهبة الفكرية والعلمية. والرازي حريص كل الحرص على انضباط الفروع على الأصول، والاطراد في النسق الفكري والمنهجي. وهذه الخاصَّة طبعت مؤلفاته طبعًا. وصار به من أكابر تشقيق الأفكار والمنازع، القادرين على الوصول إلى عُمق العُمق -إن صحّ التعبير-. ومطالعةُ أي كتاب له -مثلًا تأسيس التقديس- كفيلةٌ بسوق المثال لما عرضتُ.
ومتى أضفت هذا السمت إلى سعة أُفق الرازي؛ توضَّحتْ لك تلك البناءات العملاقة التي ستنتج عن هذا المزاج النادر. ولعلي بهذا أكون قد سُقتُ لك الرازي -برؤيتي الخاصة- سوقًا صحيحًا -إن شاء الله-.
وتفسيره بستان يانع من زهور المعارف الغضَّة؛ ونهر متدفق كثير الجداول الريَّانة. وقد اعتمد فيه -من وجهة نظري- على الخصائص التي أسلفتُ الحديث عنها، وعلى ثنائية “التركيب والتحليل”. فقد عرض لمستواه التركيبي في الفصل الثاني من مقدمة التفسير، الذي سمَّاه “في تقرير مَشْرَع آخر يدل على أنه يمكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة”، وعرض فيه عشر مراتب من الفهم. والفصل الثالث الذي عنوانه “في تقرير مَشرَع آخر لتصحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة”، وكذا من الباب المعنون “في المباحث المتعلقة بالكلمة، وما يجري مجراها”، فتناول فيها خمسين مسألة في الكلمة. وفي هذه المباحث النظرية القسم التركيبي للتفسير. وما هو إلا خلاصة المتانة المعرفية التي تصنعها علوم: البلاغة وأصول الفقه وأصول الدين في نفس العالم بها، بَلْهَ المتفنن فيها. يعرف هذا مَن خالط هذه العلوم وعاشرها.
• فُسَيْفِساء القرآن كما عرضها الرازي
وتقوم بنية “التفسير الكبير” للرازي -في نظري- على تحويل النص القرآني إلى ما يشبه لوحة الفُسيفساء الفاتنة. فاللوحة مع كمال مظهرها الكُلِّيّ تتكوَّن من عشرات أو مئات اللَّبِنات الصغرى، وهي “الوحدات المعنوية” في النص بشقيها (المبنى والمعنى)، وما بينهما من تداخلات. وفي سبيل الرؤية الكاملة للنص وَجَبَ عليه فحصُ هذه الفُسيفساء الدقيقة، والكشف عنها واحدًا واحدًا، وتبيين دورها في النص الكامل.
ويظهر ما قلتُ في التفسير، في تلك التقسيمات الكثيرة للمسائل والوجوه والتفريعات؛ حيث يحلل فيها صُغرى جزئيات النص القرآني، وصولًا إلى فهم كُبراه. وفي الكتاب آلاف المباحث اللغوية والنحوية والدلالية والبلاغية، والفقهية، والكلامية، والحِكْمية. مُستعينًا فيها بكم ضخم من علوم القرآن (القراءات، وعد الآي، والمناسبات، والمكي والمدني، وأسباب النزول، والمبهمات،….)، وعلوم عامة مساعدة شملت كامل بنية العلوم اللغوية والشرعية، وعلوم أخرى مباينة كعلوم الحياة والفلك والفيزياء.
وبالعموم، التزم الرازي تفسير القرآن بترتيبه، مع إيراد “ترتيب النزول” بعد اسم كل سورة (الاسم الأشهر)، ثم يُثنِّي بالمكي والمدني من السورة، وعد آياتها. ثم يقسم السورة إلى أقسام، ويتناولها آية آية، أو آيات آيات. مهتمًا بقراءاتها، وبكل وجوهها التفسيرية -كما سبق-.
ليُقدِّم الأستاذ الرازي ملحمة تفسيرية صارت مَعلمًا في تاريخ التفسير، ومرتكزًا له -كما سبقت الإشارة-.
وأصل الكتاب كله النقطة المركزية نفسها التي ارتكزتُ عليها في رؤيته؛ أقصد تشقيق المعاني. فقد بدأ الرازي رحلته بحكايته تلك: “اعلمْ أنه مرَّ على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة (يقصد سورة الفاتحة) يمكن أن يُستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة. فاستبعد هذا بعضُ الحُسَّاد، وقومٌ من أهل الجهل والغيّ والعِناد. وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني، والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلمَّا شرعتُ في تصنيف هذا الكتاب، قدَّمتُ هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمرٌ ممكن الحصول، قريب الوصول”. وهذا النقل يوضح لك حقيقة ما عرضت.
ويكفي في التدليل على الأمر تصوُّر أن سورة “الفاتحة” (وآياتها سبع) فسَّرها في جزء كامل من تفسيره. وتحتل في النسخة التي أمتلكها حوالي 330 صفحة وحدها. فهذا مقدار الدقة الفُسيفسائية التي رآها الرازي في النص القرآني الكريم.
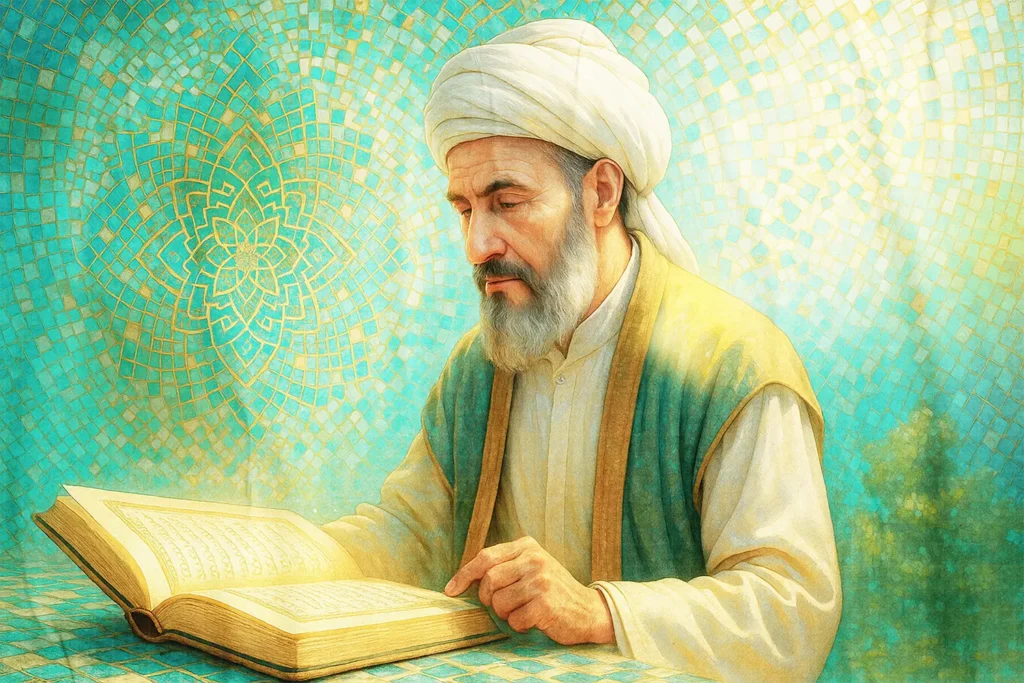
• نقاش الرازي مع معارضيه في تفسيره
وفي تشقيقه المعاني ناقش الكثيرين، وحاول الانتصار لمذهبه الشافعي في مواضع الأحكام، عارضًا للآخرين ومذاهبهم. وفي الكتاب عامةً أورد مئات الأقوال لأهل العلوم المختلفة من اللغويين بصنوفهم وأصحاب الأصول. ومع تسامحه في الفقه فلم يتسامح في العقيدة؛ فعارض المعتزلة في كل موضع ممكن، وعارض المُجسِّمة الكرَّاميَّة في كل موضع ممكن.
وعارض الزمخشري في الكتاب، رغم أنه في كثير من المواضع من العيال عليه. وتفسير الزمخشري عُمدة تفسير أهل الرأي، وغالب التفاسير تأثرت به واقتدت بدقته وفائق تدبيره، مع التنويه في المواضع العقدية المخالفة لرأيه.
• ردُّ التشنيع على تفسير الرازي
في بعض الكتب تشتهر جملة “التفسير الكبير به كل شيء إلا التفسير”. وهذه الجملة -في نظري- لها فهمان، أعجِّل بتوضيحهما.
الفهم الأول: وهو سليم النية، ويقصد أن الرازي لم يُورد ما يُسمى بـ”التفسير الإجمالي”. أي المعنى الإجمالي للآيات، وهو صُلب عمل المفسر. بل انصرف لتشقيق المسائل والوجوه على العلوم المختلفة. وهذا من جهة صحيح؛ فكثيرًا ما يورد الرازي الآية مُعقبًا إياها: “قوله تعالي (….) فيه مسائل أو مسألتان”، ثم يدلف إلى المسألة الأولى مباشرة، وتليها بقية المسائل. وهنا أوضح أمرين: أولًا أنه زاوج بين هذا وذِكر التفسير الإجمالي في الآيات، في مواضع عدة. وثانيًا أنه ما أورد هذا التشقيق المعنوي إلا لتوضيح معنى الآية إجمالًا، وإنْ لم يوردها صراحة مجموعةً في محل.
الفهم الآخر: وهو بغيض النية، ويقصد الاستهزاء والانتقاص. وقد عمل أعداء الرازي -من الحشوية والمعتزلة والمخالفون له عمومًا- على ترويج هذا القول. وليس لهذا الوجه رد في الميزان العلمي؛ فهو ليس مقولة علمية حتى يرد بالعلم. وحسبنا الكتاب وقيمته في العلم ردًا على هذا الفهم.
فهذه صفحة من أهم صفحات اجتهاد أبناء هذه الأمة، لرجل سخَّر كل ما جمع في سبيل استجلاء النص القرآني الجليل؛ فأتحفنا بهذا العمل الإبداعي الباهر.

