
يعدّ اليسار في الجنوب اليمني ظاهرة سياسية وفكرية معقدة، لا يمكن اختزالها في تجربة حزبية أو مشروع أيديولوجي؛ لأنها تعبير عن لحظة تاريخية معقدة، تداخلت فيها تحولات ما بعد الاستعمار، وصعود الحركات الثورية، وتقاطعات الصراع الإقليمي والدولي في سياق الحرب الباردة. وفي ظل هذا الصراع المتراكب نشأ اليسار الجنوبي في رحم مقاومة الاستعمار البريطاني، وتغذّى من منابع فكرية متعددة، تراوحت بين الماركسية اللينينية، والقومية العربية، والاشتراكية التحررية، متكئاً على طموح جارف لإعادة تشكيل المجتمع والدولة على أسس جديدة، تتجاوز البنى التقليدية، وتؤسس لمشروع حداثي جذري. غير أن هذا الطموح، الذي بدأ في لحظاته الأولى واعداً ومفعماً بالحيوية الثورية، سرعان ما اصطدم بجملة من التحديات البنيوية، الداخلية والخارجية، التي قادت إلى انحراف المشروع عن مساره، وانتهت به إلى الانغلاق، ثم الانهيار. ولفهم ديناميكية هذا المشروع من الناحية الفكرية، يقتضي مساءلة الأسس المعرفية التي انبنى عليها، والرهانات التي حملها، والآليات التي اعتمدها في بناء سلطته وممارستها. ذلك أن اليسار لم يكن فاعل سياسي، بقدر ما كان حاملاً لرؤية شاملة للعالم، تسعى إلى إعادة إنتاج الإنسان والمجتمع والدولة وفق منطق أيديولوجي صارم، يرى في نفسه تجسيداً للحقيقة التاريخية، وفي خصومه تجسيداً للرجعية أو الخيانة. وقد أدى هذا التمركز حول الذات إلى بناء خطاب شمولي، يقصي التعدد، ويعيد تشكيل المجال العام وفقاً لمقولاته الخاصة، مما أفضى إلى احتكار السياسة، وتشييء المجتمع، وتحويل الدولة إلى أداة في خدمة المشروع الأيديولوجي، لا وسيطاً محايداً بين المصالح الاجتماعية المختلفة. ومنذ اللحظات الأولى للتشكل، استند اليسار الجنوبي إلى سردية ثورية ترى في التاريخ خطاً تصاعدياً نحو التحرر، وفي الحزب الإشتراكي الطليعي أداة لتحقيق هذا التقدم. غير أن هذه السردية، التي استلهمت النموذج السوفيتي، أغفلت تعقيدات الواقع اليمني، وتنوعه الثقافي والاجتماعي، وخصوصياته الدينية والتاريخية، ما جعلها تنزلق إلى فرض نماذج جاهزة ومتسوردة من خارج الذات اليمنية. ومن هنا، فإن المشروع اليساري في الجنوب كان محاولة لتجاوز البنى التقليدية، ومشروعاً لإعادة هندسة المجتمع، وفق رؤية ترى في الدولة أداة لإنتاج الإنسان الجديد، وفي الحزب جهازاً لإعادة تشكيل الوعي الجمعي. وهذا ما أدى في نهاية المطاف إلى ما يمكن أن نسميه بـ” الاغتراب السياسي”، حيث لم يعد النظام يعبّر عن روح المجتمع، مما عمّق الفجوة بين السلطة والناس، وأضعف من شرعية المشروع اليساري ذاته. وبدلاً من أن يكون مشروعاً للتحرر، أصبح في كثير من مراحله مشروعاً للهيمنة، يُعيد إنتاج منطق السيطرة، ويقصي كل من لا ينضوي تحت لوائه.
تعد تجربة اليسار في جنوب اليمن، ممثلة في الحزب الاشتراكي اليمني، واحدة من أبرز التجارب السياسية التي تستحق الدراسة النقدية في سياق التحولات الفكرية والاجتماعية التي شهدها العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فقد نشأت هذه التجربة بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1967م، حين تشكلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وتولّت قيادة الدولة فصائل ثورية متعددة قبل أن تندمج لاحقًا في الحزب الاشتراكي اليمني، الذي أصبح القوة السياسية الوحيدة والمهيمنة على مؤسسات الدولة. وذلك بسبب اعتماد الحزب الاشتراكي اليمني الاشتراكية العلمية كمرجعية أيديولوجية حصرية، وسعى لبناء دولة مركزية تعتمد على تأميم الاقتصاد، وتفكيك البنى التقليدية، وإعادة تشكيل المجتمع وفق تصوراته الثورية المستوحاة من النموذج السوفيتي، دون أن تخضع هذه التصورات لعملية نقدية تراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجنوبي. وعلى الرغم من الإخفاق السياسي لهذه التجربة، فإنها تبقى تجربة تاريخية مهمة لفهم تعقيدات العلاقة بين الأيديولوجيا والسلطة، والطموح الثوري والواقع الاجتماعي، وبين الرغبة في التغيير وحدود الإمكان.
لقد قدّم اليسار الجنوبي، رغم إخفاقه في تحقيق أهدافه السياسية، مساهمات فكرية وتنظيمية لا يمكن تجاهلها، وفتح آفاقاً للنقاش حول قضايا العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني وبناء الدولة والمواطنة والهوية. وفي هذا الإطار، يمثل كتاب “سقوط الرفاق: لماذا فشلت تجربة اليسار في جنوب اليمن؟” للدكتور جمال محمد الحبيشي، الصادر عن حكمة يمانية، إضافة نوعية إلى الدراسات السياسية والاجتماعية التي تتناول الحركات اليسارية في العالم العربي. يركز الكتاب على تجربة الحزب الاشتراكي اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهي التجربة الوحيدة في الجزيرة العربية التي تبنّت الاشتراكية العلمية كنظام حكم رسمي.
منهجية البحث والتحليل.
يعتمد المؤلف في بناء أطروحته على منهج تحليلي تاريخي، يستند إلى المصادر الأرشيفية والشهادات المباشرة، ويقوم بتفكيك الخطاب السياسي الذي تبنّاه الحزب الاشتراكي اليمني منذ تأسيسه عقب الاستقلال عن بريطانيا عام 1967م، مرورًا بتجربة الدمج القسري للفصائل الثورية في كيان حزبي واحد عام 1978م، وصولًا إلى الانهيار الكامل للنظام في عام 1990م إثر الوحدة اليمنية.
يوضح الكتاب كيف أن الحزب، رغم شعاراته التحررية والتقدمية، أعاد إنتاج نمط سلطوي مغلق قائم على الإقصاء والتصفية السياسية، كما تجلّى في أحداث يناير 1986م، ما أضعف البنية التنظيمية للحزب وأصاب مشروعه بشرخ عميق. ويحلل الكتاب التوتر بين النظرية والممارسة، والأيديولوجيا والواقع، مع التركيز على إشكالية استنبات الماركسية في بيئة لم تتهيأ اقتصاديًا أو ثقافيًا لاستيعابها، ما أفرز نوعًا من الاغتراب الإيديولوجي، حيث أصبح الخطاب السياسي منفصلًا، بل متصادمًا مع الواقع، وأضعف شرعية المشروع الاشتراكي لدى قطاعات واسعة من المجتمع.
يقدم الكتاب محاولة جريئة لفهم الأسباب العميقة لفشل تجربة اليسار، في سياق اتسم بطابعه الراديكالي وتبنيه نموذجًا اشتراكيًا ماركسيًا في بيئة قبلية ودينية تقليدية. من هذا المنطلق، يركز المؤلف على التحليل الفلسفي والفكري للتوترات البنيوية بين النظرية والممارسة، والإيديولوجيا والواقع، وبين الطموح الثوري وحدود الإمكان التاريخي. وتعتبر إشكالية الاستنبات الإيديولوجي أحد المحاور الجوهرية، إذ حاول الحزب زرع منظومة فكرية مستوردة – الماركسية اللينينية – في تربة اجتماعية لم تكن جاهزة لاستيعابها اقتصاديًا أو ثقافيًا. فالفكر الماركسي، الذي نشأ في سياق صناعي أوروبي، يفترض وجود طبقة عاملة وصراع طبقي واضح ومؤسسات مدنية متقدمة، بينما كان جنوب اليمن آنذاك مجتمعًا زراعيًا قبليًا تغلب عليه الأمية وتسيطر عليه الولاءات العصبوية والدينية. هذا التناقض بين الإطار النظري والمجال التطبيقي أدى إلى نوع من الاغتراب الإيديولوجي، حيث أصبح الخطاب السياسي منفصلًا عن الواقع، بل ومتعارضًا معه في كثير من الأحيان، مما أضعف شرعية المشروع الاشتراكي في نظر قطاعات واسعة من المجتمع.

ومن خلال القراءة التحليلية للكتاب، يمكن استخلاص عدد من النقاط المحورية التي تشكل أعمدة الفهم النقدي للتجربة الاشتراكية في اليمن الجنوبي، وتُعد مدخلًا لفهم أسباب تعثر المشروع السياسي والفكري الذي تبنّاه الحزب الاشتراكي اليمني.
أولا: طبيعة النظام السياسي:
يؤكد الكاتب أنه ومنذ لحظة الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1967م، برزت الحاجة الملحّة لبناء دولة حديثة في جنوب اليمن، وهي مهمة تولتها فصائل ثورية متعددة جاءت من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة، سرعان ما اندمجت في كيان حزبي واحد، هو الحزب الاشتراكي اليمني. تبنى هذا الحزب الاشتراكية العلمية كمرجعية أيديولوجية، ساعيًا إلى إعادة تشكيل المجتمع والدولة وفقًا لمبادئ الثورة، وذلك من خلال تأميم الاقتصاد، وإعادة توزيع الأراضي، وتفكيك البنى القبلية، وتأسيس مؤسسات تعليمية وثقافية جديدة تهدف إلى تشكيل المواطن الجنوبي وفق القيم الاشتراكية. لكن على الرغم من الطموح الكبير، اصطدمت هذه السياسات بالواقع الاجتماعي المعقد؛ فقد ظل المجتمع الجنوبي متشبثًا بهوياته المحلية، ومقاومًا في كثير من الأحيان للسلطة المركزية التي فرضت نفسها باسم الثورة، مما أظهر فجوة واضحة بين خطاب الثورة وما يمكن فرضه على الأرض.
مع تأسيس دولة الحزب الواحد، احتكر الحزب الاشتراكي السلطة والقرار السياسي، مما أدى إلى انغلاق أيديولوجي حال دون تطوير أدوات الحكم أو الانفتاح على المجتمع. المركزية المطلقة للقرار وتغليب الولاء الحزبي على الكفاءة، إلى جانب تهميش القوى الاجتماعية غير المنضوية تحت الحزب، أنتجت نظامًا سياسيًا مغلقًا يفتقر إلى مؤسسات ديمقراطية وآليات مساءلة حقيقية. هذا الانغلاق السياسي خلق بيئة خصبة للصراعات الداخلية، والتي لم تُحل عبر الحوار أو التفاوض، بل انتهت أحيانًا بتصفية قيادات وحوادث دموية مثل أحداث يناير 1986م، التي كشفت هشاشة البنية التنظيمية للحزب وانهيار الثقة بين القيادات والكوادر.
يؤكد الكاتب، أن الانحطاط المؤسسي وغياب الكفاءة القيادية في تجربة الحزب الواحد كان مسألة بنيوية وليست مجرد قصور إداري بسيط. فقد أصبح النجاح في المناصب الإدارية مرتبطًا بالقدرة على الحفاظ على الدعم داخل الحزب وليس بالقدرة على الإدارة الفعلية. وحين أصبحت وظائف الدولة امتدادًا للبنية الحزبية، تأثرت التخطيطات الاستراتيجية بالصراعات الداخلية على المناصب والمقاعد بدل أن تتأثر بمتطلبات التنمية الفعلية للمجتمع. كذلك، اختلط السياسي بالإداري، وأصبحت المؤسسات مجرد آليات لتنفيذ توجهات الحزب وشبكات النفوذ المحيطة به، وليس كأجهزة فعّالة لإدارة شؤون الدولة. هذا الواقع أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعمّق الفجوة بين المؤسسات والمواطنين، ما أدى إلى فقدان الثقة الشعبية بالدولة ومؤسساتها.
الصراعات الداخلية بين أجنحة الحزب المختلفة لم تكن نزاعات سياسية عادية، بل كانت تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولة، حيث كانت المناصب العليا تمنح بناءً على التوازنات الحزبية الداخلية وليس على الكفاءة والخبرة. عدم وجود آليات للرقابة والمساءلة داخل الحزب جعل من الانقسامات الداخلية أداة لتقويض المؤسسات نفسها، فضعفت التخطيطات الاستراتيجية، وتعثرت المشاريع التنموية، وتحولت المؤسسات إلى مرآة لفشل الحزب، بدلاً من أن تكون أدوات لإدارة شؤون المجتمع. وقد زاد من حدة هذا الانحطاط خصائص المجتمع اليمني الجنوبي نفسه، حيث تعدد القبائل والهويات المحلية، وضعف البنية الاقتصادية قبل الاستقلال، والصعوبات الجغرافية، والتدخلات الإقليمية والدولية، جميعها عوامل جعلت الانحطاط المؤسسي أكثر عمقًا وأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية مقارنة بتجارب أخرى لدول حزب واحد كانت أكثر مركزية واستقرارًا. لهذا، كانت النتائج كارثية على كل الأصعدة، إذ تعطلت عملية التنمية الاقتصادية، وتراجعت جودة التعليم والخدمات الصحية، وامتلأ الجهاز الإداري بالبيروقراطية الشكلية والروتين العقيم، الذي أصبح أداة للسيطرة على الولاءات وليس لتحسين الأداء. فقد المواطنون الثقة بالمؤسسات، ولم يعد يرون جدوى من الدولة في حماية حقوقهم أو إدارة مصالحهم، بل أصبحت المؤسسات انعكاسًا لفشل الحزب نفسه، حيث ارتبط النجاح الشخصي بالانتماء الحزبي، لا بالكفاءة أو الرؤية، مما جعل سقوط النظام مسألة وقت لا أكثر، إذ لم تكن هناك قاعدة إدارية أو مؤسسية قادرة على امتصاص الصدمات السياسية أو الاقتصادية.
يمكن القول إن الانحطاط المؤسسي وغياب الكفاءة القيادية في جنوب اليمن لم يكن مجرد خلل عرضي، بل خاصية بنيوية لطبيعة الحزب الواحد نفسه. حين استبدل الحزب دوره المؤسسي بالدولة، وتحولت المؤسسات إلى أدوات لإدامة السلطة، أصبح الولاء الحزبي معيارًا للتعيين بدلًا من الكفاءة، وانتشرت شبكة من العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة التي سيطرت على القرارات، لتتراجع الدولة بشكل شامل في قدرتها على إدارة الشأن العام. هذا الانحطاط، مع خصوصيات المجتمع اليمني، مثل تعدد القبائل، وضعف البنية الاقتصادية، والتحديات الجغرافية، جعل تجربة الحزب الواحد أكثر هشاشة وأكثر تأثيرًا على المواطنين مقارنة بتجارب مشابهة في دول أخرى.
المليشيات الموازية للجيش والشرطة:
يكشف الدكتور الحبيشي في كتابه أن إنشاء ميليشيات مسلحة موازية للجيش والشرطة لم يكن مجرد إجراء أمني استثنائي فرضته ظروف طارئة، بل كان تعبيرًا بنيويًا عن أزمة ثقة عميقة داخل الدولة نفسها وعن خوف الحزب من مؤسساته قبل خوفه من خصومه. فالحزب الذي يحتكر السياسة ويعاني في الوقت ذاته من صراعات داخلية حادة، لم يكن قادرًا على الاطمئنان إلى مؤسسة عسكرية وطنية قائمة على المهنية والانضباط، إذ تمتلك المؤسسة، بحكم طبيعتها، هامشًا من الاستقلال يمكن أن يتحول في لحظة أزمة إلى تهديد لهيمنة التنظيم. من هنا، برزت الحاجة إلى قوة مسلحة حزبية، يكون ولائها مضمونًا ومرجعيتها سياسية لا وطنية، وبالتالي لم تُنشأ هذه الميليشيات للدفاع عن الوطن أو حماية المجتمع، بل لضمان بقاء الحزب في موقع السيطرة، وترجيح كفته في مواجهة خصومه داخل الدولة وخارجها.
لم تُبنى هذه الميليشيات على أساس الدفاع عن السيادة أو حماية المجتمع، وإنما على أساس ضبط الداخل ومراقبة الجيش نفسه، وترجيح كفة جناح حزبي على آخر عند احتدام الصراع. وهكذا، لم تعد القوة المسلحة أداة للدولة، بل تحولت إلى أداة صراع داخل الدولة نفسها، مما أدى إلى تفكيك مفهوم الاحتكار المشروع للعنف الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. حين تتعدد مراكز السلاح، تتعدد مصادر القرار ويغيب القانون بوصفه المرجعية العليا، وحين يختزل الحزب الدولة في ذاته، تصبح مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية النظام لا حماية الوطن، ويتحول المجتمع من شريك في بناء الدولة إلى مجرد موضوع للرقابة والضبط. لذلك تكاثرت الأجهزة الأمنية وتعددت لضمان السيطرة ومنع أي احتمال لانفلات السلطة من يد الحزب الحاكم، دون الاهتمام بتعزيز الاستقرار أو حماية البلد.
وفي هذا السياق، يضع الكتاب قرار المؤتمر الرابع للجبهة القومية عام 1968 بإنشاء ميليشيا شعبية واسعة في إطارها الحقيقي، باعتباره تعبيرًا عن انتقال مبكر من منطق الدولة إلى منطق الثورة الدائمة. فبدل السعي إلى بناء جيش وطني مهني يحتكر السلاح ويعبر عن الدولة، جرى الرهان على تعبئة جماهيرية مسلحة ذات ولاء أيديولوجي، قائم على الانتماء السياسي لا الاحتراف العسكري. هذا الخيار لم يكن معزولًا عن الصراعات داخل الجبهة القومية نفسها، بل جاء استجابة لرغبة التيار اليساري في امتلاك قوة ضاربة توازن الجيش النظامي وتكبح أي ميل للاستقلال المؤسسي. ويكشف الكاتب أن هذه الميليشيا الشعبية، منذ بدايات تدريبها في معسكر العند، وتأسيس مدرسة الشهيد عمر علي بدعم كوبي، كانت جهازًا حزبيًا مسلحًا يستنسخ تجارب ثورية أخرى دون مراعاة للفوارق البنيوية بين السياقات. فالتشابه مع النموذج الكوبي كان شكليًا أكثر منه موضوعيًا، إذ إن الدولة الجنوبية لم تمتلك العمق الاجتماعي أو البنية المؤسسية التي تسمح بتحويل الميليشيا إلى عنصر دمج وطني، فتولت الميليشيا سريعًا أدوارًا في الصراع الداخلي ووسائل ضغط سياسي بين مراكز القوى.
ومع اتساع نطاق هذه الميليشيا وضمها عناصر حزبية خالصة، بالإضافة إلى تشكيل وحدات نسائية رمزية، لم يعد دورها محصورًا في التعبئة الأيديولوجية أو الدفاع الشعبي، بل دخلت تدريجيًا في قلب المعادلة السياسية، لتصبح طرفًا فاعلًا في الصراعات على السلطة. وهنا يشير الكتاب إلى أن عسكرة الحزب عمّقت الانقسام، إذ أدى تعدد التشكيلات المسلحة المرتبطة بالتنظيم – من الحرس الشعبي إلى اللجان العسكرية والفدائيين والقوات الشعبية – إلى تفتيت القوة بدل توحيدها، وإلى إضعاف الجيش النظامي بدل دعمه. هذا التحول أظهر بوضوح أن السلاح، بدل أن يكون وسيلة لتحرير المجتمع وتمكينه، تحول إلى أداة للحكم والسيطرة، وهو ما يعكس منطق العنف الشمولي الذي اعتمدته التجارب الماركسية الثورية.
ويربط الكاتب سقوط الرفاق بهذا المسار، موضحًا أن عسكرة السياسة ليست ميزة محلية، بقدر ما تعكس تجارب عالمية للميليشيات اليسارية المتطرفة في أوروبا وأنماط العنف الثوري المستوحاة من فكر تشي جيفارا دون شروطه الموضوعية. فهذه الميليشيات لم تحقق العدالة الاجتماعية أو تمكين الفئات التي رفعت شعار الدفاع عنها، بل أنتجت دورة مغلقة من العنف ارتدت في النهاية إلى داخل النظام نفسه. ومن هذا المنطلق، فإن إنشاء الميليشيا الموازية كان خيارًا استراتيجيًا خاطئًا نابعًا من الفكر الشمولي الذي يرى في العنف أداة طبيعية لإدارة المجتمع، إلا أن هذا الخيار أضعف الدولة، ونسف مبدأ سيادة القانون، ورسّخ الخوف كآلية للحكم، إلى أن بات النظام محاصرًا بأجهزته، ومهددًا بالقوى التي أنشأها بنفسه. وهكذا، ساهمت عسكرة الحزب في تآكل التجربة من الداخل، وأصبحت أحد العوامل الجوهرية التي عجّلت بسقوط الرفاق، حين تحولت الدولة من كيان جامع إلى ساحة صراع مسلح بين أبناء المشروع الواحد، حيث صار السلاح أداة للهيمنة الداخلية بدل أداة لحماية الوطن.

الصراعات بين أجنحة الحزب:
ميزة أخرى خاصة بالتجربة الاشتراكية في جنوب اليمن هي الانقسام الداخلي داخل الحزب نفسه، حيث الصراعات على المناصب كانت مستمرة بين أجنحة الحزب، مما أضعف قدرة أي قيادة على تنفيذ سياسات متسقة. في المقابل، التجارب الأخرى مثل الصين أو كوبا، بالرغم من وجود الولاء الحزبي كشرط أساسي للتقدم في المناصب، نجحت في وضع آليات تدريب قيادي وبناء مؤسسات اقتصادية قوية نسبيًا، ما قلّل من انعكاسات الصراعات الداخلية على الأداء العام. وهنا يمكننا ربط الانحطاط المؤسسي وغياب الكفاءة القيادية بالصراعات الداخلية داخل الحزب بطريقة تحليلية واضحة، لأنهما في الحقيقة وجهان لنفس المشكلة البنيوية للنظام الحزب‑الواحد/ الاشتراكي في اليمن الجنوبي. هذه الصراعات الداخلية بين أجنحة الحزب كانت نتيجة طبيعية لنظام يضع الولاء الحزبي فوق الكفاءة، فعندما تصبح المناصب القيادية مرتبطة بالانتماء السياسي أكثر من القدرة على الإدارة، يتحول كل منصب إلى جائزة سياسية، وليس فرصة لتنفيذ سياسات أو خدمة المجتمع. هذا يعني أن أي خلاف أو صراع بين قيادات الحزب هو بالأساس تنافس على النفوذ داخل هرم السلطة الحزبية وليس صراعًا على الأداء أو الإنجاز المؤسسي. وهنا يظهر الرابط المباشر مع الانحطاط المؤسسي: المؤسسات نفسها تصبح رهينة لهذه الصراعات، فلا توجد قواعد واضحة أو آليات لضمان الكفاءة، وبالتالي كل صراع حزبي يؤدي مباشرة إلى تدهور الأداء الإداري للمؤسسات.
أحد أهم العوامل الداخلية هو الصراع المستمر بين قيادات الحزب نفسها على المناصب والنفوذ داخل هرم السلطة، ما أدّى إلى ضعف الاستقرار التنظيمي وخلق بيئة من الزعزعة وعدم الثقة داخل المؤسسة الحزبية. هذه النزاعات لم تكن فقط سياسية، بل كانت تمسّ وحدة الجهاز التنفيذي للدولة، فبدلًا من توجيه الجهود نحو التنمية والإصلاح، انصرفت إلى صراعات على التحكم في القرار. وهنا يبين الكاتب إلى أن الصراعات داخل الحزب الاشتراكي اليمني لم تكن خلافات سياسية سطحية، بل كانت صراعات على السلطة والنفوذ داخل المؤسسة الحزبية نفسها، وقد تحوّلت في مراحل متقدمة إلى صراعات دامية تصل إلى حدّ الانقسامات الحادة والتصفية العنيفة بين الرفاق- وهو ما وصلت إليه أحداث يناير 1986 التي تضمّنت مواجهات وسقوط قيادات من الحزب داخل مؤسسات الدولة، في واحدة من إذكاء هذه النزاعات الحزبية داخل الدولة نفسها.
هذه الصراعات الداخلية داخل الحزب كانت من أبرز مظاهر الأزمة البنيوية التي واجهتها التجربة، إذ لم يكن الحزب كتلة متجانسة، وإنما كان مكوّنًا من تيارات متعددة، بعضها قومي، وبعضها ماركسي، وبعضها ذو خلفية نضالية محلية. هذه التناقضات لم تُحل عبر الحوار أو التفاوض، بل غالبًا ما انتهت بتصفيات سياسية، كان أبرزها أحداث يناير 1986، التي شهدت اقتتالًا داخليًا بين جناحين في الحزب، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الكوادر، وانقسام فعلي في القيادة، وتفكك البنية التنظيمية. هذا الحدث لم يكن مجرد أزمة عابرة، بل كان تعبيرًا عن فشل الحزب في بناء ثقافة سياسية ديمقراطية، وعن عجزه في إدارة التنوع الداخلي، وعن هشاشة شرعيته أمام المجتمع.
يركز المؤلف على قضية الصراع داخل الحزب، فهو أحد أبرز مظاهر الأزمة البنيوية التي واجهتها التجربة، مؤكدا بذلك أن هذه الصراعات أضعفت الحزب من الداخل، وخلقت حالة من عدم الاستقرار السياسي، و أفقدت النظام شرعيته أمام المواطنين. كما أن غياب مؤسسات رقابية مستقلة، وانعدام الفصل بين الحزب والدولة، ساهم في تكريس الاستبداد المؤسسي، وتحويل المشروع الثوري إلى سلطة بيروقراطية عاجزة عن التجديد. وبحسب المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي في كتابه المعنون بـ “الاثنين الدامي في عدن” فإن ما حدث في الثالث عشر من يناير عام 1986م، تعبيرا جليَّا في تحول المشروع السياسي لليسار اليمني ومساره التاريخي والسياسي، فقد كانت عدن/الجنوب العربي مع موعد لانفجار وجودي هزّ البنية العميقة لكيان اليسار الوليد، وفضح التناقضات التي كانت تتراكم بصمت تحت سطح الشعارات الثورية. فقد كان هذا الصراع على السلطة بين رفاق الأمس، بمثابة لحظة انكشاف مروّعة لانهيار أحلام الرفاق، ولانفصال الخطاب عن الواقع، ولتحوّل الحلم التحرري إلى كابوس دموي، وفشل مشروع كان يفترض أن يعيد تشكيل الإنسان والمجتمع والدولة على أسس جديدة، فإذا به يعيد إنتاج أكثر أنماط الحكم قسوة وتهميشاً وإقصاءً. ولهذا، نجد كثيرا ما يؤكدا طرابلسي بأن هذا الحدث الدّامي ليس من باب المصادفة للرفاق، فهو ثمرة مرة لبنية سلطوية تأسست منذ اللحظة الأولى على مركزية القرار، وعلى اختزال الدولة في الحزب، والحزب في القيادة، والقيادة في الفرد.
القارئ لهذا الصراع بين الرفاق، يجد بأنه صراع على تأويل الثورة، والتنافس على مواقع النفوذ والسلطة، وعلى من يملك الحق في تمثيلهما، وعلى أي مشروع ينبغي أن يبنى فوق أنقاض الاستعمار. لقد تصادمت رؤيتان: واحدة تسعى إلى التغيير الجذري، لكنها تفتقر إلى أدواته المؤسسية، وأخرى محافظة، تتقن فن البقاء، وتجيد استخدام الأيديولوجيا كغطاء للهيمنة. وبين هاتين الرؤيتين، سقط الجنوب العربي، وسقط الرفاق، وسقطت التجربة برمتها. وما يزيد من مأساوية المشهد أن هذا كله حدث في زمن كانت فيه البشرية تتجه نحو آفاق جديدة من الحرية والكرامة، بينما كانت ديمقراطية الرفاق في اليمن الجنوبي تعود إلى منطق التصفية، وإلى لغة التخوين، وإلى منطق الدم. هذا الحدث الدّامي كشف عن هشاشة المشروع السياسي لليسار، وعن عجز القيادة عن إدارة التعدد والاختلاف، وعن فشلها في بناء مؤسسات قادرة على احتواء الصراع ضمن أطر سلمية وديمقراطية. ولهذا، سقطت الدولة لأنها لم تُبنَ على أسس صلبة، بل على توازنات هشة، وتحالفات ظرفية، وشعارات لا تجد لها ترجمة في الواقع. وسقط الحزب لأنه لم يتحوّل إلى فضاء للنقاش والتعدد، بل إلى جهاز طارد لكل اختلاف، ومغلق أمام كل مساءلة. ولهذا، يمكننا القول بأن الفشل كان بنيوياً، لا شخصياً، وكان الانهيار نتيجة منطقية لمسار طويل من التآكل الداخلي، ومن الانفصال بين الخطاب والممارسة، وبين الطموح والواقع.
صحيح أن الدولة الجنوبية تأسست على أنقاض الاستعمار البريطاني، لكنها لم تتحرر من أدواته في السيطرة، فقد استعارتها وأعادت توظيفها تحت لافتة التحرر. وهكذا، تحوّل التنظيم السياسي الموحد إلى جهاز بيروقراطي مغلق، يحتكر الحقيقة، ويقصي المختلف، ويعيد إنتاج السلطة الفردية تحت غطاء الجماعية. وهنا يمكننا القول بأن: الاشتراكية في صورتها اليمنية، كانت مشروعا بلا ديمقراطية، وثورة بلا مساءلة، وتنظيماً بلا تعددية. والدليل على ذلك، أنه حين انفجر الصراع بين الرفاق، لم تكن هناك مؤسسات قادرة على احتوائه، ولا آليات لحله، بل كانت النتيجة حتمية: العنف، ثم الانهيار، والأفول. هذه الإشكالية التي يمكننا تسميتها بـعقدة السلطة الثورية، والتي تحولت من أداة للتحرر إلى أداة للقمع ضد كل من يرفض السياسات التي ينتهجها الحزب الإشتراكي. فالحزب الاشتراكي اليمني، بعد أن وصل إلى الحكم، لم ينجح في بناء مؤسسات ديمقراطية تشاركية، فقد أعاد إنتاج منطق الدولة السلطوية، وإن كان بلغة ثورية. هذا التناقض بين الشعارات التحررية والممارسات السلطوية يعكس مأزقًا فلسفيًا عميقًا في الفكر اليساري العربي عمومًا، وهو مأزق العلاقة بين الغاية والوسيلة: هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وسائل قمعية؟ وهل يمكن بناء مجتمع اشتراكي من دون حرية سياسية؟ هذه الأسئلة، التي لم تجد إجابة مقنعة في التجربة اليمنية، تكشف عن هشاشة البنية الأخلاقية للمشروع الثوري حين يُختزل في السيطرة على الدولة بدلًا من تمكين المجتمع.
كذلك، يطرح الدكتور الحبيشي في كتابه سقوط الرفاق إشكالية السلطة الثورية، التي غالبًا ما تتحول من أداة للتحرر إلى أداة للقمع. فالحزب الاشتراكي اليمني، بعد أن وصل إلى الحكم، لم ينجح في بناء مؤسسات ديمقراطية تشاركية، بل أعاد إنتاج منطق الدولة السلطوية، وإن كان بلغة ثورية. هذا التناقض بين الشعارات التحررية والممارسات السلطوية يعكس مأزقًا فلسفيًا عميقًا في الفكر اليساري العربي عمومًا، وهو مأزق العلاقة بين الغاية والوسيلة: هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وسائل قمعية؟ وهل يمكن بناء مجتمع اشتراكي من دون حرية سياسية؟ هذه الأسئلة، التي لم تجد إجابة مقنعة في التجربة اليمنية، تكشف عن هشاشة البنية الأخلاقية للمشروع الثوري حين يُختزل في السيطرة على الدولة بدلًا من تمكين المجتمع. إضافة إلى جانب آخر يتناوله الكتاب هو العلاقة بين النخبة الثورية والجماهير. فبدلًا من أن يكون الحزب أداة لتمثيل مصالح الطبقات الشعبية، تحول إلى طليعة مغلقة، تحتكر الحقيقة وتفرض رؤيتها على المجتمع من أعلى. هذا النمط من الطليعية، المستوحى من النموذج اللينيني، أدى إلى قطيعة بين القيادة والقاعدة، وساهم في تآكل الحاضنة الشعبية للمشروع الاشتراكي.
من منظور فلسفي، يمكن القول إن هذه القطيعة تعكس فشلًا في تحقيق ما يسميه هابرماس بـ”الشرعية التواصلية”، أي القدرة على بناء توافق اجتماعي من خلال الحوار والإقناع، لا من خلال الإكراه الأيديولوجي. فالحزب، حين استبدل التواصل بالإملاء، والإقناع بالتعبئة، فقد أحد أهم مصادر شرعيته الأخلاقية والسياسية، حتى وإن احتفظ بسلطة الدولة وأجهزتها. ولهذا، نجد غياب الشرعية التواصلية لم يقتصر أثره على العلاقة بين الحزب والمجتمع، وإنما انسحب إلى داخل الحزب نفسه. فالتنظيم الذي لا يحتمل الاختلاف مع المجتمع، لن يحتمله مع ذاته. وهكذا، أعادت الطليعية المغلقة إنتاج منطق الإقصاء داخل القيادة، فتحوّل الحزب من فضاء سياسي إلى ساحة صراع بين «طليعات» متنافسة، كلٌّ منها تدّعي تمثيل الخط الثوري الصحيح. ومع غياب آليات ديمقراطية داخلية حقيقية، لم يعد الصراع يُدار بالحوار أو التسوية، بل بالقوة والتنظيم والسلاح. وبهذا المعنى، يمكن فهم الانفجار الداخلي اللاحق للتجربة الاشتراكية بأنها إحدى النتائج الغير المقصودة؛ إذ إن المشروع الذي عجز عن بناء توافق اجتماعي واسع، ولم يطوّر أدوات تواصل عقلاني مع قاعدته، كان محكومًا بأن ينقلب العنف الرمزي الذي مارسه باسم الحقيقة إلى عنف داخل بنيته التنظيمية. فالطليعية التي تبدأ بإقصاء المجتمع، تنتهي- بحكم منطقها الداخلي- إلى إقصاء ذاتها.
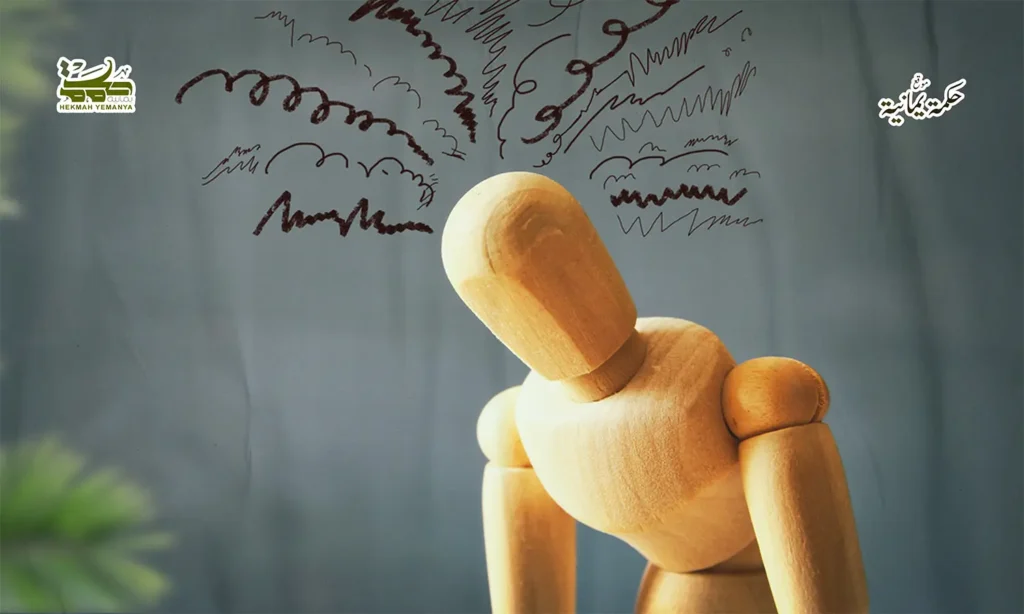
معضلة التحديث:
أحد المحاور الجوهرية التي يعالجها الكتاب هو إشكالية الاستنبات الإيديولوجي، أي محاولة زرع منظومة فكرية مستوردة – الماركسية اللينينية – في تربة اجتماعية لم تنضج بعد لتقبلها، لا من حيث البنية الاقتصادية ولا من حيث التكوين الثقافي. فالفكر الماركسي، الذي نشأ في سياق صناعي أوروبي، يفترض وجود طبقة عاملة صناعية، وصراع طبقي واضح المعالم، ومؤسسات مدنية متقدمة، بينما كان جنوب اليمن آنذاك مجتمعًا زراعيًا قبليًا، تغلب عليه الأمية، وتتحكم فيه الولاءات العصبوية والدينية. هذا التناقض بين الإطار النظري والمجال التطبيقي أدى إلى نوع من الاغتراب الإيديولوجي، بحيث أصبح الخطاب السياسي منفصلًا عن الواقع، ومتصادمًا في كثير من الأحيان معه، مما أضعف شرعية المشروع الاشتراكي في نظر قطاعات واسعة من المجتمع. ومن خلال النظر في محركات وآثار التجربة الاشتراكية، وفي البنية العميقة التي أنتجت هذه التجربة، وفي السياقات التاريخية والاجتماعية التي شكلت مسارها، ثم في النتائج التي تمخضت عنها، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع أو الوعي الجمعي. نجد بأن هذه التجربة افي جنوب اليمن لم تكن مجرد خيار سياسي، بقدر ما كانت تمثل مشروعًا وجوديًا حاول أن يعيد صياغة الإنسان والمجتمع والدولة وفق رؤية كلية شمولية، مستلهمة من الماركسية اللينينية، ولكنها مصاغة في قالب محلي مشحون بالتناقضات.
ولعل من أبرز تجليات إشكالية التحديث في هذه التجربة هو التوتر بين الدولة والمجتمع، حيث سعت السلطة إلى تفكيك البنى التقليدية – كالقبيلة والدين – باعتبارها عوائق أمام التحديث، لكنها لم تنجح في بناء بدائل مؤسسية قادرة على ملء الفراغ. فبدلًا من أن تُنتج الدولة مجتمعًا مدنيًا حديثًا، أنتجت فراغًا اجتماعيًا، ملأته لاحقًا قوى مضادة، بعضها ديني وبعضها مناطقي. هذا الفشل في بناء وسيط اجتماعي بين الفرد والدولة أدى إلى هشاشة البنية السياسية، وجعل النظام عرضة للانهيار بمجرد اهتزاز مركز السلطة. من منظور فلسفي، يمكن القول إن الدولة الاشتراكية في الجنوب لم تفشل فقط في تحقيق العدالة الاجتماعية، بل فشلت أيضًا في تأسيس “عقد اجتماعي جديد”، يُعيد تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس تشاركية. وفي التطبيق العملي، سعى الحزب إلى إعادة تشكيل المجتمع عبر سياسات جذرية شملت تأميم الممتلكات، وإعادة توزيع الأراضي، وتأسيس مؤسسات تعليمية وثقافية جديدة تهدف إلى خلق “الإنسان الاشتراكي”. غير أن هذه السياسات، رغم طموحها، اصطدمت بواقع اجتماعي غير مهيأ، حيث لم تكن هناك طبقة عاملة صناعية بالمعنى الكلاسيكي، ولا بنية اقتصادية تسمح بتطبيق التخطيط المركزي بشكل فعال. كما أن المجتمع الجنوبي، الذي خرج لتوه من تجربة استعمارية طويلة، لم يكن مستعدًا لتقبّل نمط حكم شمولي يُقصي الهويات المحلية، ويُخضع الحياة اليومية لمنطق أيديولوجي صارم. وهنا يمكننا القول بأن: هذا التبني للنظام الماركسي لم يكن نتاج تطور عضوي داخلي، بل كان في كثير من جوانبه استيرادًا لنموذج خارجي، تم إسقاطه على واقع مغاير. وهنا تكمن المفارقة: بينما كانت الماركسية في أوروبا نتاجًا لتطور الرأسمالية الصناعية، جاءت في جنوب اليمن كأداة ثورية في مجتمع ما قبل رأسمالي، ما أدى إلى نوع من الانفصام بين النظرية والممارسة.
ومن الآثار العميقة التي خلفتها معضلة التحديث هذه، ما يمكن تسميته بـ”التحول الأنطولوجي” في وعي الأفراد. فالتجربة الاشتراكية سعت إلى خلق “الإنسان الجديد”، المتحرر من قيود الدين والقبيلة والملكية، والمندمج في مشروع جماعي لبناء الاشتراكية. لكن هذا الإنسان ظل في كثير من الأحيان كائنًا مترددًا، ممزقًا بين هويته التقليدية ومتطلبات الدور الجديد المفروض عليه. هذا التمزق أنتج نوعًا من الازدواجية في السلوك والوعي، حيث يتبنى الفرد خطابًا ثوريًا في العلن، لكنه يحتفظ بولاءاته القديمة في السر. هذه الازدواجية، التي غذتها أيضًا ممارسات القمع والتخوين، ساهمت في تآكل الثقة بين الأفراد، وفي تفشي ثقافة الخوف والانتهازية، ما أضعف النسيج الاجتماعي وأفرغ المشروع الاشتراكي من مضمونه الأخلاقي.
لقد تأسست التجربة الاشتراكية في جنوب اليمن على خلفية فكرية مشبعة بالماركسية اللينينية، التي تم تبنيها بوصفها “علمًا للتاريخ” و”خارطة طريق” للتحول الاجتماعي. غير أن هذا التبني لم يكن نتاجًا لتطور داخلي في البنية الطبقية أو الاقتصادية، بل جاء في سياق ما بعد الاستعمار، حيث كانت النخب تبحث عن أدوات لفهم الواقع وتغييره، فوجدت في الماركسية وعدًا بالخلاص من التبعية والتخلف. لكن هذا التبني لم يكن نقديًا، بل كان أقرب إلى التماهي الإيديولوجي، حيث تم التعامل مع الماركسية بوصفها عقيدة مغلقة، لا بوصفها منهجًا مفتوحًا. وهنا تكمن المفارقة الفلسفية الأولى: فبينما تدّعي الماركسية أنها علم للتاريخ، فإنها حين تُختزل في شعارات حزبية، وتُفرض من أعلى، تتحول إلى أداة للهيمنة الرمزية، وتفقد قدرتها على النقد الذاتي. وفي هذا السياق، تم استيراد مفاهيم مثل “الطبقة العاملة”، و”الصراع الطبقي”، و”ديكتاتورية البروليتاريا”، و”التحول الاشتراكي”، دون أن يكون لها تجذر فعلي في الواقع اليمني، الذي كان مجتمعًا زراعيًا قبليًا، تغلب عليه الولاءات العصبية، وتتحكم فيه البنى التقليدية. هذا التناقض بين النظرية والواقع أدى إلى نوع من الاغتراب الإيديولوجي، حيث أصبح الخطاب السياسي منفصلًا عن التجربة المعيشة، وفي كثير من الأحيان متصادما معه. ومن منظور غرامشي، فإن هذا يعكس فشل النخبة الثورية في تحقيق “الهيمنة الثقافية”، أي في بناء توافق اجتماعي حول مشروعها، ما اضطرها إلى اللجوء إلى العنف الرمزي والمادي لفرض رؤيتها على المجتمع اليمني الجنوبي.
لهذا السبب كانت العلاقة بين الأيديولوجيا والواقع الاجتماعي من أبرز الإشكاليات التي واجهها الحزب، حيث فشل في مواءمة الخطاب الماركسي مع البنية القبلية والثقافية للمجتمع الجنوبي، ما أدى إلى عزلة سياسية واجتماعية، وانفصال بين النخبة الحاكمة والجمهور. هذا الفشل في التكيّف مع الواقع المحلي جعل المشروع الاشتراكي يبدو مفروضًا من أعلى، دون جذور اجتماعية حقيقية، وهو ما ساهم في تآكل شرعيته تدريجيًا. كما أن الاعتماد المفرط على الدعم السوفيتي خلق نوعًا من التبعية الخارجية، وجعل النظام هشًا أمام التحولات الدولية، خصوصًا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، مما كشف عن ضعف البنية الاقتصادية والسياسية للدولة، وأدى إلى تسارع الانهيار، ودخول الحزب في مرحلة من التراجع الحاد، لم يستطع خلالها إعادة إنتاج نفسه أو صياغة خطاب جديد يتفاعل مع المتغيرات. لذلك، أعتقد أن الكاتب كان محقًا، حينما أكد على أن فهم الخلفيات الفكرية والسياسية التي شكلت التجربة الاشتراكية في جنوب اليمن لا يمكن فهمها إلا من خلال تفكيك البنية المعرفية التي استندت إليها النخبة الثورية، وتحليل السياقات التاريخية التي أفرزت هذا المشروع، واستبطان التوترات الإبستمولوجية التي رافقت عملية الترجمة القسرية لنموذج فكري دخيل إلى واقع عربي تقليدي. فهذه الخلفيات لم تكن مجرد مقدمات ظرفية أو أدوات تحليلية، بل كانت أنساقًا معرفية وإيديولوجية شكلت أفق التفكير السياسي، وحددت نمط الممارسة، وأسهمت في إنتاج خطاب سلطوي باسم التحرر.
بحسب الكاتب فإنه الحزب الإشتراكي بدلا من العمل على إنتاج خطاب نقدي قادر على تجاوز الشعارات الثورية التي كان الحزب ينادي بها، وإفساح المجال أمام المثقفين والمفكرين لتطوير رؤية وطنية جامعة، ساهم في تكريس ثقافة الخوف والرقابة، وانكماش المجال العام، وانعدام التعددية الفكرية، مما أدى إلى تراجع الحريات العامة، وتكلّس الحياة السياسية. هذا الانغلاق الثقافي كان أحد أسباب فشل المشروع الاشتراكي، لأنه حال دون بناء قاعدة اجتماعية واعية ومشاركة في صناعة القرار السياسي، والانخراط في العمل الاجتماعي. لهذا السبب، فإن البعد الثقافي والفكري في تجربة الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن يشكل أحد المفاتيح الجوهرية لفهم أسباب تعثر المشروع الاشتراكي، إذ إن أي مشروع سياسي لا يمكن أن يترسخ أو يحقق استدامته دون أن يكون مصحوبًا برافعة ثقافية قادرة على إنتاج خطاب نقدي، وتأسيس فضاء عام يسمح بالتعدد والتفاعل، ويعزز من قيم المشاركة والمساءلة. والمشروع الإشتراكي في جنوب اليمن اختزال الثقافة، والعمل الفكري والصحفي في وظيفة دعائية، تخدم الخطاب الرسمي، وتُقصي كل ما لا ينسجم مع الأيديولوجيا الماركسية التي تبناها الحزب بوصفها مرجعية مطلقة. هذا الاختزال أدى إلى تهميش المثقفين المستقلين، وإخضاع المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية لرقابة صارمة، وتحويلها إلى أدوات لإعادة إنتاج الولاء الحزبي، لا لتغذية العقل النقدي أو تعزيز التعددية الفكرية. وقد ساهم هذا المناخ في خلق حالة من النفاق الإجتماعي تجاه السلطة، حيث أصبح المثقف إما تابعًا للسلطة أو معزولًا عنها، ما أدى إلى فقدان الثقافة لدورها الحيوي في مساءلة السلطة، وفي بناء وعي جماعي قادر على التفاعل مع التحولات الاجتماعية والسياسية. هذا الفشل الثقافي كان أحد الأسباب البنيوية التي قادت إلى انهيار المشروع الاشتراكي، لأنه حال دون بناء وعي جماعي قادر على الدفاع عن التجربة، أو على تجديدها، أو على نقدها من الداخل. وفي غياب هذا الوعي، تحولت السلطة إلى جهاز بيروقراطي، وتحولت الثقافة إلى شعارات، وتحول الحزب إلى كيان مغلق، لا يرى في المجتمع سوى موضوعًا للتغيير، لا شريكًا فيه.

تصدير الثورة وصناعة الأعداء:
يعالج كتاب «سقوط الرفاق» مسألة تصدير الثورة وصناعة الأعداء بوصفها أحد أخطر العوامل الداخلية التي ساهمت في فشل تجربة نظام الحزب الواحد، ليس لأنها أرهقت الدولة خارجيًا، وانعكست تدميرًا من الداخل على بنية النظام ذاته. وهنا، يؤكد الكتاب بأن مسألة تصدير الثورة كانت امتداد مباشر للفكر الشمولي الذي يرى نفسه مشروعًا كونيًا لا يعترف بالحدود السياسية ولا بخصوصيات المجتمعات. فالحزب، وقد احتكر الحقيقة الأيديولوجية داخل الدولة، تعامل مع محيطه الإقليمي والدولي بمنطق الاستقطاب الحاد: صديق ثوري أو عدو رجعي. هذا المنطق لم يكن مجرد خطاب تعبوي، فقد تحوّل إلى ممارسة سياسية وأمنية أنتجت حالة دائمة من التوتر، ودفعت الدولة الفتية إلى الدخول في صراعات تفوق قدراتها الاقتصادية والعسكرية والمؤسسية. ومع سيطرة التيار اليساري على مقاليد الحكم في الجنوب، واعتماد الاشتراكية وتصدير الثورة خيارًا سياسيًا موجّهًا، تجاوز النظام الجديد حدود الجغرافيا السياسية لمحيطه الطبيعي، وانتقل من موقع الدولة الناشئة الباحثة عن الاعتراف والاستقرار، إلى موقع الفاعل الأيديولوجي المتحدّي للنظام الإقليمي القائم. هذا التحول كان إعلان تموضع صريح وضع اليمن الديمقراطي الشعبي في موضع الشبهة والعداء المباشر مع دول الجوار الخليجية الغنية بالنفط، المرتبطة بتحالفات استراتيجية مع الغرب عمومًا، والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وبدل أن تدار العلاقة مع هذا المحيط بمنطق المصالح المتبادلة والواقعية السياسية، جرى تأطيرها ضمن خطاب ثوري صدامي، يرى في تلك الدول امتدادًا للمنظومة الإمبريالية التي ينبغي تقويضها لا التفاهم معها.
وفي هذا السياق، اتخذ النظام في عدن مواقف عدائية واضحة تجاه دول الخليج النفطية، تُرجمت عمليًا في دعم حركات المقاومة المسلحة في سلطنة عمان والخليج، خاصة في مرحلة انتقال السلطة من بريطانيا إلى حكام الإمارات الخليجية الصغيرة الثلاث. وقد سبق هذا الدعم العسكري خطوة سياسية ذات دلالة رمزية عالية، تمثلت في رفض نظام اليمن الديمقراطي الاعتراف بتلك الكيانات السياسية الجديدة، رغم أن الاتحاد السوفيتي نفسه- الحليف الاستراتيجي الأهم لعدن- قد اعترف بها. والمفارقة اللافتة أن هذا التناقض بين الموقفين اليمني والسوفيتي لم يحدث أي شرخ في العلاقة بين الطرفين، ما يعكس حجم الهامش الذي كان يمنح لعدن في تبنّي سياسات أيديولوجية متطرفة، حتى وإن تجاوزت البراغماتية السوفيتية ذاتها.
وقد بلغ نهج تصدير الثورة ذروته بدعم النظام في عدن للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، دعمًا تجاوز السياسي والإعلامي إلى المساندة العسكرية المباشرة، لتتحول عدن إلى مركز دعاية ثورية عابر للحدود عبر نشرة «صوت الثورة» الصادرة من المعلا، والتي وُجّهت حتى إلى البرلمان البريطاني. وقد كشفت وثائق بريطانية رُفع عنها السر عام 2004 عن مضمون عدائي مباشر للولايات المتحدة والأسطول السابع، ما عكس طبيعة هذا التموقع الصدامي. ولم يقتصر هذا النهج على الجوار الخليجي، فقد امتد إلى المغرب العربي بدعم جبهة البوليساريو، في موقف مؤسسي أُقرّ رسميًا في وثائق الحزب الاشتراكي عام 1978، بما يجسّد تغليب الانتماء الأممي على الاعتبارات القومية.
وفي السياق ذاته، ونتيجة لسوء التقدير السياسي وتضخم الرؤية الأيديولوجية، ذهب النظام في عدن إلى دعم المعارضة الماركسية الإيرانية، ممثلة بحزب تودة الشيوعي، وتنظيمي مجاهدي خلق وفدائي خلق، ومن بينهم مجتبى طالقاني، نجل آية الله طالقاني، أحد أبرز رموز الثورة الخمينية الإيرانية. هذا التوجّه جاء في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، إذ كان العالم العربي، في معظمه، مصطفًا خلف العراق في حربه مع إيران، بينما اختار اليمن الديمقراطي الوقوف في موقع مناقض للمزاج العربي العام.
وقد بلغ هذا الانفصال عن المحيط العربي ذروته قبيل أحداث يناير 1986، حين استعدت عدن لاستقبال الرئيس الإيراني علي خامنئي أثناء الحرب العراقية–الإيرانية، في تعبير عن استمرار الرهان الأممي رغم كلفته السياسية. وهذا السلوك السياسي بتعبير الدكتور الحبيشي يجد ما يفسّره في اعترافات لاحقة لقيادات جنوبية بارزة، حيث أقرّ علي ناصر محمد، في حديثه لصحيفة «الوسط»، بأن مجرد إعادة تموضع اليمن الديمقراطي ضمن إطاره العربي عُدّ، في نظر خصومه داخل الحزب، شكلًا من أشكال الخيانة، قائلاً إن نقله البلاد من «الدائرة الحمراء» إلى «الدائرة العربية» اعتُبر خروجًا على الخط الثوري، وهو ما يكشف عمق القطيعة الذهنية بين النظام اليساري الحاكم ومفهوم الدولة الوطنية المنتمية إلى محيطها الطبيعي.
وهنا بالذات تتجلّى المفارقة الكبرى: إذ بينما كانت الدولة في أمسّ الحاجة إلى تثبيت شرعيتها الداخلية، وبناء عقد اجتماعي جامع، والانكباب على قضايا التعليم، والصحة، والإنتاج، أعادت القيادة الثورية تعريف أولوياتها وفق منطق الصراع الدائم، فغدا الخارج- بما يحمله من «أعداء محتملين»- أكثر حضورًا في الذهن السياسي من الداخل بما فيه من هشاشة بنيوية وتنوّع اجتماعي قابل للانفجار. وهكذا تحوّل مفهوم «تصدير الثورة» من أداة تحرّر في الخطاب، إلى أداة استنزاف في الواقع، حيث استُهلكت موارد الدولة المحدودة، المادية والبشرية، في مغامرات أيديولوجية لا طاقة لاقتصاد هشّ على تحمّل كلفتها.
وبحسب رؤية الكاتب فإن هذا النهج أسهم في تعميق عزلة اليمن الجنوبي إقليميًا، إذ دخل في حالة خصومة شبه دائمة مع محيطه الطبيعي في الجزيرة العربية، باعتبارها – في الوعي الثوري- تجليات لمعسكر «رجعي» ينبغي زعزعته أو على الأقل محاصرته، دون التعامل مع هذه الخلافات سياسية بوصفها قابلة للتسوية. وبذلك صنعت شبكة واسعة من الخصومات، لم تكن ناتجة عن تهديدات مباشرة للأمن الوطني، بقدر ما كانت انعكاسًا لرؤية أيديولوجية ترى العالم من خلال ثنائية صارمة: ثورة/ثورة مضادة، تقدّم/رجعية، صديق/عدو. وهي ثنائيات، حين نقلت من مستوى التنظير إلى واقع دولة فقيرة خارجة لتوّها من الاستعمار، تحوّلت من أدوات تحليل إلى مصادر دائمة للتوتر والانفجار.
وعلى المستوى الدولي، وبحسب تعبير المؤرخ روبرت ستوكي (Robert W. Stookey) في كتابه (South Yemen: A Marxist Republic in Arabia) والذي يتناول تاريخ اليمن الجنوبي وصولًا إلى تحوّله إلى دولة ماركسية، من منظور سياسي وتاريخي واسع، فأن هذا النهج أدى إلى اختزال علاقات اليمن الجنوبي في محور ضيّق قوامه الاتحاد السوفيتي وبعض دول المعسكر الاشتراكي. وبالرغم من أن هذا التحالف وفّر دعمًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا أساسيًا، لكن ستوكي يلفت إلى أن هذا الدعم كان مشروطًا وغير كافٍ لتعويض العزلة الواسعة. كما أن الاعتماد شبه المطلق على قوة عظمى واحدة جعل الدولة الجنوبية رهينة لتقلبات السياسة الدولية، وأفقدها القدرة على المناورة أو تنويع خياراتها الخارجية.
ويبرز ستوكي أن المفارقة الكبرى في سياسة عدن الخارجية تكمن في أن خطابها الأممي، الذي يفترض تجاوز القوميات والحدود، انتهى عمليًا إلى قطيعة مع المحيط العربي، لا إلى اندماج أوسع فيه. فقد اصطدمت الرؤية الماركسية الصلبة بحساسية النظام الإقليمي العربي، الذي كان—رغم تنوّعه—يتعامل بحذر شديد مع أي مشروع يسعى إلى تصدير الثورة أو زعزعة شرعية الدول القائمة. وهكذا تحوّلت عدن إلى حالة شاذة في النظام العربي، لا تنتمي إليه بالكامل، ولا تستطيع الفكاك منه جغرافيًا وتاريخيًا.
بتعبير الدكتور الحبيشي فإن حصيلة هذا النهج القائم على تصدير الثورة، بعد أكثر من عقد على تبنّيه، كشف عن استراتيجية سياسية فاشلة، ليس لأنها أخفقت في تحقيق أهدافها الأممية فحسب، بل لأنها أضعفت الأسس الداخلية للدولة ذاتها، و راكمت شروط الانفجار من داخلها. فهذه الدولة التي ولدت في سياق تاريخي هشّ، كانت أحوج ما تكون إلى سياسة خارجية واقعية تخفف من عزلتها، وتحوّل موقعها الجغرافي إلى جسر للتكامل لا إلى ساحة صراع، اختارت بدلًا من ذلك أن تثقل نفسها بعداوات مفتوحه تتجاوز قدراتها الاقتصادية والعسكرية، وتضعها في مواجهة مباشرة مع محيط إقليمي أكثر ثراءً ونفوذًا وتأثيرًا. وقد أسهم هذا التموضع العدائي في حرمان اليمن الديمقراطي من فرص ثمينة للدعم الاقتصادي والاستثماري، سواء من دول الجوار أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بها، ما جعل الدولة تعتمد اعتمادًا شبه كلي على المساعدات السوفيتية، التي كانت، بدورها، خاضعة لحسابات استراتيجية لا تتطابق دائمًا مع المصالح الوطنية الجنوبية. ومع تقلّص هامش المناورة الاقتصادية، تحوّلت الدولة إلى جهاز توزيع شحيح للموارد، الأمر الذي غذّى التنافس داخل النخبة الحاكمة، وفتح الباب أمام صراعات مكتومة حول النفوذ والقرار، سرعان ما اتخذت طابعًا أيديولوجيًا حادًا يخفي خلفه صراعًا على السلطة.
وفوق ذلك، فإن الارتهان شبه الكامل لمحور أممي واحد جعل النظام أكثر هشاشة أمام أي تحوّل في ميزان القوى الدولي. فمع بداية التراجع السوفيتي في الثمانينيات، وانشغاله بأزماته الداخلية، بدأت مظلة الدعم السياسي والاقتصادي تضيق، ما كشف عُري الدولة الجنوبية، وأفقد القيادة الثورية سندها الخارجي في لحظة كانت فيها الانقسامات الداخلية قد بلغت مستوى خطيرًا من الاستقطاب. وبذلك تزامن الانكشاف الخارجي مع الاحتقان الداخلي، في تفاعلٍ قاتل لا يمكن فصله عن الخيارات الاستراتيجية السابقة. وهكذا، فإن السياسة الخارجية الثورية، التي رفعت بوصفها تعبيرًا عن القوة والمبدأ، أسهمت- في مفارقة تاريخية قاسية- في تعرية ضعف الدولة، وتعجيل تفككها من الداخل. كما أدّى منطق «صناعة الأعداء» في الخارج إلى إعادة إنتاجه في الداخل؛ فالثورة التي اعتادت تعريف ذاتها عبر نقيضها، لم تَعُد قادرة على التمييز بين الخصم الخارجي والرفيق المختلف، فتم إسقاط القاموس ذاته—قوامه الاتهام والانحراف والتآمر—على العلاقات داخل الحزب والدولة. وهكذا، أصبح الصراع الداخلي امتدادًا عضويًا للصراع الخارجي، لا نقيضًا له، وصارت بنية العنف السياسي جزءًا من الثقافة التنظيمية لا استثناءً طارئًا.

العوامل الخارجية:
١- التدخل الخارجي
في تحليل العوامل الخارجية التي أدت إلى فشل التجربة اليسار اليمني في الجنوب اليمني، يسعى الكاتب إلى تقديم خطاب تفسيري يسعى إلى إنتاج معرفة سياسية تتجاوز السرد الوقائعي للأحداث، عبر تفكيك العلاقة بين القوة والمعرفة في تفسير فشل النظام السياسي في اليمن الديمقراطي. فمن الناحية الإبستمولوجية، لا يتعامل المؤلف مع «التدخل الخارجي» بوصفه مفهومًا مركبًا، تتداخل فيه مستويات متعددة من الفعل والتأثير، وتتشابك فيه البنى الدولية مع السياقات المحلية. وهنا، يقوم المؤلف على نقد ضمني للمعرفة التبسيطية التي تعزو فشل التجارب السياسية في العالم الثالث إلى عامل واحد، سواء كان خارجيًا أو داخليًا. إذ يعيد النص تعريف التدخل الخارجي من كونه فعلًا قسريًا مباشرًا إلى كونه شبكة علاقات وتأثيرات تعمل عبر السياسة والاقتصاد والأمن والمجتمع. وبهذا المعنى، فإن التحليل يتعامل مع العوامل الخارجية كجزء من حقل قوى أوسع، لا يشتغل إلا بقدر ما تسمح له البنية الداخلية بالاشتغال.
يرى الكاتب أن التدخل السوفيتي أدّى دورًا مركزيًا في تعميق اختلالات التجربة السياسية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في سياق دولي اتسم باحتدام الحرب الباردة والصراع على الممرات البحرية الاستراتيجية. فقد نظر الاتحاد السوفيتي إلى جنوب اليمن بوصفه موقعًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية، ليس فقط لكونه يشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وباب المندب، وإنما أيضًا لقربه من منابع النفط في الخليج العربي، وما يتيحه من قدرة على مراقبة خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبرها المصالح الغربية. وفي هذا الإطار، سعت موسكو منذ المراحل الأولى للاستقلال إلى ترسيخ حضورها في الجنوب اليمني عبر بوابة «الجبهة القومية»، مستفيدة من هشاشة الدولة الوليدة، وحاجتها الملحّة إلى الدعم العسكري والاقتصادي. وقد تُوّج هذا التوجه بتوقيع اتفاقيات عسكرية مبكرة أسهمت بموجبها موسكو في تدريب الجيش النظامي وتسليحه وفق العقيدة العسكرية السوفيتية، بما رسّخ تبعية بنيوية للمؤسسة العسكرية تجاه الدعم الخارجي.
وبحسب الكاتب فإن شبكة الاتفاقيات الثنائية توسعت لتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والفني والنقل الجوي، وهو ما أتاح للاتحاد السوفيتي امتيازات واسعة في المطارات والموانئ الجنوبية. ورغم غياب إعلان رسمي بإنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية، فإن حجم التسهيلات الممنوحة، وطبيعة الاستخدام العسكري للأراضي والمرافق، جعلا من جنوب اليمن عمليًا قاعدة متقدمة ضمن الاستراتيجية السوفيتية في المحيط الهندي والقرن الأفريقي. وقد تميّز الحضور السوفيتي في عدن بخصوصية لافتة مقارنة ببقية دول المنطقة؛ إذ كانت الدولة اليمنية الجنوبية الكيان العربي الوحيد الذي تبنّى نهجًا ماركسيًا صريحًا، ما أتاح لموسكو نفوذًا سياسيًا وثقافيًا واسعًا، تجلّى في إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع على أسس اشتراكية، وفي تغلغل الخبراء السوفييت في قطاعات التعليم، والصحة، والهندسة، والإدارة، إلى جانب الدور العسكري. غير أنّ هذا الدعم، على أهميته في تمكين الدولة من تجاوز بعض أزماتها المبكرة، لم يكن بلا أثمان. فقد ساد داخل الأوساط الرسمية والشعبية استياء متزايد من ممارسات السوفييت، خصوصًا في ما يتعلق باستغلال الثروة السمكية، والتباطؤ في مشاريع البنية التحتية الحيوية، والمماطلة في عمليات التنقيب عن النفط التي احتكرتها الشركات السوفيتية. كما بدا واضحًا أن أولويات موسكو الاستراتيجية كثيرًا ما تقدّمت على احتياجات التنمية الوطنية. ولهذا، يؤكد المؤلف بأن الدعم السوفييتي قد تجاوز حدود الدعم التقليدي إلى مستوى التأثير المباشر في موازين الصراع داخل النخبة الحاكمة. فقد أسهمت موسكو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ترجيح كفة أطراف معينة داخل الحزب والدولة، والتدخل في تحديد أدوار المؤسسات السيادية، ورسم السياسات الاقتصادية، بل والتأثير في شكل العلاقة مع الشطر الشمالي من اليمن، وقضية الوحدة، والعلاقات الإقليمية، ولا سيما مع دول الخليج.
٢- دول الجوار والإقليم
يؤكد الدكتور الحبيشي بأن دول الجوار لعبت دورا كبيرا في التأثير على الحزب الاشتراكي في جنوب اليمن، فخلال العقود التي أعقبت قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لعبت دول الجوار، وبالأخص المملكة العربية السعودية، دوراً محورياً في تشكيل مسار الأحداث اليمنية، وتأجيل أي محاولات الوحدة بين الشطرين. وقد انبنى هذا الدور على مزيج من الاعتبارات الأمنية والإيديولوجية والاستراتيجية، فقد كان النظام السعودي شديد القلق من توسع نفوذ الماركسيين في جنوب اليمن، واعتبر أن أي وحدة محتملة بين الشطرين تحت تأثير اليسار ستغير موازين القوى في المنطقة لصالح مشروع اشتراكي، قد يهدد أمنها الحدودي ومصالحها الاستراتيجية.
وعلى الرغم من التزامن الزمني لنشأة الدولة السعودية الحديثة مع التشكّل التدريجي للدولة اليمنية الحديثة، والذي كان من الممكن – نظرياً – أن يؤسس لعلاقة تقوم على قدر من الندية والتوازن بين كيانين سياسيين في طور التكوين، فإن المسار الفعلي للعلاقة بين البلدين سار في اتجاه مغاير. فقد تضافرت مجموعة من العوامل البنيوية والسياسية والإقليمية لتمنح المملكة العربية السعودية قدرة متزايدة على الهيمنة على الملف اليمني، والتحكم في إيقاع أزماته الداخلية، وتوجيه مساراته السياسية بما ينسجم مع تصوراتها الأمنية ومصالحها الاستراتيجية. فقد كان الهاجس الأمني السعودي، إلى جانب التباين الجوهري في طبيعة النظامين السياسيين، من أكثر المحددات تأثيراً في رسم السياسة السعودية تجاه اليمن الجنوبي، وهي سياسة اتسمت بالسعي الدائم لإدارة المجال اليمني بوصفه امتداداً للأمن الوطني السعودي.
هذا الموقف السعودي اتسم بعداء ثابت تجاه النظام الاشتراكي في الجنوب، وهو عداء تُرجم إلى سياسات عملية شملت دعم قوى المعارضة الجنوبية في المنفى على المستويات الدبلوماسية والمالية والإعلامية. وقد أدى هذا الواقع إلى تعقيد شبكة العلاقات الثلاثية بين الرياض وعدن وصنعاء. فالجمهورية العربية اليمنية، بوصفها الطرف الأضعف في هذا المثلث، كانت شديدة التأثر بطبيعة العلاقة بين السعودية وجنوب اليمن. وفي هذا الإطار، تعاملت المملكة مع النظام الجمهوري في شمال اليمن ببراغماتية محسوبة، خصوصاً بعد انسحاب القوات المصرية وانتهاء الحرب الأهلية. فقد جاء الاعتراف السعودي بالجمهورية في بداية السبعينيات مشروطاً بضمانات واضحة تتعلق بمواجهة التيار الشيوعي الصاعد في الجنوب. ولم تكتفِ الرياض بذلك، بل أسهمت – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في نقل بؤرة الصراع من الداخل الشمالي إلى العلاقة بين الشطرين، بحيث تحولت المواجهة إلى صراع بين دولتين يمنيتين بدلاً من كونها صراعاً داخلياً. وتجسدت هذه السياسة في اندلاع الحروب بين الشمال والجنوب، والتي لم تؤدِّ فقط إلى ترسيخ حالة الانقسام، وإنما أسهمت في إضعاف البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان من المفترض أن تشكل الأساس الموضوعي لبناء دولة يمنية موحدة.
وخلال النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، اضطلعت السعودية بدور إقليمي بالغ الفاعلية في مسألة احتواء نظام جنوب اليمن، مستفيدة من الامتداد الحدودي الطويل، ومن شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، ومن ثقلها الاقتصادي والسياسي. وقد ارتبط هذا الدور بجملة من الهواجس، في مقدمتها الخوف من نجاح تجربة وحدوية يمنية قد تفضي إلى قيام دولة ذات توجهات يسارية، أو على الأقل دولة قوية قادرة على إعادة رسم موازين القوى في جنوب شبه الجزيرة العربية، بما قد ينعكس سلباً على الأمن السعودي. وفي السياق الأوسع للحرب الباردة، لم يكن القلق من جنوب اليمن مقتصراً على السعودية وحدها، فقد شاركتها فيه القوى الغربية التي رأت في اليمن الديمقراطي قاعدة متقدمة للمعسكر الاشتراكي في العالم العربي. وقد تعزز هذا التصور بعد توقيع معاهدة التعاون والصداقة بين عدن والاتحاد السوفييتي، والتي كرست الموقع الجيوسياسي لجنوب اليمن بوصفه نقطة ارتكاز استراتيجية للسوفييت في منطقة المحيط الهندي وباب المندب وشبه الجزيرة العربية. وبدأ هذا التحالف، في نظر الغرب، تهديداً مباشراً لمصالحه الحيوية، لاسيما في منطقة قريبة من أهم احتياطيات النفط العالمية، وفي قلب خطوط الملاحة الدولية.
٣- دور اليسار العربي في اليمن الديمقراطي
يرى الكاتب بأنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و1990، تحول اليمن الجنوبي إلى ما يمكن وصفه بعاصمة الشيوعية العربية وقاعدة خلفية للتيارات الفلسطينية، بحيث أصبح الجنوب بمثابة حرم تقدمي في أطراف العالم العربي. لقد تزامن هذا الدور مع الحماية السوفيتية التي أمنت استقرار النظام الحاكم في عدن، على الرغم من هشاشة الدولة وكونها معرضة للصراعات القبلية المستمرة، والتي بلغت ذروتها أثناء النزاع العنيف بين تياري الحزب الاشتراكي اليمني عام 1986. وعلى الرغم من موقعه الجغرافي على هامش العالم العربي، فقد اكتسب اليمن الجنوبي أهمية استثنائية، ليصبح مركزاً للشيوعية العربية وقاعدة لوجستية للمقاتلين والتدريب والتبادل الأيديولوجي.
وخلال هذه الفترة استقبل الجنوب شيوعيين من دول عربية أخرى، مثل العراق ولبنان، الذين فروا من ضغوط الأنظمة المحلية أو شاركوا في حروبها، بما في ذلك الحرب اللبنانية بين 1975 و1990، حيث قدم عدد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين البارزين، ومن بينهم جورج حبش ونايف حواتمة وكريم مروة ونديم عبد الصمد ومحسن إبراهيم وفواز طرابلسي، إسهامات مباشرة في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني عام 1975. وقد انبثق هذا الحزب عن التحالف بين الجبهة القومية، الاتحاد الديمقراطي للشعب، وحزب الطليعة الشعبي، ليجمع بين إرث الوطنيات القومية والاتجاهات اليسارية الاشتراكية.
غير أن هذه الروابط الإقليمية لم تكن خالية من التوترات، فقد مارست بعض القيادات الفلسطينية أدواراً تسببت في توتير الحياة الداخلية للحزب، ومحاولة التأثير على صراعات القيادة اليمنية لتحقيق مصالح شخصية أو امتيازات في عدن. وقد أشار الرئيس علي ناصر محمد إلى أن هذه التدخلات الخارجية أدت إلى تأجيج الخلافات الداخلية داخل الحزب الاشتراكي، وأسهمت في فقدان عدد من القيادات المتعاقبة، مثل سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض، إذ أن غياب التقاليد الديمقراطية للحوار داخل الحزب جعل هذه التدخلات أكثر حدة وتأثيراً. كما لعب بعض قيادات اليسار الفلسطيني، مثل نايف حواتمة، دوراً محورياً في تغذية الصراعات بين يمين ويسار الجبهة القومية، معتمداً على خطاب أيديولوجي قائم على التصنيفات الطبقية والفرز الأيديولوجي، مما أعطى للصراعات الداخلية طابعاً عميقاً ودامياً. وكان تأثير هذه المقولات على اليسار القومي في اليمن قوياً، إذ اعتُبرت نوعاً من الإلهام الفكري والتوجيهي الذي منح هذا التيار قدرة على استقطاب أنصار حول أيديولوجية صارمة، وهو ما عمّق الانقسامات داخل الحزب وساهم في ظهور العنف كأداة لحسم النزاعات منذ بدايتها.
وقد أشار الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، الشهيد جار الله عمر، في حديثه حول أحداث يناير، إلى اتساع نطاق التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للحزب والدولة، سواء من الدول العربية أو من الكتلة السوفيتية والأحزاب الشيوعية العالمية. وقد أظهر هذا التدخل تبايناً في المواقف؛ فبعض القوى كان يسعى لحل الأزمة ودعم الاستقرار، بينما انحاز آخرون إلى هذا الطرف أو ذاك، مستغلين غياب تقاليد ديمقراطية واضحة داخل الحزب، وعدم وجود آليات سلمية لحسم الخلافات السياسية الداخلية. وقد أسهم هذا التداخل الخارجي في تفاقم الانقسامات داخل الحزب، وتعميق الصراعات بين قياداته، بحيث أصبح القرار السياسي في اليمن الديمقراطي مرتبطاً بعوامل خارجية تتجاوز قدرة النظام على التحكم بها، الأمر الذي أسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار وتأزيم الوضع الداخلي على مدار سنوات طويلة.
رغم ذلك، يؤكد الكاتب بن الحديث عن الفشل والتحولات السياسية في اليمن الجنوبي لم يكن متجانساً مع تجاهل الإنجازات. فقد قام الحزب الاشتراكي اليمني، في خطوة نادرة على مستوى الأنظمة الشيوعية العربية، بإجراء مراجعة نقدية شاملة لتجربة الدولة منذ الاستقلال وحتى منتصف الثمانينيات. وقد صدرت عن اللجنة المركزية للحزب وثيقة نقدية تحليلية عام 1987، تضمنت تقييماً موضوعياً لمسار الدولة في الجنوب، مشيرة إلى مكاسبها وإنجازاتها، وفي الوقت ذاته، إلى الأسباب البنيوية والسياسية التي أفضت إلى الصراعات والانقسامات الداخلية، بما يعكس وعياً غير مسبوق داخل الحزب بمحدودية أدواته وقدراته على إدارة الدولة في سياق إقليمي ودولي معقد.
الخاتمة
في النهاية، يمكن القول إن الكاتب قد تمكن من استكشاف دراسة معمقة للتجارب العربية في الحكم بنظام الحزب الواحد الشمولي، ذي التوجه اليساري الماركسي، الذي أعلن اليمن الديمقراطية سابقًا تبنيه لمبادئ الاشتراكية العلمية في فترة حكمها الممتدة من عام 1969 حتى عام 1990. هذه الدراسة لا تكتفي بسرد الأحداث التاريخية أو تقديم وصف عابر للمسار السياسي، بل تتجاوز ذلك إلى تحليل الأسباب الداخلية والخارجية التي شكلت مسار التجربة، بما في ذلك طبيعة الصراع على السلطة داخل النخبة الحاكمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير التدخلات الأجنبية، وخاصة في سياق الحرب الباردة، التي فرضت على الدولة الصغيرة واقعًا مضطربًا من التنافس الأيديولوجي والدعم المتقاطع من القوى الكبرى.
وتتضح أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على جانب محدد ومركزي من ظاهرة فشل اليمنيين في بناء نظام سياسي مستقر خلال القرن العشرين، وهو الفشل الذي تجسده تجربة نظام الحزب الواحد في اليمن الديمقراطية. فقد فشل هذا النظام، رغم ما تبناه من أفكار ومبادئ ثورية، في تحقيق استقرار سياسي دائم، وهو الفشل الذي يعكس أبعادًا معقدة، تشمل النسيج الاجتماعي التقليدي المتعدد، والقبائلية المتجذرة، والصراعات الإقليمية، والتباين بين الطموحات الاقتصادية والسياسية للحزب وبين القدرة الواقعية على تطبيق الاشتراكية العلمية في مجتمع لم يعتد على مؤسسات الدولة الحديثة
وبالتالي، فإن هذه الدراسة لا تقتصر على كونها استعراضًا تاريخيًا، بل هي تحليل متعمق لدرس سياسي واجتماعي مهم، يساهم في فهم العلاقة بين النظرية والسياسة، بين الطموح الاشتراكي والواقع اليمني، وبين محاولات بناء دولة حديثة ومتطلبات الاستقرار السياسي في سياق عربي معقد، يجعل من التجربة اليمنية نموذجًا فريدًا لفهم مسار الفشل والنجاح في مشاريع الدولة العربية الحديثة.

