
بعد تسعِ سنواتٍ من الحرب في اليمن، أهلكت الحرث والنسل، لا نجد مهربًا من مساءلةِ أسباب الفشل في تحقيق السَّلام والاِستقرار، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يُعزى – فقط – إلى نقصِ الكفاءة العسكرية أو غياب إرادة المجتمع الدولي، فالتَّحالف الذي قادته المملكة من أكثر من عشر دول وبدعم قوى عظمى، وتأييد أكثر من نصف الشعب في بدايته، لم ينقصه الكفاءة العسكرية ولا غطاء الشرعية. وعلى الرَّغم من كل ذلك، فقد وصلنا في هذه اللحظة إلى مشهد لا يمكن أن يكون أكثر سخرية مما هو عليه، فالتدخل العسكري الذي بدأ في عام 2015، بهدف إعادة الرئيس هادي المعترف به دوليًّا، أدى إلى استبداله بمجلس رئاسي مُعيَّن، بعض أعضائه لم تعرف أسماؤهم حتى عشية إعلانهم.
والتدخل الذي أَعْلَنَ في بداياته رغبته الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، أدى إلى تقسيمها وتركها مجزَّأة تحت سيطرة فصائل وميلشيات متنوعة بما في ذلك الحوثيين والقاعدة والانتقالي وقوات حزب الإصلاح. إنَّ حجم هذا الفشل ومعاناة الشَّعب الناتجة عنه وغياب التفسيرات المنطقية لما حدث ويحدث هو ما يحتِّم على اليمني أن يتوقف لوهلة، ويفكر بالأسئلة الكبرى التي يواجهها كل يوم:
لماذا فشل التدخل في تحقيق السلام؟
لماذا عادت الهاشمية السياسية؟
ولماذا عاد شبح الانفصال؟
والأهم من ذلك كله لماذا نحن البلد الوحيد في الجزيرة العربية الذي يعيش هذا الوضع في الوقت الذي ينعم أبناء عمومتنا في الخليج بالرخاء والاستقرار؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، يجب علينا أن نبحث بعيدًا عن نشرات الأخبار ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات من فشلوا في إدارة الحرب والأزمة، والأهم من ذلك كله، بعيدًا عن الخطاب السِّياسي الرومانسي التقدمي الذي سيطر على الساحة الثقافية والسياسية اليمنية منذ قيام الجمهورية وحتى هذه اللحظة.
ما يسمى بالحكومة “الشَّرعية” المعترف بها دوليًّا، التي سعى التَّدخل السُّعودي إلى إعادة تثبيتها في اليمن، كانت في الأساس بقايا لنظاميْنِ غير شرعيين من حقبةِ الحرب الباردة، النِّظام الاشتراكي في الجنوب، والجمهوري في الشَّمال. هذان النِّظامان اللذانِ أُنشِئا في شمالِ وجنوب اليمن، كانا محصلة لتأثيرات أيديولوجيات الحرب الباردة والتدخلات العسكرية المباشرة من قبل جمال عبد النَّاصر والاتحاد السوفيتي. وهكذا لم يكن قيام هذه الأنظمة واستدامتها على مدى عقود لاحقة في صُلبِ الإرادة الشَّعبية اليمنية أو احتياجات الإنسان اليمني، بل في الطُّموحات الجيوسياسيَّة للقوى الخارجية خلال فترة مضطربة من التَّاريخ العالمي. اليمن هي الأمَّة العربية الوحيدة الواقعة في شبه الجزيرة العربية التي برزت كحاضنة لنظام سياسي “تقدُّمي” في مِنطَقَة مُحاطة بالمشيخات، وهي كذلك أفقر تلكَ البلدان وأقلها استقرارًا، هذا التَّرافق بين الحالتيْن لافتٌّ جدًّا بحيث لا يمكن تجاهله كمصادفة ولا حتى من قبل عوام النَّاس، لكن الأيدولوجيات اليسارية “التقدمية” التي سيطرت على العقلية اليمنية بعد أن سيطرت على بلاده، كانت جاهزة بإجاباتها المُعلَّبة التي سوغت هذه الظاهرة بتبريرات سطحية كوجود النفط في الخليج بكميات أكبر، أو عمالة أنظمة الخليج لقوى “الإمبريالية”، ويكأنَّ كثرة النفط أسلمت العراق الشقيق من المصير المأساوي الذي يشهده، ويكأنَّ نظام صنعاء وكأن نظام صنعاء لم يكن فعل كل ما يستطيع في سبيل إرضاء أرباب البيت الأبيض.
قبل العام 1962، لم يكن المشهد السِّياسي في اليمن يختلف عن محيطه في الجزيرة، حيث كان الشَّمال يُحكم بواسطة إمامة ملكيَّة، في حين كانَ الجنوب يتألَّفُ من عدة سلطنات ومشيخات واقعة تحت معاهدات حماية مع الإمبراطورية البريطانية، باستثناء مدينة عدن التي كانت تحت الاحتلال البريطاني المباشر، غير أنَّ الموقع الاستراتيجي لليمن جعله عرضةً بشكل خاص لتأثيرات أيديولوجيات اليسار النَّاصرية والسوفيتية في تلك الحقبة. ففي العام 1962، دبَّرَ ناصر انقلابًا ضد حليفه، الإمام أحمد بن حميد الدِّين، في شمال اليمن الذي كان قد سلَّمَ قيادة جيشه قبل ذلك بثلاث سنوات للقيادة المصرية ضمن ما سُمِّيَ حينها بالوحدةِ العربية، مما أدى إلى إنشاء نظام جمهوري عسكري مشابه لنظام مصر ناصر. وفي العام 1963، أدى انسحاب بريطاني غير مُنظَّم من الجنوب إلى حدوثِ فراغٍ في السُّلطة، ذلك الفراغ مكَّنَ للقُوى اليسارية، المُنظَّمة في عدن، والمدعومة من الاتحاد السوفيتي من انتهاز الفرصة والانقضاض على الاتحادي المشْيَخي الضَّعيف في الجنوب، مما أدى إلى إنشاء نظام شيوعي. هكذا وجدت اليمن نفسها واقعة في وحْلِ الأيديولوجية اليساريَّة للحرب الباردة، مما حرف بوصلتها السياسية وأخرجها عن مسار صيرورتها التاريخية الطبيعية، وهو المصير الذي نجحت جارتها الأشبه بها، عُمان، في تجنبه عندما تمكَّنَ السُّلطان العُماني من قمع “ثورة” ظفار.

عانت تلك الأنظمة “التقدمية” التي ظهرت وسط تقاليد قبلية عريقة ومتجذرة في البُنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليمن، من نقصٍ فاضح في الشَّرعية المحلية، حيث كان يُنظَرُ إليها من قبل شريحة كبيرة من السُّكان على أنها مُنتج أجنبي مفروض من الخارج وإن حاولوا تجميلها وتعريبها ويمْنَنَتْها وأسلمتها بتغيير الأسماء وتوزيع المناصب. أعاق غياب الشَّرعية ذاك تلك الأنظمة عن بسط سيطرتها وفرض احتكار العنف خارج المدن الكبرى. ونتيجةً لذلك، ظلّت مساحات واسعة من الأراضي والسكان اليمنيين يعيشون تحت واقع حُكم ذاتي، ولا يرون في سلطات الدولة في المراكز الحضرية إلا ككيانات غريبة، لا تربطهم بها إلا علاقة الشَّيخ بالدولة وولائه غير المضمون لها. أما المشايخ، أولئك القادة القبليون الذي تمتعوا بشرعية سياسية واسعة ضمن مجتمعاتهم المحلية، استمروا في العمل ضمن فراغ السُّلطة الذي لم تستطع الدولة أن تملأه ، ولملء ذلك الفراغ غالبًا ما توجهوا إلى الممالك المجاورة في عمان والسعودية للحصول على الدعم السياسي والمالي مقابل ولائهم للجار ضدَّ الأنظمة الأجنبية المُستورَدَة في صنعاء وعدن، هذه الديناميكية في العلاقة بين الدَّولة والشَّيخ والجار، لم تعرقل استقرار النِّظام السِّياسي وحسب، بل سمحت أيضًا لهذه الدول المجاورة بممارسة نفوذ استثنائي من الدَّاخل.
مع اقتراب نهاية الاتحاد السوفيتي، أنهى السوفييت دعمهم للنِّظام الاشتراكي الجنوبي في اليمن فانقشعت الشرعية الزائفة للنظام الذي كان يشتريها بمساعدات الغذاء والقمح القادمة من الخارج وبمرتبات القطاع العام المترهل الذي وظَّفَ أغلب الشباب القادر على العمل فيه. أدّى ذلك إلى هرولة النظام الاشتراكي باتجاه اندماج مُتسرِّع وغير مُنظَّم مع الشمال خوفًا من المصير الذي لاقاه أقرانه من اشتراكيات شرق أوروبا وهو الذي يعلم أن القبيلة الشبوانية والحضرمية والمهرية التي أعمل فيها تنكيلاً تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه. ذلك الاندماج السريع غير المدروس والمدفوع بالخوف والمصالح الشخصية أدّى إلى وحدة قصيرة الأجل انهارت بعد أربع سنوات فقط، وأدى ذلك الانهيار إلى حرب توحيد انتهت بانتصار الشّمال، وتفكيك النُّخب السياسية الجنوبية، وولادة وحدة ميتة سريريًّا – وحدة بالمُسمَّى وحسب، وحدة افتقرت إلى التكامل والاندماج العادل.
رغم تحديات غياب الشرعية المشابهة التي واجهت النظام في الشمال، إلا أنَّ النظام حاول تمديد عمره عن طريق تشكيل تحالفات مع بعض المشايخ الأقوياء كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. ساعدت هذه التحالفات في إطالة عُمْر النِّظام لعشرين سنة إضافية موزانة بقرينه في الجنوب، لكنها لم تكن حلًّا للمشكلات العميقة في بُنية النِّظام نفسه، حيث استمرَّ الصدام المؤسسي بين البُنى القبلية الأصيلة وجهاز الدولة المُستورد أمرًا لا مفر منه، الأمر الذي انتهى بالنظام في الشمال بمصير مشابه لذلك الذي في الجنوب.
بعد حرب الخليج، واجه النظام في صنعاء سلسلة من الصدمات الاقتصادية، التي زادت سوءًا بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي سيئة السمعة. ونتيجة لذلك، وجدت الحكومة في صنعاء نفسها عاجزة بشكل متزايد عن الاستمرار في دفع الحوافز المالية التي كانت سابقًا تضمن ولاء المشايخ القبليين، وبدلًا من استخدام موارد الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أُهدِرت الكثير من المصادر في الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية ومسرحية الديموقراطية الهزيلة. في ذلك الوقت، زادت نسب الاستياء من الدولة المُستوردة في المناطق القبلية، وأدت محاولات الحكومة لاستغلال الموارد في هذه المناطق دون مبادرات تنموية مُقابلة إلى زيادة الاستياء والغضب بين أبناء القبائل تجاه الدولة، وأثر هذه الاستياء بشكل خاص على الجيل الأصغر داخل هذه المجتمعات القبلية الذي لم يعد مُرتبطًا بالشيخ بنفس طريقة ارتباط والده وجدِّه، فالشيخ لم يعد مندوب القبيلة وقائدها، بل صار مندوب الدولة وعميلها. ومع ذلك الغضب أصبح أولئك الشَّباب أكثر انجذابًا لحركات التمرد المختلفة كالقاعدة، والحَرَاك الانفصالي في الجنوب، وجماعة الحوثي. كل واحدة من هذه الحركات، بطريقتها الخاصة، قدَّمت منفذًا للتعبير عن الإحباط والمعارضة ضد الحكومة المركزية، مما زاد من زعزعة الوضع المتوتر بالفعل في اليمن.
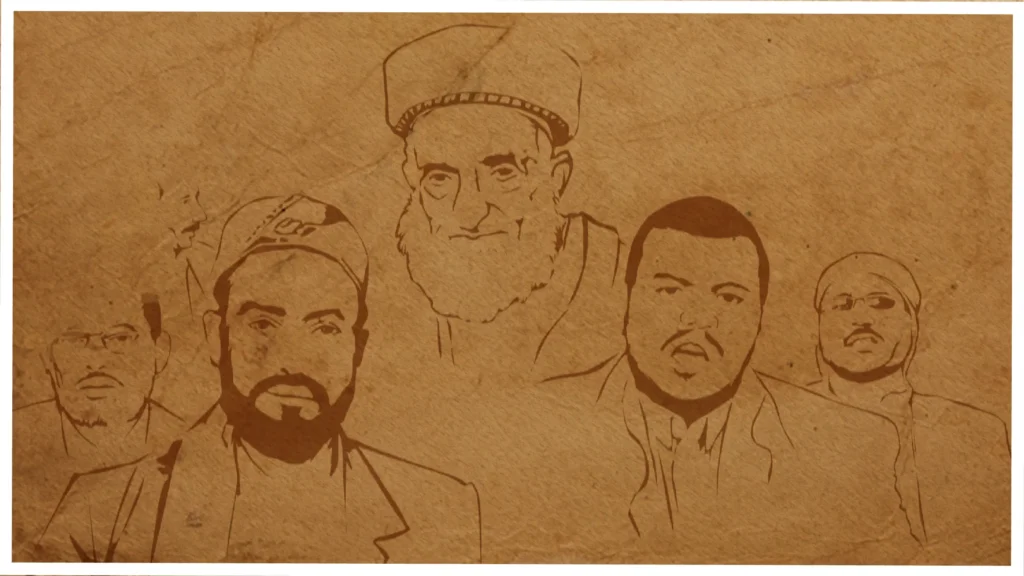
استفادت عائلة الحوثي، على وجه الخصوص، من ارتباطاتها التَّاريخية المذهبية والعائلية مع بعض أقوى القبائل الشَّمالية وقدَّمت نفسها بشكل متزايد كمدافع عن حقوق أبناء القبائل، وكوريث شرعي لنظام الإمامة الذي حكم تلك المناطق لقرون طويلة، وتمكنت الجماعة من خلال لغة خطابها القريبة من احتياجات الناس ومعاناتهم من تأمين موقعها كمدافع عن شرف القبائل الشمالية وسيادتها وثقافتها ومصالحها، فتمكنت من إعادة إحياء الحِلف التَّاريخي بين تلك القبائل والهاشمية السياسية. وموقف الجماعة الحوثية في كينونته عبارة عن مشروع مُناهِض لمشروع الدولة “التَّقدمية” المستوردة، التي نظرَ إليها أبناء القبائل ككيان أجنبي يحاول تدمير القبيلة بكلِّ ما تحمله لهم من معانٍ حسيَّةٍ ومعنوية. استفادت الجماعة من الفراغ في السُّلطة الذي ظهر في عام 2011 إثر تمرد الريف والحضر الذي شهدته البلد، واستخدمت الجماعة قوة أبناء القبائل الشمالية للإطاحة بما تبقى من النِّظام “التقدُّمي” الضَّعيف وأحكمت سيطرتها على الشَّمال، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
منذ انهيار الدولة في عام 2011، ركَّزت جهود السُّعودية بشكلٍ رئيس، إمَّا عمْدًا أو عفويًّا، على إعادة إحياء نظام انتهت صلاحيته بالفعل، وهذا الهدف حدَّد نوعية الحلفاء التي اختارتهم المملكة في حربها، فشكل المملكة تحالفات مع الفصائل المختلفة التي أفرزتها الحقبة الجمهورية القصيرة عوضًا عن تحالفها مع المكونات المحلية التي أفرزها التَّاريخ اليمني الطويل الممتد، وشملت هذه الفصائل حزب الإصلاح، والحركة الانفصالية الجنوبية، وجماعات وميلشيات أخرى. وفي الوقت الذي عمدت وعزَّزت فيه الحرب التَّحالف بين الحوثي والمكون الأعرق والأقوى في اليمن، القبيلة الشَّمالية، ظلت تفاعلات التحالف مع القبائل اليمنية ذات طبيعة مؤقتة، متجاهلًا بذلك النَّهج الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القبائل في الصراع، خاصةً بالنظر إلى قدرتها المشهودة على دعم الحوثي ومواجهته على حد سواء، وكانت الحالة الأخيرة أشد وضوحًا في محافظة مأرب الغنية بالنِّفط، وهي المحافظة الوحيدة في هذا الوقت الواقعة تحت حكم زعيم قبلي، سلطان العرادة. وتعدُّ مأرب استثناءً في الطريقة التي تعامل بها التَّحالف مع الحربِ اليمنية، فغالبًا ما تمَّ تهميش الآليات القبلية أو الاستهانة بها من قبل القوى “التقدمية” الداخلية والقوى الخارجية، وهكذا فكلٌ من قبائل الشمال الموالية للحوثي وقبائل مأرب المناهضة له تضرب مثالًا واقعًا وحيًّا عن فعالية وثمار الانخراط بشكل أعمق واستراتيجي مع البناء القبلي في المشهد السياسي والعسكري اليمن.

هذه المراجعة العامَّة لتاريخ اليمن السِّياسي يؤكد نقطة واحدة، وهي: إنَّ أي حلٍّ دائم وسلام مستدَام للقضية اليمنية يجب أن يقوم على أساس مواءمة البلاد مع بقية محيطها الجيوسياسي. ويعني هذا بناء دولة قائمة على التَّحالفات القبلية، تمنحُ القبيلة دورًا مستحَقًّا داخل كيان الدولة وهيكلها، ولمقاربة هذا التصور فهناكَ عدد من النَّماذج المشابهة في المنطقة والعالم التي تعطي لمحة لشكل وتركيبة تلك الدولة ومستقبلها، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو سلطنة ماليزيا أو غيرها من الاتحادات الملكية التي نجحت في دمج كيانات سياسية متنوعة في إطار وطني متماسك. ولا يعني ضيق المقام يُسر وسهولة المقال، فمثل هذا الحل يتطلَّب التَّعامل مع تأثيرات وبقايا حقبة الحرب الباردة التي أثَّرت بشكل كبير على الحالة الراهنة لليمن، فتجاوز تلك الآثار التَّاريخية لبناء دولة تستغل وتستوعب البناء القبلي ليس بالأمر الهيِّن. غير أنَّ البذل في سبيل العودة للجذور وَفْقًا لرؤية واضحة من أجل الوصول للسَّلام المستدَام والاستقرار المحفز للتنمية لن يكون أعلى ثمنًا من ذلك الذي يدفعه اليمنيون كل يوم لقاء هذا التَّخبط الذي يعيشونه منذ أضاعوا مسار صيرورتهم التَّاريخية في ستينيات القرن الماضي.
*للتوسع في موضوع المقال يمكن مطالعة كتاب جمهورية بلا جمهور للكاتب.

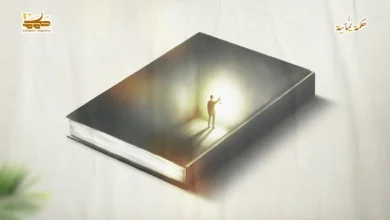
ودواها بالتي كانت هي الداء !!!
قرأت المقال وهناك ملحوظات عليه:
– بادئ ذي بدأ فالكاتب لم يجب على الأسئلة الكبرى التي أوردها، و إنما ذهب ليحلل واقع كل مرحلة بفرضيات لم يسندها الى أدلة ملموسة وحقيقية من التأريخ، ولذلك غلب على المقال الاستنتاجات البعيدة عن الأدلة الموثقة بشواهد حقيقية.
– جزء من التحليل التأريخي غير دقيق فعلى سبيل المثال:
– يقول : إن بريطانيا انسحبت وتركت فراغ في السلطة في عام 1963م، وهذا الكلام غير صحيح، بل إن بريطانيا خرجت بقوة البنادق وكان جلاءها في 30 نوفمبر 1967م، وهذه المعلومة قد تعطينا تصور لمدى صواب التحليل من قبل الكاتب لما بعدها من تحليلات وهو فعلاً ما حصل، فالداعم لسبتمبر وأكتوبر واحد فمسألة الأيدلوجية المغلقة لم تكن في تلك المرحلة حكراً على الجنوب رغم أن الداعم واحد لثورة سبتمبر و أكتوبر ..
– التيار الأيدلوجي للسلطة الحاكمة في الجنوب ظهر جلياً وبشكله الفاقع بعد أحداث الرئيس سالمين بقيادة عبدالفتاح أسماعيل الذي أسس الحزب الاشتراكي في أكتوبر 1978.
– من التصوير الخاطئ للمشهد التأريخي أن انسحاب بريطانيا كان انسحاباً غير منظّم، مع أن وزير الخارجية أعلن في مجلس العموم البريطاني أن حكومته قررت تقديم تاريخ الإستقلال من عام 1968 إلى نهاية شهر نوفمبر1967. وحددت بريطانيا المفاوضات برئاسة اللورد شاكلتون مع وفد الجبهة القومية برئاسة قحطان في الساعة الثانية مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 1967 في مدينة جنيف، بسويسرا.
– هل الدور الذي يلعبه سلطان العرادة هو نفس الدور الذي لعبه عبدالله بن حسين الأحمر في استمرار الدولة الهزيلة الموالية للقبيلة أكثر من ولائها للدولة والنظام؟!
ما ذكره صاحب المقال أن القبيلة كانت غطاء لنظام بلا شرعية وأنها هي العصب!
هذا التحليل يضعنا أمام رسم صورة حقيقية حسب المنطق السياسي لا سيفان في غمدٍ واحد وهذا ما يقرره الشرع والعقل الواعي والتأريخ السياسي اليمني، فوجود القبيلة بالنموذج السابق لنظام عفاش يعطي نتيجة حتمية لفشل أي نظام يمكن أن يقوم مع مناطق القبائل التي تمتلك كثير من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مع الأكثر من الناس المنتمين للقبيلة حيث يعتبر العنصر القبلي في اليمن يشكل النسبة الأعلى للسكان.
الخلاصة : نموذج العرادة ليس هو النموذج للحل كما تحاول المناكفات قوله في اليمن فمأرب ليست دولة و إنما الوضع فيها الان كالوضع في مرحلة ما قبل الدولة والتعرض للخطر الداهم والمحدق ..وهي غالبا تكون مرحلة تفاهمات و ومرحلة الأعراف والتهدئة كون هناك خطر مرتقب على التخوم ولذلك الكل عليه أن يتماسك و يؤجل أي خلافات أو إحداث فوضى، هذا فقط.
– في الحقيقة الكلام كثييير و الحقيقة تعبت من الكتابة ولكن رؤوس أقلام.
– لماذا لم يذكر الاسباب الحقيقية لفشل الدولة والتي منها:
-أولاً : فشل الوحدة وهذا ملف طويل له أسبابه الموضوعية وهنا نتحدث سياسية بعيدا عن الأيدولوجيا ..
فحصر الشراكة في الوحدة بالحزب الاشتراكي وليس الجنوبيين كان الخطأ الأكبر بعد انتصار حرب 1994 حصروا الشراكة للجنوبيين في الاشتراكي واستبدلوها بحضور ضعيف جداً ممثلاً بالدنبوع ومن على شاكلته على اعتباره ممثلاً للجنوبيين وهي ذات العقلية القبيلية في الشمال والتي تكررت على مستويات متعددة ( جيب واحد ضعيف جنوبي ومكنه من منصب (النائب لأي تكوينه) حتى فريق رياضي ههههههههههه أفضل ما يجيك شخصية حقيقية ملو هدومها على رأي المصريين، مقابل إحالة أكثر من 100 الف موظف من كادر الجنوب الى التقاعد من اصحاب الكفاءات.. وأحالوها وأحالوا أسرهم الى خانة الفقر وهذا الاسباب التي كونت ماسمي بعد ذلك بالحراك الجنوبي.
ثانيا : الفساد المستشري الذي أصاب السلطة والمعارضة والقبيلة معاً في حالة لا نظير لها في العالم القديم والحديث حتى أصبح الفساد ثقافة وتلوث كل المجتمع بعقلية الفساد حتى في أدق الامور وأصبح أحد أساسات التفكير المجتمعي ويمارسه كل أشكال المجتمع تقريبا إلا من رحم الله حتى أن الدعوة وهي أشرف القطاعات لم تخلو من بعض أشكال الفساد والمحسوبية.
ثالثا: الارتهان للخارج اعتبار الوصول الى اللجنة الخاصة شرف ونجاح فالكثير يستلم رواتب من أجهزة الدول بمافيها الرئيس والشيخ الاحمر وأولاده واحد يستلم من المملكة وثان من مفطر وثالث من ليبيا القذافي في حالة مقرفة وهذا ما أقر به حميد الاحمر في لقاء متلفز وحتى بعض قيادات العمل الاسلامي لم تسلم والله المستعان ..
رابعاً : تقاسم النفوذ بين الأسر الحاكمة من المنطلق القبلي حتى وصل الى النفوذ العسكري والاقتصادي بل وتقسيم الثروات بينهم وتوزيع الأدوار في الاحزاب حتى وجدت المعارضة الهشة والمرتهنة للنظام وللخارج، حتى وقع السقوط الحتمي ..
الكلام يطول
وخلاصته :
لولا سلطة القبيلة في اليمن لمًا ارتد الجنوب عن الوحدة ولما سقطت الجمهورية وعادت الامامة ..
المقال ممتاز في توصيف الحالة اليمنية منذ انقلاب ٢٦سبتمبر….فهو يصف الحالة اليمنية سياسيا واجتماعيا وجيوسياسيا بشكل جميل وواعي ..
لكنه لم يجب بشكل واضح على السؤال الكبير الذي طرحه عنوانا لمقاله..ولا الاسئلة التي سطرها في مقدمة مقاله أيضا..
كما أننا للاسف لربما نتفق في التوصيف والعرض وتختلف عند التنزيل ووضع الحلول.
فالقبيلة التي يرى أنها سبب لنكبات اليمن وامتداد للتدخلات الخارجية …يراها ذاتها حلا لليمن واستيعابها ضروري في المرحلة القادمة …وهذه من الإشكاليات التي لم يوضح كيف تكون المشكلة مشكلة وحلا في آن واحد.
اشكر صاحب المقال على التوصيف الجميل والواعي..والمزيد من التأمل والعناية والتجرد سيعطينا المزيد من الوعي والرشد عند وضع الحلول وتوصيف المخارج
مخجل ان ينشر هذا المقال في حكمة يمانية.. الكاتب لا يعلم تاريخ اليمن بدقة والامام احمد قبل الثورة.. والثورة لم تكن تدبيرا خارجيا او مؤامرة خارجية
يا فرحة الحوثيين بالمقال
المقال يشكك في شرعية رفض اليمنيين للامامة