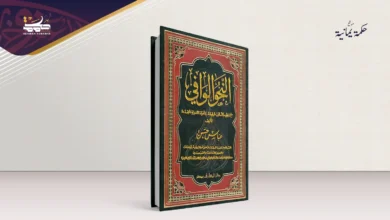من غديرِ خم إلى نهر الشَّعب
تعدُّ مسألة الحكم من أهـمِّ المسائل التي طال الخلاف فيها وتوسَّع، وزاد من تعقيدهـا اعتبارهـا من مباحثِ علم الكلام لدى بعض الفرق الإسلامية كالاثني عشرية والزيدية، بخلاف أهل السُّنة التي هـي عندهـم من مباحثِ الفقه، والفَرق بين الأمرين: أنَّ الأول يجعل هذه المسألة من المسائل الثَّابتة التي تميز الجماعة عن غيرها، في حين يجعل المبحث الفقهي من الإمامة قضية مرنة مستوعبة للواقع، مُكيفة للجديد على ضوءِ القواعد العامة للدِّين، والخلاف فيها وارد، وتجاوز ما ليس بصالحٍ منها للزَّمان والمكان واجب؛ ولكن هذه المسألة أقحمت في أبواب العقيدة عند المذهب الزيدي، وتمَّ من خلالها مصادرة حقَّ الأمَّة في الاختيار، وعلى الرَّغم من تجاوز اليمنيين لها، ومُضيهم في تأسيس دولتهم على مبادئ العدل والمساواة إلا أنَّ الفكرة عادة بعد الانقلاب الحوثي على إرادةِ اليمنيين، ويتم التَّرويج لها في كلِّ المحافل المرتبطة بالجماعة، ولهذا كان من الأولى الوقوف على أصولها، وبيان مدى انحرافها وزيْفها.
أولًا: البدايات التَّأسيسية لفكرة الولاية
إقحام مسائل الحكم بأصولِ الدِّين اكتسبَ أحقيته من الخلافاتِ السِّياسية حولَ الحكم، حيثُ اكتسبَ البعد القبلي حضوره في المشهد، مستمدًا وجوده من صراعات النُّفوذ قبل الإسلام بين القبائلِ القرشيَّة بعضها مع بعض، كما كان بين بني أميَّة وبني هاشم، أو بعد الرِّسالة كما كان بين الأنصار والمهـاجرين، أو ما حصل بعد ذلك من خلافٍ بين الأمويين والهاشميين بقسميهم العبَّاسي والعلوي، ثمَّ بين العبَّاسيين والعلويين فيما بينهم، مما أدى على تقديس الفكرة، وحشد المبررات الشَّرعية والعقلية لها.
هـذا التَّحول الذي حصل في تقديس الإمامة والإمام ربما كان مصدره بيئة أخرى خارج البيئة الإسلامية، كما يرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري في كتابه “العقل الأخلاقي العربي”، حيث يُرجع هـذا التحول إلى عهد هـشام بن عبد الملك، الذي تُرجم في زمنه الموروث الفارسي، خاصة منه ما يتعلَّق بالملوك والآداب السُّلطانية والبرتوكول والسِّياسة والأخلاق والكتاب[1]، وفي هـذا الإطار يقول أبو عثمان الجاحظ في كتابه “التَّاج في أخلاق الملوك” في بيان مدى تأثر الثَّقافة الإسلامية بالموروث الفارسي: “وعنهم أخذنا قوانين الملك والمملكة، وترتيب الخاصة والعامة، وسياسة الرَّعية، وإلزام كل طبقة حظها”[2].
يُعد المَلِك عنصرًا أساسيًا وضروريًا في الأخلاقِ الكسروية، وطاعة المَلِك هـي القيمة المركزية في هذه الأخلاق، ولتعزيز منزلته وُظِّفت كتب ونُسجت أساطير لتخليد هذه القيمة في وجدانِ الفرس، وبهم تأثرت الحياة السِّياسية العربية، ومن المجالات التي تأثرت بها- بحسب رصد الجابري- تأسيس الملك على الدِّين، وحراسة أهـله من أن ينقلبوا على المَلِك، وترسيخ فكرة خلافة الله، وتمجيد الطَّاعة، وربط العدل بالعمارة والمال، والجند من أجلِ مصلحة الملك ودوامه، وتقديس شخصية الملك واعتبار الرَّعية عبيدًا، وتنصيب المَلِك وسيطًا بينهم وبين الله، وقد انتقلت هذه القيم إلى المجتمع العربي ورسخها بعض رجال الدِّين الرَّسميون، وخصومهم من حاملي لواء المعارضة والثورة ضدهم[3].

هذه الثَّقافة التي تأثَّر بها الحكام الأوائل تجعل الدين خادمًا للدولة، وتحوله إلى أداة تسويغ لا رسالة تغيير، فهـو يمنح الملوك شرعية استخدام الدين في ترسيخ ملكهـم، والتحكم في رقاب رعيتهـم، ومحاربة خصومهـم السياسيين، ويُرسخ ما يُسمى بتأميم الدين، ومصادرة فهمه لصالح الحاكم.
وفي حقيقة الأمر أنَّ كل دعوة تسعى لتغيير الواقع أو تصويبه تشتبك مع الظروف المغايرة لها؛ ولهذا تبحث عن الأمور التي توفر لها الانطلاق وتحرسهـا من الانتهـاء، ومن ذلك التشكل في كيان اجتماعي أو سياسي كبير، والدعوات ذات الغاية الدينية تستخدم الوسائل السياسية والاجتماعية لتأمين بقائها، أو العكس، وهذا الأمر يعد انعكاسًا مباشرًا للخلط بين التشريع الإلهي وإفرازات الصِّراع السِّياسي.
وهـكذا تدرج الفعل الشيعي عمومًا، “فقالوا أولًا بأولوية أهـل البيت في الحكم والخلافة، ثم قال بعضهم بتعيين الله للأئمة… وقد التقت هذه المفاهـيم التي كانت تتبلور في مطلع القرن الثاني الهجري مع حالة التمزق الذي كان يعصف بالحركة الشيعية والصراع الداخلي على القيادة بين أجنحة أهـل البيت المختلفة، فأدى كل ذلك إلى نشوء نظرية الإمامة”[4]، ثم استخدمت الزَّيدية ذلك بعد الوصول إلى الحكم لتثبيت السلطة السياسية، واستخدمت السلطة السياسية فيما بعد لتحقيق وحدة عقائدية، وهذه الوحدة العقائدية التي أرادت الزيدية فرضها ترى الإمامة ركنًا من أركانِ الدِّين، وتراهـا محصورة في البطنين منهم فقط، واستخدمت كل الوسائل لتثبيت هـذا الحق، وشرَّعت عددًا من وسائل القمع لمن لا يقر لهم بذلك ولو كان من الزيدية أنفسهم، ومزجت بين طغيانين عظيمين طغيان الدين وطغيان السياسة، وأثبتت تلك الحالة أنَّ الطغيان الديني والسِّياسي قرينان متى وجد أحدهـما وجد الآخر.
هـذا الأمر جاء بحسب تعبير الباحث الزيدي محمد عزان “نتيجة للخلط بين التشريع الإلهي في المسألة، وبين إفرازات الصراع ومقتضيات الظروف والأحوال، فمسألة الإمامة ذات الأصل الشرعي والطبيعة السياسية، قد أقيم الصراع فيها على أرضية دينية، فطوعت الآيات والأحاديث؛ لتدل هـنا على شيء وتعارض هـناك شيئا آخر، فقُدمت بتفاصيلها للمجتمع على أنها جزء من الدين والعقيدة، وأخذ كل طرف يطالب الآخر بتطبيق ما يراه شرعًا في المسألة، فكثر النزاع واشتد الصراع”[5].
وهكذا أثَّر عاملان مهمَّان في هذا الموضوع:
الأول: تراكمات الصِّراعات القبلية قبل الإسلام وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني: التجارب السياسية المجاورة.
وهذه التراكمات لا تزال حاضرة في عصرنا، ومؤثرة في عقول بعض المعاصرين وفكرهم، وهي نوع من الظلم للإسلام والمسلمين، حيث تعد أول جناية فيما يتعلق بالحكم اعتباره أصلًا من أصول الدين، ثم جعل إقامة الحاكم واجبًا شرعيًا بالمفهوم الذي يريد احتكار الفلسفة والإجراء، وحتى الشكل نفسه عند بعضهم، وهـذا معناه التوقف والجمود.
ثانيًا: حق الأمة في الاختيار

جاءَ الإسلام بقيم وقواعد تنظم الحياة، ومن أهمها تلك القيم المتعلقة بشؤون الحكم والسياسة، وعلى رأسها حق الأمة في اختيار من يحكمها، فالأمة هي مالكة السُّلطة ومدبرة الشَّأن، وهي من تقوم بكلِّ أشكال المراقبة والمحاسبة والعزل، وهذا الحق كفله الإسلام، وأكدته الدَّساتير الحديثة، فلم يكن ترك النَّبي صلى الله عليه وسلم للاستخلاف من بعده حدثًا عفويًا أو أمرًا عاديًا، بل كان فيه من القصد ما يكفي لإشعار الأمة أنها أقدر على حفظ مصالحها بما يتوافق مع الواقع، وهو اعتراف بإرادة الأمة وأحقيتها في الاختيار.
إنَّ اختيار الحاكم حقٌّ للأمة عن طريقِ الشورى، وللأمة أن تحدد الآلية التي بها تطبق هذا الحق، فاختيار الوسائل الممكنة أمر متروك لمعطيات الزَّمان والمكان والإمكان، ولقد تضافرت الأدلة من القرآن والسُّنَّة لتبيين أمر الشورى؛ بل واقترنت بالعبادات الشعائرية في بعض الآيات كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى: 38)، فهذه الآية تجمع بين الصَّلاة والشورى والصدقة في بيان صفات المؤمنين؛ بل إنَّ الله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم لموقفه المؤيد للشورى ونتائجها في قرار من أخطرِ القرارات، وهو القرار المتعلق بغزوةِ أحد، وأيهما أفضل للمسلمين في المدينة؛ البقاء بها أم الخروج، فنزل الوحي مؤيدًا لهذا الإجراء الذي اتخذه النَّبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: 159).
ولهذا حرصَ النَّبي صلى الله عليه وسلم على مشاورة الصَّحابة فيما يتعلق بأمور الأمَّة العظيمة، ونزل عند رأي أغلبهم، وإن رأى أنَّ هناك رأيًا أصوب أخذ به، إلا في أمور الوحي، والآيات السَّابقة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشَّك- أنَّ أمر الأمة شورى، وأنهم هم من يختارون حكامهم ويراقبونهم ويحاسبونهم ويعزلونهم، وهذا هو فهم الصحابة الذي تحوَّلَ إلى واقع عملي بعد وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وكان اجتماعهم في السقيفة تطبيقًا واضحًا لهذه النصوص القرآنية، ولا يحصل التعبير الصحيح عن إرادة الأمة إلا إذا كان اختيارهم من مجموع الأمة، وكان هذا الاختيار صريحًا وليس شكليًا أو مزورًا.
إنَّ تمكين الأمة من حقِّ الاختيار ينسجم مع طبيعة الدِّين نفسه، حيث يميز علماء الأصول تمييزًا واضحًا بين العبادات والعادات، ولهذا يقول الشَّاطبي في موافقاته: “الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد، دون الالتفات إلى المعاني. وأصل العادات الالتفات إلى المعاني”[6]، ويرجع الشَّاطبي العبادات إلى حفظِ الدِّين، كالإيمان والشهادتين والصلاة والزكاة وغيرها، والعادات راجعة إلى حفظ النَّفس والعقل والنسل والمال، وأمور الدولة مرتبطة بهذه الأربعة الأخيرة، التي الأصل فيها النظر والاجتهاد، وتغليب المصالح العامة للأمة.
وهكذا يجب التمييز في حياتنا بين العبادات والعادات، فالعبادات تم التفصيل فيها شرعًا، والعادات، وهي ما يتعلق بجوانب التدبير البشري، ومنها تلك الأمور المتعلقة ببناء السلطة وأدائها، خاضعة للاجتهاد والموازنة البشرية، وهذا التمييز مهم؛ لأنَّ الخلط بينهما من مداخل الغلو في الدين الذي ما زلنا نعاني آثاره إلى يومنا هذا، وهذا المعنى يوضحه الجويني في غياثه حيث يقول: “ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين”[7].
على أنَّ ذلك لا يعني أنَّ هذه المسائل مقطوعة الصلة بالدين، بل هي داخلة في عموم القواعد الأساسية، وتخضع للتوجيهات والقيم العامة التي جاء بها الإسلام، وأغلب تلك التوجيهات والقيم والقواعد لا تختلف عليها العقول البشرية، وتبقى الآليات والإجراءات خاضعة لمتطلبات الواقع وتجارب البشر، تحكمها الصلاحية والقدرة، وما سبق من تصرفات واجتهادات وأشكال وأنظمة هي تجارب بشرية خاضعة للنقاش والتداول مثلها مثل بقية التجارب الإنسانية، ويمكن الاستفادة منها ما لم يكن هناك ما هو أصلح منها للواقع، لأنها متروكة للاجتهادات البشرية، والبحث فيها يكمن في البحث عن صلاحيتها وقدرتها على الاستمرار وعدم تعارضها مع قواعد الإسلام العامة.

ثالثًا: مصادرة حق الأمة في الاختيار
في الوقت الذي تجاوزت فيه الأمم الأخرى مسألة انتقال السُّلطة وتحديد الآليات المنظمة لها، ونصَّت دساتيرها على أنَّ الشعب مالك السلطة، وهو المعني بمراقبة الحاكم ومحاسبته، لا زلنا نسمعُ أصواتًا مناهضة لهذا الحق، وتُغلف -للأسف- في كثير من الأحيان بنصوص دينية وأخرى سلطوية، تكبل الأمة وتلغي حقها في اختيار حكامها.
ومن ذلك ما يستدل به الزَّيدية من أدلةٍ مجملة يدخل فيها عموم المؤمنين، أو أدلة خاصة لا تدلُّ على الفضل وليس فيها ما يدل على الإمامة، مثل قوله تعالى: “إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُوله وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهـمْ رَاكِعُونَ”(المائدة: 55)، على أنَّ الصفات المذكورة في الآية تنطبق على عليٍّ، وقد يُذكر الواحد بلفظ الجميع تفخيمًا لشأنه، وأنه هـو من تصدق وهـو يصلي، لذا فإن الآية تنطبق عليه، والولاية المقصودة هـي الإمامة.
ويقولون المراد بالولي لا يخلو من وجهـين: التولي في باب الدين، أو نفاذ الأمر وتنفيذ الحكم، وإذا سلمنا بذلك فإنَّ الأول لا يختص به هـو فقط لأن الواجب تولي كل المؤمنين، وهـذا النص كما يرى القاضي عبد الجبار إما أن يتعلق بظاهـره، أو بأمور تقارنه، فإن تعلق بظاهـره، فهـو غير دال على ما ذكروه، وإن تعلق بقرينة فيجب أن يبينها، ولا قرينة من إجماع أو خبر مقطوع به، وظاهـره لا يدل على ما ذكروه، لأنه تعالى ذكر الذين آمنوا من غير تخصيص لعلي، ولا فرق بين من تعلق بذلك أنه الإمام، وبين من تعلق بذلك أنه غيره، وقوله تعالى: “وَهـمْ رَاكِعُونَ” لم يثبت أنه لم يحصل إلا لعلي، وإن ثبت فما فعله علي من باب النفل وليس الزكاة، والمدح هـنا لمن يؤتي الزكاة وطريقتهم التواضع والخضوع، وليس المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة، فإن صح أنه المختص فمن أين أنه يختص بهذه الصفة في وقت معين، فإن كان ثابتًا له من وقت النزول، فأنه لا يصح أن يكون إمامًا مع الرسول، والآية ذكرت تولي الله والرسول وذكرت فيما بعد تولي المؤمنين، “وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُوله وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هـمُ الْغَالِبُونَ” (المائدة: 56)[8].
إضافة إلى ما تقدم فإنَّ كل الضمائر التي وردت في هذه الآيات أتت بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تفيد جميع المؤمنين إلا بقرينةٍ صارفة ولا قرينة هـنا، ومثل ما قيل في آية الولاية يمكن أن يقال في كل الآيات والأحاديث العامة، والتي لم يرد فيها ما يفيد الحصر أو التخصيص أو الإفراد.
ومثل ذلك الولاية المذكورة في حديث غدير خم الذي قصد به المولاة في الدين، ولو كان المقصود به الإمامة، “لكان علي لا بد أن يدعي لنفسه هـذا النَّص، ويدعيه له غيره ممن كان يتعصب له في باب الإمامة ويحب نصرته فيه، كالعباس والزبير وعمار والمقداد، بل كان يجب إذا كان الأمر ظاهـرًا أن لا يجوز من جماعتهم، مع التَّمسك بالشريعة أن يعدلوا عن ذلك، والعهـد قريب، كما لا يجوز أن يعدلوا عن الأمور الظاهـرة بالشرع، وقد ثبت في المناقب المختلفة التي تحتاج في مثلها لقطع المنازعة ولغير ذلك من الأغراض المتعلقة بالدين والدنيا أنه يحتاج إلى ذكر النَّص لو كان له أصل، ومع ذلك لم يذكره”[9].
لا شك أن عليًا كان يعتبر نفسه أولى من الآخرين بأمر خلافة المسلمين واستلام زمام أمورهـم؛ لكنه لم يعتبر في أي وقت من الأوقات أنَّ دليل أحقيته هـذا هـو النَّص الإلهي له في هـذا المقام، خاصة يوم الغدير، بل كان يشير في معرض إثباته لتقدمه على سائر الصحابة إلى خصائصه؛ ليثبت من خلال ذلك فضيلته وتقدمه على الآخرين؛ ولكنه لم يقل قط: إن الله تعالى نصبني بأمره وبواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم إمامًا على الأمة، وإذا لم يسمع لي الناس ويطيعوا أمري فقد خانوا الله ورسوله[10].
وللمفكر الإسلامي العراقي يحيى محمد تخريج جيد بخصوص هـذا الموضوع، حيث يرى عدم وجود دلالة صريحة في القرآن الكريم تتعلق بأمر الخلافة أو الزعامة الإلهية، إذ لو كان حالها بالغ الأهـمية من حيث التعيين كالنبوة لكانت بينة مثلها، أو على الأقل لكانت لا تقل ظهورًا عن ضرورات الدِّين من الصَّلاة والصوم والحج، كذلك لم يرد عنهم أي ذكر للوصية والنص عليها، ولا يعقل أن المهاجرين والأنصار تجاهـلوهـا جميعًا، خصوصًا وأنَّ خسارة الأنصار أمام المهـاجرين تجعلهم في أمس الحاجة لتوظيف مثل هـذا السلاح إن كان موجودًا، كما أن الإمام عليًا هـو الآخر لم يحتج بالنَّص على حقه في الخلافة، بل روي أنه احتج على حقه تبعًا لاعتبارات فضله في الإسلام ومكانته من النَّبي، وأيضًا فإن تنازله عن حقه في الخلافة ومبايعته لغيره وقبوله أن يرضى كواحد من أعضاء الشورى المرشحين للخلافة بعد عمر بن الخطاب من غير اعتراض يتعلق بالنص – سوى ما كان يذكّر به من مناقبه – رغم ما آلت إليه النتيجة من عدم اختياره للحكم، كل ذلك يجعل أمر الوصية في الخلافة مستبعدًا، هـذا بالإضافة الى الروايات التي دلت على ما أبداه من مرونة فائقة عند إلحاح النَّاس عليه بالبيعة بعد مقتل عثمان، وهـذا المرونة لا تتسق مع التعيين والوصية، ومثل ذلك ما حدث من ولده الحسن حين صالح معاوية وتنازل له[11].
وقد ورد عن علي بن أبي طالب عدة نصوص في نهج البلاغة وهو من أهم كتبهم توضح أنه كان لا يرى لنفسه حقًا ولا وصية، ومن ذلك قوله: “أيها النَّاس، إنَّ أحق النَّاس بهذا الأمر أقواهـم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه”[12]، ولما أراد النَّاس مبايعته بعد مقتل عثمان، قال: “دعوني والتمسوا غيري؛ فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم عليه القلوب ولا تثبت عليه العقول”[13]، فلو كان علي يؤمن بأنَّ له حقًا في هـذا الأمر لما صرَّحَ بهذا، بل ويؤكد على أمر الشورى في قوله: “وإنما الشورى للمهـاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهـم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى”[14].
فلم يكن علي يرى أن هـناك حقًا إلهيًا له، ولو كان ثمة وصية في الأمر مثلًا لكان بإمكان النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يحول دون سوء الفهم هـذا ببيانه الصَّريح والواضح للموضوع، والتأكيد على نصب علي من بعده إمامًا وخليفة، مع اعتبار أنَّ هـذا أمر من عند الله وأصلٌ من أصولِ الدين حسب زعمهم، وهـل يعقل أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ترك هـذا البلاغ الصريح، وهـل يمكن أن يرد الناس أمر رسولهم، وهـل التصريح بذلك فيه ضرر كما يزعمون، فإين الضرر في الموضوع، هل بدنياهـم أم بآخرتهم، إن كانت تضر بدنياهـم، فكيف يمكن لمثل هـذا الضرر المحتمل أن يحول دون قبولهم، في حين أنهم فقدوا جميع دنياهـم في مكة[15].
وإذا كانت الإمامة من الدِّين فإنه لا يجوز للحسن بن علي “التنازل عنها إلى معاوية تحت أي ظرف من الظروف، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعته، ولم يكن يجوز له أن يمهل الحسين، وإنما كان يجب أن يشير إليه من بعده، ولكن الحسن لم يفعل أي شيء من ذلك، وسلك مسلكًا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهـم عبر الشورى” .
وإذا افترضنا أنَّ حديث العترة المقصود به العمل بقولهم، فإنَّ الاختلاف قد وقع فيهم، ولا يجوز أن يكون قول كل واحد منهم حقًا؛ لأن الحق لا يكون في الشيء وضده، وقد ثبت اختلافهـم[16].
والأدلة التي ذكروهـا في علي بن أبي طالب وولديه، إن ثبت أنهم مقصودون بالإمامة من ورائهـا، فإنها لا تدلُّ على كل إمام من بعدهما، أو تدل على إمامة كل أهـل البيت، والزيدية ترى الإمامة محلها الشرع وليس العقل، فكيف تعمم هذه الأدلة في كل إمام من غير دليل، أو كيف تخصص بها واحدًا منهم من غير دليل.
ربما أنَّ الظروف السِّياسية هي من ولدت هذا الرأي، وليست النصوص الشرعية التي لم تسعفهم في بيان هذا الحق، ولهذا خالف القاسم والهادي جدهم زيد بن علي مخالفة واضحة، وساقوا الأدلة المجملة على ذلك، وحملوهـا تفسيراتهم الخاصة لتتناسب مع ما رأوه؛ ولعلَّ الأمر جاء كردة فعل لما حصل لآلِ البيت من قبل الأمويين والعباسيين، ومهما يكن الأمر، فهم بالنَّص والبطنين قد خالفوا رأي زيد في خلافة الرَّاشدين، فهو لم يقل بالنَّص في علي ولا في البطنين، وإنما كان يرى الأولوية لعلي لا النَّص، كما يرى زيد بن علي الوزير[17].
دعوى الوصية ربما يرفضها كذلك الواقع السياسي الذي كانت تعيشه قريش، والخلاف المستحكم بين بني أمية وبني هـاشم، والوصية لأحد هذه الأسر دون غيرها، يوحي بتحيز الدين في حالة صراع معقدة، قد تؤثر على المجتمع المسلم في بداياته الأولى، واستعمال مصطلح أهـل البيت في بداية الأمر كان في سياق قبلي عائلي، وليس في إطار ديني، وتميز النقاش الدائر بين الصحابة بأنه نقاش سياسي أملته ظروف الزمان والمكان وموازين القوى المختلفة، وقل فيه استخدام النصوص الدينية.
وحتى تلك النصوص الدينية التي فهم منها الزيدية معنى الوصية لم تكن حاضرة في نقاش السقيفة ولم يستشهد بها علي على أحقيته إذا جاز ذلك، وقد اقتصر اعتراضه على تغييبه وعدم إشراكه في الشورى، وعلى منزلته الدينية التي لا يملك أحد من المسلمين أن ينافسه فيها، وعلى نسبه القريب من جده، وهـذا الأمر يؤكد عدم وجود وصية سياسية خاصة من النبي، سواء بتنصيب شخص معين أو التلميح إليه”[18].
خاتمة:
إنَّ فكرة حصر الإمامة في البطنين تجني على الدِّين الآمر بالعدل والحاظ على المساواة، وتجني على النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسى قيم العدل وهـدم معالم الجاهـلية، وفيها مصادر لحق الأمة في الاختيار، كما أنها تلغي أغلبية الأمة مقابل رأي الفرد، وتعجز الأدلة التي يسوقونها عن إثبات ذلك، وإذا أعدناها للعقل فإنَّ العقل يغلب رأي الجماعة على رأي الفرد.
قد يسع المتأخرين من الزيدية ما وسع الجماعة الصَّالحية والسليمانية منهم الذين يرون صحة الإمامة في كل قادر كفء بصرف النَّظر عن انتمائه الأسري، أو الاكتفاء بالانتخاب كبديل خصوصًا عند من يبرر من الزيدية لشرط البطنين، بأنَّ الإمامة رئاسة عامة يكمل المقصود بها، لكمال انقياد النَّاس لصاحبها وينقص لنقصانه، وأنَّ انقياد النَّاس للبطنين أكمل من غيرهم، ونحن نسلم بصحة المقدمة مع تحفظنا على النتيجة، وهـي أنَّ الانقياد مهم، فإذا كان تعيين البطنين شرط للانقياد فإن هـذا المبرر لم يعد كافيًا، والأمة تذعن للمنتخب وتنقاد لمن تختاره عن قناعة ورضى، ولهذا فإن شرط الانتخاب هـو الأولى بالترويج إن كان القصد بذلك وحدة اليمنيين.
إنَّ فكرة حصر الإمامة في البطنين، ليس فكرة قائمة على أرض راسخة، وكم جرت من ويلات وانقسامات وصراعات وخصومات، لا زال اليمن يعاني آثارها، ويتجرأ مرارتها؛ ولهذا فإن التعامل الأمثل مع هذه الفكرة أن يعاد النَّظر في أصولها، بحيث يُقطع بابها المؤدي إلى التفرقة والتشرذم، وحتى لا تكون وسيلة لإيقاع الأذى من جديد، وتُطور المناهـج التعليمية والبرامج الإعلامية لتعالج الشرخ الذي أحدثته هذه الفكرة في جسم الأمة اليمنية قديمًا وحديثًا، وأن يُعاد النظر الشرعي والقانوني في فكرة الهاشمية التي تعتمد عليها نظرية الإمامة عند الزيدية.
هوامش:
- محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولى، 2001م، ص147.
- أبو عثمان الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، مكتبة المصطفى الالكترونية، https://cutt.us/eW7yh، ص7.
- محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص170.
- أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، دار الجديد، بيروت، الطبعة الأولى: 1998م. ص89.
- محمد عزان، قراءة في نظرية الإمامة عند الزيدية، مجلة المسار، مركز التراث والبحوث اليمني، العدد التاسع، 2002م.، ص1.
- أبو إسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، وزارة الأوقاف السعودية، تحقيق: عبد الله دراز وعبد السلام عبد الشافي محمد، المجلد الثاني، ص228.
- أبو المعالي الجويني، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، غياث الأمم في التياث الظلم، دار الدعوة، مصر، الطبعة الأولى: 1979م، ص59.
- القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق محمود محمد قاسم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة، مصر، الجزء العشرون، القسم الأول، ص136.
- المرجع نفسه، ص153.
- حجت الله نيكوئي، نظرية الإمامة في ميزان النقد، ترجمة سعود محمود رستم، اجتهـادات، موقع اجتهـادات، https://cutt.us/R5RHY، ص67.
- يحيى محمد، الحديث الشيعي ومشكلة العقيدة، موقع فهـم الدين، يحيى محمد، تاريخ الاطلاع: 25/4/2020م، https://cutt.us/2WATX.
- علي بن أبي طالب، نهـج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، دار الكتاب المصري، مصر، الطبعة الرابعة، 2004م، ص248.
- حجت الله نيكوئي، مرجع سابق، ص138.
- المرجع نفسه، ص367.
- المرجع نفسه، ص58.
- أحمد الكاتب، التشيع السياسي والتشيع الديني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى: 2010م، ص33.
- القاضي عبد الجبار، مرجع سابق، ص192.
- زيد بن علي الوزير، الانتخاب والدعوة عند الهادوية الزيدية، مجلة المسار، مركز التراث والبحوث اليمني، العدد (1)، ص43.
- وجيه قانصو، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، دار الفارابي، لبنان، الطبعة الأولى، 2016م، ص153.