
تمهيد:
صدر مؤخَّرا للكاتب والباحث عصام القيسي كتاب بعنوان “استعادة الإسلام.. حفريَّات في جيولوجيا الإسلام التاريخي”، عن دار رؤية للنشر والتوزيع(1). والمؤلِّف بطبيعته وأطروحاته عبر الفضاء الإعلامي والإلكتروني مثير للجدل، فهو يضع أفكاره بشكل حدِّي وصريح وجريء، دون مبالاة بما قد يتعرَّض له مِن نقد أو ردٍّ (2). كما أنَّه يتَّصف بكونه شخصيَّة مثقَّفة وقارئة، وهو ما لا يجوز غمطه إيَّاه وإن اختلف المرء معه.
وكاتب هذه المقالة لم يسبق له التعرُّف على المؤلِّف وجهًا لوجه إلَّا في ندوة جمعت بينه وبين المؤلِّف صدفة، فكان المؤلِّف فيها يتمتَّع بهدوء ولباقة وأدب رفيع في الخطاب والحوار. وعدا عن ذلك فليس بين كاتب المقال ومؤلِّف الكتاب معرفة مسبقة توجب التنافس أو الخصومة فضلًا عن العداوة. ومِن ثمَّ فليس هناك أيُّ موقف شخصي مسبق ضدَّ المؤلِّف. وعدا عن ذلك سبق لي أن اطَّلعت على بعض منشورات الكاتب في “فيسبوك” ومنصَّة “X”، وعلَّقت على بعضها. وبالتالي فمنطلقاتي في هذه الحفريَّات هي منطلقات لا رصيد لها مِن الولاء والعصبيَّة، أو الخصومة والعداء، وإنَّما باعثها التطارح المعرفي والثقافي والمنطقي والعلمي مع المؤلِّف، بحثًا عن الحقيقة والصواب في الآراء، والحقِّ واليقين في التصوُّرات والأفكار، والعدل والإنصاف في الأحكام والمواقف.
وغاية ما أطلبه في هذه المقالة هو أن أوفَّق ومؤلِّف الكتاب للهدى والرشاد، وسلامة النيَّات والصدور، والرجوع عن الخطأ والزلل، خصوصًا وأنَّ المؤلِّف أشار إلى أنَّه ابن حركة إسلامية عريقة في الدعوة والتربية على الإيمان والقيم والأخلاق، وأمدَّت الساحة الإسلامية بعلماء أجلَّاء ومفكِّرين عظماء وقادة كبار، نفع الله بهم الأمَّة شرقًا وغربًا، وخلال قرابة قرن مِن تأسيسها.
ورجائي الشخصي أن يأخذ المؤلِّف ملاحظاتي ونقدي بعين الاهتمام، كما كانت قراءتي لكتابه تتمُّ بعين الاهتمام، وبعيدًا عن الشخصانيّة، إذ أنَّ أيَّ خلاف مع المؤلِّف خارج ما دوَّنه في كتابه ينبغي ألَّا يُحاسب عليه في نقد الكتاب والتعليق عليه، إلَّا بالقدر الذي يرتبط بالفكرة والموضوع والطروحات التي يقدِّمها كنتاج لحياته بما فيها مِن تجارب وخبرة وعلاقة، فالمرء فيما يقوله ويطرحه ويعتقده ويميل إليه ابن بيئته وظروفه.
العنوان وظلاله:
ابتكار العنوان لمؤلَّف مِن المؤلَّفات فنٌّ مِن الفنون، فهو الاسم الذي سيلازمه ويخلَّد به، وهو العلامة التي ستلفت انتباه السالكين في طرق المعرفة والثقافة، وأوَّل تجليَّات الخطاب التي يُقابلها المتلقِّي قبل أن يشرعَ في استقبالِ النَّص. ومع أنَّ وظيفة العنوان الأساسيَّة هي التَّحديد والتسمية، فإنَّ دلالته تتأسَّسُ باعتباره دالًا يكتملُ بمدلوله، وأفقًا يفتحُ المجال أمام توقُّع المتلقِّي(3). “وبما أنَّ قدرًا كبيرًا مِن الوقت يُنفَقُ في اختيار الأسماء فلا ينبغي أن تؤخذ باستخفاف”(4) ؛ لذلك يتطلَّب اختيار العنوان “وعيًا دقيقًا وتفكيرًا مليًّا، فهو ليس مجرَّد كلمة عابرة يضعها النَّاص بعد فراغه مِن النَّص، بل هو عنصر موجَّه للدلالة”(5) . وعادة ما يختزل العنوانُ فكرةَ الكتاب وموضوعه في كلمة أو كلمات، بحيث يشكِّل تهيئة وتنبيهًا للقارئ لطبيعة المحتوى ومدى حاجته له. وصياغة العنوان تنبع مِن ثقافة المؤلِّف ولغته وفكره، وتعبِّر عن شخصيَّته، لهذا اعتنى المؤلِّفون منذ القدم باختيار عناوين مؤلَّفاتهم. والعناوين تختلف بطبيعة اختلاف المادَّة، فهناك عناوين أكاديمية بحتة، وهناك عناوين أدبية محضة، وهناك عناوين بين بين.
واختيار المؤلِّف(6) مصطلح “استعادة الإسلام” يوجز فكرته في الكتاب، والموضوع الذي سيبحثه فيه، فالمؤلِّف يرى “أنَّ الإسلام الذي يعرفه المسلمون اليوم مختلف -بصورة تكاد تكون نوعيَّة- عن الإسلام الذي عرفه أبناء القرن الهجري الأوَّل”، كما جاء في مقدِّمة الكتاب، وهي الدعوى التي ألِّف الكتاب لإثباتها أساسًا للانطلاق مِنها إلى ما يريد المؤلِّف طرحه، وهي “نظرية مقترحة” “لفهم الظاهرة القرآنية”.
ولا أريد أن أحمَّل الكلام فوق ما يحتمل، فالحديث عن انحراف حال كثير مِن المسلمين عن الإسلام كان محور اهتمامات المصلحين والمجدِّدين في الجزيرة العربية والشام والعراق، ومصر، وشمال أفريقيا، وغيرها. ولهذا سنساير المؤلِّف في هذا الاتِّجاه لنصل معه إلى تقديره لهذا الاختلاف “النوعي” في معرفة الإسلام لدى المسلمين اليوم عن معرفة القرن الهجري الأوَّل. وكون المؤلِّف يسعى لـ”استعادة الإسلام” كما هو في القرن الهجري الأوَّل حيث شعَّت أنواره، وظهرت معجزته في صناعة أمَّة حضارية، ونهضة علمية تأخذ بهدايات الوحي وإرشادات العقل في اتِّساق وتآلف تامٍّ بينهما، أمر يشكر له، وإن اختلفنا معه في شيء مِن الأفكار والمضامين الرئيسية أو الفرعية.
ومع هذا ينبغي أن نبقى حذرين في القراءة خصوصًا أنَّها قراءة نقدية تأتي على التراث المعرفي التراكمي للأمَّة باعتباره “جيولوجيا الإسلام التاريخي”، واتِّهامه بالعديد مِن التُّهم التي ساقها المؤلِّف في مقدِّمته وثنايا كتابه. خصوصًا وأنَّ المؤلِّف ينقد هذا التراث وحملته إجمالًا، بأصوله وقواعده ومناهجه -كما يبدو في طرحه. وإذا كان المؤلِّف يؤكِّد على متابعيه دومًا إعمال العقل في التعامل مع هذا التراث فإنَّ هذا الإعمال مع ما يطرحه المؤلِّف أولى، خصوصًا وأنَّ عامل الزمن كفيل بإحالته إلى حلقة مِن حلقات التراث في نظر الأجيال القادمة، فهو ليس طرحًا قادمًا مِن السماء، بل هو نابع -كما أشار المؤلِّف- مِن جهد بشري في القراءة والبحث والاطِّلاع الشخصي، قابل للخطأ والصواب، ومِن ثمَّ فهو محتمل لكافَّة العوامل التي تعتري عمليَّات التلقِّي والفهم والاستيعاب والتحليل والتفسير والربط والتقييم والنقد، بل وحالات المؤلِّف النفسيَّة وعلله الشخصية والعلاقات المؤثِّرة على فكره ومواقفه في الحياة عمومًا.
وخلال سيرنا في قراءة الكتاب علينا أن نبقي ذاكرتنا يقظة ونابضة بالعنوان، فهو أوَّل معيار نحاكم المؤلِّف له. وكنت أتمنى لو أنَّ الكاتب وضع تمهيدًا خاصًا لبيان المصطلحات والمفاهيم التي سيتناولها في الكتاب، والتي يتقيَّد بها في السياقات المختلفة كي لا يظلَّ باب التأويل مفتوحًا، وقطعًا لمادَّة الجدل. فتعيين مراد المؤلِّف للمفاهيم التي يقصدها مِن وراء المصطلحات التي يوردها في ثنايا حديثه وطرحه، لأنَّ هذا التعيين يساعد المتلقِّي على إبعاد كلِّ ما يمكن أن يحضر مِن مفاهيم أخرى مستعملة للمصطلح ذاته، خصوصًا إذا تعدَّدت دلالته أو اتَّسعت لتشمل مفاهيم مختلطة أو متنازعة بين أطراف فكرية أو فقهية أو عقدية، أو تخصُّصات علمية.
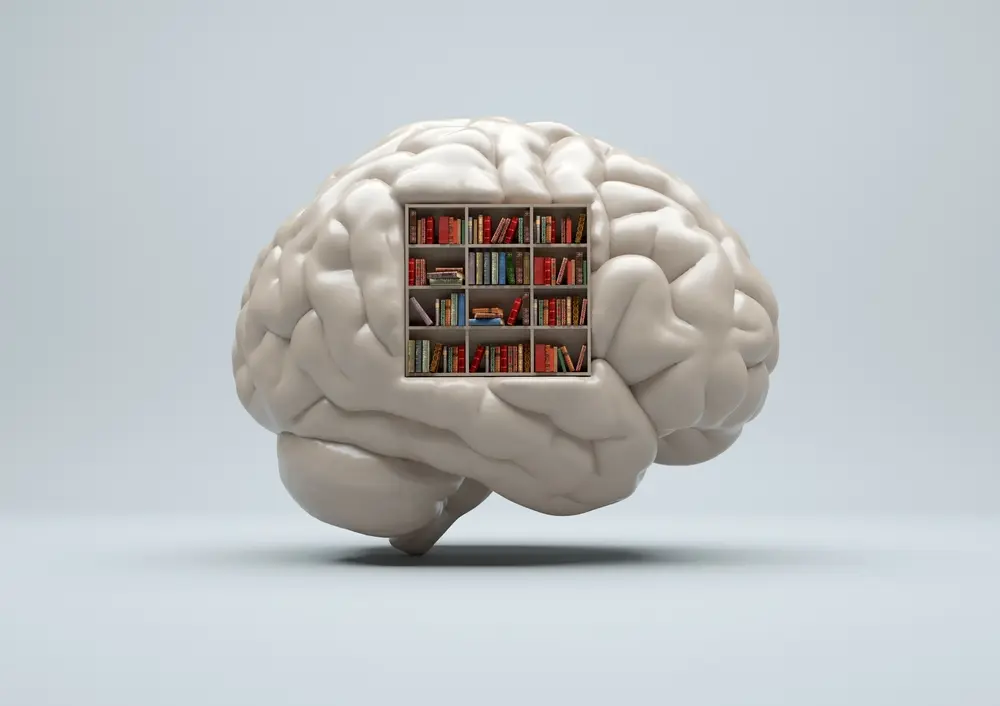
"المقدِّمة" العَجِلة:
ابتدأ المؤلِّف كتابه بمقدِّمة تضمَّنت حديثًا موجزًا عن طبيعة المسار الذي قاد المؤلِّف لتغيير آرائه وأفكاره دون التفصيل في الأسباب والعوامل التي قادت لذلك، سوى إشارته للمطالعة المركَّزة في (الفكر الإسلامي)، خلال فترة انتسابه شبابًا لجماعة الإخوان المسلمين مِن عام 1990م وحتَّى عام 2000م. ولم يذكر المؤلِّف ما هي الكتب التي قراءها في هذا الشأن وأحدثت لديه هذا التحوُّل، ومَن هم المؤلِّفون الذين قرأ لهم بشكل واسع، بحيث يمكننا – كقارئين لنتاج المؤلِّف- تتبُّع ما صدر عنه المؤلِّف مِن مراجع وكتب، للاطمئنان إلى مدى موثوقيَّة وصلاحيَّة تلك المصادر والكتب للتعبير عن فكر إسلامي راشد وعلمي ومنهجي وموضوعي، فكثيرًا ما ينسب أفراد وكتب إلى الفكر الإسلامي في حين أنَّها خارج هذا الفكر، وإنَّما كان الإسلام موضوعًا لها تعمل فيه أدوات التشريح والنقد في محاولة لإضعافه وهدمه. لا أقول هذا تشكيكًا في المؤلِّف لأنَّنا نتوقَّف عند ما نعلمه، وما لا نعلمه نسأل عنه ولا نتكلَّف التهمة فيه. لكن، مِن حقِّنا على شخصيَّة تطرح رؤية تغييريَّة جذرية وتحوُّلًا شاملًا كما تشير أن نطمئنَّ إلى بدايات تكوين هذه الشخصيَّة ومحيطها المعرفي والعلمي والمنهجي الذي جعلها فريدة ومتميِّزة وقادرة على نقد “التراث” كلِّه، والإتيان برؤية تجديدية بالمطلق، تتجاوز كلَّ هذا “الركام الجيولوجي التاريخي” الذي عبَّر عن الإسلام وأخفق في ذلك!
فقد أشار عصام في مقدِّمته إلى أنَّ عام 2004م، شهد على مستواه الشخصي “تحوُّلًا نوعيًّا على مستوى الفكر والاعتقاد، بعد رحلة من المطالعة المركَّزة في الفكر الإسلامي، خلال فترة انتسابه شابًّا لجماعة الإخوان المسلمين، مِن عام 1990م إلى حدود عام 2000م. وهي التجرِبة التي خرج مِنها مزوَّدًا بثقافة دينيَّة نوعيَّة (أصوليَّة)، جرَّأته على ممارسة التفكير الناقد لميراث الفكر الإسلامي، وفي مقدَّمتها أصول هذا الميراث ممثَّلة في أدلَّة الأحكام. وكان الكاتب قد عزَّزت خبرته في هذا المجال بالدراسة التخصُّصية في مجالات اللغة العربية والأدب والنقد الأدبي، وخصوصًا هذا الأخير الذي أصبح مجال اختصاصه في الدراسات العليا”.
ومِن الملاحظ أنَّ المؤلِّف يغيِّب أيَّ إشارة إلى أيِّ شخصيَّة علمية أو فكريَّة لحساب إظهار شخصه كبناء قائم بذاته، يملك مِن المواهب والقدرات والملكات ما يجعله مستغن عن الإشارة لأيِّ تأثير أو سبق للآخرين. وفضلًا عن ذلك، يُعطي المؤلِّف لذاته مكانة عليا ومنزلة رفيعة تمنحه الحقَّ في ممارسة دور ضخم وبالغ الخطورة، حتَّى مع حداثة العهد والتجربة بالانتماء لحركة إسلامية. فقد ذكر المؤلِّف أنَّه انتمى لحركة الإخوان المسلمين في عام 1990م، وأنَّه “ركب قطار المراجعات لفكر الحركة الإسلامية المعاصرة منذ عام 1997م على أبعد تقدير؛ عندما وصل آنذاك إلى قناعة بأنَّ ما يحتاجه الإسلام حقًّا هو (التجديد) وليس (الصحوة)، بما تعنيه كلمة (تجديد) مِن إعادة نظر في أهداف العمل الإسلامي المعاصر وأدبيَّاته وسرديَّته”، رغم أنَّه أكَّد في السياق ذاته أنَّه كان حين ذاك “مجرَّد شاب قلق الفكر قليل الخبرة!”. فهل سبع سنوات كفيلة بقراءة “التراث” والإحاطة بكلِّ علومه وتخصُّصاته، وبالفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، لتتهيَّأ النفس لتقديم رؤية تجديدية جذرية؟!
ويشير الكاتب إلى أنَّه مع مرور السنوات تنقَّل “مِن عربة إلى أخرى” في قطار المراجعات، “حتَّى وجد نفسه في مقصورة القيادة!، أي العربة الأولى في قطار الفكر الإسلامي، عربة الكتاب والسنَّة!”؛ وذكر أنَّ هدفه مِن المراجعات كان “إعادة تأصيل الأصول والمفاهيم، على ضوء مقرَّرات أصول الفقه نفسه، بوصفه العلم المهيمن على منظومة الفكر البياني الإسلامي برمَّته”. ولم يوضِّح المؤلِّف كيف جرى هذا التنقُّل، وهل كان تنقُّلًا عن تمكُّن مِن آلات العلم وأدواته ومناهجه وتخصُّصاته ذات الصلة بهكذا مهمَّة خطرة؛ وما هي طبيعة هذه العربات، وما علاقتها بالتراث والفكر الإسلامي، فخطورة الدعوى تقتضي الابتعاد عن العبارات الأدبية الفضفاضة التي تشبع رغبة الإنسان في تضخيم الذات دون إمكانية فحصها والتدقيق فيها.
ثمَّ يشير المؤلِّف في مقدِّمته إلى جملة نتائج توصَّل إليها بحسب مداركه وخبرته واطِّلاعه، غير أنَّه يجعلنا أمام موقف حاسم لهذه النتائج باعتبارها “حقائق“، لا يمكن تجاهلها، وعليه فهو لا يخضعها للحوار والنقاش والمراجعة كونها تحمل يقينًا جازمًا، استنادًا إلى كونه لا يمكنه “اتِّهام فهمه بالقصور عن إدراك حقيقتها كما يفعل البعض، وكما يود الكثير مِن الإسلاميين أن يتصوَّروا”! ما يعني أنَّ المؤلِّف لم يتواضع لجعل ما توصَّل إليه في بحثه ومسيرة اطِّلاعه فرضيَّات قابلة للأخذ والعطاء، والقبول والردِّ، والفحص والتدقيق، لمجرَّد أنَّه لا يرغب في اتِّهام فهمه بالقصور! وكأنَّ القصور أمر يستعصي لحوقه به!
علمًا بأنَّ العلم الحديث يقوم في كثير مِن مقرَّراته أساسًا على مبدأ الشكِّ، خصوصًا في العلوم الفلسفية والتجريبية، وذلك لأنَّ القطعيَّات الحاسمة أضرَّت بالعقل الأوربِّي، خصوصًا تلك التي أنتجها العقل البشري ثمَّ أضفى عليها سمة العصمة وهالة القداسة. وبغض النظر عن صحَّة هذا المبدأ إلَّا أنَّه يعبِّر في بعض أوجهه عن روح التواضع أمام الأمور التي يراها المرء ويقطع بأنَّها حقائق لا جدال عليها.
ولا شكَّ أنَّ المؤلِّف بتضمينه هذه النتائج كحقائق في مقدِّمة كتابه يبدأ مِن حيث كان ينبغي أن ينتهي، لأنَّ الطبيعي في طرح كهذا ترك أفق للقارئ للتدرُّج مع المؤلِّف والسير معه خطوة بخطوة لبناء المعلومة والتحليل والاستدلال والحكم وصولًا للنتائج عن قناعة، ودون فرض النتائج كـ”حقائق” نهائيَّة ليس بوسع القارئ إلَّا التسليم لها ابتداء قبل أن يفحصها ويتأكَّد مِنها، لأنَّ هذه مغالطة منطقية لا ينبغي تمريرها دون اعتراض.
"حقائق صادمة" فعلًا:
ذكر المؤلِّف في مقدِّمته إلى أنَّه توصَّل إلى “حقائق صادمة”، ولم يقل إلى “نتائج صادمة”، وهذه الحقائق حسب المؤلِّف في مقدِّمته هي(7):
1- “أنَّ القرآن قد مُني بخذلان واسع مِن قبل المسلمين. تجلَّى هذا الخذلان في صور شتَّى، مِنها: إحاطته بمجموعة مباحث تقليدية سُمِّيت بـ(علوم القرآن)، ليس لأكثرها قيمة حقيقية في فهم الخطاب القرآني، أو استيعاب فلسفة الظاهرة القرآنية. في مقابل غياب مجموعة أخرى مِن العلوم التي كان في أمسِّ الحاجة إليها، وكان مِن المعوَّل عليها تحويل القرآن مِن خطاب خام إلى نظريات فلسفية تغطِّي مختلف جوانب الحياة والمعرفة، وتجيب عن الأسئلة التي يطرحها العقل في مختلف العصور”.
2- “وضع القرآن تحت سلطة خطاب آخر ليس مِن مقامه في الحجِّيَّة والثبوت، هو خطاب السنَّة والحديث المنسوبين للنبي، بدعوى حاجته إليهما لبيان مبهماته، وتفصيل مجملاته، وتخصيص عموميَّاته، وتقييد مطلقاته. وبهذه الدعوى أَعمَلُوا في القرآن معاول النسخ والتعطيل والتحريف أيضًا! وهو الأمر الذي انتهى إلى إضعاف القدرة التفسيرية للقرآن، والحدِّ مِن أنواره. وخصوصًا في أوساط المثقَّفين النوعيِّين كالفلاسفة والمفكِّرين الذين يجدون -صدقًا أو تمحُّلًا- العديد مِن صور التناقض والقصور والضعف في الفكر الإسلامي. ظانِّين أنَّها تنتمي إلى الأصل المنزل نفسه. في حين أنَّها عند التحقيق مِن آثار الفكر الإسلامي الذي أضاف إلى دائرة الوحي ما ليس مِنها، أو توقَّف عن الإبداع في وقت مبكِّر”.
3- “أنَّ الفقه في الإسلام نشاط يومي عفوي يقوم به المسلم (المكلَّف)، مهما كانت درجته في الفهم والعلم، وليس نشاطًا نخبويًّا لمن بلغ رتبة (الاجتهاد) في العلم كما تزعم المذاهب التقليدية. يفعل ذلك مستندًا إلى ما علمه مِن حقائق، وعلامات دالَّة، في نصِّ الكتاب وتجربة النبي وصحابته وأبناء القرن الإسلامي الأوَّل. وهو ما يعني أنَّ وظيفة المفتي والمستفتي ليست مِن مطالب النهج الإسلامي الأصيل، بل هي طارئة عليه، كما سنبيِّن في ثنايا هذه الدراسة”.
وأشار المؤلِّف إلى أنَّ هذه الأطروحات خاض لأجلها جدلًا واسعًا مع مَن وصفهم بـ”خصوم” هذه الأطروحات التي وصفها بـ”المستفزَّة”، ولم يعبِّر عنهم بأنَّهم “مخالفيه”، وبين التعبيرين بون شاسع لمن عرف المعنى والأثر النفسي في التعامل مع الآخر. وخلص المؤلِّف مِن تجربته إلى قناعة بضرورة تحويل هذه الأطروحات والآراء إلى مشروع نظري متكامل، ينشر في سلسلة كتب، قدَّرها بثلاثة في الحدِّ الأدنى. ولا أعلم ما مدى تأثير الآراء المخالفة في تصويب أو تصحيح هذه الأطروحات التي بدأ المؤلِّف في إخراجها في مشاريع بحثية (كتب)، إذ عادة ما يجد الإنسان ما يفيده مِن نقاشات المخالفين له، ومِن جدله مع الأنظار والقرناء، ومِن النقد الذي قد يُصبُّ عليه مِن “خصومه”، إذ الإنسان لا يكمل بذاته، ولا تنضج أفكاره وآراءه ورؤاه استقلالًا عن التأثيرات الإيجابية لمن حوله، بمَن فيهم أولئك الذين يهدونه عيوبه وأخطاءه بأمانة وإنصاف.
وسوف يتناول المؤلِّف هذه الحقائق الصادمة والأطروحات المستفزَّة حسب ما ذكر في ثلاثة كتب، الأوَّل مِنها يتناول “مظاهر الخلل الذي أصاب الفكر الإسلامي وتاريخه، والتحوُّل النوعي الذي طرأ مِن فقه المكلَّف إلى فقه المجتهد، ودور محمَّد بن إدريس الشافعي المحوري في هذا التحوُّل الخطير”. وهو هذا الكتاب الذي أصدره مؤخَّرًا ونتناوله في هذه المقالة. وأمَّا الثاني فهو دراسة مركَّزة وشاملة لمشكلة حجِّية الحديث المنسوب للنبي؛ وهو بمثابة تطوير تقني لدراسة سبق للمؤلِّف إخراجها بعنوان (هذا بيان للناس.. حديث النبي مِن التاريخ لا مِن الدين)؛ وهي دراسة “أقامت الحجَّة بمنطق أصولي على بطلان دعوى حجِّيَّة الحديث النبوي (اعتبار الكلام الصادر عن النبي امتدادًا لرسالته الدينية التي كلَّف بإبلاغها للنَّاس في كلِّ زمان ومكان)”، وقد يأتي الحديث عنها في مقال آخر. وهي دراسة بحسب المؤلِّف ألَّبت عليه “المتعصِّبين”، ولقي بسببها -وما زال- ألوانًا مِن “العداوة والبغضاء”! ولم يُشر إلى أيِّ وجهة نظر مقبولة لديه خالفته ولها احتمال ولو نسبي في الموضوع، فالكلُّ محشور في خانة “المتعصِّبين” الذين يُعمِلون أخلاق العداوة والبغضاء مع مخالفيهم. وكأنَّه لا خيار لك فإمَّا أن تكون “معي” أو “ضدِّي”! أمَّا الكتاب الثالث فمِن المتوقَّع أن يطرح المؤلِّف فيه “النظرية التي يقترحها.. لفهم الظاهرة القرآنية”.
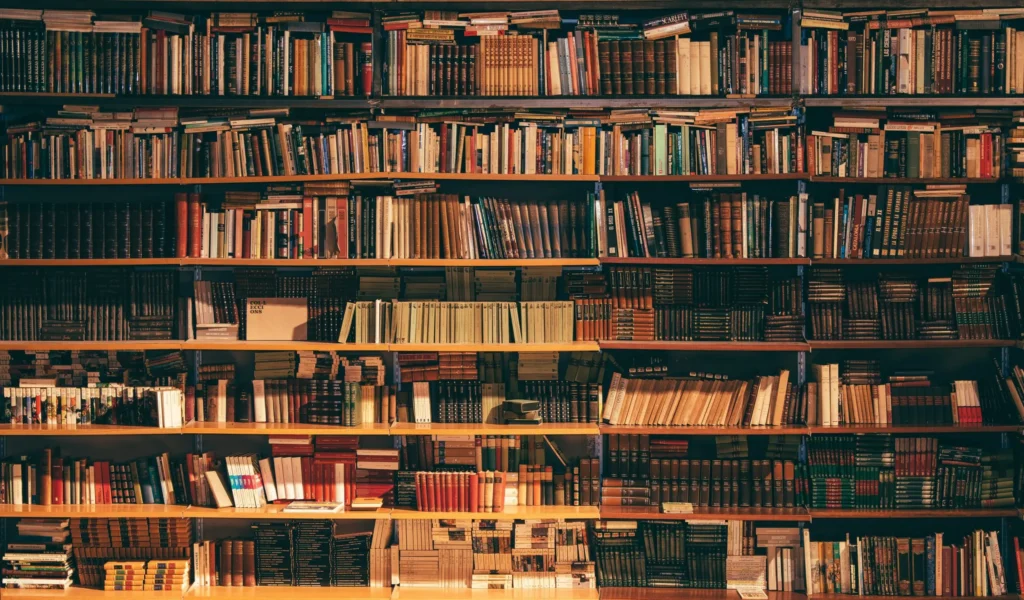
التمويل.. والأمانة العلمية:
يُثير بعض مخالفي عصام في صفحات الفيسبوك “تهمة” تلقِّي تمويل مِن المنظَّمات الأجنبية، بهدف القيام باختراق المجال الفكري والثقافي والمعرفي للأوساط الإسلامية بأطروحات شاذَّة تعيد إنتاج الشبهات القديمة والحديثة في صيغة متجدِّدة معاصرة. وهي تهم لا دليل ماديَّ عليها لدى الكثير عند التحقيق، ولا يمكن مع وجود تمويل ما الربط المباشر بين المدخلات والمخرجات، فأمُّ موسى أخذت الأجرة مِن فرعون، في ظلِّ الضرورة، وظلَّت محافظة على قيمها ودينها وانتمائها، وظلَّ الحليب الذي تسقيه لموسى في قصر فرعون حليب الإيمان والتوحيد والولاء لأهل الحقِّ والنصرة للمظلوم. وأنا هنا لا أدافع بقدر ما أريد أن نبتعد عن مجال لا بيَّنة لنا فيه، ولا ينبغي أن تناقش الأفكار والأطروحات استنادًا إليه طالما وهو في دائرة الدعاوى التي لا يمكن إقامة الأدلَّة عليها.
وهذه التهمة بظنِّي هي التي دفعت المؤلِّف للحديث عن التمويل المفاجئ الذي ناله، مِن شخص “عراقي” مجهول له فضلًا لنا، لغاية إنتاج هذا الكتاب. فقد أشار المؤلِّف -في إطار تناوله لحافزه إلى كتابة الكتاب- أنَّه وجد، في شهر يونيو عام 2021م، في بريده، “رسالة مِن شخص مجهول الهُويَّة، يظهر مِن أسلوبه أنَّه مِن المهتمِّين بقضايا الدين والصراع المذهبي، يقول: إنَّه قد استمع إلى رأي الكاتب في مسألة حجِّيَّة الحديث النبوي في إحدى المساحات، فوجده معقولًا مبنيًّا على أساس أصولي معتبر، وليس مجرَّد رأي بلا خطام، وأخذ يُثني على ما سمع. ثمَّ تساءل: لم لا يظهر الرأي في صورة كتاب يقرأه الناس؟! فأجابه الكاتب بما يُفيد أنَّ ذلك هو مشروعه المؤجَّل، وأنَّ طبيعة عمله -وهو مصدر دخله الوحيد- لا تبقي له مِن الوقت متَّسعًا للبحث والكتابة. وهنا تقدَّم الرجل بعرض كريم وطريف، حيث أبدى استعداده لتقديم منحة مالية شهرية تغطِّي حاجة الكاتب لعدد مقدَّر مِن الشهور إلى أن ينتهي مِن تأليف الكتاب. ومع سخاء هذا العرض وحاجة الكاتب إليه إلَّا أنَّه قد اعتذر عن قبوله؛ وذلك لأنَّ المبلغ المعروض لم يكن كافيًا لتغطية الالتزامات المالية الشهرية للكاتب. لكنَّه وعد الرجل الكريم أن يبدأ باستغلال الفائض مِن وقته في إنجاز الكتاب دون حاجة إلى ترك عمله الأساس، ودون حاجة إلى المنحة المعروضة؛ لولا أن الرجل أصرَّ على منحة مالية موقوفة للكتاب”.
إنَّ حقيقة أنَّ ظروف اليمن استدعت المؤلِّف وغيره مِن رجالات اليمن وشبابه إلى مغادرة بلادهم في ظلِّ الحرب الطاحنة وتسيُّد جماعات مسلَّحة طائفية عنصرية على المشهد السياسي أمر ملموس، وهو ما جعل الكثير مِن هؤلاء في ظروف مادِّية صعبة، خصوصًا في ظلِّ الخناق الذي فُرِض على خياراتهم في اللجوء والهجرة، وقلَّة فرص العمل المتاحة، وضآلة ما يُمنح لهم في مقابل ما يقومون به مِن عمل وجهد.
غير أنَّ فجوة الرجل “المجهول” الذي لا يعرفُ الكاتبُ “مِن هويَّته شيئًا” حتَّى تاريخ تسطير كتابه، سوى أنَّه “عراقي الجنسية، واسمه سعد!”، تبقى محلَّ نظر، فأمثال هؤلاء الأشخاص الذين يلتفتون إلى مشاريع بحثية بهذا المستوى مِن الطرح الذي يرتبط بنخبة النخبة إن صحَّ ندرة نادرة لا يمكن لقاءهم في الواقع الحياتي فضلًا أن يكونوا في العالم الافتراضي دون وضوح شخصهم أو شخصيَّتهم بأيِّ شكل مِن الأشكال، ولو مِن خلال سندات التحويل أو مندوبي الاستلام أو أرقام التواصل. خصوصًا أنَّ وضع العراقيين (السنَّة) في الغالب لا يختلف عن واقع اليمنيِّين، إذ فُرِضت عليهم الجماعات الطائفية حالة مِن الفقر والخوف والانكسار، وخسارة الأموال، والأملاك، والمدَّخرات.
ومع ذلك، هذا لا يلغي أبدًا أنَّ الأساس هو مناقشة الأفكار والآراء والرؤى، بعيدًا عن هذه النتوءات الجانبية، إذ مقتضى الجدال الفكري والحوار العلمي والتباحث المعرفي البقاء في دائرة الأطاريح والأفكار المثبتة والمدوَّنة، ونقدها وفق أسس علمية وموضوعية ومنطقية ومنهجية، للوصول إلى معرفة مدى كونها حقًّا أو صوابًا في ذاتها، أم لا.
لهذا ستبقى حلقات هذه المقالات في صلب الموضوع قدر المستطاع والإمكان، مراعية الأمانة العلمية والموضوعية، والإنصاف مع المؤلِّف نصرة لمبدأ العدل والحقِّ. والله أسأل أن يهديني والمؤلِّف للحقِّ والصواب فيما نقول ونعمل، وأن يرزقنا النيات الخالصة لوجهه. وبالله التوفيق.
الهوامش:
- الكتاب صدر في 2024م، والدار الناشرة دار مصريَّة. وجاء الكتاب في (417) صفحة مِن القطع العادي.
- وإن أخذ عليه في منصَّات التواصل الاجتماعي نزقه السريع وحظره لكلِّ مَن يخالفه الرأي لمجرَّد الدخول معه في نقاش جدِّي.
- ينظر: مرسل العجمي، تجليات الخطاب السردي: الرواية الكويتية نموذجًا، (الرواية العربية ممكنات السرد) أعمال الندوة الرئيسة لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، 11- 13 سبتمبر 2004م، المجلس الوطني للفنون والآداب، الكويت، 2009م: ج1/71.
- جوزيف. م. بوجز، فنُّ الفرجة على الأفلام، ترجمة: وداد عبد الله، الهيئة العامَّة للكتاب، مصر، 2005م: ص58.
- عبدالحكيم محمد صالح باقيس، العنوان وتحوُّلات الخطاب في الرواية اليمنية، علامات في النقد، الرواية في الجزيرة العربية، النادي الأدبي الثقافي، جدَّة- السعودية، مج17، ج68، فبراير 2009م: ص366.
- سوف اعتمد الإشارة للمؤلف بوصف الكاتب والباحث والمؤلِّف دون أي ألقاب تفخيم أو تبجيل، وهذا ليس استنقاصًا له ولكن أسوة بمنهجه في التعامل مع الأشخاص، ولإبقاء ما يطرحه في قيمته الضمنية لا خلف الشخصية وتفخيمها.
- تعمَّدت نقلها كما هي مِن الكتاب دون تعليق.

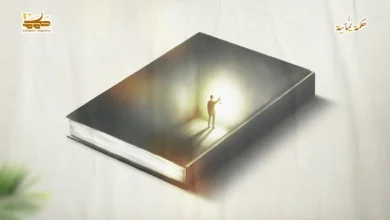
ملاحظتي الاولى على النقد – بعد حسن الصياغة والادب الظاهر لصاحبها جزاه الله خيرا – انه مأسور – كحال اغلبنا الاعم – في التعرف على السلف البشري الذي اخذ منه استاذ عصام ملامحه الفكرية التجديدية، وكأن هذا الامر – معرفة الاثر الذي سار عليه اللاحق – هي السمة الاشهر التي صبغت بصمتنا الفكرية وكأني بقوله تعالى على لسان منكري الدعوة الاوائل (انا وجدنا اباءنا على امة) تعنينا جميعا كامة عربية و لا تخص الذين جاء السياق مخاطبا لهم ، ولست افهم لم نحن مأسورون بهذه اللازمة مع اننا نقرا دوما في كتاب الله العزيز ، في مجال الجدال و النقاش، قوله تعالى (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) ! متى تكون ضالتنا و بوصلتنا هي البراهين وليس اثر الاسلاف ؟ اظن ان هذا الامر هو احد اكبر المطبات التي نقع فيها والتي تجرنا دوما الى الاسفل وتقطع كل يد صادقة تروم اخذنا الى الاعلى لتنسم شيئ من التغيير !
اظن ان مطالبة الناقد في معرفة الاسماء التي تأثر بها الاستاذ عصام و شكلت فكره التجديدي هي زلة تفقده شيئا من علمية النقد اذا قد تتشكل عند كل منا اعتراضات منذ ايام مراهقته الفكرية وتتبلور بفعل العديد العديد من الامور دون الحاجة الى ان نمسك اثرا من احد ونسير عليه .
الملاحظة الثانية لي على المقدمة النقدية والتي اجدها هي الاخرى لازمة لمجتمعاتنا هي حرص الناقد على الطعن في شخص المؤلف و في نزاهته رغم انه كان حريصا بعد ايراد الطعن ان يعود للقول انه لن يكون معنيا به وان اهتمامه سينصب على النقد العلمي للكتاب ! و بصراحة انا ارى ان هذا الاسلوب ساذج جدا في الطعن بالاشخاص وقد اكلت عليه دهورنا و شربت حتى مللناه ، بان ذلك من خلال تعريض الناقد بالرجل العراقي الذي عرض المعونة على استاذ عصام ومن ثم التلميح بتبعية الاخير لمنظمات مشبوهة وهو امر يؤكد -في نظره- التهمة التي طالما رماه بها خصومه ، ورغم اني اعرف هذا الرجل العراقي حق المعرفة وتربطني به صداقة عمرها سنوات وانه كان سنيا متعصبا لسنيته وانه تعرض مع عائلته في سنوات العنف الطائفي (٢٠٠٦ – ٢٠٠٨) لاذى كبير كان اكثرها ايلاما مقتل شقيقه على يد ميليشيات العنف الطائفي الرافضية وتهجيره مع عائلته من بيتهم و حيهم وان الرجل بسبب ذلك صارت عنده توجهات قرانية لانه يرى ان الشيعة لم يخترقوا الصف المسلم الا من جانب الروايات المبثوثة في اصح كتب السنة الروائية وهذا سر اهتمامه بكل مايطرح في هذا المجال الا انه و بغض النظر عن ذلك كله فانه و بحسب رايي المتواضع فان تطرق الناقد لهذه التفصيلة رغم ما فيها توابل تثوّر ذائقة القارئ الا انها فاتحة سوء سفلت بالنقد و اضرت به للاسف الشديد فضلا عن انها اعطت انطباعا سيئا عن مدى النضج الذي يتمتع به الناقد المكرم ، اذ هل من تسنده منظمات او مؤسسات مالية سيختار ان يذكر مصدر تمويل كتابه ؟!
اتفق مع الناقد ان اسلوب الاستاذ عصام في الكتاب يظهر للاخر انه معجب بنفسه كثيرا او مغرورا و ربما لو انه اختار اسلوب عرض اكثر تسامحا مع الاخرين فان ذلك سيكون اكثر ارضاءا للمتلقي و لكن دعونا لا ننسى ان خصومه فجار جدا في خصومتهم وان رمي من يخالفهم في دائرة الكفر او الفسق – على اقل تقدير – فضلا عن الطعن بالذمة و الامانة ( وهو امر انساق له الناقد شديد الادب نفسه !! ) تجر الاستاذ عصام ومن هم مثله الى هذا الاسلوب في الطرح ويمكن لنا ان نتفهمه جدا حتى وان رفضناه.
هذه المقدمة جاءت بما هو لها و ماعليها
ارجو ان يكون القادم منه افضل وان يرتقي حقا لدعواه حول النقد العلمي بل و لمستوى الكتاب الذي انبرى لنقده .
معرفة الخلفيه الثقافيه من اهم الوسائل المنهج العلمي فمن خلالها يتبين التاثر العلمي ومسار الباحث فلا شك ان اي باحث لن يخترع الفكره بكل تفاصيلها ولكنه يبني ويطور ويضيف ..
ما ذكره المؤلف من قصته مع العراقي اساسا لا ارى لها داع فهي اشبه بحشو ربما يسيء للكاتب اكثر مما يفيده
كنت اتمنى ان اجد ردا يعتمد على منهجية علميه للرد على الكاتب لكن يبدوا الانحياز واضحا