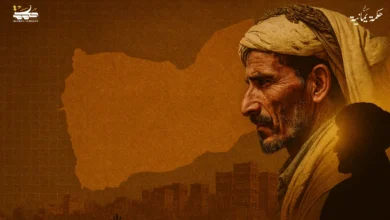عندما غادرت اليمن تركيا عام ١٦٣٥م كما أسلفنا، بقيت في الحجاز على مقربة منها. وفي عام ١٨٣٩م الموافق ١٢٣٥هـ احتلت بريطانيا مدينة عدن وبسطت حمايتها على النواحي اليمنية المجاورة لعدن، التي جعلت منها محطة تموين لسفنها بالماء والوقود، وقاعدة عسكرية لحماية سفنها ومصالحها في المنطقة.
وفي عام ١٨٤٩م عادت تركيا إلى اليمن بدعوة من الإمام المنصور محمد بن يحيى، الذي استدعاهم للقدوم إلى صنعاء واستقبلهم في طريق الحديدة مجاراةً للشريف حسين بن علي حيدرة في تهامة، الذي وجَّه إليهم دعوة للقدوم من الحجاز إلى الحديدة. وفي عام ١٨٦٩م وُلِد الإمام يحيى بن محمد بن يحيى في مدينة صنعاء، وعاش طفولته وشبابه بجانب والده الإمام المنصور محمد بن يحيى بن محمد، الذي كان يعمل بالتجارة، ويُعتبر من أمهر وأذكى التجار في صنعاء.
وفي عام ١٨٩٠م الموافق ١٣٠٧هـ تُوفي الإمام الهادي، فغادر الإمام يحيى صنعاء مع والده الذي استقر في الأهنوم، حيث دعا للإمامة لنفسه، وأعلن مقاومته للأتراك من هناك، وأخذ يعمل على إخراجهم من اليمن، إلا أنه توفي عام ١٩٠٤م، فبويع ابنه خلفًا له، واتخذ من (قفلة عذر) عاصمة له.
تسلَّم الإمام يحيى السلطة في المناطق الشمالية التي كان يحكمها والده، فراح يعمل بدهائه ومكره وحنكته على ترسيخ أقدامه في السلطة، واستقطاب الرجال الأقوياء إلى صفه بما يبذله لهم من وعود في الإصلاح أو المشاركة في الحكم وإقامة الحكم المحلي الذي سيُبنى عليه حكمه بعد تخلصه من الأتراك، حتى تعاون معه كثيرون من أبناء الأسر المنافسة له في الإمامة، وتعاون معه بعض المدنيين وشيوخ القبائل على أساس ما وعد به من الإصلاح أو الجاه أو النفوذ.
ومثلما ركز على بناء سلطته ونفوذه، ركز أيضًا على مواصلة الحرب ضد الأتراك لإخراجهم من اليمن ليبسط نفوذه على المناطق التي يحكمونها، وشددت قواته من حصارها لصنعاء. إلا أن الأوضاع الدولية السائدة يومها، والأخطار المحيطة بالإمبراطورية التركية من قبل الدول الغربية التي أخذت تنسق مواقفها ضدها بخلق القلاقل والحركات الانفصالية وحركات الاستقلال في كثير من البلدان الخاضعة لحكمها، تمهيدًا لتمزيقها وبسط نفوذها على كثير منها، اضطرت تركيا إلى عقد اتفاقية مع الإمام يحيى عام ١٩١١م، المعروفة باتفاقية (دعان)، لتتفرغ لمجابهة المؤامرات الغربية التي تُحاك ضدها. وكانت المنافسة الاقتصادية بين الدول الأوروبية والمطامع السياسية في التوسع قد بلغت ذروتها، وأخذت تُقيم التكتلات والأحلاف على ذلك الأساس تمهيدًا لدخول الحرب العالمية الأولى ضد بعضها. وقد اختارت تركيا أن تقف إلى جانب صديقتها وحليفتها ألمانيا، وتخوض الحرب إلى جانبها ضد الدول الأوروبية الأخرى، خاصةً وقد كان لكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مطامع في احتلال البلاد العربية التي كانت تُعتبر جزءًا من الخلافة العثمانية. وفعلاً بدأت تلك المطامع تظهر عندما أقدمت إيطاليا عام ١٩١١م على احتلال ليبيا. وعندما نشبت الحرب العالمية عام ١٩١٤م، خاضتها تركيا في كل من اليمن والحجاز وسوريا وفي أوروبا ضد أعدائها وإلى جانب حليفتها ألمانيا.
وكانت بريطانيا أكثر الدول الغربية خوفًا على مصالحها وعلى طرق مواصلاتها إلى مستعمراتها في الشرق، وعلى مستعمرتها ومحطة تموين سفنها ونقطة حراستها (عدن) القريبة من القوات التركية، التي زحفت بعد اشتعال الحرب على المحميات واستقرت في مدينة الشيخ عثمان على بُعد بضعة أميال من عدن.
أخذت بريطانيا تعمل منذ بداية الحرب على كسب بعض الحكام المحليين في الجزيرة العربية إلى جانبها، إلا أنها عجزت عن كسب الإمام يحيى، الذي كان قد عقد معاهدة صلح مع تركيا، وفشل الضباط السياسيون الذين وصلوا من عدن في إقناع الإمام بدخول الحرب إلى جانب بريطانيا ضد تركيا، فقد رفض ذلك، وبقي على الحياد، ناكثًا بوعوده لتركيا بتقديمه المساندة لها أثناء زحف قواتها على عدن والمحميات لاحتلالها.
ومن يراجع الوثيقة رقم (٣٦) في كتاب د. سيد مصطفى سالم وثائق يمنية صـــ ٣١٩، وهي برقية جوابية مطوَّلة من الوالي محمود نديم للإمام يحيى، سيتعرف على مدى تخاذل الإمام يحيى وتقاعسه عن تقديم العون للقوات التركية المحاربة ضد القوات البريطانية، واحتجاج الإمام عليهم في عدم الإسراع في احتلال النواحي أو المحميات، وشكوى محمود نديم من تصرفات القوات الإمامية التي أرسلها الإمام لمساندتهم في الحرب، إذ إن هذه القوات الإمامية أخذت تنهب القرى الكائنة في طريقها والممتدة من إب إلى الضالع.
ومع ذلك، فإن كثيرين من أبناء مناطق تعز والعدين وإب لم يقفوا موقف الإمام يحيى السلبي من الحرب، وإنما قرروا الوقوف إلى جانب تركيا ومساندتها وخوض الحرب معها ضد بريطانيا، لأنهم آمنوا بأن تلك الحرب كانت دينية إسلامية ووطنية وليست حربًا سياسية. فجمعوا الجيوش من مناطقهم ودخلوا الحرب إلى جانب القوات التركية تحت قيادة سعيد باشا، الذي وصل بهذه القوات إلى مدينة الشيخ عثمان، إلا أن هذه الحرب انتهت بهزيمة ألمانيا وتركيا. وبذلك تمزقت الإمبراطورية الإسلامية أو أراضي الخلافة العثمانية، وخرجت كل الأقطار العربية من تحت سيطرة الخلافة العثمانية، لتقع بين براثن الاستعمار الغربي الذي تقاسم تركة (الرجل المريض) بعد انتصاره في تلك الحرب.
ساد الأقطار العربية التي وقعت تحت وطأة الاستعمار نوع من الديمقراطية الصورية، مثل المجالس المحلية والتشريعية المقيَّدة، والأحزاب، والدساتير، والصحف، والمجلات المستقلة أو التابعة للسلطة. وبالتالي انفتحت هذه الأقطار على الغرب، وتعرَّفت على كل ما يجد في العالم من تطورات في مختلف جوانب الحياة، وأخذت تتأثر بذلك وتتفاعل معه.
هذا بالنسبة لما حدث للبلاد العربية التي تحررت من النفوذ التركي بعد الحرب ووقعت فريسة للاستعمار الغربي. أما بالنسبة لما حدث في بلادنا، فإن الأجزاء التي كانت خاضعة للحكم التركي واستعادت سيادتها، لم تُنكب بالاستعمار مثلما حدث للأقطار العربية الأخرى، وإنما نُكبت بدسائسه ومؤامراته، وقد تكوَّنت منها المملكة المتوكلية اليمنية، ويُعتبر شهر نوفمبر ١٩١٨م شهر ميلادها أو تأسيسها.
ففي شهر نوفمبر دخل الإمام يحيى صنعاء بدعوة من الوالي محمود نديم، آخر والٍ تركي على اليمن، ليتسلم منه مقاليد السلطة رسميًا قبل تركه لوظيفته. أما بالنسبة للمناطق اليمنية الجنوبية التي كانت خاضعة للحماية البريطانية واحتلتها قوات سعيد باشا أثناء الحرب، فقبل انسحابه بقواته منها، طلب من الإمام يحيى أن يبعث من يستلم منه هذه المناطق، فلم يوافق الإمام على استلامها لأنه لا يرغب في أن يحكم المحميات الفقيرة التي ستشكل عبئًا ماليًا عليه، وإنما يرغب في أن يحكم عدن لما سيدره ميناؤها من أموال على خزانته. وبعد انسحاب القوات التركية من المحميات، عادت إلى الحماية البريطانية.
كان الإمام يحيى يُحسن الظن بنوايا بريطانيا، وأنها ستسلم إليه كل المحميات ومستعمرة عدن تقديرًا منها لموقفه المحايد في الحرب وعدم تقديمه المساعدة للأتراك. وفي بداية الأمر عرضت عليه بريطانيا أن تتخلى له عن المحميات وتحتفظ بمستعمرة عدن، فرفض ذلك لأن مطامعه منصبَّة على ما سيدره ميناء عدن من أموال على خزينته، فهرول ما بين هذا وذاك، فلا تلك أتت، ولا ذلك حصل. أما وحدة الأراضي اليمنية والسيادة عليها فلم يكن يهتم بها إلا بقدر مردودها المالي فقط، ولذا قرر التخلي عن بعض المناطق التي يحكمها مثل البيضاء ومأرب.
فبالنسبة للبيضاء التي كانت جزءًا من لواء ذمار، تقول أكثر من رواية إن أمير اللواء عبد الله بن أحمد الوزير طلب من الإمام يحيى مبلغ ألفين ريال للجيش المرابط في البيضاء كرواتب، فأجاب الإمام يحيى بقوله: (إذا كانت وارداتها لا تفي بمصاريفها، فلتلحق بأخواتها). أي تدخل تحت الحماية البريطانية إذا كانت ستكلف رواتب الجنود والموظفين. ثم استدعى عبد الله إسحاق وسأله: هل بمقدوره إذا كان أميرًا على البيضاء أن ينفق عليها من دخله؟ فأجاب بالإيجاب، ففصلها الإمام من لواء ذمار، وعيَّنه محافظًا عليها بعد أن جعلها محافظة مستقلة.
وبالنسبة لمأرب، فقد روى لي أحد الأصدقاء عن الأستاذ زيد عنان قوله: إنه سمع الإمام يحيى شخصيًا يقول ما معناه: (ما معانا فائدة من مأرب هذه.. تخسرنا كل سنة خمسة آلاف ريال معاشات ونحن ما فيش معانا منها مدخول.. ما عد نشتيهاش).

الإمام يحيى يفرض العزلة على مملكته
كان من الممكن، بل والمفروض، أن يتحقق حلم الطلائع اليمنية وأملها في حكم وطني عادل بعد جلاء الأتراك، في ظل حكم الإمام يحيى، خاصة وقد جاءت الوفود المهنئة والمبايعة له والمطالبة منه أن يكون حاكمًا لليمن كلها من مختلف أنحائها، إذ كان من ضمن الوافدين إليه ابن عبيد الله السقاف، مفتي الديار الحضرمية، قال فيه عدة قصائد جمعها في ديوان صغير أسماه “الإماميات”.
كان من الممكن أن يتحقق حلم هذه الطلائع اليمنية، التي كانت على جانب من الاطلاع والفهم بالتطورات الجارية في العالم، وتأثرت بها واحتكَّت بالإدارة التركية أو البريطانية واستفادت منها، لو كان الإمام يحيى صادقًا فيما بذله من جهود ووعود لهذه الطلائع وغيرها، وكثير من المناطق التي قدَّم رؤساؤها الطاعة والولاء، وقدموا لتهنئته ومبايعته.
لكن الإمام لم يكن متجاوبًا مع هذه الطلائع ولا يشاركها تفكيرها وطموحها، بل كان على نقيضها؛ لم يحتك مثلهم بإدارات حديثة، ولا تأثر بما يحدث في العالم من تطورات، ولم يؤمن بالأخذ بأساليب الحكم الحديثة من إدارة ودستور وبرلمان وجيش في بناء الدولة. عاش وترعرع في بيئة متزمتة تأثر بها، واتخذها أسلوبًا لتصرفاته ومنهجًا لنظام حكمه.
لقد جاء من مناطق جبلية جرداء قاحلة، منغلقة على نفسها، ومنعزلة عن المناطق التي عاشت مدة من الزمن تحت الحكم التركي، ولم تكن على صلة بما يجد في العالم. دخل صنعاء بنفسية كئيبة وروح مظلمة، وتسلم السلطة وهو أسير ذهنية قديمة متزمتة تنفر من كل جديد أو غريب، فلم يستطع أن يرقى بنفسه وطموحه إلى مستوى العصر، أو يتفهمه، ويستوعب منجزاته، ويستفيد مما يجد حواليه.
حاول أن يحكم بنفس القاعدة والأساليب البالية والقاسية التي حكم بها الأئمة الذين سبقوه، معتمدًا على القبائل الموالية له في ضرب القبائل غير الموالية، وفي فرض الأمان والاستقرار في مملكته. ولم يحاول تكوين جيش نظامي مثل بقية الدول، لولا أن مفتي إب القاضي يحيى الحداد نبَّهه إلى خطورة الاعتماد على الجيش البراني، ونصحه بضرورة تكوين جيش نظامي حديث، كما نصحه باستبقاء بعض الضباط الأتراك لتدريب وتنظيم الجيش النظامي.
كما عمل القاضي غب بك (التركي) وزير الخارجية على استكمال مظاهر الدولة بإقامة علاقات وعقد اتفاقيات مع بعض الدول الأجنبية. هذان هما فقط المظهران من مظاهر الدولة الحديثة اللذان وافق الإمام يحيى على إيجادهما، أما ما عداهما فقد كان سلوكه وأسلوب حكمه تجسيدًا لقسوة الحياة وطبيعة التفكير والسلوك السائد في المناطق المنغلقة على نفسها.
وقد فرض حصارًا رهيبًا على البلاد وعزلها عن كل ما يمت إلى العالم الخارجي بأي صلة، بل عمد إلى إلغاء النظم الإدارية الحديثة، وأساليب التعليم الحديث التي كان الأتراك قد نقلوها معهم إلى اليمن عند عودتهم الثانية إليها. وقد تحدث الأحرار اليمنيون عنها في كتاب اليمن المنهوبة المنكوبة الذي أصدروه في الأربعينيات، إذ جاء فيه:
“ومما هو خليق بالذكر للحقيقة والتاريخ أن اليمن بمناطقها الجميلة وسواحلها ومختلف مقاطعاتها الممتدة في السهول والوديان، كانت في عهد الحكم التركي، خاصة بعد الانقلاب الدستوري العثماني الأخير، تتمتع بحكم شعبي يتناسب وحالة العصر مما هي محرومة منه الآن. ولو امتد حكم الأتراك إلى يومنا هذا، لتدرج اليمانيون في ظل الحكم الشعبي نحو الحياة العامة المناسبة أكثر وأكثر. ولهذا نسجل أن الولاة والمحافظين وكبار رجال الحكم الأتراك كانوا غير منفردين بالسلطة، بل كانوا يرجعون إلى الدوائر العليا في الآستانة ويحاسبون أمامها عما يكون قد حدث من تقصير في تصريف شؤون الحكم”.
“كان في كل محافظة وقضاء (مركز) مجالس محلية يطلق عليها مجلس الإدارة، أعضاؤها من صفوة أبناء البلاد، الواقفين على حاجيات مواطنيهم. كانوا خير أداة لعون الحكومة على تطبيق العدالة، لأنهم يعتبرون وسطاء بين الشعب وولاة الأمور المسؤولين. هذا ما عدا ما كان لليمن من نواب يمانيين كرام يتمتعون بالوطنية والكفاية بالبرلمان العثماني، يناقشون ويجادلون ويسألون ويستجوبون بحرية تامة في مصالح بلادهم، فكان للشعب رهبته ومكانته لدى الحكام المحليين والمنفذين لقوانين الدولة، ولو بدا منهم أي تقصير نحو الشعب، سارع أولئك النواب اليمانيون في توجيه السؤال والاستجواب”.
“وعدا هذا، فقد كان هناك أمر شعبي عظيم آخر، هو المجلس العمومي للولاية، مقره صنعاء، رئيسه الوالي ونائب الرئيس من الوطنيين الخبيرين بشؤون البلاد، وأعضاؤه يبلغون الثلاثين نائبًا. وكان هذا المجلس يتمتع بسلطة واسعة كبرلمان مصغر، يفتتح في موعد معين باحتفال شعبي عظيم، يُلقى فيه الوالي خطبة الافتتاح، وهو بمثابة خطاب عرش في البرلمانات الكبرى، يذكر فيه الوالي ما تم في السنة الماضية وما قامت به حكومة الولاية من إصلاح وتعمير وتعليم، وبالجملة كل ما أُدخل على مرافق البلاد من تحسين ونهوض برفاهية الشعب ورخائه”.
ويتحدث محمد أحمد نعمان عن ذلك ويقارنه بحكم الإمام يحيى إذ يقول:
“وصنعاء حاضرة البلد كانت في عهد الترك على علاقة بكل جديد، ونشأت فيها مجموعة من الكوادر الذين تدربوا تدريبًا تركيًا، وكان نقيضها مدارس شهارة والأهنوم وصعدة. وكان الإمام وكل من حوله منغلقين في الجبال، وفي الثقافة التاريخية التقليدية التي ورثتها البلاد في المخطوطات القديمة. وكان في صنعاء قشرة بسيطة صغيرة اتصلت بالإدارة التركية، وكانت أول من دق ناقوس الخطر بدخول الإمام، لأن الإمام سيأتي يلغي كل هذه الأشياء. وكان بينهم من يعرف الإمام وهو صغير لأن والده الإمام المنصور كان قاضيًا شرعيًا في بعض مناطق صنعاء، وكان له لدات يعرفونه ويعرفون شخصيته”.
أي أن الاستقلال اليمني من الأتراك قد كان، في نتيجته، استقلالًا عن العالم المعاصر، وكان انعزالًا عما حوالينا من تطورات. وكان الحاج محمد المحلوي أول من نبَّه وحذَّر المواطنين من تقبل الإمام يحيى إمامًا بعد رحيل الأتراك، لأنه سيدمر كل شيء وسيلغي كل شيء.
ولكي يحكم الإمام حكمًا مطلقًا، ويحكم قبضته على المواطنين، اعتمد على ما يلي:
1. تخلص من العلماء الذين واجهوه بالمعارضة وجاهروه بآرائهم، واستشعر خطرهم عليه فسحقهم نفسيًا وسلط عليهم السفهاء باسم الشريعة، أو سحقهم أخلاقيًا بتوظيفهم وتسليط من يفسدهم بالرشوة.
2. تنكر للوعود والعهود التي قدمها لأبناء المناطق المختلفة في إقامة النظام اللامركزي كقاعدة لنظام حكمه أثناء دعوته لهم بمساندته.
3. بادر إلى إلغاء أسلوب التعليم الحديث الذي أدخله الأتراك.
4. سن نظام الرهائن المعروف والعقوبة الجماعية، الذي قال عنه أمين الريحاني: “إنه لحكم عسكري قاسٍ شديد، بل حكم اشتباه وارتياب”.
5. سن نظام الخطاط على القرى، بحيث يتولى أبناؤها طحن وطبخ غداء عسكر الإمام ونقله من منازلهم إلى مركز الحكومة مجانًا وإجباريًا.
6. أخذ يشرف بنفسه على واردات الدولة وجباية الضرائب ويحدد مقاديرها بنفسه، كما لو كان مأمور جباية، كما هو الحال في رسالته التالية:
“الفقيه الفخري عبد الله الشامي، حماه الله، والسلام عليكم ورحمة الله: وإنه قد سبق الأمر إليكم بقبض علف الذرة من نفس شبام بعد كل قدح ربع ريال. وحيث تحقق بأن ذلك موافق للحق، نأمركم بالقبض من جميع ما تحت نظارتكم من المحلات بعد كل قدح ربع ريال من ذرة وغيرها، فخرج ما لم يُستفد، يعلقه مثل الخردل والحلبة والقلا والعدس والسعتر والذرة. وهذا اعتبار من الصراب الحاصل بهذه السنة، وأجروا الضم على التزام ما يقاوم الثمن ريال الزائد على الدرهم، فلا بد من ضمه حيث كان الالتزام بشرط أن القبض بعد كل قدح ثمن ريال، فاعتمدوا هذا”. تاريخ ١٦ رجب ١٣٤٩هـ.
وعندما راجع الإمام أحد أصدقائه من جور الضرائب التي يفرضها على المواطنين، وطلب منه أن يخفف منها، أجابه بقوله: “هل رأيتهم يحملون البصائر ويعرضون أرضهم للبيع؟”.
ولَّد هذا الأسلوب من الحكم ردود فعل معاكسة لدى المواطنين، اتخذت أكثر من شكل وأكثر من أسلوب، باختلاف دوافع السخط والتذمر ونوعية الاضطهاد الذي يعانون منه. ومثلما اختلفت بواعث التذمر وأساليب الاحتجاج من قبل المواطنين، اختلفت أساليب الانتقام منهم وفقًا لاختلاف مواقفهم ومكانتهم الاجتماعية.
سخط عليه المستنيرون والعلماء من أبناء المدن، وبالذات أبناء صنعاء وذمار، لتزمته وانغلاقه، وكانوا يرون أنفسهم أكثر تطورًا وتفهمًا وانفتاحًا على العالم ولأساليب الحياة الجديدة منه، فراحوا يضيقون به ذرعًا وبما يمارسه من تزمت وانغلاق وربط طاعته بطاعة الله سبحانه وتعالى، فأخذوا ينتقدون تصرفاته وسلوكه ليفضحوا القداسة التي يغلف بها تصرفاته ويسبغها على نفسه ونظام حكمه، ويفرقون بين طاعته وطاعة الله.
فأخذ الإمام يعمل على وأد طموحهم وكبت تطلعاتهم وتحريض العامة عليهم بما يوجهه إليهم من تهم، كتقصيرهم في أداء الشعائر الدينية، واتهم الذين تقدموا له بالنصح بمحاولة اختصار القرآن، وتحت هذه التهمة زجَّ في السجن بكل من الحاج محمد المحلوي، وعبد الله العزب، والعزي صالح السنيدار، وأحمد المطاع، ومحمد المطاع، وعلي الشماحي.

أمراء حرب الإمام يحيى
منذ بويع الإمام يحيى إمامًا خلفًا لوالده عام ١٩٠٤م، وقبل أن يتسلم السلطة من الأتراك، دخل في تحالف مع كثير من الشخصيات البارزة من أبناء البيوتات الكبيرة المنافسة له، والطامعين في حكم اليمن باسم الإمامة مثله، والمجانسين له نفسيًا وذهنيًا وتربيةً وسلوكًا، ليكسبهم إلى جانبه.
وبعد دخوله صنعاء وتسلمه السلطة في نوفمبر ١٩١٨م، اختار منهم رجال حكومته ودعائم عرشه وقادة جيوشه وحكامًا على الألوية أو المحافظات كنوع من المشاركة له في الحكم. أُطلق على هؤلاء الحكام، يومها، أمراء الحرب، ولا يزالون يُعرفون بذلك اللقب حتى وقتنا الحاضر، إذ بقيت التسمية ملتصقة بهم، سواء الذين عُينوا حكامًا في المناطق التي بايعت الإمام طواعية، مثل لواء تعز الذي كان يشمل يومها تعز وإب، أو التي أخضعها بالقوة مثل البيضاء والجوف، أو التي تمردت عليه مثل حاشد والزرانيق.
فقد دخل الأمراء المناطق التي أُرسلوا إليها أمراء حكم، أو التي أُرسلوا لإخضاعها كقادة جيوش، دخلوها كلها دخول الغزاة الفاتحين، بما فيها المناطق التي أرسلت وفودها إلى صنعاء لتهنئة الإمام يحيى ومبايعته، وحكموا فيها حكم الطغاة، مستخدمين العقوبة الجماعية والخطاط والتنافيذ والرهائن وجور الضرائب، إذ كانت هذه الأشياء أو المسميات هي قواعد الحكم الإمامي وأسسه.
وكان أمراء الحرب يعتبرون أنفسهم شركاء الإمام في الحكم، لا مجرد موظفين حكوميين، وهناك نكتة يتداولها الناس حول ذلك، وهي أن الإمام قرر عزل أحد كبار موظفيه (أبو طالب)، فذهب هذا الموظف إلى الإمام حانقًا وقال له: “عانت عازل؟” أي نحن عيناك وأنت عينتنا، وإذا كنت ستعزلنا فنحن أيضًا سنعزلك، فتراجع الإمام عن قراره.
لقد كان هؤلاء الأمراء شركاء للإمام في حكمه وفي ظلمه، واستهدفوا جميعًا إذلال المواطنين، بمن فيهم الشخصيات الرئيسية التي عُينوا فيها، وسحق آدميتهم واعتصار أرزاقهم، فدخلوا في مجابهة مع الشيخ ناصر الأحمر في حاشد، ومع السلطان الرصاص في البيضاء، ومع مشايخ تعز وإب وتهامة، لأن الهدف المشترك بينهم وبين الإمام هو سحق نفسية الإنسان اليمني بحيث لا يبقى في الساحة اليمنية إلا شخصية الإمام وأمراء حربه.
* من كتاب: لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين
للأستاذ المناضل علي محمد عبده، (ص 26-35).