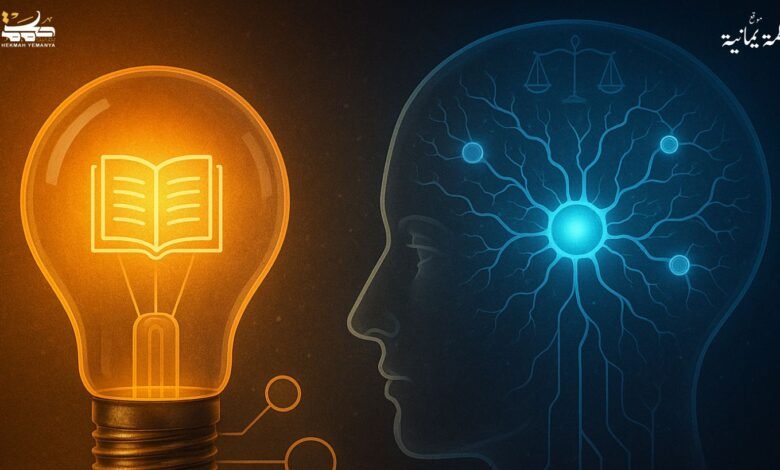
«المنهجُ الذي نتبنّاه يجعل من الحدث المنفرد جزءًا من كل، فيمنحهُ ذلك حياةً ومعنى، ويعصمه من الاجتزاء أو التوظيف، ونستطيع بذلك أن ننتقلَ من المعلومة إلى المعرفة، فتتحرر الروايةُ التاريخية من القوالب اللفظية والدلالات الوصفية والإسقاطات السياسية لتستوي سردية كلية، تنسجمُ مع الفهم الشامل…»
— وضاح خنفر، الربيع الأول: مدخل [الرسالة والمنهج]: ٢٢.
ما أصغى ولا اطّلعَ ساعٍ إلى أطروحاتِ الأستاذ وضّاح خنفر إلا وغبِقَ الخالصَ وأفاد، وفي هذه القطعة المكينة في مدخله لاستقراء السيرة النبوية واستنطاقها في ضوء التدبير السياسي يَميزُ ببيان مراجع تعامله مع السيرة، ومنها ما استوقفني: «الانتقال من المعلومة إلى المعرفة» كمنهجٍ في تحرير الرواية التأريخية من التحيزات اللفظية والدلالات الوصفية والإسقاطات السياسية، وهي بأهميةٍ لضمان التبصرة، فإليك بيان نهجها، أُجلّي لك عن غوامضها بعون الله:
من حاصل المُفاد أنّ العلم لا يحصل إلا بجمع الجزئيات وتأليف الكُليات، ومن ابن خلدون أفدنا أنّ اللغطَ والغلط في التأريخ ليس إلا من اثنتين: فإن لم تكن سوأة النقل وسَقَطه، ففي قصور فَهم المتأوّل عن إدراك العِلل. وذكره للمعلومة بيانٌ للجزئيات كوحداتٍ منفصلة، وأما ذكره للمعرفة فبيانٌ للكُليّات كنسيجٍ رابطٍ بين المعلومات تفسيرًا وتركيبًا لاستخلاص الإبريز المُهذَّب من الفَهم الشامل.
فأنّى للقارئ والناظرِ والحائر القلق من عظيم مُحدَثاتِ واقعنا السياسي اليوم أن يخرجَ من [المعلومة/الجزء] إلى [المعرفة/الكل]؟
مُقرّرٌ في مذاهب النُظّار والمناطقة أنّ ذاك يكون من جسرين:
الاستقراء فالتركيب، فاستقراؤك للحدث لا يتم إلا بجمع المعلومات وأشذاذها هنا وهناك بُغية الوصول إلى حكمٍ كُلي، ثم بالتركيب الذي لا يستقيم لك إلا بنَسج المعلومات في إطارٍ مفاهيميٍّ جامعٍ يُسفرُ عن وجه العلاقات بينها. وهذا التقريرُ من عيون المنطق؛ إذ لا كيان لمعرفةٍ جُرِّدَت عن فَهم وإيعاب العلاقات بين الأجزاء، وذا مُحصَّلٌ في كثيرٍ من بيان التصنيف عند علماء المسلمين إذ عرّفوا المعرفة: إدراك الأشياء بحقائقها وعللها. (1) فإنِ استحصلَك وقعُ الخطأ في بيان فيصل الجزء والكل قد تثني عِطفك عن بعض الأجزاء، أو يتخطّفك الاقتصارُ على بعضها، وعلى بعضها جعلتَ من الكلِّ مجموعًا لها، بينما الكل أكبر من مجموع أجزائه. وما غفلَ التُّراثُ الإسلامي المنطقي من معالجة هذه القضية بالتقعيد السليم لها، كما ركّزَ المَلَوي في شرحه للسُلّم على [التعريف التام والقياس] فهذين العمادين هما بزّة المنطق وخامته، فبالتعريف التام يتيسّر عليك فهم ضرورة الجمع بين الجنس والفصل، وبالقياس يُيسَّرُ لك ربطُ المقدماتِ الجزئية بالنتائج والحواصل الكلية. وهذا مربطُ الفرس في انتقالنا من المعلومة إلى المعرفة: بيان علاقة الجزء بالكل، فعلى الأولى [المعلومة] تُبنى الثانية [المعرفة]، وبالثانية يتحقّقُ المعنى على الأولى، وذا نهجُ الذمّة العقلية في التحصيل العلمي والمعرفي.
وليس بعد تحصيل المعرفة إلا تحريرها، فإنِ استحكمَتِ المعرفةُ في الصدور، فتحريرُها من أدرانِ الهوى أمانةٌ، وها هنا أقفُ عندَ قول المتنبي «إنّ المعارف في أهل النُهى ذممُ» بيانًا لوضاحة المنهج، وقد أوفى السؤالُ وقعَه في نفسي: لمَ كانت الذمم وما كانت الحقائق؟ هذا الربطُ بين الذمة العقلية والذمةِ الشرعية على جهة المعارف من لُمع الإشارات الفلسفية عند المتنبي إلى غايةِ تحرير المعرفة من الأهواء، وصياغةٌ شريفة للمعنى والغاية، تراها تُخرّجُ لمسؤوليةٍ أمام الله تعالى، من حصائل ربّانية إلى ودائع أخلاقية: «إن السمعَ والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»(2). كما والذمة الشرعية مُحصِّلةٌ لصرامة المنهج ونزاهة التطبيق ولآلةِ الحقّ مُحقِّقة. وشأنُ المعرفة كسلطةٍ أخلاقية لا يتوقّف عند التحصيل، بل طائلٌ إلى سياقاتٍ وأطيافٍ صميمة، كالسياسة على سبيل المثال، فالجمعُ بين العلم الضروري كفَهم المبادئ العامة للعدل، والعلم العملي كتطبيقها قياسًا على ظروف الخليقة، إن أُهمِلَ الأخذُ بتوازنه وأُقعِد النظرُ في جوانبه، قامت خيانةٌ لذمةِ الحُكم. فالتصورُ أمانةُ الفَهم والتصديقُ أمانةُ الحكم. وزِد على هذا قياسًا لخيانة شرف المعرفة في الفصل بين العلوم النظرية والتجريبية، ومثلهما تحرير الروايات التأريخية والأخبار السياسية والمواقف الشرعية…
وإنْ أطلنا النظرَ بعين الفحصِ للذممِ وفصولها عند [أهل النُّهى] لانتهينا إلى فيصلٍ جامعٍ بين اثنين من ماهيتِها: ذمةٌ نظرية تُوجبُ قوةَ عقلٍ عطّاش لمناهل الحقائق من المبادئ اليقينية على صحيح البُرهان. وذمةٌ عمليةٌ تُقرّرُها حكمةٌ تزنُ بين المبادئ الكُلية، كأصول العدل مثلاً، والجزئياتِ المتغيرة، كأحوال السياسة. فإنِ اختلّتِ الذمةُ النظرية فسدَ التصوّرُ/الإدراك. وإنِ اختلّت الذمةُ العملية فسدَ التصديقُ/الحكم. وكلاهما خيانةٌ لوديعة العقل الفاعل والسرديةِ الأخلاقية.
كان المتنبيّ حصيفًا بما فيه من تخليصه الإبريز المُصفّى من ذاك الشطر إذ أوحى بالمقاصد: [ما يجبُ أن يكونَ]، ليترك لنا كعادتِهِ من المُستشهَد على الغائب ما يُؤسسُ للنُظمِ الواجبة وما يترتبُ على قيامها أو سقوطها من مصاحّ ومفاسد المجتمع، فالذي يستشهدهُ المجتمعُ الإنساني من خيانةٍ للذممِ أسقامًا وعللاً صحَّ بيانُها في منزلتيْ السياسة والعلوم لِما تقوم عليها الأسبابُ والمُسبّبات؛ ففي السياسة إذا فُصِلَ فيها العلمُ الضروري [كُليّات العدل] عن العلم العمليّ [جزئيات التطبيق] فمِن أقطعِ المحصول إصابةُ الحاكم بـ [عَطَلِ الحكمة وبُطْلِ الحقّ] وما الظُلم في الحُكم إلا خليقة ذا؛ ذاك أنّ السياسة الحقّة طبٌ عمليٌ يبري أسقامَ المدينة وأهلها بمِقدار، فإذا جُهلَ المبدأُ أو فُسِّرَ بالهوى صارَ الدواءُ داءً. وفي العلوم إذا ما انجذمَ النظرُ الفلسفي [طلبُ الغايات] عن العلم التجريبي [وسائل التحصيل]، أو صُيّر التأريخُ آلةً لعَماية الهوى لا مرآةً للحقّ والهُدى، فشأنُ المعارف حينها شأنُ الأوهام المُسقِمة للعقول والمُفسدة للنفوس، أما رأيت كم أفسدَ التعسّف التدويني للتأريخ بحمولتهِ الدلالية أُممًا وأسمجَ مساراتِها؟
وقولُه جل وعلا: «إن السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسئولا» بُرهانٌ بيّنٌ في بيان قِوى آلات الاتصال بالعقل الفاعل، وإهمالُها قطعٌ لفيضٍ إلهي أودعَه اللهُ في النفوس الناطقة المسؤولة عن قِوىً ثلاث، أولاها قوةُ تصوّرٍ، ومخونةٌ إن أبدلَتِ الظنَّ باليقين. وثانيها قوةُ تصديقٍ مخونة إن حكمَت بلا برهان، وآخرُها قوة التطبيق التي تُخان إذا استوثق الباطلُ على الحقِّ الفاعل. وما هذا مُقتصرٌ على مسئوليةٍ دينية، بل سنة كونية تقضي على النفس انفصالها عن كمالها إذا ما خانت ودائعَ العقل التي من دونها يسمج التكليفُ وتسقطُ الحجة.
الهوامش:
- وهنا إشارة نفيسة إلى قولةِ الرازي في بيان الجزء بالكل
- «وهذا إشارةٌ إلى أن إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكاتٌ متغيرة». [ينظر: التفسير الكبير ٢/ ٤٢٢]. سورة الإسراء: ٣٦.

