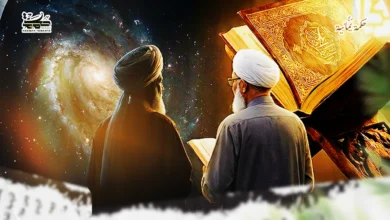في المقال الموسوم بـ “أزمة الكيف واللماذا: كيف يغتال الوصف التفسير في العقل التحليلي العربي؟”، طرح الكاتب سؤالًا مهمًا: لماذا تتوقف تحليلاتنا السياسية والاجتماعية عند وصف ما حدث بدل تحليل ما جعل حدوثه ممكنًا؟ سؤال مشروع، لكن الإشكال لا يكمن في كثرة الوصف بل في سوء فهم طبيعة “الكيف” ووظيفته التحليلية.
الكاتب افترض أن -الكيف- بطبيعته سرديٌّ سطحيٌّ وأن -اللماذا- هو مفتاح العمق البنيوي، غير أن علم الاجتماع السياسي لا يقر بهذه الثنائية القاطعة. فـالكيف ليس حكايةً تُروى بل آلية تُفكّك، و-اللماذا- ليس تعويذةً فلسفية للغوص في الأعماق بل استنتاج سببيٌّ يُبنى على فهمٍ تشغيليٍّ للبنية. في العلوم الاجتماعية الحديثة -الكيف- ليس مرحلة الوصف بل أداة تشريحٍ وظيفيٍّ للواقع. عندما سأل ماكس فيبر “كيف تعمل البيروقراطية؟” لم يكن يروي قصة إدارة، بل كان يفكك العقلانية المؤسسية التي جعلت الدولة الحديثة ممكنة. وعندما حلل تشارلز تيلي كيف تصنع الحرب الدولة وتبنيها؟ لم يبحث عن “لماذا” الغائية بل عن الآليات المادية والرمزية التي تنتج السلطة.
التحليل الكيفي، بهذا المعنى، هو تحليلٌ تشغيليٌّ–ميكانيزمي، لا يقف عند الوصف بل يتجاوزه إلى تفكيك آليّات الواقع:
كيف تتوزع الولاءات؟
كيف تنتج الأنظمة هشاشتها؟
كيف يُعاد إنتاج الفساد؟
هي أسئلة في قلب علم الاجتماع السياسي، وليست نقيضًا للعمق أو التحليل البنيوي.
في المقابل، -اللماذا- هي أداة التفسير السببي التي تُجيب عن: لماذا تتولد هذه النتائج من تلك البُنى؟
لكن المشكلة تظهر حين تُستعمل -اللماذا- كبديلٍ عن التحليل نفسه، أي حين تتحول من سؤالٍ معرفي إلى شعارٍ نقدي يوحي بالعمق أكثر مما ينتجه.
فلا يكفي أن نقول “لماذا سقطت الدولة؟” ما لم نعرف كيف كانت تعمل.
التحليل الذي يبدأ بـلماذا دون كيف يقفز فوق الوقائع إلى التجريد،
والذي يكتفي بـكيف الوصفية دون التشريحية التي تصله بلماذا يغرق في التفاصيل دون أن يبني تفسيرًا.
والمنهج الجدّي هو الذي يربط السؤالين في نسق معرفي واحد:
من التشغيل إلى العلّة ومن البنية إلى النتيجة.
إن العقل التحليلي العربي لن ينهض بإستبدال لماذا بكيف،
بل بتجاوز الثنائية نحو منهجٍ تركيبيٍّ يربط بينهما.
فـ“الكيـف” هنا يُستخدم لتفكيك البُنى وآليات اشتغالها،
و“اللماذا” تُستخدم لتفسير النتائج التي تنتجها هذه الآليات.
المنهج المركّب يبدأ بـالملاحظة والتحليل التشغيلي (كيف تعمل المنظومة؟)
وينتهي بـالاستنباط السببي (لماذا أنتجت هذه النتائج؟)
هو منهجٌ يزاوج بين الميكانيزم والسياق، وبين الحقل البنيوي والعوامل التاريخية بدل أن يضعه في فخ المفاضلة بين سؤالين متكاملين أصلًا.
خذ مثال سقوط صنعاء عام 2014. يمكن تفسيره بسردية “الخيانة” (الكيـف السطحي)، أو بالهشاشة البنيوية للدولة اليمنية (اللماذا البنيوية).
لكن التحليل الأعمق لا يقف عند أحدهما، بل يركّز على:
- من يتخذ القرار؟
- كيف تُوزَّع الصلاحيات؟
- كيف تنتقل الموارد؟
- أين يحدث الخلل في التدفق؟فعوض أن نذهب رأسًا فنسأل “لماذا فشلت الدولة اليمنية؟” نقوم بتحليل الوظيفة التشغيلية للنظام.فنسأل: “كيف تتخذ القرارات داخل أجهزة الدولة؟ كيف تُدار الموارد؟ كيف تُعامل الأخطاء؟”كيف تُنتج البنية الزبائنية الولاءات داخل الجيش؟هل نلوم الفاعلين هنا أم ندين البُنى أم نقرأ منطق التفاعل بينهما؟فكل ضابطٍ موالٍ لشخص لا لمؤسسة هو نتيجة لكيفية اشتغال الدولة الزبائنية وليس فقط شاهدًا على لماذا سقطت.
إن أزمة الفكر العربي ليست في غياب “اللماذا”، بل في غياب المنهج الذي يصل بين السؤالين دون أن يحوّلهما إلى خصمين. فـ“الكيـف” لا يغتال التفسير و“اللماذا” لا تصنع العمق وحدها.
إذا حصل هذا الوصل فسيكون اختزال الفشل في عجز النظام الجمهوري ليس تحليلًا بل تبريرًا جديدًا بلباس علمي. فالنظام لا يسقط لأنه غير مناسب للمجتمع، بل لأنه أُدير بمنطقٍ عطّل مؤسساته وأفسد توازناته.
ما يجب أن ندرسه ليس “لماذا وُلدت الجمهورية هشة” بل “كيف صارت كذلك؟” فالفكرة لا تُدان بل تُختبر في آلياتها. هناك فقط يبدأ علم الاجتماع السياسي الحقيقي: من تفكيك تشغيل الدولة لا من نعيها وتشييعها!