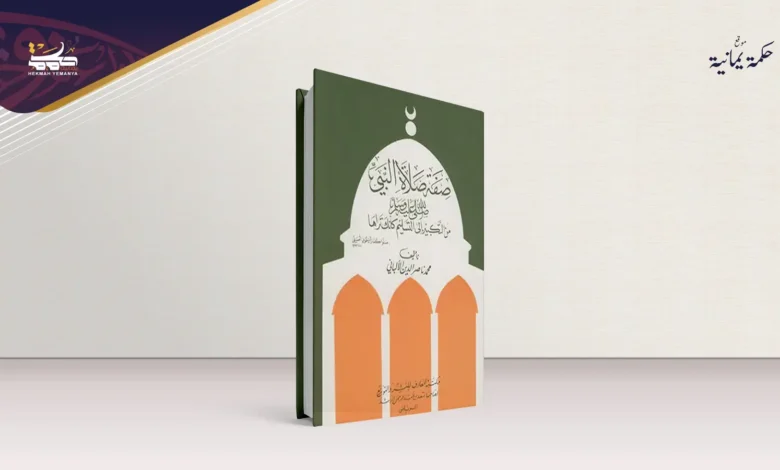
أول مرةٍ عرفتُ أنَّ الطَّبعة الثانية للكتاب تعني أن الطبعة الأولى قد نَفِدَت من السوق، كانت عندما رأيت طبعات كتاب صفة صلاة النبي للألباني – رحمه الله تعالى – تتوالى: الثانية، الثالثة، الخامسة… بفتراتٍ متقاربة.
لقد انتشر الكتاب ورقيًا بشكلٍ كبيرٍ جدًّا، وظهر أثره بصورةٍ جليَّة على شباب الصحوة، من المدرسة السلفية خصوصًا، وبصورٍ شتَّى لنشر فكرة الكتاب، بل تفاصيله: تدريسًا، مدارسةً، دلالةً، قراءةً فردية، وتواصٍ على قراءته وتعليمه للناس، وغيرها.
ولذلك ظهرت مظاهر جديدة لم يكن يعرفها عامة الناس في المساجد، مثل: الحرص الشديد على السترة، وجلسة الاستراحة، والتورك، ورفع اليدين قبل الركوع، وطريقة رفع اليدين بعد الركوع، وموضوع النزول إلى السجود: أيّهما أولًا، الركبتين أم اليدين؟
بدأ الكتاب بمقدّمةٍ تشدك شدًّا إلى قراءته، وكأنك تواجه تحدِّيًا جديدًا، إذ يُحدثك عن تغيّرٍ في طريقة صلاتك، مخالفٍ لما خالف الدليل، ولو كان مذهبك أو ما اعتدتَ عليه من صغرك دون وعي، بل تقليدًا. ويأتي على التقليد من جذوره، فيبدأ بنقل أقوال أئمة المذاهب المعتمَدة في موقفهم من الدليل وإن خالف مذهبهم ورأيهم، وينقل من الآثار ما يدعم فكرة الأخذ بالدليل، والوقوف عند الكتاب والسنة وإن خالف رأيَ إمام أو فتوى عالم.
وأقول جازمًا إنَّ هذا الكتاب لاقى إقبالًا وانتشارًا، وحصلت فيه البركة بشكلٍ ظاهر، وإذا كان الناس يتحدثون عن البركة في الأثر الدَّعوي – في استجابة الناس لداعية أو دخولهم في الإسلام مثلًا – فإنَّ البركة التي حصلت من هذا الكتاب قد وصلت أقطار الأرض، وشملت الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعربي والعجمي، والمثقف والعادي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا أدري إلى أي مدى سيبقى أثر هذا الكتاب، فسبحان من إذا أعطى لا حدَّ لعطائه، وإذا اختار فلا عائق لاختياره.
وقد سمعتُ مرَّةً عن دورةٍ في قلعة علمية مشهورة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني – رحمه الله تعالى – فظننتها تأكيدًا وتشجيعًا لنشر فكرة ومحتوى الكتاب، فقال لي أحدهم: بل هي في الرد على بعض ما ذهب إليه الألباني في الكتاب – وبالطبع هذا أمرٌ طبيعي، ولا غبار عليه، فكلٌّ يُؤخذ من قوله ويُردّ – ولكنْ: قامت الدورة والدورات، وما زال كتاب الألباني – رحمه الله تعالى – تُصدر منه الطبعات، ويُنافس في الكتب الأكثر مبيعًا، وأثره ينتشر، وإن خفَتَت ظاهرة التقيُّد الحرفي بما فيه، فإن التأثُّر به ما يزال يسري ويجري. وقد صدرت حوله ردود ونقاشات واعتراضات، بل حتى رسائل علمية، ويَبقى شامخًا، كما هي حال السلسلة الصحيحة والضعيفة، وتخريج أحاديث كتب السنن، وغيرها من كتب الألباني – رحمه الله تعالى – التي اعترض المعترضون على طريقته في التصحيح والتضعيف، إلا أن (صححه الألباني أو ضعفه الألباني) قد فرضت نفسها في أروقة الأبحاث، وحواشي المقالات، والدراسات الشرعية.
ولك أن تتخيّل أثر هذه الرسالة إلى اليوم، فقد تناقل الجيل عن الجيل صفة الصلاة من طلاب العلم ومعلمي الحِلَق، وكأنها حديثٌ مُسلسَل بصفة الصلاة، ومبدأُه – أو أغلبُه – من كتاب الألباني – رحمه الله تعالى.
ولكي يعرف من لم يمرّ بفترة ما قبل كتاب الألباني – رحمه الله – كيف كانت المساجد، فليذهب إلى قريةٍ نائيةٍ ما زالت على المذهب الشائع عندهم.
ولتقريب الصورة: فإنه لم يكن هناك أي اهتمام أو ذكر أو عناية بالسترة أمام المصلّي، فكان الناس يتخطَّون من أمام المصلّي دون أي حرج أو شعورٍ بالخطأ. وأما موضوع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، فكان أمرًا غريبًا، لأن الشائع والعادة أن المصلّي إذا رفع من الركوع عند قوله: “سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد”، أن يرفعهما على هيئة الدعاء، بحيث يكون بطن اليد إلى جهة الوجه، ولا يزال البعض إلى اليوم يفعلها.
وكذلك كانت جلسة الاستراحة أشدّ غرابة عند عوام الناس، وأكثر استنكارًا؛ حتى إن بعضهم قال مرةً، لما تكرّر من يقوم بجلسة الاستراحة قبل القيام إلى الثانية أو الرابعة: “كثير النسيان، لا يُصلَّى خلف الإمام، فلْيَزَمْ طرف الصف حتى لا يُشوِّش على الناس”، إذ كان يظنها نسيانًا!
وهكذا تغيّرت طريقة وضع اليدين على الصدر، والنظر إلى موضع السجود، ووضع القدمين في الصف، ورصّهما عند السجود والتصاقهما، والإسرار بالبسملة، والافتراش والتورك، وحتى طريقة التسليم من الصلاة؛ كان لها آلية خاصة تشعرك بأن قائلها قد مرَّ على الكتاب أو سمع ممن مرّ عليه.
وما تميز به كتاب الألباني – رحمه الله تعالى –:
• تحرِّي الدليل وصحته: وهذا ظاهر في كل فتاوى ومواقف الإمام الألباني – رحمه الله تعالى – غير أن هذا الكتاب، وأنت تقرأ في حواشيه أو تخريجه للأحاديث، ينقلك إلى علم الحديث، ليثبت كل جملةٍ فيه، بل كل لفظة، أو يُضعِّفها، ويبني عليها حكمًا ورأيًا بتفاصيل فنية ووقفات علمية مذهلة.
• الشمولية في الموضوع: بقدر ما يقف على تفاصيل الصلاة وهيئاتها، بقدر ما يُعطي كل هيئة وحركةٍ حقَّها من البحث، والأخذ، والردّ، والإثبات أو النفي؛ من القيام واستقبال القبلة إلى التسليم، وكل موضع يتعامل معه بكل علمية واهتمام، وكأنه ركن من أركان الصلاة، لا فرق بين موضع وآخر.
• الاعتناء بالتفاصيل: فَصَلَ المتن عن الحاشية، فالمتن أغلبه – بل كله – يذكر فيه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ويذكر الأدلة التفصيلية بطريقةٍ متدرجة؛ فمثلًا: السترة في الصلاة، بدأ بذكر فعله صلى الله عليه وسلم، ثم قوله، ثم أمثلة على تحرّيه السترة في مواضع مختلفة، وما كان يستخدمه في السترة، ثم ذكر الاحترازات، والموقف من الاعتراض بين يديه، وما يفعله المصلّي إذا أراد أحدهم أن يجتاز بين يديه، ثم ختم بذكر الوعيد لمن يمرّ بين يدي المصلي.
وهكذا – رحمه الله – أعطى للصلاة معنًى جديدًا في نفوس طلاب العلم، وأظهرها بصورةٍ وهيبةٍ ومكانةٍ كانت شبه مفقودة، وخاصةً مع غياب العلم الشرعي، وسيطرة المذاهب، وجهل الناس. فالسرعة، وعدم الاهتمام بحق الصلاة من الاطمئنان والخشوع، وإعطاء كل موضعٍ حقَّه، كانت هي السائدة. فغيَّر برسالته صورة المساجد وصورة الصلاة، وأحدث ثورةً ناعمةً في صفوف المصلين، ما زالت ثمرتها يانعةً دانية، إلى ما شاء الله.
رحم الله الإمام أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، ورفع درجته في علِّيِّين، وجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونفعنا بعلمه في الدارين.


مع احترامي للكاتب فإن انتشار كتب الألباني وتصحيحاته محصور في السلفية المعاصرة ولا أثر لذلك في مدارس أهل السنة التقليدية التى يتبعها السواد الأعظم من المسلمين
العكس هو الصحيح، فإن كتب الألباني غزت قلوب الناس قبل مكتباتهم، فلما رأى أصحاب (التعصب) المذهبي أن البساط قد انسحب من تحت أرجلهم، شنوا هجمة شرسة ضد الألباني وكتبه؛ ليحفظوا ما بقي من أتباعهم الذين لا يعلمون.
كيف بمن هجر الصلاة وانكر وجودها..؟