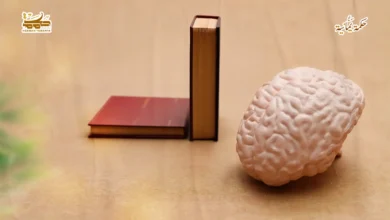على كتف جبل عرعر، حيث تتكئ السحاب على السفوح كما يتكئ الطفل على صدر أمه، تقيم قريتي الصغيرة كأنها قصيدة قصيرة، بيوتها قليلة بعدد أصابع اليدين أو أكثر قليلا، لكنها تضج بالحياة، وأصوات الضحكات، ورائحة الخبز، وخطوات العابرين من باب إلى باب.. الحجارة هناك أليفة، تعرف أسماء الناس، وتحتفظ بأصداء النداءات في المساء، هناك تنسج الروابط كما تنسج السلال من سعف النخل.
الجار ظل دائم، والأخ كتف حاضرة، والعم سند لا يميل، والخال جبل على ظهر جبل، مكان شاغر في صف الصلاة قد يشغل القرية حتى يطمئنوا على صاحبه، فالأسماء محفوظة في الذاكرة كما تحفظ آيات السور القصيرة، والوجوه تقيم في العين إقامة الضوء في الفجر.
يصل رمضان إلى القرية، كموكب عريس محبوب، تتقدمه نية صافية، وتتبعه بركة عظيمة، تتعطر أزقة القرية بندى المساء، وتخرج البيوت ما ادخرته من دفء، ويملأ الأطفال الدنيا ترحيباً بقدومه بأهازيج روحانية، وقد تكون مضحكة أحياناً ( مرحب مرحب يا رمضان … يا شهر التوبة والغفران)، ثم لا يلبثون حتى يتوعدوه إذا شعروا بقليل من الجوع ( يا رمضان سهلة للمغرب … شاتل اللقمة وشضرب)، وإذا تأخر الإفطار في البيت قال أحدهم: ( الناس تعشوا وانعموا وأنا بقي لي القرقرة).
وإلى قبيل المغرب يحمل كل بيت من بيوت القرية نصيبه من الطعام إلى الجامع، إناءً صغيراً يفيض بما فيه، وقدراً متواضعًا يتسع للجميع، وهكذا تتجاور الأطباق في ساحة الجامع، وتذوب الحدود بين صاحب القرية وضيفها.. الحلبة بخضرتها الزاهية، واللحوح ببخاره الدافئ، والشفوت ببياضه الناصع، ألوان تروي الحكاية قبل أن تذاق، ويلين الزمن في تلك اللحظات، وتخفق القلوب على إيقاع واحد.
وبعد التراويح تمتد الليالي كوشاح من سكينة، وتضج دواوين القرية بالحكايات والذكريات، فإذا انتصف الليل امتد المشهد عند دكان القرية كأنه قلب صغير يخفق في صدر الجبل، ذلك الدكان المتواضع لم يكن رفوفًا تتراصّ عليها السلع، ولا بابًا يفتح للشراء، ويغلق للانصراف؛ كان مجلسًا عامرًا، ومفترق طرق، تلتقي عنده الحكايات كما تلتقي الجدول في واد واحد.
أمام ذلك الدكان تنتصب شجرة “الخصالة”1، وارفة كأنها مظلة رحمة، باسطة ظلها على رؤوسنا، جذعها العتيق يحمل آثار أجيال مروا واستندوا إليها، وأغصانها تمتد كأذرع تضم الساهرين، كانت المقاعد البسيطة تحتها ترتب بعفوية، حجر أو صندوق خشبي وقطعة كرتون كافية، وكل واحد يجد لنفسه موضعًا تحتها، فيتحول المكان إلى لوحة من ألفة ومحبة، يتقدم أحدهم بخبر سمعه في مكان ما ومن شخص ما، فيلتف الجميع حوله كما يلتف السوار حول المعصم، وتدار الأحاديث ببطء عميق، تتخللها ضحكات صافية وتعليقات ساخرة ونقاشات تزداد حدة إذا ما حضر “سلطان” أو “ناظر2“.
أما تلك الشاشة الصغيرة المعلقة في باب الدكان، فكانت نافذتنا الواسعة نحو العالم، إطار متواضع وصورة تتخللها أحيانًا خطوط وارتعاش، غير أنها كانت تفتح أمامنا مدنًا وعوالم لا نعرفها ووجوهًا لم نلتق بها وأحداثًا تتجاوز حدود قريتنا، وحين تبدأ برامج رمضان يخفت اللغط، وتثبت العيون في اتجاه واحد، كأن القرية أجمعها تمسك بأنفاسها، الأطفال يجلسون في المقدمة والكهول يميلون قليلًا إلى الوراء، وكل مشهد يعلق عليه وكل كلمة تستعاد في الطريق إلى البيت، كانت تلك الشاشة معبرًا نعبر منه إلى العالم، وما يُعرَض فيها يتحول إلى حديث الغد، وإلى مادة للجدل، وإلى سبب لاجتماع قادم.
واليوم أقيم في إسطنبول؛ مدينة تتلألأ على صفحة البحر كأنها عقد من لؤلؤ، وترتفع مآذنها كأصابع يد مرفوعة بالدعاء إلى السماء، الطرقات عريضة والمساجد فسيحة، والوجوه تمضي مسرعة كالريح، أصلي بين عشرات تتبدل ملامحهم كل يوم كما تتبدل سحب الخريف، وتمضي بي الخطى في زحام لا ينتهي، أسمع الأذان هنا، فيرتج الأفق بجلاله، فينهض في داخلي صوت مؤذن قريتي، خاشعًا دافئًا، كأنه يخرج من قلب الجبل، تلوح لي حصائر المسجد وأطياف الرجال وابتسامات الصغار وهم يتنازعون على مكان قريب من المائدة، تمتد المدينة أمامي بسعتها، ويضيق صدري بحنين ينساب كخيط دخان من موقد قديم في تلك القرية.
تعلمت في تلك القرية أن البركة هيئة خفية تسكن القليل، وأن الجماعة جناح يحمل الروح فوق أثقالها، وتعلمت هنا أن العظمة قد تتجلى في الحجر والبحر والقباب، بينما يظل القلب يبحث عن بساط بسيط، يجمع الأحبة حول لقمة متواضعة.
يا سامع يا شرفة الضوء على كتف جبل عرعر الأسود، ما زلت محفورة في الذاكرة كأثر ماء على صخر، وفي إسطنبول أعيش بين العظمة والدهشة غير أن قلبي يقيم في تلك القرية الصغيرة، حيث كان رمضان نغمة واحدة، وحيث كانت الحياة قطعة خبز دافئة، تقسم بالتساوي بين الجميع.