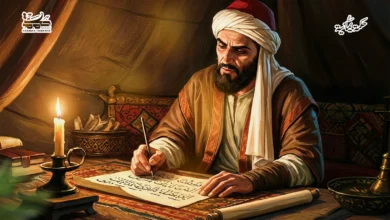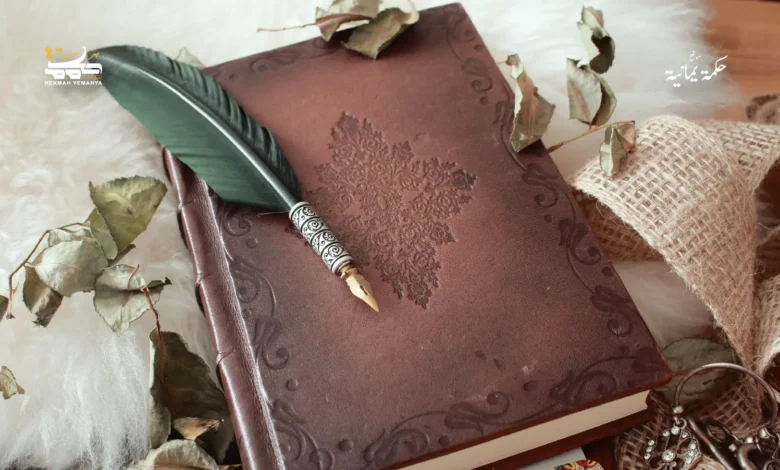
عندما ينظرُ الإنسانُ في أغلبِ الإجاباتِ الّتي يُقدّمُها لمشكلاتِ الحياةِ، فإنّه لا يجدُ أيّ نوعٍ من الإثارةِ أو الإبداعِ الفكريِّ المنتظرِ منها، بل يجدُ نفسَهُ أمامَ سيلٍ من الابتذالِ، وأفكارٍ تتمحورُ حول الصّبرِ والثّباتِ والأملِ والإخلاصِ والإيمانِ، وغيرِها من الأفكارِ التّي اعتادَ على سماعِها منذُ الطّفولةِ.
رُبّما يحظى “المبتذلُ” بنوعٍ من الاحتقارِ أو الاستصغارِ في هذا العالمِ الّذي تتضخّمُ فيه قيمةُ “الجديدِ” لا لشيءٍ إلّا لأنّه جديدٌ، وكذلك الشّأنُ بالنّسبةِ للبسيطِ مقابلَ كلِّ ما هو معقّدٌ ومركّبٌ.
إلّا أنّ هذه الأفكارَ البسيطةَ والمبتذلةَ بقيت على مدى الأزمانِ الأفكارَ الأكثرَ ثباتًا واستدعاءً أمام مشكلاتِ الحياةِ، في حين أنّ النّزعةَ نحوَ الأفكارِ الجديدةِ، والجريَ خلفَ بريقِها وألقِها، والسّعيَ الحثيثَ خلفَ المدهشِ والغامضِ والمُثيرِ، لم تزد عن كونِها حماسًا طائشًا سُرعانَ ما خفتَ ضوءُه في مواجهةِ مشكلاتِ الحياةِ.
ربّما يُعتذرُ عن هذا بما يعتادُه الإنسانُ من تلقّيه للأفكارِ المعاصرةِ في مثل هذه القوالبِ، يقولُ ابنُ تيميّةَ رحمَه اللّهُ: “كثيرٌ من النّاسِ إذا ذُكرَ له الواضحُ لم يعبأ به… وهذا الغالبُ يكونُ من معاندٍ، أو ممّن تعوّدت نفسُه أنّها لا تعلمُ إلّا ما تعنّت عليه، وفكّرت فيه، فإنّ العادةَ طبيعةٌ ثانيةٌ، فكثيرٌ ممّن تعوّدَ البحثَ والنّظرَ صارت عادةُ نفسِه كالطّبيعةِ له، لا يعرفُ ولا يقبلُ ولا يسلّمُ إلّا ما حصلَ له بعدَ بحثٍ ونظرٍ، فالطّريقةُ الطّويلةُ والمقدّماتُ الخفيّةِ الّتي يذكرُها كثيرٌ من النّظارِ تنفعُ لمثلِ هؤلاءِ. . .”
فإذا أُريدَ للإنسانِ أن يتحرّرَ من هذه السّلطةِ المقيّدةِ لتقبّلِ هذه الأفكارِ البسيطةِ والعملِ بها لإحسانِ التّعاملِ مع مُشكلاتِ الحياةِ، فلا بُدّ له من وسائلَ تُساعدُه على ذلك.
في أواخرِ القرنِ العشرينِ كتبَ “جورج لايكوف” و”مارك جونسن” كتابَهما “الاستعاراتُ الّتي نحيا بها” في إطارِ تعبيرِهم عن فكرةِ أنّ الاستعاراتِ اللّغويّةَ متجاوزةٌ للبناءِ اللّفظيِّ فهي لا تنصّبُ على الألفاظِ فقط وإنّما على التّفكيرِ أو الأنشطةِ كذلك و”أنّ الاستعارةَ حاضرةٌ في كلِّ مجالاتِ حياتِنا اليوميّةِ. إنّها ليست مقتصرةً على اللّغةِ، بل توجدُ في تفكيرِنا وفي الأعمالِ الّتي نقومُ بها أيضًا. إنَّ النّسقَ التّصوّريَّ العاديَّ الّذي يُسيّرُ تفكيرَنا وسلوكَنا له طبيعةٌ استعاريّةٌ بالأساسِ.”
“خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ” الرحمن 3-4
وفي تفسيرِ قولِه صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ:”إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا”، قالَ الخطابيُّ : البيانُ اثنانِ: أحدُهما: ما تقعُ به الإبانةُ عن المرادِ بأيِّ وجهٍ كان، والآخرُ : ما دخلته الصّنعةُ بحيثُ يروقُ للسّامعين ويستميلُ قلوبَهم، وهو الّذي يشبّهُ بالسّحرِ إذا خلبَ القلبَ وغلبَ على الّنفسِ حتّى يحولَ الشّيءُ عن حقيقتِه ويصرفَه عن جهتِه، فيلوحَ للنّاظرِ في معرضِ غيره. وهذا إذا صُرفَ إلى الحقِّ يُمدحُ ، وإذا صُرفَ إلى الباطلِ يُذمُّ.”
إنّ الفكرةَ هنا بسيطةٌ جدًّا، وهي أنَّ وسيلةَ تقبّلِ البساطةِ ليست سوى اللّغةِ والبيانِ، دون الحاجةِ إلى أدواتٍ معرفيّةٍ متقدمّةٍ، فمن جهةٍ هذه الأداةُ أي اللّغةُ مُتاحةٌ لكلِّ إنسانٍ ممّا يضمنُ نوعًا من الانتشارِ وارتفاعًا لاحتماليّةِ الفاعليّةِ، ومن جهةٍ أخرى نبتعدُ عن شُبهةِ التّناقضِ لو استُعملَت أدواتٌ متقدّمةً لأنّها تقومُ بتعقيدِ البساطةِ وإخراجِها عن حقيقتَها لتُظهرِها في صورةِ الفكرةِ المعقدّةِ والمبهرةِ.

إنّ ما تقومُ به اللّغةُ في البسيطِ – بشرطِ أن لا تنزعَ إلى شيءٍ من التقعّرِ والتكلّفِ – هو إعادةُ قوّتِه الّتي خسرِها من الابتذالِ أو تمنحُه القوّةَ في مواجهةِ سُلطةِ الغموضِ، ليعودَ البسيطُ إلى جِدّتِه الأولى دون أن تتغيّرَ حقائقُه.
فلعلّ الإنسانَ على شعورِه الأوّلِ بالابتذالِ إذا قُدمت هذه الأفكارُ البسيطةُ في لغةٍ جميلةٍ وبيانٍ عالٍ وطابعٍ بلاغيٍّ مميّزٍ، يستقبلُ هذه الأفكارَ وقد زايلَها هذا الشّعورُ، وينجحُ في الاتّصالِ بها، حيثُ مثّلَ هذا القالبُ التّعبيريُّ قوّةً مُكافئةً لشعورِ الابتذالِ وتطلّبِ الدّهشةِ، واستُعيض به.
إنّه لا وُجودَ لأسرارٍ وخفايَا اكتشفها الكُتّابُ والمفكرون عن أفكارٍ كالصّبرِ والثباتِ والإيمانِ والأملِ.. ولكن، يتميّزُ كلّ كاتبٍ بقدرةٍ تعبيريّةٍ اعتملت في شعورِ القارئِ، ونجحت في تقديمِ هذه المفاهيمِ لا بصورةٍ على خلافِ حقيقتَها، ولا بصورِ عقليّةٍ جديدةٍ، إذ ليس في البسيطِ -غالبًا- ما يُمكنُ اكتناهُه، وإنّما بصورةٍ شعوريّةٍ نفسيّةٍ كسرتْ القيودُ وحطمّت سُلطةَ المعقّدِ، وأحلّت مكانها سُلطانَ البيانِ وما يتبعهُ من الجمالِ والحلاوةِ. وأخرجت المفاهيمَ البسيطةَ عن كونِها مجرّداتٍ عقليّةٍ ذهنيّةٍ إلى أشبهَ بكائِناتٍ حيّةً، وإلى هيئةٍ أكثرَ توازنًا تجمعُ بين البُعدِ العقليِّ الذّهنيِّ والبُعدِ النّفسيِّ الشعوريِّ، وكلّما ناسبت هيئةُ الأفكارِ هيئةَ الإنسانِ كان أدعَى للامتزاجِ بها.
كثيرًا ما يستصعبُ الكاتبُ الّذي تعوّد على مستوى وطريقة معيّنة من الكتابة أن يعبّر عن أفكاره ومشاعره بغيرها، فلا يستطيع تبسيط المعلومات، ولا تقريب المفاهيم، ويُعاني في ذلك معاناة كبيرة، وكلّما ذهب في ذلك الطّريق صعب عليه الرّجوع منه.
الكتابة المركّزة تجمع في داخلها متعلّقات كثيرة من المعاني، لذلك تُكتبُ بطريقة تجعلها كاللّغز لشدّة التّركيبات والتّعقيدات، فإذا حاول الكاتبُ التّبسيط، داهمته نفسه بأنّه يخلّ بالفكرة ويقتطع جزءً مهمّا منها، وربّما يظنّ أنّه يحرّفها ويجعلها عرضةً لسوء الفهم، فيصعب عليه صياغتها في عبارات بسيطة. وهذا -أي تبسيط المعرفة دون إخلال- لبراعة كبيرة، والقدرةُ على الانتقال بين مستويات الكتابة وطرقها مهارةٌ أكبر، وليس يستطيعها كلّ النّاس.
وهذا من آيات خلق الله المتفاوت، وهذا آية من الله على كلامه، فلم يعرف النّاس كتابا كالقرآن، لا تنفد معانيه ولا تلغز.
كلّما زخرَ خاطري استعفاه قلمي من الاستغراقِ ليكتبَ، وكأنّ في خطِّه فصاحةَ الألسنِ وراحةَ النّفوسِ، وكأنّ في رصفِه للألفاظِ ونظمِه للمعاني إيناسًا لوحشةِ ذاك الخاطر، فإذا اطمئنَّ القلبُ إلى ما يكتبُ جعلَ في المكتوبِ حياةً يمدُّها بحبرٍ مدادهُ الدّمُ، وقوّةً في أعصابِ معانيه تتّصلُ أوشاجُها بالغيبِ، فالفكرةُ المؤمنةُ التي تُحييها هي الفكرةُ التي تُحييك. . .
إنّ ما يُمتعُك من كلامِ الأدباءِ والكُتّابِ، إنّما مُتعَتُهُ من صلةِ الفكرةِ فيكَ الّتي تحفُّ جوانبَ عقلِكَ وتُلامسُ أعطافَ قلبِكَ وتشغفُ بها نفسُكَ ولكن لا يُبِينَهَا لسانُك ولا تستطيعُ لنظمِ معانِيهَا بناءً بالألفَاظِ. مُتعَتُكَ بهذهِ الفكرةِ تجدُها مَبنِيّةً في أجزلِ لفظٍ ومُبِينَةً في أَحسنِ نظمٍ هي فرحةُ من وجدَ ضالّةً ينشُدُها، ووقع على رغبةِ نفسِهِ في أبهَى صُوَرِهَا، تستمتعُ نفسُهُ كأنْ وجدت قطعةً من نفسها، ولا يزيد الأدباءُ والكتّابُ بما آتاهُم اللهُ من فضلِهِ، من حُسنِ العبارةِ وتفتُّقِ القريحةِ وقُدرَةِ البَيانِ، على ربط المعاني بين النُّفُوسِ بأعصابٍ من ألفاظٍ يسري فيهَا دمٌ من معانٍ، هي بين الأديب والقارئِ كرحمٍ موصولةٍ، يصِلُهَا الأديبُ بالإبانةِ عن الفكرةِ في نفِسِه ويصِلُها القارئُ ببناءِ نفسِهِ بالفكرَةِ.