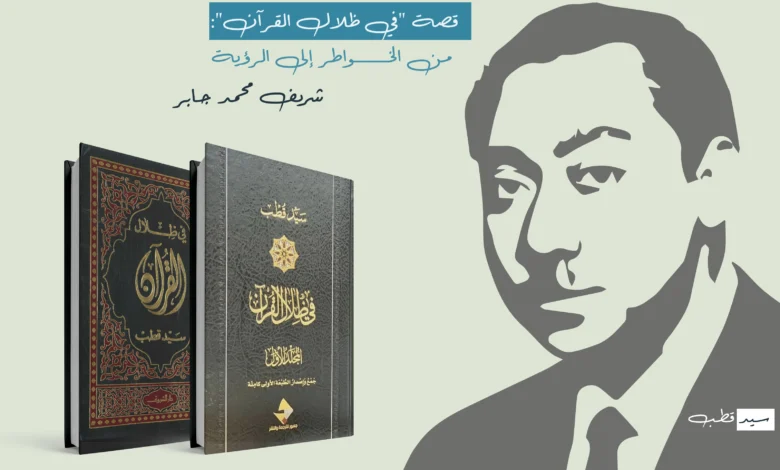
في ظلّ الجدل الدائر مؤخّرا حول إصدار كتاب “في ظلال القرآن” للأستاذ سيّد قطب بطبعته الأولى، الخالية من نحو ثُلث الكتاب، أي من المادة الثرية التي أضافها الأستاذ سيّد قطب رحمه الله في السنوات الأخيرة من حياته على نحو نصف أجزاء التفسير.. في ظلّ هذا الجدل يحسن بنا أن نعقد مقارنة يحتملها مقال، بين الطبعة الأولى للكتاب والطبعة الثالثة المنقّحة التي انتشرت ونَسختْ ما قبلها من طبعات، وصارت هي الطبعة المعتمدة منذ أواخر حياة سيّد قطب وحتى يوم النّاس هذا.
وقد خطر لي وأنا أراجع ما كُتب حول الموضوع من نقاشات، أنّه سيكون من المفيد جدّا أن تكون هذه المقارنة بين مقدّمة الطبعة الأولى للظلال ومقدّمة الطبعة الثالثة الأخيرة؛ لأنّ هذه المقارنة هي التي تبيّن قيمة ما أضافه سيّد قطب. فهناك وصمة يحاول بعضه الكتّاب إضفاءها على تلك الإضافة باعتبارها “متشدّدة” أو “منغلقة” أو “تنضح بالتكفير” وما شابه من تهم جزافية لا تعدو أن تكون نتيجة قراءة سطحية لكتاب الظلال، أو تأثّرا بالهجوم الإعلامي المستمرّ على الرجل من منابر وشخصيات مختلفة منذ أن توفّاه الله.
كما أنّ هناك فهمًا خاطئًا لـ “الحركية” التي طرحها سيّد قطب في إضافاته تلك وتنقيحاته، يجعلها شيئا يكاد يكون مرادفًا للحزبية والتعصّب للجماعة التي كان سيّد قطب يكتب في منابرها ويخالط أفرادها ومحيطها، وإنْ لم يكن له فيها أي صفة إدارية حركية، وهي جماعة “الإخوان المسلمون”. وسأحاول في هذا المقال توضيح مفهوم “الحركية” عند سيد قطب، والذي هو أبعد شيء عن التحزّب والانغلاق في جماعة وتوجيه الخطاب إلى أعضاء هذه الجماعة فحسب.
لكنّ النقطة الأهمّ التي سأحاول تجليتها في هذا المقال، هي طبيعة التغيير الذي حدث بين الطبعة الأولى والطبعة الثالثة للظلال، وهو الذي سمّيته في العنوان “من الخواطر إلى الرؤية”، فالنتيجة التي تشكّلت في ذهني بوضوح هي أنّ الذي ميّز طبعة “في ظلال القرآن” المنقّحة والمزيدة هو احتواؤها على رؤية فكرية وحركية متماسكة وشبه متكاملة، لها محاور واضحة سوف أتطرّق إليها خلال استعراض مقدّمة تلك الطبعة، بينما كانت الطبعة الأولى أقرب إلى ما وصفها به سيّد قطب في مقدّمتها من كونها “خواطر” حول الآيات، تُزاوج بين الأبعاد الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والإنسانية وبين المجال الأدبي الفنّي الذي أتقنه سيّد أيّما إتقان، وبرع به أيّما براعة، والذي كان مدخله إلى التلبّس بتفسير القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة النّاس، فكان ما كتبه في هذا الباب من أعظم فتوح التفسير في القرن العشرين.
ولكن قبل استعراض المقدّمتين والمقارنة بين مضامينهما وما تعبّران عنه، إلى جانب عرض نموذج من الإضافات، وهو ما أضافه سيد قطب على سورة الفاتحة في الطبعة المنقّحة؛ أحبّ أن أقدّم قراءة نقدية لما فعله عصام تليمة في إخراجه لكتاب “في ظلال القرآن” عن دار جسور عام 2022 مقتصرًا على نصّ الطبعة الأولى (حتى عام 1959) التي لا تحتوي تلك الإضافات التي عبّر فيها سيّد قطب عن رؤيته التي استقرّ عليها ونافح من أجل إيصالها للناس حتى الرمق الأخير من حياته رحمه الله.
(1)

أول ما يقال عن فعل تليمة هذا إنّه مريب من الناحية العلمية المحضة، فعندما يحقق المحققون اليوم الكتب التراثية، ومنها كتب التفسير، يحاولون الوصول إلى النسخة الأخيرة التي ارتضاها المؤلّف ويقدّمونها بالطبع على ما سبقها من نسخ، بصرف النظر عن طبيعة أفكاره التي أضافها (ودون تجاهل باب دراسة تطوّر الأفكار).
إنّ المنزعج من أفكار سيد قطب التي انتهى إليها – وهي ما يعتبره سيّد نفسه زيادة وعي – له أن يُبدي انزعاجه ونقده لأفكاره، لكن عند عرض سيد قطب وآثاره ينبغي أيضا عرضها كما هي، وبالصورة التي أرادها هو في تعديلاته وتنقيحاته الأخيرة.
كنت منذ زمن بعيد، في بدايات أيام الدراسة الجامعية، مولعًا بتتبّع آثار الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وكانت مكتبة الجامعة توفّر عددا كبيرا منها، وكان من بينها نسخة قديمة من “في ظلال القرآن”، أي أنّ هذه النسخة متوفّرة في بعض المكتبات العامّة، بل ولعلّ بعضهم قد رفعها على الشبكة كما أذكر، أي أنّ مادة الطبعة الأولى متوفّرة للباحثين عن تطوّر الأفكار، لكنّ فِعل إعادة صفّ النصّ القديم وإصداره بطبعة تسمّى “جديدة” وهي لا تأخذ بعين الاعتبار آخر تعديلات المؤلّف؛ هو فعلٌ غير علمي، ويحمل في ثناياه أبعادًا أيديولوجية تتعلّق بنظرة المشرف على المشروع إلى الدين، التي من الواضح أنّها مخالفة إلى حدّ بعيد لِما انتهى إليه سيد قطب رحمه الله. أو أنه يريد إظهار سيّد قطب بصورة يرتضيها هو له، مع أنّنا لا يمكننا أن نخالف التاريخ، وعلينا أن نعرض فكر الرجل بأمانة، سواء اتفقنا معه أم لم نتفق.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي على القراء أن يعرفوا ما الذي أضافه سيد قطب وأين ولماذا؟ ولِمَ تحمّس عصام تليمة إلى إصدار “في ظلال القرآن” قبل تلك الإضافات؟
بحسب كتاب “مدخل إلى ظلال القرآن” للدكتور صلاح الخالدي رحمه الله، وهو جزء من رسالته للدكتوراة، فقد كتب سيد قطب الظلال في ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى:
مقالات في مجلة “المسلمون” بدأها في شهر شباط 1952، ووصل فيها حتى الآية 103 من سورة البقرة. ثم أعلن عن توقف الحلقات لأنّها سينشرها في كتاب مستقبلي في دار إحياء الكتب العربية.
المرحلة الثانية:
وهي قبيل اعتقاله، وقد ظهر الجزء الأول من الظلال في تشرين الأول 1952، وبين تشرين الأول 1952 وكانون الثاني 1954 أصدر 16 جزءًا من الظلال.
المرحلة الثالثة:
إكماله للظلال في السجن، فقد سجن للمرة الأولى في 1954 لثلاثة أشهر وأصدر فيها الجزئين السابع عشر والثامن عشر. ولم يلبث طويلا خارج السجن حتى أعيد إليه بعد حادث المنشية. لم يكتب في الفترة الأولى شيئا من الظلال. ولم يكمله حتى هدأ التعذيب وحُكم عليه 15 عشر عامًا واستقرّ في سجن “ليمان طرة”. وكان الشيخ محمد الغزالي في تلك المرحلة رقيبًا دينيّا يُعرَض عليه الظلال قبل طبعه، ولم يحذف منه إلا تعقيب سيد قطب على تفسير سورة البروج، حيث أشار فيه إلى التعذيب الذي لقيه هو وصحبه في السجن (نُشر لاحقا تحت عنوان “هذا هو الطريق” مع تغييرات طفيفة في العبارة في كتاب “معالم في الطريق”).
في هذه المرحلة تعمّقت تجربة سيد قطب الدينية والروحانية، كما يذكر الدكتور الخالدي، وقد ذكر ذلك في رسائل أرسلها لبعض أصدقائه، تحدث فيها عن كونه يجد نفسه خيرا من أي وقت مضى في عقيدته وإيمانه، ووضوح العقيدة والإيمان في قلبه، ووضوح إدراكه وتصوره لهذا الأمر ومقتضياته، ووضوح الهدف والوسيلة والطريق والغاية. وقال إنه وجد الله كما لم يجده من قبل، وعرف منهجه وطريقه كما لم يعرفه من قبل قط. ولا شكّ أنّ هذا قد أضاف إليه الكثير في كتابة الظلال، بل قال عنه شريكه في زنزانته مصطفى العالم في مقال له: “فها هو يجوب الزنزانة كل يوم، يذرعها قارئًا لسورة من كتاب الله بصوت عذب رخيم، ومعه قلمه يدوّن به كل ما يخطر له من خواطر وأفكار على هامش المصحف، وهو فرح مسرور بما يجول في خاطره من معانٍ جديدة لم تكن تلامس ذهنه قبل أن يدخل السجن ويأنس فيه بكتاب الله”.
وفي ظلّ ذلك تحوّل القرآن – كما يُبيّن الخالدي – عند سيّد قطب من معان مدركة إلى حقائق متذوّقة معاشة، وقد ذكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى من سورة فاطر: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} (فاطر: 2)، وهو مما كتبه في تلك المرحلة، حيث قال: “يسّر الله لي أن أطّلع على حقيقتها، وأن تسكب حقيقتها في روحي، كأنّما هي رحيق أرشفه وأحسّ سريانه ودبيبه في كياني، حقيقة أذوقها لا معنى أدركه. فكانت رحمة بذاتها تقدّم نفسها لي تفسيرا واقعيّا لحقيقة الآية التي تفتّحت لي تفتّحها هذا. وقد قرأتها من قبل كثيرا، ومررت بها من قبل كثيرا، ولكنها اللحظةَ تسكب رحيقها، وتحقّق معناها، وتنزل بحقيقتها المجرّدة وتقول: هآنذا.. نموذج من رحمة الله حين يفتحها، فانظر كيف تكون…”.
كما ذكر شيئا من هذه المعاني في مقدمّة الطبعة المنقّحة من الظلال فقال: “الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكّيه.. والحمد لله.. لقد منَّ عليّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقتُ فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي. ذقتُ فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه…”.
وفي ضوء ذلك كلّه لم يعد الظلال “تسجيلا لخواطر متنوّعة حول الآيات، وبيانًا لما فيها من جمالٍ وفنٍّ وتصويرٍ، وعرضًا لما تضمّنته من مبادئ ومناهج وتشريعات” كما يقول الدكتور صلاح الخالدي، فبعدما طالت حياته في ظلال القرآن، وتعمّقت تجربته العملية وفّقه الله إلى إدراك طبيعة هذا الدين الواقعية الجدّية والحركية. وقد فسّر الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الظلال وفق منهجه الحركي الجديد، ثم قرّر إعادة النظر في تفسير الأجزاء الأولى لإعادة تنقيح الظلال على أساس هذا المنهج، فكانت الطبعة الثالثة المنقّحة.
وما ميّز هذه الطبعة – بحسب الدكتور الخالدي – كان وقوفه الطويل عند الآيات، وتسجيل كل خواطره حولها، وتعرّضه للحديث عما توحي به من قضايا في العقيدة والحركة، أو الفقه والتشريع، أو السياسة والاقتصاد، أو التاريخ والاجتماع، أو غير ذلك. وكانت أطول وقفاته وأعمقها وأنضجها، تلك التي تتعلق بالعقيدة والحركة، والألوهية والعبودية، والحاكمية والتشريع.
ويذكر الدكتور الخالدي أيضا أنّ الجزء السابع كان أكثر الأجزاء تركيزا وأنضجها فكرا، حيث توسع في الحديث عن العقيدة ومباحثها، في مقدّمته المطوّلة لسورة الأنعام، وأثناء تفسيرها.
والآن، تخيّلوا أن يأتي رجل عام 2022 يريد تجاوز هذه التجربة الثرية كلها، وإعادة طبع “في ظلال القرآن” وترويجه بطبعته الأولى التي خلتْ من كل ذلك! هل يرضى مؤلّف أن يُفعل هذا بكتبه؟ وهل يعبّر تليمة بهذا الفعل عن تقديره فعلا لفكر الأستاذ سيد واحترام حقّه في التعبير عن رأيه؟ وما المشكلة في أن يبقى الظلال في نسخته المنقّحة الأخيرة، فتكون الخواطر القديمة بجوار الخواطر الجديدة؟
لهذا كله أقول إنّ فعل تليمة لا يخلو من أدلجة، فهو يحبّ سيد قطب ولكنه – كما يبدو – يريد ظلالًا بغير هذا المنهج “الحركي” الذي يركّز على مسائل الحاكمية والولاء وارتباط العقيدة بالشريعة وجاهلية الحضارة المعاصرة كما اتّضح في تجربة سيد قطب الناضجة بعد طول معايشته للقرآن وخوضه للتجارب وزيادة عقله وحكمته.
أما الحديث عن سوء حالته النفسية بسبب التعذيب، فكلّ من قرأ سيد قطب مع قراءة تطوّره الفكري وتجربته الحياتية وكيف كان يكتب يُدرك أنّ الرجل حافظ على اتّزانه حتى آخر لحظة في حياته (انظر مثلا كتاب “مقومات التصور الإسلامي” وهو آخر ما كتب سيد قطب)، بل صارت كتاباته أعمق وأبعد عن الانفعالية التي تميّزت بها مقالاته القديمة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.

(2)
وثمّة جانب آخر ينبغي توضيحه قبل الشُّروع في تناول المقدّمتين والمقارنة بينهما مع تناول نموذج من الإضافات على تفسير سورة الفاتحة، وهو أنّه لا يمكن قراءة ما فعله عصام تليمة بإعادة إصدار الطبعة الأولى من “الظلال”، الخالية من إضافات الأستاذ سيد قطب الثريّة في الطبعة التي اعتمدها في السنوات الأخيرة من حياته، من غير فهم دوافعه ومنطلقاته الفكرية، التي لم يستطع إلا أن يكشف عنها من خلال إصداره لتلك الطبعة، وأول ذلك قوله على الغلاف الداخلي للطبعة: “وهي تقلّ بمقدار الثُّلُث عن الطبعة الأخيرة المشهورة لتفسير الظلال، التي أضاف إليها بعد ذلك مجموعة من الأفكار ثار حولها الجدل”.
وضعْ خطّا أحمر تحت “ثار حولها الجدل”، فكأنّه يصرّح أنّ غاية إخراج هذه الطبعة الناقصة هو استبعاد “الجدلي”، وليست غاية بحثية تتعلّق بدراسة تطوّر الأفكار، فلو كانت كذلك لأرفقها بالمقارنات في جميع مواضع الزيادة، ولكنّه قصر عن ذلك وكان همّه إخراج الطبعة الناقصة، فلا حقّق الغاية البحثية المزعومة، ولا أبقى على نصوص أضافها سيّد في حياته وطُبعت وخرجتْ للناس وتفاعلوا معها.
ومن ذلك أيضا قول تليمة في مقدّمة طبعة دار جسور إنّ أفكار سيّد التي وضعها فيما بعد “دخيلة” على التفسير، وإنّه كان يتوسّع ويطيل فيها النَّفَس بشكل لا يتطلّبه شرح الآيات!
وهذا من أعجب العجب، ففضلا عن كونها أقرب للتفسير من الخواطر السابقة، فمن الذي يحدّد “الدخيل” وغير الدخيل؟ لدينا تفاسير أثرية وأخرى لغوية وثالثة صوفية إشارية ورابعة فقهية وخامسة كلامية وسادسة تجمع كل ذلك وأكثر، وجميعها من ضمن “التفسير” لكونها تعليقًا على عموم النصّ القرآني من الفاتحة حتى النّاس، بل إنّ تفسير الظلال مثلا أقرب لمعنى “الفَسْر” الذي يتضمّن الكشف والإبانة عن معاني الآيات ودلالاتها الواقعية من التفسير الصوفي الإشاري، أو حتى اللغوي الذي يقتصر على بيان معاني المفردات، بل والأثري الذي يقتصر على سرد الروايات الواردة في الآيات أو معانيها دون شرحها وبيان ارتباطها ببعضها بعضًا وغاياتها ومقتضياتها الواقعية.
وهذا يؤكّد أنّ تليمة لديه موقف أيديولوجي منزعج من تلك الإضافات لما فيها مما يخالف فكره، فمن هو ذلك الباحث المتجرّد الذي ينزعج من توسّع الكاتب الأصلي؟! ومن الذي يقرر ما تتطلّبه الآيات نيابة عن الكاتب الأصلي؟! مثل هذه التحكّمات تكشف لك عن دوافع مُخرج الطبعة. وحين نتناول نموذجًا من إضافات سيد قطب على سورة الفاتحة في الطبعة المنقّحة سندرك جيّدا كيف أنّها كانت في صلب التفسير، وأنّه توسّع إيجابي لا يتضرّر منه عاقل، بل يفرح به ويفتح له عقله وقلبه.
ومن ذلك أيضًا استعمال تليمة لعبارة “الطبعة الأصلية الأولى” في مقدّمته لطبعته! وكأنّ الطبعة الثالثة التي خرجت في حياة سيّد وتحت إشرافه وبرغبته ليست أصلية! والعبارة توحي بأنّ ثمّة “أصليّ” وثمّة “دخيل”، وأنّ تليمة يريد “العودة إلى الأصل” قبل “الانحراف”.. فهي عبارة تكشف عن وجهة نظر غير علمية، بل موقف أيديولوجي شعوري من تليمة تجاه الطبعة الموسّعة بإضافاتها التي بلغتْ الثُّلث على حدّ تعبيره.
وأخيرا، ثمّة بعد أخلاقي عميق يتعلّق بهذا الحذف المتعمّد لحجم كبير من نصوص سيد قطب في أحد كتبه، لا يكاد يدركه إلا من قرأ سيرة الرجل وعاش مع كتبه وعرف أخبارها، وهو أنّ الرجل حُبسَ دهرًا وأُعدم مظلومًا كما أُعدم العديد من كتبه، بل لم تُتَح له الفرصة لإتمام بعض الأبحاث التي صرّح بها في هوامش كتبه.
وقد كنت أمرّ على تلك الهوامش قبل نحو 15 عامًا أثناء مطالعاتي الطويلة لكتب الرجل، فأشعر بالحسرة كيف يُقطف هذا النَّفَس النفيس وهذا الزخم الفكري الأدبي الحسّاس.. كيف لا يُمهل ليقول ما يريد ويتحفنا بنظراته العميقة وقلمه النديّ الأريب!
ومن بين تلك الأبحاث (التي أنقل أسماءها من الذاكرة) بحث بعنوان “في ظلال السيرة”، وبحث آخر كبير بعنوان “نحو مجتمع إسلامي” (غير المطبوع حاليا، فهو تجميع لمقالات نُشرت بنفس العنوان)، وبحث بعنوان “تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصر”، وبحث بعنوان “أمريكا التي رأيت” (غير المطبوع حاليا، والذي جمعه الدكتور صلاح الخالدي رحمه الله مما تبقى من مقالات نشرها سيد من هذا البحث، الذي أعدمه كما يبدو أحد الذين خُبّئ عندهم خوفًا من البطش)، والفصلان الأخيران من كتاب “مقومات التصور الإسلامي” الذي نُشر بعد وفاة سيّد بعشرين عامًا! فقد كان أخوه الأستاذ محمد قطب رحمه الله يأمل بالعثور على كامل هذين الفصلين عند أحد المقرّبين، لكنّه لم يعثر عليهما فنُشر الكتاب مع رؤوس أقلام لكل فصل تركها سيد في أواخر حياته. وغيرها من الأبحاث التي لم ترَ النّور، إمّا لأنّ السلطات المصرية قد أعدمتها أو أخفتْها، أو لأنّها ضاعتْ، أو لأنّ الرجل لم يُمهَل ليكتبها أو يتمّها أو يتمّ إضافاته عليها كما حدث مع الظلال، والحمد لله على ما قدّر وقضى.
تصوّروا أنّ رجلا هذا حاله، يتتبّع الباحثون أخباره النادرة ونصوصه النفيسة، ويدركون أهمية كل كلمة قالها كما يفعلون مع غيره من الشخصيات المؤثّرة في التاريخ الإسلامي، يأتي أحدهم ليقول: أريد نشر طبعة أحذف منها قدر ثُلث الكتاب، وهو ما أضافه الكاتب في سنوات حياته الأخيرة، لأنّها إضافة مثيرة للجدل، أو لأنّي أريد خدمة الباحثين.. أو لأي سبب من الأسباب!
ولو أنه أبقى على جميع النصوص في المتن، وأخرج طبعة كطبعة دار الشروق ولكنْ أشار فيها إلى تلك الزيادات وحدّدها؛ لخدمَ الباحثين خدمة أكبر، ولحقّق غايته المزعومة بما لا يُقارَن مع ما فعله من نشر الكتاب ناقصًا بتلك الطبعة التي لا تخلو من التباسها بالغايات الأيديولوجية والمساهمة في إعدام نصوص سيّد قطب.
إنّ انتشار مثل هذه الطبعة التجارية غير المحدودة تحت اسم “في ظلال القرآن” وتحت وصف “الطبعة الأصلية الأولى” مهما أضيف من توضيحات سيساهم مستقبلا في بلوغ الظلال بهذه الصورة الناقصة إلى شرائح من القرّاء، الذين قد يلتبس عليهم الأمر ويظنّون أنّهم قرأوا الظلال، مع أنّهم لم يقرأوا الكثير مما أراد الرجل أن يقوله.
لهذا كلّه فهي طبعة مشبوهة: علميّا: لأنّها لا تتماشى مع المعايير العلمية ولا تحقق الأهداف البحثية المزعومة، وفكريا: لأنّ المحقق أقحم آراءه ومنطلقاته الفكرية والأيديوجية في هذا العمل، فلم يكن عملا بحثيا خالصًا كما رأينا، وأخلاقيا: لأنّها تساهم في مسيرة إعدام نصوص الرجل وكتمها، مع أنّ الرجل في حالة فكرية تستدعي المساهمة في إنقاذ كلّ ما كتبه وعرضه على النّاس ليقرّروا بأنفسهم قيمة ما كتب.

بين المقدّمة الأولى للظلال والمقدّمة الثانية
والآن، فلنشرع في عقد مقارنة بين مقدّمَتَي الطبعتين، فأمّا مقدّمة الطبعة الأولى فقد اعتمدتُ في نقلها على نسخة مصوّرة من الطبعة الثانية الصادرة عن “دار إحياء الكتب العربية” لعيسى البابي الحلبي وشركاه، وهي تحتوي على نصّ الطبعة الأولى المكتوب عام 1372 هـ – 1953 م كما ذُكر في نهاية المقدّمة، وكما أشار سيّد قطب بنفسه في الهامش، فقد قال عنها: “مقدمة الطبعة الأولى. ولم أجد ما يدعو إلى زيادة شيء عليها”. ويمكن للقارئ العثور عليها بسهولة شديدة عبر الشبكة، من خلال كتابة عبارة “المجموعات العربية على الإنترنت” في جوجل، ليلج في النتائج الأولى إلى موقع يضمّ الكثير من الكتب العربية القديمة المصوّرة مع محرّك للبحث، وليكتب في محرّك البحث: “في ظلال القرآن”، فسيعثر بإذن الله على نسخة قابلة للتحميل.
وأمّا مقدّمة الطبعة الثالثة المنقّحة، فقد اعتمدتُ فيها على نسخة مصوّرة لطبعة دار الشروق الشرعية الأولى الصادرة عام 1972، وهي الطبعة الثانية والثلاثون منها الصادرة عام 1423 هـ – 2003 م.
وأول فارق ظاهر بين المقدّمتين هو الفارق الكمّي؛ فمقدّمة الطبعة الأولى لا تتجاوز صفحتين ونصف، مع خطّ كبير، بينما يبلغ حجم مقدّمة الطبعة الثالثة المنقّحة نحو سبع صفحات ونصف بخطّ صغير. أمّا على مستوى المضمون، فهو فارق كبير أيضًا، بين مقدّمة لكتاب في “خواطر” روحية واجتماعية وإنسانية وأدبية حول الآيات، وبين “رؤية” متكاملة حول الدين والحياة والواقع والأفكار والمفاهيم.
المقدّمة الأولى للظلال: الخواطر المتناثرة
تبدأ مقدّمة الطبعة الأولى للظلال بهذه الكلمات:
“عنوان لم أتكلّفه، فهو حقيقة عشتُها في الحياة.. فبين الحين والحين كنت أجد في نفسي رغبة خفية في أن أعيش في ظلّ القرآن فترة، أستروح فيها ما لا أستروحه في ظلّ سواه. فترة تصلني بالسماء، وتفتح لي فيها نوافذ مضيئة وكوًى مشعّة؛ وهي في الوقت ذاته تثبِّت قدميّ في الأرض، وتشعرني أنني أقف على أرض صلبة، لا تدنّسها الأوحال، ولا تزلّ فيها الأقدام”.
ويحسن بنا أولا أن نلخّص مضامين المقدّمة الأولى، وأوّل انطباع يأخذه القارئ لهذه المقدّمة هو خلوّها من القضية الكبرى، فهي لا تعدو أن تكون خواطر أديب مفكّر يستعرض تأمّلاته الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية والأدبية حول الآيات، فقد ذكر سيّد قطب في بدايتها أنّه كان يعيش في ظلّ القرآن فترة بين الحين والحين، يستروح فيها ما لا يستروحه في ظلّ سواه، وتفتح له فيها نوافذ مضيئة وكوًى مشعّة، وتثبّت قدميه في الأرض. وكانت تعنّ له في تلك الجولات خواطر متناثرة في العقيدة والنفس والحياة والناس، ولكنّه كان يكتفي بأنْ يعيشها دون أن يسجّلها.
ثم إنّه بدأ بتسجيلها لاحقا في سلسلة مقالات تحت عنوان “في ظلال القرآن” في مجلّة “المسلمون”، ثم تطوّرت الفكرة إلى أن يكتب خواطره حول جميع آيات القرآن، ليسجّل كل ما يخالج نفسه وهو يستروح ذلك الجوّ العلويّ الطليق.
ويذكر سيّد في المقدّمة أنّ القرّاء قد يختلفون في توصيف هذه “الظلال”: فمنهم من يراها تفسيرا للقرآن، ومنهم من يراها عرضًا للمبادئ العامة للإسلام كما جاء بها القرآن، ومنهم من يراها محاولة لشرح ذلك الدستور الإلهي في الحياة والمجتمع، وبيان الحكمة فيه. ويقول إنّه لم يتعمّد شيئا من ذلك، ولم يجاوز أن يسجّل خواطره وهو يحيا في تلك الظلال. وإنّه لا يريد أن يغرق في بحوث لغوية أو كلامية أو فقهية تحجب القرآن عن روحه، وقد اقتصر على ما يوحيه النصّ القرآني ذاته من خواطر روحية أو اجتماعية أو إنسانية.
وإلى جانب ذلك ضمّن ظلاله ما خالج نفسَه من إحساس بالجمال الفنّي العجيب في القرآن، وشعور بالتناسق في التعبير والتصوير. وهو في ذلك يتابع مشروعه في كتاب “التصوير الفنّي في القرآن”، الذي كانت فكرته الرئيسية أنّ التصوير هو القاعدة الواضحة في التعبير القرآني الجميل، وقد أدار ذلك الكتاب كلّه على هذا المحور لشرح هذه القاعدة والتمثيل لها من القرآن.
هذا هو كل شيء من حيث المضمون، فالظلال في طبعته الأولى هو تلك الخواطر الروحية والاجتماعية والإنسانية وغيرها، إلى جانب تسليط الضوء على الأبعاد الجمالية الفنّية من خلال نظرية التصوير الفنّي وما يدور حولها.
وليس في ذلك كلّه ما يغمط من قيمة الكتاب بصورته تلك، بل كان بهذه الصورة إضافة غنية إلى حقل الدراسات القرآنية المعاصرة، مهما بدا من “تواضع” مقدّمة الأستاذ سيد. ولكنّ قَدَر الله كان يخبّئ لهذا الظلال “نقلة بعيدة” بتعبير الأستاذ سيد، نقلة بعيدة نحو الإدراك العميق لقضية المسلم في هذه الحياة، ورؤيته لأحوال العالم المعاصر ودَوْر الأمّة المسلمة المغيّب.
المقدّمة الثانية للظلال: الرؤية والمضامين والنقلة البعيدة
إنّنا حين ننتقل بعد قراءة المقدّمة الأولى للظلال إلى قراءة المقدّمة الثانية، ندرك منذ اللحظة الأولى أنّنا دخلنا إلى أجواء مختلفة، وإلى تسابيح عالية رفيعة، وإلى فيض شعوري هائل يجتاحنا في فقراتها الأولى:
“الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا مَن ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكّيه.
والحمد لله.. لقد مَنَّ عليّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقتُ فيها من نعمته ما لم أذقْ قط في حياتي. ذقتُ فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.
لقد عشتُ أسمع الله – سبحانه – يتحدّث إليّ بهذا القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أيّ رفعةٍ للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضّل به على الإنسان خالقه الكريم؟”.
وإذا ما قارنّا هذه الفقرات بما تبتدئ به مقدّمة الطبعة الأولى، ندرك تمامًا الفارق الكبير في عمق التجربة الروحية بين العهدين؛ بين عهدٍ كان سيّد قطب فيه حرّا طليقًا، حديث عهدٍ بالتوجّه الإسلامي، لم يدخل السجن بعد، وعهدٍ تعمّقت فيه تجربته الروحية والفكرية بخوض معركة ضدّ هذه الجاهلية الضاربة أطنابها في العالَم، والاستناد في هذه المعركة كلّها إلى هداية القرآن، وبركة القرآن، ورفعة القرآن.
ولعل أكثر من يمكنه التعبير عن هذا التغيير هو سيّد قطب نفسه، كما ذكر في كتابه “خصائص التصوّر الإسلامي”، فقد قال رحمه الله:
“ولكنّ الناس بعدوا عن القرآن، وعن أسلوبه الخاص، وعن الحياة في ظلاله، وعن ملابسة الأحداث والمقوّمات التي يشابه جوُّها الجوّ الذي تنزّل فيه القرآن.. وملابسةُ هذه الأحداث والمقوّمات، وتَنَسُّمُ جوّها الواقعي، هو وحده الذي يجعل هذا القرآن مدرَكًا وموحيًا كذلك. فالقرآن لا يدركه حقّ إدراكه مَن يعيش خالي البال من مكابدة الجهد والجهاد لاستئناف حياة إسلامية حقيقية، ومن معاناة هذا الأمر العسير الشاقّ، وجرائره وتضحياته وآلامه، ومعاناة المشاعر المختلفة التي تصاحب تلك المكابدة في عالم الواقع، في مواجهة الجاهلية في أيّ زمان!
إنّ المسألة – في إدراك مدلولات هذا القرآن وإيحاءاته – ليست هي فهم ألفاظه وعباراته، ليست هي “تفسير” القرآن – كما اعتدنا أن نقول! المسألة ليست هذه. إنّما هي استعداد النّفس برصيد من المشاعر والمدرَكات والتجارب، تشابه المشاعر والمدرَكات والتجارب التي صاحبتْ نزولَه، وصاحبتْ حياة الجماعة المسلمة وهي تتلقّاه في خضمّ المعترك.. معترك الجهاد.. جهاد النفس وجهاد الناس. جهاد الشهوات وجهاد الأعداء. والبذل والتضحية. والخوف والرجاء. والضعف والقوة. والعثرة والنهوض.. جوّ مكة، والدعوة الناشئة، والقلّة والضعف، والغربة بين النّاس.. جوّ الشّعب والحصار، والجوع والخوف، والاضطهاد والمطاردة، والانقطاع إلا عن الله.. ثم جوّ المدينة: جوّ النشأة الأولى للمجتمع المسلم، بين الكيد والنفاق، والتنظيم والكفاح.. جوّ “بدر” و”أحد” و”الخندق” و”الحُديبية”. وجوّ “الفتح”، و”حُنين” و”تبوك”.. وجوّ نشأة الأمّة المسلمة ونشأة نظامها الاجتماعي والاحتكاك الحيّ بين المشاعر والمصالح والمبادئ في ثنايا النشأة وفي خلال التنظيم.
في هذا الجوّ الذي تنزّلت فيه آيات القرآن حيّة نابضة واقعية.. كان للكلمات وللعبارات دلالاتها وإيحاءاتها.. وفي مثل هذا الجوّ الذي يصاحب محاولة استئناف الحياة الإسلامية من جديد يفتح القرآن كنوزه للقلوب، ويمنح أسراره، ويُشيع عطرَه، ويكون فيه هُدى ونور”.
ومن يقرأ مقدّمة الظلال في طبعته الثالثة المزيدة المنقّحة، يدرك تماما أن سيّد قد مضى شوطًا طويلا في هذا الجوّ الذي تحدّث عنه، فصارت الخواطر التي تهطل على عقله وقلبه في أثناء هذه التجربة الإيمانية العميقة، التي كلّفته حريّته وحياته في نهاية المطاف؛ أعمقَ وأبلغ أثرًا، وصار أقدرَ على فهم القرآن ومدلولاته في الواقع الذي يعيشه.
ولا أزعم أنّ سيّد قطب كان خلوًا من هذه المشاعر والتجارب والمدرَكات ومن الرغبة باستئناف الحياة الإسلامية حين شرع في كتابة الظلال أول مرة، أو حين أتمّ طبعته الأولى، بل كان الرجل كما يبدو من خلال تتبّع سيرته قد مرّ بمنحنى روحيّ جعله يقترب من الدين ومن القرآن على وجه الخصوص، ولكنْ لا شكّ أنّ تجربته قد تعمّقت فيما بعد، حين أدرك حقيقة هذه الجاهلية وأدواتها، وجذرية الانحراف الذي أحدثته في الحياة البشرية عمومًا وفي حياة المسلمين على وجه الخصوص، والمدلولات الواقعية المختلفة لإقامة هذا الدين في الأرض.
فلم تعد المسألة مجرّد معركة بين الإسلام والرأسمالية، ولا عرْضًا للعدالة الاجتماعية في الإسلام، ولا بيانًا للسلام العالمي الذي يُشيعه هذا الدين ويسعى إليه.. كما تشير عناوين كتبه التي سطرها في بدايات توجّهه الإسلامي. بل صارت إلى جانب هذا كلّه “نقلة بعيدة” تتمثّل في الفارق الهائل بين التصوّر الإسلامي لله والكون والإنسان والحياة وبين التصوّرات الجاهلية المهيمنة على العالم اليوم، والفارق الهائل بين المجتمع المسلم والواقع الإسلامي المنشود وبين المجتمع الجاهلي والواقع الجاهلي الذي يهيمن على العالم اليوم. فباتت “جنسية المسلم عقيدته” مقابل الاجتماع على الوطنيات والقوميات التي جاءت مع هذه الجاهلية، وصار تحكيم الشريعة هو المدلول الأول والمباشر للشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد ارتبط هذا المدلول في حسّه ارتباطًا واضحًا بالعقيدة، فقبول الشريعة ليس مسألة اختيارية ولا قضية أفضلية، بل يعني بشكل واضح ومحدّد: إمّا إسلام أو لا إسلام!
في الواقع، تمثّل مقدّمة الظلال بطبعته المنقّحة والمزيدة مفتاحا لفهم رؤية سيّد قطب التي انتهى إليها وقُبض وهو عليها. وتراه يبدأ الكثير من الفقرات بقوله: “وعشتُ في ظلال القرآن”، ثم يتناول محورا من محاور رؤيته تلك، وتلفّ جميعَ هذه المحاور قاعدةٌ عميقةٌ من التوجّه الروحي الخالص، والفيض الشعوري الزاخر، الذي يشير إلى الحالة النفسية العالية التي كان الرجل يعيشها، والتي ستظهر بوضوح فيما أضافه على تفسيره لسورة الفاتحة.

ففي بداية المقدّمة يحكي أنّه عاش في ظلال القرآن وهو ينظر من عُلوّ إلى الجاهلية التي تموج في الأرض، وكيف اغترّ الناس بهذه الجاهلية وارتكسوا في الحمأة الوبيئة، وأعرضوا عن نداء الوحي العلوي الجليل، الذي يرفع العمر ويباركه ويزكّيه.
ثم تحدّث عن تَملّيه للتصوّر الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود ولغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني، ويقيس إليه تصوّرات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية.
ثم أشار إلى التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله وحركة الكون الذي أبدعه الله. وهي الرؤية التي عرضها في فصل “شريعة كونية” في كتابه “معالم في الطريق”، وبعضُ فصول هذا الكتاب مستلٌّ من الظلال.
ثم تحدّث عن سَعة حجم الوجود في حسّه، وأنّه أكبر من ظاهره المشهود، بل هو ممتد في الغيب والشهادة والدنيا والآخرة، وعن امتداد النشأة الإنسانية في شعاب هذا المدى المتطاول.
وتحدّث عن رؤيته للإنسان، وكيف أنّه في ظلال القرآن أكرم من كل تقدير عرفته البشرية مِن قبلُ للإنسان ومِن بعدُ، وكيف أنّ الآصرة التي ينبغي أن يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدّة من النفخة الإلهية الكريمة، وهي آصرة العقيدة في الله، فهي وطن المؤمن وقومه وأهله، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج! والمؤمن ذو نسب عريق ممتدٍّ في شعاب الزمان من قديم، وهو امتداد لموكب الأنبياء الكريم، الذي يواجه مواقف متشابهة وأزمات متشابهة وتجارب متشابهة على تطاول العصور وكرّ الدهور. فهو يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى، والاضطهاد والبغي، والتهديد والتشريد. ولكنّه يمضي في طريقه ثابت الخطو مطمئنّ الضمير، واثقًا من نصر الله، متعلّقا بالرجاء فيه.
وحتى هنا نحتاج أن نشير، ونحن نستعرض مضامين المقدّمة والموضوعات التي تلخّصها مما بسطه سيّد في الظلال وغيره، إلى أنّ تعمُّق المفاهيم الجذري الذي بدا واضحًا في كلامه قد رافقه تعمّقٌ روحيٌّ لا يخطئه قلبٌ يقرأ ويحسّ وينبض، فالزيادة التي أضافها سيّد إلى الظلال لم تكن زيادة أفكار فحسب بقدر ما كانت أيضا ثراء روحيّا هائلا.
ويتحدّث سيد بعد ذلك عن مضامين أخرى لا يتّسع المقام هنا لبسطها، ولكنّا نشير إليها إشارة أوجز من ذي قبل، فهو يتحدّث عن عمق الأثر الشعوري والواقعي لمفهوم القدَر كما يعرضه القرآن، والفاعلية الإيجابية لصفات الله تعالى، ليلج بعد ذلك إلى الحديث عن “المنهج الإلهي” الذي وُضع ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية، والذي يأخذ في الاعتبار فطرة الإنسان وطاقاته واستعداداته وقوته وضعفه وحالاته المتغيّرة التي تعتريه.
ومن اللفتات اللطيفة التي تدلّ على عمق اتزّان سيّد قطب في مراحل حياته الأخيرة، بخلاف ما يثور حول انفعالية أفكاره وانقلابيّته، وأنّ كتاباته في تلك الفترة كانت نتيجة لمعاناته وتعذيبه في السجن؛ ما ذكره في سياق الحديث عن المنهج الإلهي إذ يقول:
“..ومن ثمّ فإنّ المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل – الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن – ومن ثم لم يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج. إنّ المدى أمامه ممتدّ فسيح، لا يحدّه عمر فرد، ولا تستحثّه رغبة فانٍ، يخشى أن يعجّله الموت عن تحقيق غايته البعيدة؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كلّه في جيل واحد، ويتخطّون الفطرة المتّزنة الخطى لأنّهم لا يصبرون على الخطو المتّزن! وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر، وتسيل الدماء، وتتحطّم القيم، وتضطرب الأمور، ثمّ يتحطّمون هم في النهاية، وتتحطّم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب المعتسفة! فأمّا الإسلام فيسير هيّنًا ليّنًا مع الفطرة، يدفعها من هنا، ويردعها من هناك، ويقوّمها حين تميل، ولكنّه لا يكسرها ولا يحطّمها. إنّه يصبر عليها صبرَ العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة.. والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف.. فالزمن ممتدّ، والغاية واضحة، والطريق إلى الهدف الكبير طويل، وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة، وتتطاول فروعها وتتشابك.. كذلك ينبت الإسلام ويمتدّ في بطء وعلى هيّنة وفي طمأنينة. ثم يكون دائمًا ما يريده الله أن يكون.. والزرعة قد تسفى عليها الرمال، وقد يأكل بعضها الدود، وقد يحرقها الظمأ، وقد يغرقها الريّ. ولكنّ الزارع البصير يعلم أنّها زرعة للبقاء والنماء، وأنّها ستغالب الآفات كلّها على المدى الطويل؛ فلا يعتسف ولا يقلق، ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتّزنة، السمحة الودود.. إنّه المنهج الإلهي في الوجود كلّه.. {ولن تجد لسنّة الله تبديلا}”.
وبعد الكلام حول طبيعة المنهج الإلهي وعن أصالة الحقّ والخير والصلاح والإحسان فيه، يحكي لنا سيد قطب أنّه انتهى من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم بأنّه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة، ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله. وهنا يتحدّث سيد قطب عن كون الرجوع إلى الله له صورة واحدة وهي العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم، وهو تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للنّاس، والارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله. وسنجده فصّل في هذا الباب في كتابه المهمّ “الإسلام ومشكلات الحضارة”.
يركّز سيّد قطب في مقدّمته على محور “تحكيم الشريعة” كما ركّز على محور “الجاهلية” الذي ذكرناه سابقًا، ويربط بين تحكيم الشريعة وبين الإيمان، فهذا التحكيم ليس موضع اختيار، إنّما هو – على حدّ تعبيره – الإيمان، أو فلا إيمان. ويستدل بالآيات ذات الدلالة الواضحة الحاسمة في هذا المعنى. والأمر إذن جدٌّ كما يقول، إنّه أمر العقيدة من أساسها، وهو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها.
ثم يبيّن لنا سيّد بُعدًا آخر من رؤيته تلك، وهو ما يسمّيه “قيادة الإسلام للبشرية”، فقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثًا هائلا في تاريخها، ونكبة قاصمة في حياتها لم تعرف لها البشرية نظيرا كما يقول. وقد كان تسلُّم الإسلام لقيادة البشرية بعدما فسدت الأرض مولدًا جديدا للإنسان. ويقول سيد في هذا السياق: “لقد أنشأ القرآن للبشرية تصوّرا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقّق لها واقعًا اجتماعيّا فريدًا، كان يعزّ على خيالها تصوّره مجرّد تصوّر، قبل أن يُنشئه لها القرآن إنشاءً”.
وهذا الكلام تحديدًا يُحيلنا إلى ثلاثة كتب لسيد قطب، اثنان اكتملا ونُشرا إلا قليلا، والثالث بات في حكم المعدوم. فأمّا الكتابان المنشوران فهما “خصائص التصور الإسلامي” و”مقومات التصور الإسلامي” مع نقص فيه، ومن اسميهما فهما يستهدفان بيان هذا التصوّر الذي أنشأه القرآن. وأما الكتاب المفقود فهو “نحو مجتمع إسلامي”، فقد ذكره سيد قطب في كتاب “الإسلام ومشكلات الحضارة” في سياق حديثه عن المجتمع الإسلامي، حيث قال: “فأما المعرفة العامة لملامح هذا المجتمع وخصائصه الذاتية فنعتقد أنّها ضرورية منذ الآن، وقد أشرنا إلى بعضها في ثنايا فصول هذا الكتاب.. وفي حدود جهدي الخاص: لقد أعددت لهذا بحثًا ضخمًا مفصّلا تحت عنوان “نحو مجتمع إسلامي” وبحثًا آخر عن “خصائص التصور الإسلامي ومقوماته” وكلاهما يكمل الآخر في هذا المجال”.
ومجدّدا، يؤكّد هذا كلّه أن سيّد قطب كان ينطلق في تنقيحاته الأخيرة على الظلال من رؤية عميقة، ومن مشروع لم يُكتب له الاكتمال وإنْ كان قد وصلنا منه الكثير بفضل الله، ولو قارنّا هذه الرؤية وهذا المشروع مع الظلال في طبعته الأولى لأدركنا ماذا يعني نشر الظلال بتلك الطبعة الأولى، فهو يعني شطب هذه الرؤية، التي يراها القائم على هذه الطبعة “دخيلة” على الظلال كما أشرنا سابقا!
ويمضي سيّد قطب في مقدمة الظلال بطبعته المنقّحة ليبيّن لنا كيف حلّت النكبة القاصمة المتمثّلة بتنحية الإسلام عن القيادة، واستلام الجاهلية لهذه القيادة بصورة التفكير المادي الذي يهيمن على البشرية اليوم، وكيف أنّ المضلِّلين يخدعون البشرية فيضعون المنهج الإلهي في كفّة والإبداع المادي الإنساني في كفة أخرى ويطلبون منها أن تختار بينهما، وكأنّه لا يمكن الجمع بينهما.

ومرّة أخرى، يُزاوج سيد قطب بين إقامة الشريعة وبين السنن الكونية، فالإيمان بالله وعبادته على استقامة وإقرار شريعته في الأرض إنفاذ لسنن الله، وهي سنن نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحسّ والاختبار. ويخبرنا كيف أنّ الحضارة المادية اليوم تقف كالطائر الذي يرفّ بجناح واحد جبّار، بينما جناحه الآخر مهيض، فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني، ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية بسبب ذلك. ويحدّثنا عن التكامل والتناسق بين سنن الله كلّها، سواء ما نسميه “القوانين الطبيعية” وما نسمّيه “القيم الإيمانية”، فكلها أطراف من سنّة الله الشاملة لهذا الوجود على حدّ تعبيره.
ومن يقرأ المقدّمة من أولها إلى آخرها سيطّلع على بُعدٍ إنساني بل كونيّ في هذا النصّ الفريد، وهو يعبّر خير تعبير عن جميع أجزاء الظلال، فلم يكن كتابا موجّها إلى جماعة أو حزب أو حتى مجتمع مسلم بحدّ ذاته، بل هو خطاب للإنسانية جميعا. ومن هنا يبدو غريبًا ذلك الاتهام بالحزبية أو الانغلاق والتعصّب لمثل هذا الخطاب، والأعجب أن يكون ذلك كلّه تحت عنوان “الحركية”؛ لأنّ حركية سيّد قطب لا تختصّ بحزب أو جماعة بعينها، بل هو يعبّر من خلالها عن طبيعة هذا الدين التي تأبى أن تنغلق في تصوّرات اعتقادية معزولة عن الواقع، أو في شعائر تعبّدية لا تتدخّل في الحياة. بل سنجده في بعض ما كتب يصف الدعوة الإسلامية الأولى بالحركة الإسلامية، فالحركة الإسلامية عنده مصطلح عموميّ لا يعبّر عن جماعة بعينها أو تحزّب أو انغلاق، بل هي تحرّك المسلمين بمبادئ هذا الدين وقيمه لتحقيقها في الواقع، وهذا أمر استفاده من كتاب الله، وليس هدفًا خاصّا بجماعة معيّنة أو حزب.
إنّ أجمل ما في كتابات سيّد قطب ومن بينها الظلال هو أنّه يخاطب فيها جميع النّاس، وهذا في اعتقادي أحد أسباب انتشار كتابه “في ظلال القرآن” بطبعته المنقّحة المزيدة ذلك الانتشار الهائل في بيوت المسلمين من مختلف المشارب، بل من الذين لم ينتموا يوما إلى جماعة إسلامية أو حزب إسلامي. وهو في كتابه لا يشير إلى جماعة أو طائفة بعينها، ولا يتحدث من منطلق التحزّب أو الترويج لتيّار معيّن، بل يترفّع عن جميع هذه الحيثيات، فقضيّته في كتابه أكثر اتّساعًا وأرحب أفقًا من أن تنغلق في رؤية حزبية أو برنامج لجماعة بعينها، إنّها قضية البشرية جميعا، وهو يتحدث من منطلق الإشفاق على هذه البشرية والشعور بمسؤولية إبلاغ الكلمة التي استوحاها من القرآن. ولذلك من الغريب جدّا أن يقول عصام تليمة، كما في مقال له على الجزيرة مباشر، عن طبعة دار جسور التي أشرف عليها إنّ “نشر هذه الطبعة، هو إنقاذ للظلال الذي كان تفسيرا للقرآن من باب البيان، وجمال العرض، من الظلال التفسير الذي تحول إلى سياق فكري وتنظيري، يخرج به من النفع للجميع، إلى انتفاع طائفة معينة منه”! وسنرى أثناء عرض بعض الزيادات على سورة الفاتحة كيف أنّها موجّهة – كسائر الزيادات والتنقيحات – إلى جميع القرّاء، وأنّ الزعم بأنّ سيد يخاطب في إضافاته الأخيرة فئة معيّنة هو زعم فاسد لا أساس له من الصحّة.
إنّ إحدى أبرز الرسائل التي يوضّحها سيد قطب في ظلاله أنّ العمل على استئناف الحياة الإسلامية والتمكين لدين الله في الأرض وإزالة الغربة الثانية التي حلّت بهذه الأمّة المسلمة ليس عملا خاصّا بجماعة أو طائفة بعينها، بل هو مسؤولية هذه الأمّة كلها، ومَن وجد في نفسه القدرة والعزيمة على الانخراط في هذا العمل فإنّه لا يرى في نصّ سيد قطب ما يوجّهه إلى جماعة أو تيّار أو منهج أو برنامج محدّد، بل يجده يُحيل دوما إلى الجماعة الأولى في العهد النبوي وخطّ سيرها وطبيعة بنائها.
ومِن أقبح موضات هذا العصر أن يوصم الذي يعي أحوال هذه الأمّة الكارثية من تنحيتها عن دفّة القيادة وتبديل شريعتها وولائها، والذي يبذل جهدًا في توعية الناس بهذا الباب الخطير في الدين.. أن يوصم هذا بـ “الحركية” على سبيل الذمّ والتنفير! فالحركية اليوم هي الجَمَل الذي سقطَ وكَثُرتْ سكاكينُه، خصوصا بعد فشل ثورات الربيع العربي وسقوط الكثير من الحركات الإسلامية إمّا بالبطش أو بالاستدراج والتخذيل، وصارت مقولات “التمكين لدين الله في الأرض” و”تحكيم الشريعة” و”الاهتمام بالشأن السياسي” و”تغيير نظام الحكم” مقولات خاصة بفئات من الناس يوصمون بأنّهم “حركيّون”، وكأنّ هذه الأهداف والاهتمامات ليست حقّا وواجبًا في الآن نفسه لكلّ مسلم يشهد لله بالوحدانية والطاعة ولنبيّه بالرسالة والاتّباع!
لقد تبيّن إذن أن جوهر الزيادة التي أضافها سيد قطب في نسخته المنقّحة والمعتمَدة من الظلال هو الإدراك الأعمق لأبعاد قضية الإسلام، وامتلاك رؤية متماسكة حول حقيقة الواقع الجاهلي الذي يحكم العالم اليوم، وخطورة غياب الإسلام عن قيادة البشرية، والمدلولات العميقة لإقامة دين الله في الأرض، وموقف الإسلام من بعض المفاهيم الجاهلية كالولاءات القومية والوطنية وغيرها. ولقد كان ذلك كلّه محمولا على روح أكثر طلاقة ورهافة وحساسية.. روح ناسك له “حالٌ” مع الله، وضمير يكاد يخلو من شُهودِ غيره في هذه الحياة!
تفسير سورة الفاتحة بين الطبعة الأولى والطبعة المنقّحة
ولم يبق لنا الآن سوى أن نسلّط الضوء على بعض الإضافات في تفسير سورة الفاتحة، لندرك طبيعة التغيير الحادث بين النسخة الأولى للظلال والنسخة الأخيرة المنقّحة.
بعض الإضافات هي من جنس الإضافات العلمية التي تعزّز المعرفة الدينية حول الآية أو السورة، مثل قوله في بداية تفسير سورة الفاتحة في الطبعة المنقّحة: “ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لِما ورد في الصحيحين عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – من حديث عبادة بن الصامت: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”. أو تفسيره للبسملة الذي أغفله في الطبعة الأولى، وهو أمر يعتني به عموم المفسّرين للقرآن.
ولعلّ هذه الإضافات وما هو من جنسها، والتي خلتْ منها الطبعة الأولى، هي بأثرٍ من تعمّق سيد قطب في المعرفة الدينية، وزيادة مطالعته لكتب التفسير والحديث وغيرها مما أثرى تدبّرَه للقرآن، وهي إضافات تزيد من اقتراب الكتاب من وصف “التفسير”، بخلاف ما ذكر تليمة في مقدّمته.
لقد كانت إضافات سيّد قطب في الواقع هي من جنس التوسّع في المستوى المعرفي التفسيري، وفي المستوى الروحي الوجداني، وفي المستوى الفكري الحركي. وسنأخذ من هذه الإضافات ما ذكره في تفسير قوله تعالى: {الحمدُ لله ربّ العالمين}، فحين نعقد مقارنة بين تفسير النسخة الأولى للظلال لهذه الآية وتفسير النسخة المنقّحة المزيدة ندرك ما الذي أضافه سيّد لظلاله في هذه المستويات الثلاثة.
في البداية، نجد أنّه في النسخة الأولى غير المنقّحة قد تجاوز تفسير “الحمد لله”، فقال: “تبدأ السورة – بعد البسملة – بالتوجّه إلى الله بالحمد، حيث تتضمّن الآية الإقرار بالربوبية المطلقة: {ربّ العالمين}.. وهي إحدى كلّيات العقيدة الإسلامية”.
أمّا في النسخة المنقحة المزيدة فنجده يقول بعد تفسيره للبسملة:
“وعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يجيء التوجّه إلى الله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين: {الحمدُ لله ربّ العالمين}..
والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرّد ذكره لله.. فإنّ وجوده ابتداءً ليس إلا فيضًا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء. وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمّع، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان.. ومن ثمّ كان الحمد لله ابتداء، وكان الحمد لله ختامًا قاعدة من قواعد التصوّر الإسلامي المباشر: {وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة…}.
ومع هذا يبلغ من فضل الله – سبحانه – وفيضه على عبده المؤمن، أنّه إذا قال: الحمد لله، كتبها له حسنة ترجح كل الموازين.. في سنن ابن ماجة عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – حدّثهم أنّ عبدًا من عباد الله قال: “يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”. فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها. فصعدا إلى الله فقالا: يا ربّنا، إنّ عبدًا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله – وهو أعلم بما قال عبده – : “وما الذي قال عبدي؟” قالا: يا ربّ. إنّه قال: لك الحمد يا ربّ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: “اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها””.
فانظر إلى هذا النصّ الذي يضيف إلى الظلال على المستوى الروحي الوجداني في شطره الأول، ثم يضيف على المستوى المعرفي التفسيري في شطره الثاني، ذلك لتعلمَ أنّ زعم اختصاص النسخة الأولى من الظلال قبل التنقيح بالجانب البياني الجمالي هو زعم فاسد، وكذلك الزعم بأنّ إضافاته في النسخة المنقحّة “دخيلة” على التفسير هو أيضًا زعم فاسد، فهي ألصق بالتفسير وطبيعتِه كما نرى.
وقبل الحديث عن الإضافة الفكرية الحركية أحبّ أن أنوّه إلى أنّ ثمّة تعديلات على النصّ هي من باب إعادة صياغته في مواضع من الظلال، فقد كان الحديث عن قوله تعالى {ربّ العالمين} في النسخة الأولى على النحو التالي:
“والربّ هو المربّي والراعي والسيّد. فالله لم يخلق الكون ثم يتركه هملا. إنّما هو يربّي ويرعى ويسود. والعوالم كلّها في رعايته وتحت سيادته. وعن طريق التربية الحكيمة التي يتعهّد العالمين بها، تنمو هذه العوالم وترقى، كلٌّ في اتجاهه، وكلٌّ بحسب الناموس الأزلي الذي يحكمه، وكلٌّ بحسب ما رُكز في طبيعته وخِلقته”.
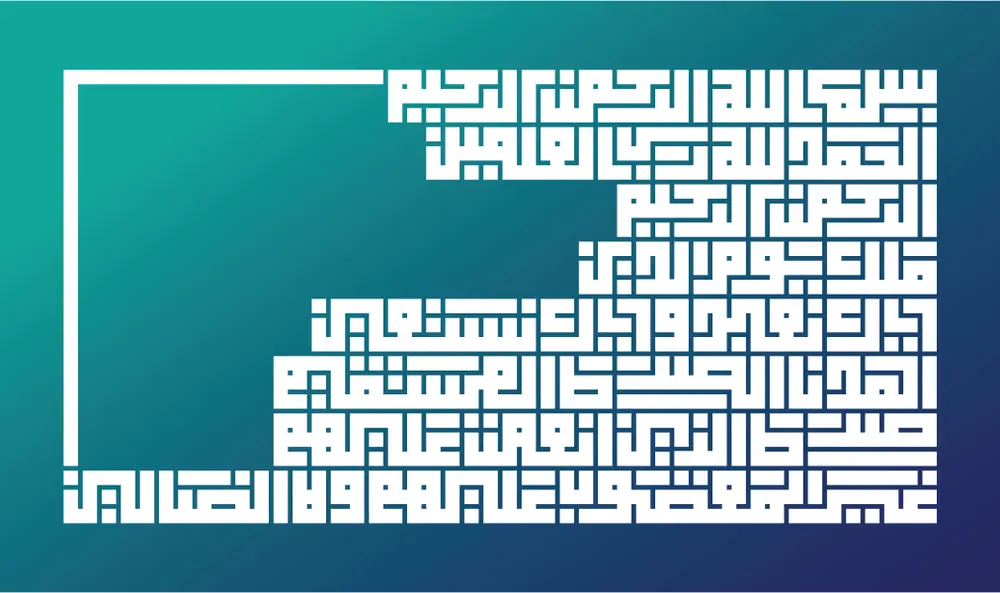
بينما نجده في النسخة المنقّحة يعدّل هذا النصّ فيقول:
“والربّ هو المالك المتصرّف، ويُطلق في اللغة على السيّد وعلى المتصرّف للإصلاح والتربية.. والتصرّف للإصلاح والتربية يشمل العالمين – أي جميع الخلائق – والله – سبحانه – لم يخلق الكون ثم يتركه هملا. إنّما هو يتصرّف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربّيه. وكلّ العوالم والخلائق تُحفظ وتُتعهّد برعاية الله ربّ العالمين. والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدّة قائمة في كلّ وقت وفي كل حالة”.
وقد يكون هذا التعديل مزيدًا من التدقيق في دلالات مفردة “الربّ”، حيث نجده يضيف دلالة “الإصلاح”، ويزيد من التركيز على دلالة “الرعاية” والصلة بين الخالق والخلائق، لأنّها لصيقة بموضوع “الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم” الذي سيركّز عليه في الفقرات الأخيرة من تفسير الآية. وقد يكون تجويدًا للصياغة اللغوية والأدبية. وأيّا كان سبب هذا التعديل، فهو يعبّر عن رغبة الكاتب وإرادته وتطوّر فكره ومعرفته، وليس من الصواب تجاهل هذه الرغبة والتنصّل من البُعد الأخلاقي الرسالي عند تناول مسلم لكتابات مؤلّف مسلم مثله، وقد أشرنا سابقا إلى أنّ الغاية البحثية كان يمكن تحقيقها بنشر النصّ المنقّح كاملا في المتن، والإشارة في الهوامش أو غيرها إلى شكله السابق في الطبعة الأولى، لا بالصورة التي أخرجتها طبعة دار جسور.
ومن النماذج الأخرى على التعديل في النصّ، للتدقيق في الدلالات أو لتجويد الصياغة، النصّ الذي يلي النصّ السابق مباشرة، يقول سيد رحمه الله في النسخة الأولى من الظلال:
“والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في عالم العقيدة. بين الاهتداء إلى الناموس الشامل لعلاقة الخلق بالخالق، والحيرة والتشتّت وتعدد الأرباب.. وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله خالق الكون، والاعتقاد بتعدّد الأرباب الذين يتحكّمون في الحياة! ولقد يبدو هذا غريبًا مضحكًا، ولكنّه كان وما يزال. ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن آلهتهم المتعددة: {ما نعبُدهم إلا ليقرِّبونا إلى الله زُلفى} فيعترفون بوحدانية الله وتعدّد الأرباب. والكنيسة المسيحية إلى هذه اللحظة تعتقد بألوهية الله، ولكنّها تسمّي عيسى ربّا، وتخلع عليه صفات الأرباب”.
بينما وجدنا النصّ في النسخة المنقّحة المزيدة على النحو التالي:
“والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. وكثيرًا ما كان النّاس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون، والاعتقاد بتعدّد الأرباب الذين يتحكّمون في الحياة. ولقد يبدو هذا غريبًا مضحكًا. ولكنّه كان وما يزال. ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرّقة: {ما نعبُدهم إلا ليقرِّبونا إلى الله زُلفى}.. كما قال عن جماعة من أهل الكتاب: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله}.. وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلّها يوم جاء الإسلام، تعجّ بالأرباب المختلفة، بوصفها أربابًا صغارًا تقوم إلى جانب كبيرِ الآلهة كما يزعمون!”.
وعند مقارنتنا بين النصّين نلحظ فروقات مثل استعمال عبارة “بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة” في النسخة المنقّحة، بدلا من عبارة “بين النظام والفوضى في عالم العقيدة. بين الاهتداء إلى الناموس الشامل لعلاقة الخلق بالخالق، والحيرة والتشتّت وتعدد الأرباب”. والفرق بين العبارتين هو فرق في الوضوح؛ فالعبارة الأولى المستعملة في النسخة المنقّحة واضحة لا لبس فيها، بينما يلتبس المعنى في عبارة النسخة الأولى من الظلال، ونجده للمرة الثانية في تفسير هذه الآية يتخلّى عن مفردة “الناموس” في التعبير عن مسائل إيمانية، ويستعمل بدلا منها عبارات أوضح وأكثر تعبيرا عن المعاني القرآنية.
كما نجده يستعمل عبارة “الاعتراف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون” بدلا من عبارة “الاعتراف بالله خالق الكون”، فهذا التعديل هو فيما أرى من جنس التدقيق في حكاية عقيدة أولئك المشركين؛ فهم لم يعترفوا بالله خالق الكون حقّ الاعتراف، بل اقتصر أمرهم على الاعتراف بأنّه وحده أوجد هذا الكون كلّه، ثم يجمعون مع ذلك الاعتقاد بتعدّد الأرباب الذين يتحكّمون في الحياة كما قال. وقد غيّر عبارة “آلهتهم المتعدّدة” إلى عبارة “أربابهم المتفرّقة”، وهي عبارة قرآنية، وأدقّ لغويّا من العبارة السابقة. وسائر التغييرات بين الفقرتين واضحة لمن أراد المقارنة.
وفيما تبقّى من تفسير هذه الآية نجده يقول في النسخة الأولى من الظلال: “فإطلاق الربوبية لله في هذه السورة، وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعًا.. هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة، لتتّجه العوالم كلّها إلى ربّ واحد؛ تقرّ له بالسيادة المطلقة؛ وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرّقة، وعَنَتَ الحيرة كذلك بين شتّى الأرباب!”.
أمّا في النسخة المنقّحة المزيدة من الظلال، فنجده يزيد على ذلك أكثر من ثلاثين سطرًا، يؤكّد فيها على دلالة الرعاية الدائمة لله عزّ وجلّ، ليلج من خلال ذلك إلى صورة الفوضى والأرباب المتفرّقة عبر التاريخ. يقول رحمه الله بعد النصّ السابق مباشرة في النسخة المنقّحة: “ثم ليطمئنّ ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة وربوبيّته القائمة. وإلى أنّ هذه الرعاية لا تنقطع أبدًا ولا تفتر ولا تغيب”. ثم يحدّثنا عن أرسطو واعتقاده في الإله، وعن ركام العقائد والتصوّرات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام وهي تعمّ العالم، وتخلط الحقّ بالباطل، والصحيح بالزائف، والدين بالخرافة، والفلسفة بالأسطورة، وعن تخبّط الضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل، وعن التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور في تصوّر البشرية لله وصفاته وعلاقته بخلقه، ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص، وكيف أنّ الإنسان لا يمكن أن يستقرّ على قرار في أمر الكون والإنسان ومنهج الحياة قبل أن يستقرّ على قرار في أمر العقيدة وتصور إلهه وصفاته، وأهمية الاطلاع على ضخامة ذلك الركام من العقائد والفلسفات والتيه الذي كانت فيه لإدراك ضرورة هذا الاستقرار، ويخبرنا سيّد قطب بأنّه سوف يقدّم لنا الكثير منها خلال استعراض سور القرآن، مما عالجه القرآن علاجا وافيًا شاملا كاملا.
ومن هنا يبيّن سيد أنّ عناية الإسلام الأولى كانت موجّهة إلى “تحرير أمر العقيدة، وتحديد التصوّر الذي يستقر عليه الضمير في أمر الله وصفاته، وعلاقته بالخلائق، وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين”. وأنّ التوحيد الخالص كان هو قاعدة التصوّر التي جاء بها الإسلام، وظلّ يجلوها في الضمير، ويخلّصها من كل غبش، مع قوله كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات الله وخصوصا ما يتعلّق منها بالربوبية المطلقة، إذ كان معظم ذلك الركام في ذلك التيه الذي ذكره يتعلّق بهذا الأمر الخطير، العظيم الأثر في الضمير والسلوك.
وعلينا أن نلاحظ هنا شدّة عناية سيّد قطب في رؤيته الجديدة بأمر العقيدة، ولأجل ذلك كتب كتابيه اللذين أشرنا إليهما سابقا وهما “خصائص التصوّر الإسلامي” و”مقومات التصوّر الإسلامي”، وكان الثاني آخر ما كتب قبل استشهاده رحمه الله، وموضوعه الحديث عن تصوّر الإنسان عن الله والكون والإنسان والحياة، ويتضمّن بيان طبيعة العلاقة بين الله وعباده، تحديدًا في فصل “ألوهية وعبودية”، وهو من أعمق ما كتب إلى جانب إضافاته الثرية الأخيرة في الظلال.
ونختم بنقل هذا النصّ في آخر تفسيره لهذه الآية من سورة الفاتحة، يقول رحمه الله:
“وإنّ جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثّلها.. كلّ هذا لا يتجلّى للقلب والعقل كما يتجلّى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصوّرات، والأساطير والفلسفات! وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم.. عندئذٍ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة. رحمة حقيقية للقلب والعقل، رحمة بما فيها من جمال وبساطة، ووضوح وتناسق، وقرب وأنس، وتجاوب مع الفطرة مباشرٍ عميق”.
ويمكننا أن نخلص – بعد استعراض هذا النموذج للتنقيح والزيادة في الطبعة الأخيرة للظلال – إلى أنّ الأستاذ سيّد رحمه الله قد عدّل بعض الصياغات في الظلال لأسباب لغوية وتعبيرية ودلالية، وكان ما أضافه من نصوص إلى الظلال على ثلاثة مستويات: المستوى الروحي الوجداني؛ الذي ازدادت حرارته وعمقه وتوهّجه في تلك الزيادات، والمستوى المعرفي التفسيري؛ الذي تميّز بزيادة التدقيق اللغوي والتعبيري، ورفد الآيات بالأحاديث والآثار المتعلّقة بها، والمستوى الفكري الحركي؛ الذي يعبّر عن المدلولات الواقعية لمعاني القرآن الكريم، ويؤكّد على تميّز العقيدة الإسلامية والمنهج الإلهي عن سائر التصوّرات، وأهميّة تحقيق هذا المنهج في هذه الأرض الغارقة في جاهلية عمياء، وأنّه لا أمل ولا صلاح ولا نماء ولا فلاح للبشرية إلا باتّباع منهج الله الذي بيّنه في كتابه سبحانه.
لقد انتقل سيّد قطب في رحلته من ظلاله الأولى إلى ظلاله الأخيرة من الخواطر الأدبية الشفيفة واللفتات الفكرية اللطيفة، إلى الرؤية العميقة الرائدة والبنى الفكرية المتماسكة، دون أن يتخلّى في أثناء عرضه لهذه الرؤية عن بيانه العالي الرفيع، وعن أدبه الساحر البديع، بل ازدادت رفعة بيانه وتوهّج سحرُ أدبه مع النصوص الأخيرة، فقد كان لتعمّق تجربته الإيمانية وهو ملازم لكتاب الله تعالى أثرٌ كبير في التعبير عن هذه الرؤية بدماء قلبه الذي يخفق وليس بحبر قلمه فحسب. فهو القائل: “إنّ المبادئ والأفكار في ذاتها بلا عقيدة دافعة مجرّد كلمات خاوية، أو على الأكثر معانٍ ميّتة! والذي يمنحها الحياة هي حرارة الإيمان المشعّة من قلب إنسان. لن يؤمن الآخرون بمبدأ أو فكرة تنبتُ في ذهن بارد لا في قلب مُشعّ”. وهو القائل: “كلّ فكرة عاشت قد اقتاتتْ قلب إنسان، أما الأفكار التي لم تطعم هذا الغذاء المقدّس فقد ولدت ميّتة ولم تدفع بالبشرية شبرا واحدا إلى الأمام”!


مقال قيم بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل
حقيقية العلامة سيد قطب من العلماء الذين أولو أهمية بالغة لسنن الله ونواميسه في هذا الكون، وبينوا كيفية استرجاع الأمة لمجدها و قوتها من خلال تسخير هذه السنن والعمل وفق ما جاء به ديننا الحنيف من تشريعات وقوانين تحفظ للانسان كرامته و تيسر له سبل للاستخلاف في الارض ..