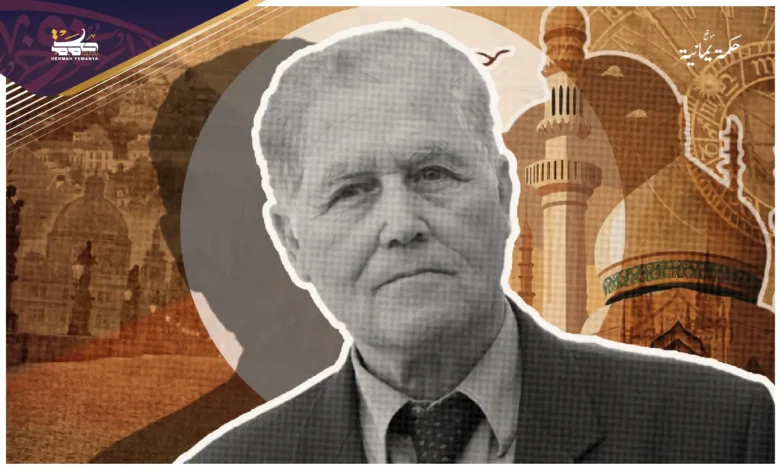
من “التاريخانية” الماركسية اليسارية الحادَّة، إلى “التَّاريخانية” المحافظة اليمينية النَّاعمة، من القطيعة المعرفية المنهجية مع “التُّراث”، إلى التَّواصل الثقافي المعرفي معه، هكذا يتحوَّل “العروي”، ليسطِّر لنا رؤاه الإصلاحية، ومواقفه تجاه “التراث”، في كتابه “السنة والإصلاح”.
هل نحن أمام تحوُّل أيديولوجي؟ أو “تاريخانية” جديدة يدشّنها “العروي”؟
لم يتحرَّر هذا السؤال من سلطة قلم “العروي”، ونهجه الجديد في تناوله مشكلة “الحداثة”، وبذلك عجز عن تجاوز القشرة الرقيقة التي غلَّف بها مضامين كتابه، فافتقر بذلك إلى العمق النقدي الكاشف عن غلط هذين الفرْضين، إذ لم تكن تلك “تاريخانية” جديدة، ولا تحوُّلًا أيديولوجيًا، وإنما نحن أمام تغيير إجرائي “تكتيكي”، بعد أن باء العنف الحداثي، وصدامه “التراث” الإسلامي بالإخفاق.
بهذا الإجراء انحاز “العروي” لطريقة تيار الحداثيين المؤمنين بضرورة التوقف عند “التراث” وتفكيكه، لفهم مكوّناته، وإذابة مقولاته الصّلبة، وتمرير مفاهيم “الحداثة” تحت غطائه، كما فعله “الجابري” في بعض مشاريعه!
عراك السُّنَّة والإصلاح
غاير المؤلف أسلوب كتابه عما عُهِدَ عليه من الأساليب الصارمة ذات الطابع الفلسفي البرهاني، والصبغة الحجاجية العقلية، مما أضفى عليه شيئًا من الغموض البياني الشاعري، قَدَّم لنا مضامينه الفلسفية في وعاء “المذكرات”، وقوالب “المراسلات” و”الاعترافات”، وخَلَطَ ذلك كله بنَفَسه الروائي، إذ لم يكن همُّ المؤلف إقناع القارئ بحجته وبرهانه، بقدر ما أراد إدهاشه بنمط بيانه!
ثنائية تتناحران في “الرُّؤية”، وتختصمان في “المنهج”، “سُنَّة” تُصمّم على إيقاف مجرى الزمن والتغيير، وتعزم على تحويل “الحدث” إلى “بِنْية” و “نظام” ثابتين، و “إصلاح” يسعى جاهدًا إلى خلخلة “السنة” و إعادة خَلْقها بمنطق “الحدث” و”الصيرورة”!.
في سياق صراع تلك “الثنائية”، يستهلُّ كتابه بتقديم وصفته الشّفائية، لسائلته المسلمة الغربية، عن صيغةٍ للحفاظ على ثبات “الهوية” و”الانتماء” الإسلامي، دون المساس بصيرورة رؤيتها، ونمط عيشها الحداثي، صورةٌ رمزيةٌ تختزل بنية الإشكال الذي يؤرق المؤلف.
طبيعة "السُّنَّة" في الرُّؤية الحداثية:
“السُّنَّة” ـ في رؤية الحداثة العروية ـ ” مؤسسة بشرية سواء أكانت رسمية أم شعبية، منظمة أم غير منظمة … ذات طبيعة اتِّباعية، تحتمي بالماضي، وتتّخذ موقف السَّلف أسوة ومرجعية ومعيارًا”(1).
تمثل “السُّنَّة” حجر العثرة في طريق المشاريع الحداثية، الخاضعة لمنطق “الحدث” و “الصيرورة”، إذ بدون تفتيتها، والانعتاق من قبضتها، سيتوقف قطار “الحداثة” والتحديث، وستتلاشى الجهود المضنية لـ”الإصلاح الحداثي” هباءً منثورًا، لذا كان أول الفروض النّضالية للقلم الحداثي تفكيك بنية تلك “السنة”، وتحويلها إلى أحداث يصنعها منطق التاريخ في صيرورته وجريانه، في هذا المناخ المشحون بالعداء والخصومة، ستصبح المقولة السَّلفيَّة المشهورة: “لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها” خرافة أَمْلَتْها “السُّنَّة” الجامدة المعادية لحركة التاريخ وتطوره من الماضي إلى المستقبل!.
لا ريب أن تلك المُنَاوأة الشَّرسة لـ “السُّنَّة” ستصطدم بصلابة الحقائق الاجتماعية و التَّاريخية، فإنه ما من حضارة بشرية إلَّا وتُشَيَّد على “رُؤَى” و”عقائد” و”تقاليد”، تحتضنها “مؤسَّسات” تمثّل هويتها، وتحقّق وجودها التاريخي، فهل يمكن أن يبنى التاريخ الحضاري للبشر دون تلك المؤسَّسات ؟!.
ولا مناص من أن وحش “الصيرورة” ـ الذي تؤمن به “الحداثة” معيارًا ـ سَيلْتَهم المؤمنين به، أوليست “التاريخانية”، والمبادئ المعيارية الحداثية، بحاجة إلى “التفكيك” بمنطق الصيرورة نفسه؟! ألم تتحول رؤى “الحداثة” إلى “سُنَّة” ثابتة، ومرجع معياري ذي طبيعة اتّباعية، تحتمي بماضيه؟!.

الصخرة الكأداء
في دُرُوب “التَّفكيك” يقف “العروي” على الجذور الأولى للثقافة العربية، في مرحلة “ما قبل السُّنَّة” ـ على حدّ تعبيره ـ سعيًا منه وراء عقد صلحٍ بين “العقل الحداثي” و “عقل ما قبل الحداثة”، وعلى هَرَمِه “العقل الإيماني”، وفي إطار تلك القراءة يَصِلُ الثقافة العربية بجذرين: أولهما: “العهد الهيلينستي”، المتعلّق بالسُّنَّة العلمية، وثانيهما: “الحَدَث الإبراهيمي” المرتبط بالسُّنَّة الدّينية.
وبمنطق “التحكُّم”، ومنهج “الافتراض”، يحاول جاهدًا إقناع القارئ بمسوّغات قراءته التحليلية لجذور تلك الثقافة، متجاهلًا الوقوف على أسئلة التاريخ والمنطق، فلماذا ـ إذن ـ توقَّف الزمن والتاريخ عند هذين الجذرين؟ أوليس في هذا ما يناقض منطق “التاريخانية” نفسه، الذي يهدم الماضي ليسير نحو المستقبل، والذي يأبى الوقوف عند لحظة تاريخية معينة، واتّخاذها مرجعًا لقراءة الواقع؟ أليست “الصيرورة” في تسارع زمني سابق ولاحق؟ فلماذا كانت هاتان الَّلحظتان مرتكزًا لفهم التاريخ وتحولاته؟ وكيف يمكن القفز على تاريخ الحضارة المديد “ما قبل العهد الهلينستي” وما قبل “الحدث الإبراهيمي”؟ كل ما قَدَّمَه المؤلف ـ في هذا السياق ـ من مسوّغات لم ترتقِ إلى مستوى الإجابة عن إشكالات تلك الأسئلة!.
هَوَسُه بمركزيَّة الثقافة الهلينستيَّة، مَنَحَهَا السلطة المطلقة في إنتاج السّجل الفلسفي الطويل، والمدارس الكلامية الإسلامية، بل أَبْعَدَ في النّجعة حينما رأى أن الإسلام نفسه نشأ في أحضان تلك الثقافة المختلطة من ثقافة اليونان والشرق! تلك عقدة “الحداثيين” دومًا، إذ لم يستطيعوا التحرُّر من سلطان “الثقافة الغربية”، حتى وهم يحرثون في أعماق التاريخ!. (2)
حاول ـ في محيط تلك القراءة ـ تفكيك أبرز اتجاهات “السُّنَّة” في الثقافة العربية، وهي ثلاثة: “الفلسفة” و “علم الكلام” و “القراءة السَّلفيَّة للدين”، فبعد محاولة تقويضه السُّنَّة الفلسفية والكلامية، من جهتي المنهج والمضامين، في الفصلين الثاني والثالث، تفرَّغَ قلمُه لنقض “السنة الدينية” في سياق القراءة السلفية، المُتَّكئة على مفاهيمها الزمنية الثابتة، ولكنه وَلَجَ إلى تلك القضية من باب السّياسة، كعادة بعض الحداثيين في تحليلهم الأفكار والمفاهيم والمذاهب في التاريخ الإسلامي، فالمستوى السياسي هو المدخل الملائم ـ في نظره ـ إلى تحليل “السنة الدينية”،(3).
وبغلو قَلَّ نظيره، وجرأة لا تكاد تجارى يُغرب “العروي” في تفسيره السياسي للقضايا الدينية، حتى وصل به الحال إلى الربط التفسيري بين أصل عقيدة التوحيد وواقع الاستبداد السياسي، فالحكم الواحد الاستبدادي في التاريخ القديم فرعونيًا كان أم قيصريًا أم كسرويًا، “هو الذي هيَّأ الأذهان في المدار المتوسطي إلى اعتناق عقيدة التوحيد … “. (4).
لكنه ـ في حالة انهماكه في الهدم والتقويض ـ اصطدم بالصخرة الكأداء، التي كشفت ضآلة معامل هدمه، وفقر أدواته، وفساد تصوره، إنه مبدأ “الإجماع” المرتبط بالجماعة الأولى من الصحابة، أصلب مفاهيم القراءة السلفية، الذي أعيا كل القراءات الحداثية التي لا يمنكها أن تتجاهله، ففي لغة حداثية ـ لا تقيم للدلائل العلمية وزنًا ـ يُهوّن “العروي” من سلطة الإجماع العلمية، فيقول: ” واضح ـ إذن ـ أن الإجماع رأي عدد محصور من الأشخاص هو الذي يحدد المعنى النظري والمقصد العملي للنص…” (5).

ولمَّا انتصرت نظرية كبار الصحابة السياسية، انتصرت قراءتهم للدين، هكذا يقرأ “العروي” التاريخ الإسلامي، “فأشراف قريش” و “سادة مدينة الرسول” ـ كما يسميهم ـ انتصروا باسم الجماعة المنتقاة، لكنه كان انتصارًا ـ على حد تعبيره المفتقر للموضوعية العلمية والآداب المرعية ـ بالدهاء والقدرة على التغافل والمراوغة، فكانوا هم المسؤولين عن تأسيس ذهنية التقليد والاتباع(6).
سُحُبٌ كثيفة من “الأوهام” تَلفُّ تلك القراءة، “الإجماع رأي عدد قليل”، “الصحابة الكرام احتكروا فهم الإسلام واختطفوا اسمه، وذلك عقب انتصارهم السياسي”! حقًا. إن لسيطرة “الأوهام” أثرًا سيئًا على التصورات والأحكام، ولنا في شخصية “دون كيخوتي” محارب طواحين الهواء عبرة بالغة!.
تجلَّت تلك الأوهام عندما صوَّر المؤلف “النظرية السياسية” للخوارج من جهة، والشيعة من جهة أخرى، خصمين لنظرية كبار الصحابة! إذ كيف يمكن افتعال صراع بين نظرية لا وجود لها في زمن التأسيس ـ زمن كبار الصحابة ـ وبين نظرية لا منافس لها البتة ؟! أم هل يصح افتراض زمن ما بعد الخلاف خصمًا لزمن ما قبل الخلاف؟! هنا تحضر معايير “المعارضة” و “الموافقة”، لا معايير ” الانتصار” و”الهزيمة” !.
وفي صرخة غاضبة معبرة عن إفلاس الفكرة، وألم العثرة، يتوجَّع “العروي” من أدبيات القراءة السلفية هاجيًا ثالبًا، محاكمًا تاريخ الأمة المديد بعلومه وعلمائه، إذ يقول: ” … وهكذا يمكرون بمكر التاريخ، باسم فترة زمنية وجيزة، فترة مسطحة ومختزلة، مصححة ومنقحة، يُطلب من التاريخ أن يتوقف هو الآخر عند حده، يؤمر بأن لا يتجدد أبدًا ولا يتميز، لا يتنوع ولا يتطور …”(7).
إنه لمن الصعوبة بمكان إيقاف قراءة هائجة لاهثة وراء صيرورة الزمن، لا تلوي على شيء، تُحطّم كل ما في طريقها من “لوحات المعاني” و”إشارات التعقُّل”، جاهدة لِتصْنَعَ ـ بزعمها ـ من “السَّراب” معانيَ تُخادِع الأبصار، يستحيل القبض على نواصيها! فهل لمثل تلك القراءة أن تقف ـ على حد تعبير العروي ـ عند “فترة زمنية وجيزة”؟!.
لا يمكن لتلك القراءة الحداثية ـ التي أعيت نفسها ركضًا وراء الزمن ـ أن تتفهم الوعاء الأول الذي تَلقَّى “النص الديني”، لغة ومعنى، ذلك النص الذي لا هوية له إلا بإدراك رسالته الإصلاحية للبشرية، ولا يتم ذلك إلا عبر معرفة “مراد المتكلم” من تلك الرسالة.
ومن العبث المنهجي انتزاع تلك النصوص الرّسالية من سياقها الثقافي والاجتماعي، الذي يكشف معانيها ومراميها، سواء أكانت نصوصًا دينية أم قانونية، وليس هناك من حاضنة اجتماعية لتلك النصوص والسنة الدينية، إلا تلك “الفترة الزمنية الوجيزة”، فترة “الصحابة الإطهار”، فهم أعلم بسياقاتها اللغوية والاجتماعية، مع شهادة القرآن والتاريخ لهم بطهارة القلوب، وسلامة النفوس، وأمانة النقل.
فإذا كان البحث عن ثراء النص وخصوبته، بكسر قيوده، وعزل صاحبه، وإخضاع معانيه لحركة الزمن وصيرورته ممكنًا في قراءة “النص الأدبي”، كما تراه بعض الاتجاهات الحديثة، فإنه غير ممكن في قراءة “النص الديني” للاختلاف بينهما في المضامين والأغراض.
ولا يعني هذا تعطيل الدور الحركي للعقل في قراءة “النص الديني”، لأنه من جنس النصوص ذات الأنساق المفتوحة دلاليًا على مستوى المفردات والتركيب، كما يقرره “علم الأصول”، مما يسمح لعجلة الاجتهاد الشرعي بالتحرُّك، لكن في إطار “البحث عن مراد المتكلّم”، الذي أقفل أنساق بعض النصوص القليلة فيما يسمى بـ”القطعيات”، وأبقى على أكثر النصوص مفتوحة الأنساق تتطلَّب مراد الشارع!.
تلك هي القراءة السلفية التي استطاعت أن تجمع بين “ثبات” النص ومرونته، وتؤلّف بين استقرار “المعاني” ونمائها، متطلّبة الوصول إلى معناها الرّسالي، مراعية سياقاتها الزمنية والمكانية واللغوية، ولم تكن تلك القراءة العابثة، التي أغرقها “الحدث” في صيرورته، فلم تستطع إلا إنتاج معانيَ مهترئة، تعجز عن القيام بوظائفها الحضارية، وتَلَفُّها ظلال العدمية، عبَّر عن بعض تجلّياتها “العروي” نفسه ـ بعد أن حَلَّلَ وفكَّك السنَّة العلمية ـ قائلًا: ” … وبعد التفكيك والتحليل ماذا؟ الصمت … والحرية.”!!.

غموض الرؤية الإصلاحية
لم يكن “العروي” منظرًا للحداثة فحسب، بل كان ذا همٍّ اجتماعي، ورسالة إصلاحية، هي جوهر فكره، فيه تتكشَّف مراميه الفلسفية، ففي فصل مستقل بعنوان “الإصلاح” طرح رؤيته الإصلاحية بعد محاولته تقويض وتفكيك “السنة” بطريقة لا تخلو من انتقاصٍ واتَّهام، لكنه لم يقدّم تلك الرؤية إلا من خلال ظلال باهتة غامضة غموض رؤيته الحداثية، التي تحوم حول الانغماس في دوامة “الحدث”، والرضوخ لأوامره والزاماته(8).
ولكنَّه بعد جُهْد جهيد من الدَّوران على معايير “الصيرورة” و “الحدث”، ينتهي إلى هدفه الإصلاحي النّهائي، وهو الدَّعوة إلى “العلمانية”، لإنقاذ العلم والسياسة من “السُّنَّة الدّينية”، لأنها ـ في نظره ـ سلطة محايدة! (9).
لكن أليست تلك السُّلطة المحايدة هي الأخرى “سُنَّة”، مؤسَّسة بشرية ماضوية، لها رؤيتها الثابتة في الحياة والوجود، وقراءتها التأويلية للنصوص؟! كيف يمكن تفسير الدعوة إلى تحكيم تلك المؤسسة السُّنّية البشرية في سياق إبطال تحكيم مثل تلك المؤسَّسات؟!.
منشأ ذلك التناقض وتلك الازدواجية ـ في رأيي ـ غموض رؤية الحداثة الإصلاحية، وإخفاقها في بناء المعاني الحضارية المتماسكة، ففاقد الشيء لا يعطيه، فهي وإن كانت غنية بما تمتلكه من معاول الهدم إلا أنها تعيش إملاقًا شديدًا في امتلاك مقوّمات البناء على أسس راسخة، وتعاني من أزمة “العدمية” التي تلاحقها في كل محفل!.
الهوامش:
- ـ (انظر: السنة والإصلاح، عبدالله العروي، المركز الثقافي العربي، ط الأولى، ص 210 و ص 170 ).
- (انظر: المصدر السابق، ص 94 ـ 95)
- (انظر: المصدر نفسه، ص 139 ، ص 165 )
- (المصدر نفسه: ص 166)
- (المصدر نفسه: ص 133)
- (انظر المصدر نفسه: ص130 ـ 132 ، 134 ـ 137 ، 149 ـ 150).
- (المصدر نفسه: ص 150)
- (انظر المصدر نفسه، وعلى سبيل المثال: ص 196 ، 197 ، 207)
- (انظر المصدر نفسه: ص 210)

