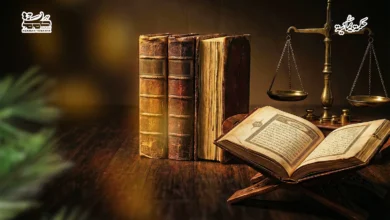أشار الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي إلى فكرة بالغة الأهمية والدلالة، نقلها عن أحد أساتذته في جامعة تكساس، وأوردها في معرض حديثه “لبودكاست مسند”، ومفادها أنَّ الأفكار الأشد خطورة وتأثيرًا ليست تلك التي تُصنّف على نحو قطعي بوصفها صائبة تمامًا أو خاطئة تمامًا، بل هي تلك التي تحتمل وجوهًا من الصواب والخطأ معًا؛ إذ تمتزج فيها الحقيقة بالوهم، والمنطق بالوهم المقنع، مما يمنحها قوة الإقناع، ويجعلها مثار جدل دائم. وتمثل هذه الفكرة التي أشار إليها الدكتور الشنقيطي مدخلًا خصبًا للتأمل في طبيعة المعرفة البشرية، وحدود التلقي العقلي، وآليات اشتغال الفكرة داخل الفضاء العلمي والفكري. كما أنها تكشف عن ديناميكية الخطاب في المجتمعات، وعن كيفية تفاعل العقول مع الأفكار الملتبسة التي تستعصي على التصنيف السريع أو الأحكام القاطعة، الأمر الذي يستدعي أدوات معرفية دقيقة، ومنهجًا نقديًا رصينًا للتفكيك والتحليل والتقويم.
ويمكن مناقشة هذه الفكرة من خلال عدة مستويات هي:
أولًا: تصنيف الأفكار بين الصواب والخطأ وما بينهما: تقليديًا، درج الفكر الفلسفي والمنهجي على تصنيف الأفكار إلى صحيحة وخاطئة، بناءً على معايير منطقية أو معيارية أو تجريبية. غير أن هذه الثنائية – رغم وضوحها – لا تفسر لنا الحراك المعرفي الذي يحدث حول الأفكار “الملتبسة”، أو تلك التي تشتمل على قدر من الصواب والخطأ معًا. فالفكرة التي تمزج بين الصدق والخطل، أو تتضمن ملامح من كلتيهما، تخرج من منطق التقرير إلى منطق التفاعل، ومن حالة الانغلاق إلى أفق الجدل والنقاش.
ثانيًا: مركزية الفكرة (الملتبسة) في تشكيل الوعي الحواري: إن الأفكار التي تجمع بين وجوه الصواب والخطأ تؤسس لما يمكن تسميته بـ”المنطقة الرمادية/ الضبابية” في الخطاب الفكري، وهي منطقة محفزة للعقول، ومثيرة للنقاش، وتدعو إلى النظر من زوايا متعددة. إنها لا تُغلق الباب أمام الرأي المخالف، بل تدعوه إلى الدخول، وتحتفي بوجوده. ولذا فهي تخلق حوارًا ديناميكيًا متجددًا لا مجرد استقطاب ثنائي، وتدفع العقل الجمعي إلى إعادة النظر في مسلماته، وتفكيك بداهاته، وتركيب معارفه من جديد.
ثالثًا: الأثر التربوي والمعرفي للفكرة المركبة: في السياقات التعليمية والتربوية، تلعب هذه النوعية من الأفكار دورًا محوريًا في تنمية مهارات التفكير النقدي، وتعليم المتعلم فن التفكيك والتحليل والموازنة، بدلًا من مجرد التلقي أو التلقين. فالفكرة “المركبة” – بحسب هذا التصنيف – تمثل دعوة ضمنية إلى الشك المنهجي، وهي المحرك الأهم للبحث والاكتشاف، لأنها تُبقي العقل في حالة يقظة وتأمل دائم.
رابعا: أهمية هذه الفكرة في مسار الفكر الإنساني: عبر التاريخ، كانت الأفكار التي جمعت بين الصواب والخطأ هي الأكثر تأثيرًا، لأنها الأقدر على النفاذ إلى العقول، ولأنها تمتلك جاذبية فكرية تسمح لها بالتغلغل في الوجدان الثقافي والشعبي. وهذه الأفكار التي جمعت بين الصواب والخطأ، أو التي كانت تحتمل أوجهًا متعددة من التأويل والفهم، هي التي شكّلت لحظات التحول الكبرى في مسار الفكر الإنساني بعامة، والفكر الإسلامي بخاصة. فعبر التاريخ، كانت هذه الأفكار هي الأكثر أثرًا، لأنها الأقدر على النفاذ إلى العقول، والأكثر إثارةً للجدل والتفاعل. ففي الفكر الإنساني العام، رأينا ذلك في أطروحات أرسطو التي جمعت بين الملاحظة الدقيقة والأخطاء المنهجية، وفي نظرية التطور لداروين التي أثارت جدلًا علميًا ودينيًا واسعًا، وفي نقد ماركس للبنية الاجتماعية رغم أبعاده المادية المتطرفة، وفي فرويد الذي كشف أعماق النفس، ولكنه اختزلها في الغرائز. وهذه الأفكار لم تكن صوابًا خالصًا ولا باطلًا محضًا، وإنما كانت تحمل من الحقيقة ما يكفي لإقناع البعض، ومن الوهم ما يكفي لرفض البعض الآخر، فكانت سببًا في إثارة جدالات لا تزال حية إلى اليوم.

وفي الإطار الإسلامي، نجد نماذج موازية لا تقل إثارة وتأثيرًا. فنظريات القدر عند المعتزلة، والتأويل العقلي للصفات، كانت تحمل قدرًا من الوجاهة العقلية والنية التنزيهية، ولكنها – في الوقت نفسه – أفضت ببعضهم إلى نفي الصفات أو الجبرية المقنعة، مما أثار موجات من النقد والمعارضة. وكذلك اجتهادات الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا، الذين حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة، ففتحوا آفاقًا عظيمة للعقل الإسلامي، ولكنهم وقعوا أحيانًا في تأويلات ميتافيزيقية أبعدتهم عن روح النص. بل حتى أفكار ابن تيمية، رغم عمقها التجديدي في قضايا كثيرة، أثارت جدالات بين مؤيد يرى فيها تحريرًا من الجمود، وآخر يرى فيها انحرافًا عن التراث العقدي السائد في عصره. أما ابن عربي، فكان في قلب هذا الحراك؛ إذ مثلت رؤيته الوجودية محورًا لتأملات صوفية مثيرة، لكنها أيضًا أثارت اتهامات بالحلول ووحدة الوجود، وانقسم الناس في فهمه بين مبدِّع له وواصف له بالإلحاد.
خامسا: الخطورة البنّاءة والخطورة المضلِّلة في الفكرة الملتبسة: رغم ما سبق من بيان أهمية الأفكار الملتبسة، إلا أن لهذه الأفكار وجها آخر، يتوقف على طريقة التعامل معها. فإذا أُهملت أدوات التفكيك والتحليل والنقد، أو غابت الخلفيات المنهجية والمعرفية الراسخة، فقد تتحول هذه الأفكار إلى فخاخ معرفية، أو أدوات تضليل، خصوصًا في الخطابات الأيديولوجية أو الدعائية. ومن هنا تنبع “خطورتها”، لا باعتبارها أفكارًا باطلة، بل لأنها تلبس لبوس الحق وتُغلف بغلاف المعقول، فتُضل من لم يكن مؤهلاً لتمييز حدود الصواب والخطأ فيها.
إن الفكرة التي تمزج بين الصواب والخطأ ليست مجرد حالة معرفية عابرة، بل هي من أخطر أنواع الأفكار وأعمقها أثرًا، إذ تتسلل إلى الأذهان بلبوس المعقول والمقبول، فتربك العقول غير المهيأة، وتوقعها في الحيرة والارتباك. وحين تغيب أدوات التحليل والتفكيك، تتحول هذه الفكرة إلى فخ معرفي، كما سبق وأشرنا آنفا، يُفتن بها من لم يمتلك القدرة على التمييز بين عناصرها، فيتبنّى الخطأ ظانًا أنه صواب، أو يرفض الصواب ظنًا أنه باطل. وهنا تبدأ المزالق الأخطر: فإما غلو في تأييدها ورفضٌ لكل من يخالفها، أو تطرف في إنكارها يصل إلى حد نفي الآخر، بل وربما تكفيره، خاصة حين تتداخل هذه الفكرة مع قضايا عقدية أو سياسية أو هُوياتية حساسة.
وفي السياقات الأيديولوجية، تُوظف هذه النوعية من الأفكار لتضليل الجمهور أو تبرير الاستبداد أو إقصاء الخصوم، فيُبرَز جانبها الصحيح ويُخفى باطلها، أو العكس، لتُوظَّف ضد من يحملها أو يُقرّ بها. كما أنها قد تزعزع يقين بعض الشباب، وتفكك منطقهم العقدي، خصوصًا حين تقترن بجاذبية عقلية أو لغوية أو رمزية، دون أن يجدوا في بيئتهم من يُفككها علميًا (عدنان إبراهيم وعلي الجفري نموذجا). ومن هنا تنبع خطورتها: لا من ذاتها، بل من العقل الكسول، والمنهج الغائب، والمؤسسات العاجزة عن التوجيه. ولذلك، فإن التعامل السليم معها لا يكون بالتحريم أو التجريم، بل بتربية عقل نقدي قادر على التمييز، يحاور الفكرة دون أن يُفتن بها أو يغلو في رفضها.
إن الفكرة التي تحمل شيئًا من الصواب وشيئًا من الخطأ ليست مجرد ظاهرة فكرية، بل هي ظاهرة معرفية وسوسيولوجية وأخلاقية أيضًا. فهي تختبر الوعي الجمعي، وتكشف نضج النخبة، وتُميّز بين المتأمل والمنساق. ومن هنا، فإن خطورتها ليست مدعاة للتحذير منها، بل دعوة إلى التسلّح بأدوات الفهم النقدي والمنهجي، والتعامل معها بوصفها فرصًا للتفكير لا ألغامًا للتيه. بعبارة أخرى: ليست خطورة الفكرة في التباسها، بل في هشاشة الوعي الذي يتلقاها.
ومن هنا، يتضح بكل جلاء أن الأفكار التي تمزج بين الصواب والخطأ ليست هامشية في مسار الحضارة، بل هي قلبه النابض. إنها تمثل مناطق التوتر الخلاق، والتفاعل الجدلي بين الأفق النصي والعقلي، بين الواقع والمثال، بين الظاهر والباطن. وإذا كان الفكر الغربي قد شهد أمثلة بارزة على ذلك، فإن الفكر الإسلامي كان ولا يزال حافلًا بتجارب معرفية عميقة، تُحرك الساكن، وتوقظ النائم، وتختبر يقظة الضمير العلمي لدى الأمة. فـ (خطورة هذه الأفكار وأهميتها في آن واحد) هي في قدرتها على تحريك العقل، لا في خطئها المجرد؛ وفي ضعف أدوات التمييز لدى المتلقي، لا في بنية الفكرة نفسها.