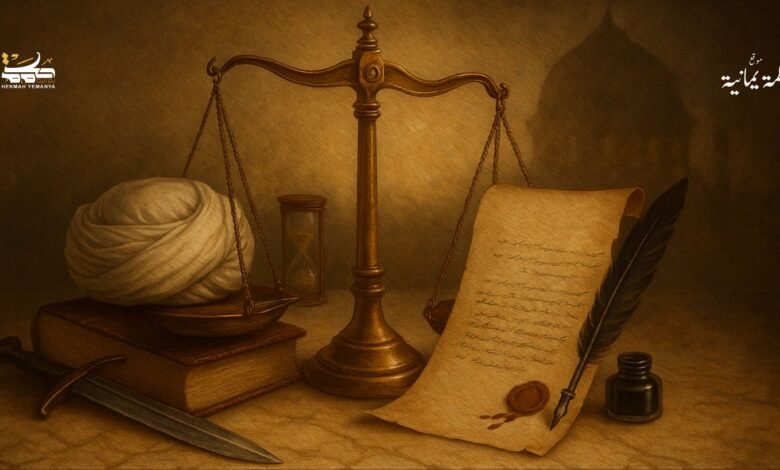
رغم اتفاق جمهور المسلمين على أنَّ الإسلام لم يحدد شكلاً معيّنًا للنظام السياسي، فقد ذهبت معظم الفرق الإسلامية إلى وجوب تنصيب الإمامة السياسية في جميع الأحوال، باستثناء تيار الّلا إمامة في مذاهب كسر السيف واعتزال الفتن من الصحابة ومن شايعهم من أهل السنة والمرجئة وبعض الخوارج والمعتزلة. وإذا كان جمهور أهل السنة يرفضون اعتقاد الشيعة أن الإمامة من أصول الدين ويؤكدون أنها من الواجبات الفرعية، فقد ذهب بعض أهل السنة وجماعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة إلى أن تنصيب الإمام غير واجب شرعًا في المجتمع الراشد القادر على إدارة مصالحه بصورة تعاونية، لأن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة الأمة، لا وظيفة الدولة: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ “110 آل عمران.
وهذه الرؤية تتقاطع مع بعض التصورات في الثقافة “الأناركية” التي تبنتها التيارات الليبرتاريّة في الغرب لمقاومة الرأسمالية والليبرالية. ومصطلح الأناركية مشتق من المصطلح اليوناني المركب “آن” و”آركي” ويترجم حرفيًا ب “اللا دولة” أو “اللا سلطوية” وسنضطر في هذا المقال لاستخدام هذا المصطلح اليوناني لتجنب بعض الإشكاليات في الترجمات العربية و التي تُحيل إلى معاني لا تتفق مع رؤية هذه التناولة للأناركية في الفكر الإسلامي. ومن أبرز المفكرين الأناركيين المعاصرين المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي المشهور بمناهضته للصهيونية والنظام الأمريكي، والذي يرى أن الأناركية نظرية ثورية تحررية تواجه تسلط الدولة، ويرفض ربطها بالعنف والفوضى والتخريب متهمًا الإعلام الغربي بتعمد تزييف صورتها الحقيقية . رغم أن تدخل الدولة شرٌّ لابد منه في تنظيرات بعض فلاسفة الليبرالية الغربية نفسها.
السبق الإسلامي في التأسيس للثقافة الأناركية
وفي هذه التناولة نؤكد أنَّ بعض مدارس الفقه السِّياسي الإسلامي كان لها السَّبق في بلورة الأناركية السياسية بثراء وعمق وتنوع مثير للدهشة. فالأناركية الإسلامية تتنوع بين أناركية اجتناب الفتنة وكسر السيف، والأناركية الثورية في مدرسة النجدات من الخوارج، والأناركية المدنية التعاقدية في مدرسة أبي بكر الأصم من المعتزلة. وأناركية رفض الخروج على السلطة مع رفض الدخول في عمل السلاطين عند ابن حنبل وأبي حنيفة، وأناركية تقييد تسلطية الدولة في فقه الحسن بن الجلال ومدرسة الاجتهاد اليمنية) وتختلف أناركية المعتزلة التي يمثلها الأصولي عبد الرحمن بن كيسان “الأصم” ، عن أناركية المتكلم المعتزلي هشام الفوطي. وقد تبلورت الظاهرة الأناركية في التاريخ الإسلامي بصورة مبكرة، أثناء خلافة علي رضي الله عنه في التيار الذي اعتزل القتال بين علي ومعاوية ورفض مبايعة علي، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو، وهما من المبشرين بالجنة في مدرسة أهل الحديث.
ويشير ابن تيمية إلى أن هذا التوجه الأناركي الاعتزالي كان توجه غالبية الصحابة مؤكدًا أن جمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم اعتزلوا الفتنة، مستدلًا بما رُوي عن محمد بن سيرين: “هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين” ويصف ابن تيمة إسناد هذه الرواية بأنه أصح إسناد على وجه الأرض .

محاولات تحجيم وتشويه الظاهرة الأناركية:
يحاول الكثير من مؤرخي وفقهاء ومتكلمي الفكر السياسي الإسلامي، التهوين من الظاهرة الأناركية في الفكر الإسلامي ووصفها بالشذوذ والخروج عن الإجماع، يقول ابن خلدون في مقدمته: “وقد شذَّ بعض النَّاس فقال بعدم وجوب هذا النَّصب رأسًا – نصب الإمام- لا بالعقل ولا بالشَّرع، منهم الأصمّ من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم” .
وهذا الإمام الزيدي عز الدِّين بن الحسن المؤيد يقول مجادلًا من يقول بوجود الخلاف حول وجوب الإمامة: “اعلم أنَّ خلاف الأصم ومن معه إن صحت الرواية عنهم لا يعتد به، ولا يلتفت إليه، لندرتهم وانقطاع خلافهم، والخلاف واقع بين الأمة وإن خرج عنه بعضهم” ، وقد عقّب عليه العلامة الزيدي علي البكري وأكد أنه “لا وجه للتقييد بقوله إن صحت الرواية لأنها ظاهرة الشهرة عنهم”، وفصّل الأدلة عل ذلك، وفنَّد دعوى المؤيد بالشذوذ والندرة وقال:” وكذلك ما ذكره من ندرتهم غير مُسَلم، فإن المخالف في ذلك أبو بكر الأصم من المعتزلة، وهشام الفوطي، وبعض الحشوية، والنجدات من الخوارج، وبعض المرجية، ولا شك في عدم ندور مثل هؤلاء. وأما انقطاع خلافهم فهو رجم بالغيب لعدم الطريق إلى ذلك، إذ يجوز وجود متابع لهم في بعض النواحي ولم يطلع عليه” .
وما قاله البكري يتفق مع ما أكده العلامة المعتزلي اليمني نشوان الحميري في شرح الحور في قوله: “وقالت الحشوية، وبعض المرجئة والنجدات من الخوارج: إن الإمامة ليست لازمة ولا واجبة، ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إمامًا عدلًا من غير إراقة دم ولا حرب فحسن، وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل امرئ منهم بأمر منزله، ومن يشتمل عليه من ذي قرابة ورحم وجار، وأقام فيهم الحدود والأحكام، على كتاب الله تعالى وسنة نبيه جاز ذلك، وإن لم يكن بهم حاجة إلى إمام، ولا يجوز إقامتها بالسيف والحرب” ولم يوضح نشوان من يقصد بالحشوية هنا، و المعروف أنه في كتاباته عن الحشوية يشير إلى تيار في مدرسة أهل الحديث يتهمه بالتجسيم والجبرية.
هل كانت الأناركية الإسلامية فوضوية كما يصورها خصومها؟
كما تم إساءة تفسير الأناركية في الثقافة الغربية، فقد تعرض الأناركيون في الفكر السياسي الإسلامي للكثير من التشويه فهذا الإمام الجويني يصف الأناركية الإسلامية بالفوضوية وهي نفس التهمة التي توجهها الأنظمة الغربية للتيار الأناركي المعارض لتسلطية الدولة. يقول الجويني في كتابه “غياث الأمم: “فنصب الإمام عند الإمكان واجب. وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب ويجوز ترك الناس أخيافا، يلتطمون ائتلافا واختلافا، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتات رأيهم رابط” ، وينزلق الجويني إلى الإساءة الشَّخصية للأصولي أبي بكر الأصم متهمًا إياه بالخروج عن الإجماع: “وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق بالعقوق، لا يهاب حجاب الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع، والحيد عن سنن الاتباع. وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة” ، وفي كلام الجويني تشويه بالغ لرأي الأصم لا يتفق مع أي تحليل منطقي لمجمل الأقوال المنقولة عن الأصم والمدرسة الأناركية. ويتجاهل الجويني أنَّ الإمام الأصم الذي يتهمه بإنكار الإجماع، هو نفسه المتهم من الإمام أحمد بن حنبل بالتأصيل لمبدأ الاجماع في الفقه السياسي” من ادعى الإجماع فقد كذب لعلَّ الناس قد اختلفوا، تلك دعوى الأصم” ، وقد تبين تهافت دعوى الجويني بالإجماع في موضوعنا كما فصّل ذلك نشوان الحميري. وفي نفس السياق يبالغ القرطبي في التشنيع على الأصم إلى درجة تعييره بصممه فيقول: “ولا خلاف في وجوب ذلك- أي الإمامة- بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه” ومن الواضح أن هذه اللغة الانفعالية في كلام الجويني و القرطبي أثرت سلبًا على موضوعيتهما و تقييمهما العلمي للظاهرة الأناركية.
كيف نفهم مواقف المدرسة الأناركية الإسلامية؟
يتم في الغالب اختزال مواقف المدرسة الأناركية الإسلامية في مقولة الأصم “لو تناصف الناس لاستغنوا عن الإمام” وفي الغالب توصم هذه المقولة الأصمية بأنها فوضوية أو حالمة دون تحري لمجمل الأقوال، وفي أحسن الأحوال يضاف إلى ذكر هذه المقولة مقولة أخرى لهشام الفوطي “إن نصب الإمام غير واجب إذا لم يتناصف الناس وهاجت الفتنة” لأنها تمثل وجهة نظر أناركية معاكسة لنظرة الأصم. فالأصم يسقط وجوب الدولة عند غياب الفتنة، والفوطي يسقط وجوبها عند هياج الفتنة.
ورغم تضافر أقوال الأناركيين في الفكر السياسي الإسلامي على عدم وجوب بناء الدولة، إلا أن ذلك لا يعني رفضهم للدولة عند الحاجة. فإن من يتأمل مجمل أقوالهم يجد أنهم كانوا يهدفون إلى تأكيد أمرين مهمين: أولهما، أن بناء الدولة ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة دنيوية لتحقيق المصالح عند الحاجة إليها. والآخر أن شرعية الدولة لا تُستمد من النص الديني، بل من التعاقد المدني الإنساني، وأن شرعية الحاكم تعتمد على الإجماع الشعبي وتسقط عند الإخلال بالعقد الاجتماعي أو ممارسة الطغيان والتسلط. وهذا يعني أن الهدف الأساسي للأناركية الإسلامية التحرر من كهنوتية وتسلطية الإمامة، وخلع غلاف الغائية المقدسة للدولة وربط الدولة بوظيفتها التعاقدية في خدمة مصالح الناس.
الشهرستاني والعرض الوافي والمنصف:
ومن خلال تتبعي فإن قلة من الراسخين في علم الكلام كالإمام الشهرستاني تمكنوا من انصاف الظاهرة الأناركية في الفكر السياسي الإسلامي واستجلاء موافقها بعمق يعكس الغايات النهائية لمجمل الأقوال. ويصل الشهرستاني إلى نهاية الإقدام في بيان مواقف أناركية الإسلام في كتابه “نهاية الإقدام في علم الكلام”.
يقول الشهرستاني:
“قالت النجدات من الخوارج و جماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم و هشام الفوطي إن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبًا لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب بل هي مبنية على معاملات الناس فإن تعادلوا و تعاونوا و تناصروا على البر والتقوى و اشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه و تكليفه استغنوا عن الإمام و متابعته فإن كل واحد من المجتهدين مثل صاحبه في الدين و الإسلام و العلم و الاجتهاد والناس كأسنان المشط والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة فمن أين يلزم وجوب الطاعة لمن هو مثله.” واستعرض الشهرستاني حجج الأناركيين ومنها أن تنصيب الإمام الواجب الطاعة إما أن يكون بالنص ولا وجود للنص، وإما بالإجماع ولم يتحقق هذا الإجماع، ولا الاختيار التعاقدي من الجميع وهو متعذر، وإذا تحقق فإن شرعية الحاكم تكون شرعيةً تعاقدية تسقط عند الإخلال بالتعاقد.
رئيس يحفظ بيضة الإسلام لا إمام للمسلمين:
ومما يؤكد أن الأناركيين من الخوارج والمعتزلة لا يتبنون الأناركية الفوضوية وأنهم ليسوا ضد مبدأ وجود دولة الحكم الرشيد العادلة التي تقوم على أسس مدنية بعيدة عن كهنوتية الإمامة وتسلطية الاستبداد ما نقله الشهرستاني عنهم بعد استعراض حججهم على اسقاط شرعية الإمامة في النص التالي: “قالوا: فدل هذا كله على أن الإمامة غير واجبة في الشرع، نعم لو احتاجوا إلى رئيس يحمي بيضة الإسلام و يجمع شمل الأنام وأدى اجتهادهم إلى نصبه مقدمًا عليهم جاز ذلك بشرط أن يبقى في معاملاته على النصفة و العدل حتى إذا جار في قضية على واحد وجب عليهم خلعه و منابذته” .
هذا يؤكد أن الأناركيين في المدرسة الإسلامية القديمة لا يرفضون وجود الدولة، بل يرفضون كهنوتية الإمامة وتسلطية الحكم، ويفضلون قيام دولة مدنية على أساس التعاقد والحاجة المجتمعية، يُطلق على رأسها لقب “رئيس” أو “مقدَّم” بدلًا من “إمام”، لما يحمله الأخير من دلالة كهنوتية. وللموضوع بقية .

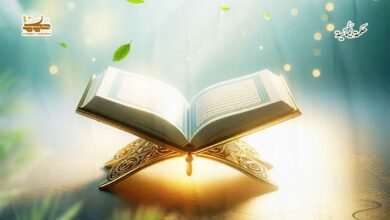
كان حَرِيٌّ بالكاتب التوقف في مستهل مقالته ليُعَرِّفَ مصطلحاتها التي تكرر ورودها في مواضع كثيرة.. التي لا يعرفها إلا المتخصصون وذوي الاهتمام؟!
حتى المثقفون سيلجأون إلى البحث بأنفسهم عن معاني ما أعجم عليهم من تلك المصطلحات، ربما قبل الانتهاء من قراءة المقال نفسه.
الشكر للكاتب على حشده هذا الكم الكبير من مقولات ومواقف علماء المسلمين ذوي الانتماءات الطائفية العديدة حول هذا الموضوع الجيد.
لماذا استخدم الكاتب مصطلح غربي؟