
مقدمة: إعادة تأطير النقاش حول وائل حلاق
يُمثّل كتاب وائل حلاق “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي” لحظة فارقة في الفكر السياسي العربي والإسلامي المعاصر. فهو ليس مجرد إضافة إلى السجال الدائر حول “الإسلام السياسي” أو “الدولة الإسلامية”، بل هو، في جوهره، عملٌ تفكيكي عميق للأسس الأنطولوجية (المعرفية الوجودية) والأخلاقية التي تقوم عليها الدولة القومية الحديثة، أو ما نُفضّل تسميتها هنا بـ “الدولة الحداثية”. إن القيمة الحقيقية للكتاب لا تكمن في تقديم برنامج سياسي بديل، بل في شجاعته على طرح السؤال الأكثر جذرية: “ما هي الدولة؟” وما هي طبيعة علاقتها بالأخلاق والذات الإنسانية؟.1
ومع ذلك، قُوبل هذا العمل الفكري المركّب، في كثير من الأحيان، بقراءات تبسيطية تختزله في إطار ثنائية “الإسلامي” و”العلماني” المألوفة. ويُعدّ النقد الذي يمثله “الشنقيطي” نموذجاً مثالياً لهذا النوع من القراءة. فهذا النقد، الذي يتهم حلاق بـ”الحنين إلى الماضي” أو “العدمية”، يفشل في الاشتباك مع البنية الفلسفية العميقة لأطروحة حلاق، ويكتفي بالتعامل معها كبيان “إسلاموي” آخر يسعى لرفض الحداثة.3
أرتكز في هذه المقالة على فرضية مركزية مفادها أن سوء فهم الشنقيطي وأمثاله لأطروحة حلاق ليس مجرد خطأ في التفسير، بل هو عرضٌ لـ”نقطة عمياء” معرفية (epistemic blind spot) متجذرة في قطاع واسع من الفكر العربي المعاصر. تتمثل هذه النقطة العمياء في استبطان المسلّمات الأنطولوجية والأخلاقية للدولة الحداثية إلى درجة أصبحت معها هذه الدولة تبدو كـ”طبيعة ثانية” أو كإطار محايد وأبدي للتنظيم السياسي.1 ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لتفكيك هذا الإطار من جذوره، كما يفعل حلاق، تبدو بالضرورة غير مفهومة، أو رجعية، أو عدمية. إن النقد الموجه لحلاق هو، ويا للمفارقة، خير دليل على صحة تشخيصه للمأزق؛ فالناقد، بتفكيره داخل الصندوق الذي يسعى حلاق لتفكيكه، يؤكد دون وعي منه على الهيمنة المعرفية لذلك الصندوق.
إن الدفاع عن حلاق، إذن، ليس دفاعاً عن شخصه أو عن كل تفاصيل أطروحته، بل هو في جوهره دفاع عن إمكانية وجود فكر نقدي جذري خارج الإطار الذي تفرضه الحداثة السياسية نفسها. ويهدف هذا المقال إلى إثبات أن حلاق لم يأتِ إلى نقده للدولة الحداثية من موقع الرفض الأيديولوجي السطحي، بل من موقع الفهم العميق والمتمكّن لأصولها الفلسفية في الفكر الغربي. فهو يحاور، ببراعة نادرة، عمالقة الفكر السياسي الغربي من كارل شميت وماكس فيبر إلى ميشيل فوكو وتشارلز تايلور، مستخدماً أدواتهم النقدية ذاتها للكشف عن تناقضات مشروعهم.5 إن إخفاق الشنقيطي في رؤية هذا العمق لا يكشف عن ضعف في حلاق، بل عن أزمة في فكر الناقد نفسه، وهي أزمة الفكر الذي لم يختبر الحداثة اختباراً نقدياً حقيقياً.
جوهر الأطروحة: الدولة الحداثية بوصفها مأزقاً أخلاقياً
إن المدخل الصحيح لفهم أطروحة وائل حلاق يكمن في إدراك أنها، في المقام الأول، “مقالة في الفكر الأخلاقي أكثر منها تعليقاً على السياسة أو القانون”.1 فالمشكلة التي يطرحها ليست مجرد مشكلة توافق عملي بين الشريعة ومؤسسات الدولة، بل هي مشكلة قطيعة معرفية وأخلاقية عميقة أحدثتها الحداثة. يرى حلاق أن “التناقضات المتأصلة في أي تصور لدولة إسلامية حديثة ترتكز في المقام الأول على مأزق الحداثة الأخلاقي”.1 هذا المأزق يتجسد في الفصل المنهجي الذي أقامته فلسفة التنوير بين عالم “ما هو كائن” (Is) — عالم الحقائق العلمية والإدارة البيروقراطية — وعالم “ما يجب أن يكون” (Ought) — عالم القيم والأخلاق.7 لقد أدى هذا الفصل إلى نشوء كيان سياسي، هو الدولة الحداثية، يتصرف كغاية في ذاته، ويستمد شرعيته من إرادته السيادية المجردة، لا من أي نظام أخلاقي متعالٍ عليه.8
في مقابل هذا النموذج، يطرح حلاق ما يسميه “نموذج الحكم الإسلامي” (Paradigmatic Islamic Governance). من المهم هنا التأكيد على أن حلاق لا يتحدث عن “دولة” بالمعنى الحديث، بل عن نموذج حكم مختلف جذرياً في أسسه. ففي هذا النموذج، لم تكن السياسة هي المجال المركزي، بل كانت الأخلاق المستمدة من الشريعة هي القوة العليا التي تنظم المجتمع والحاكم على حد سواء.1 السيادة في هذا النموذج ليست للشعب أو للأمة ككيان مجرد، بل هي لله وحده، وتتجلى في شريعته التي تمثل “السلطة التشريعية” العليا.1 أما المجتمع (الأمة)، فهو المحور العضوي الذي ينتج فقهائه وقضاته، الذين يعملون كوسطاء بين المجتمع والسيادة الإلهية، وغالباً ما كانوا في موقع استقلال، بل ومواجهة، مع السلطة التنفيذية للحكام والسلاطين.9
لفهم عمق هذه القطيعة الأخلاقية، من المفيد وضع حلاق في حوار مع أحد أبرز نقاد الحداثة الأخلاقية من داخل التقليد الغربي نفسه، وهو الفيلسوف ألسدير ماكنتاير. في كتابه المرجعي “بعد الفضيلة” (After Virtue)، يجادل ماكنتاير بأن مشروع التنوير قد فشل في توفير أساس عقلاني للأخلاق بعد تخليه عن المفهوم الأرسطي للـ “غاية” (telos) والفضيلة. والنتيجة، بحسب ماكنتاير، هي سيادة ما يسميه “الانفعالية” (emotivism)، وهي حالة يصبح فيها أي حكم أخلاقي مجرد تعبير عن تفضيل شخصي أو شعور ذاتي، وتفقد اللغة الأخلاقية أي أساس مشترك للحكم العقلاني.11
إن ما يفعله حلاق هو أنه يوضح كيف أن الدولة الحداثية هي التجسيد المؤسسي والسياسي لهذه “الانفعالية” التي شخصها ماكنتاير. فعندما تُفرَّغ السياسة من أي غاية أخلاقية مشتركة (telos) — كتحقيق الفضيلة أو السعادة الأخروية — وتصبح مجرد إدارة للمصالح المتنافسة ضمن إطار سيادي مطلق، فإنها تتحول إلى ساحة للقوة المحضة التي لا يحكمها سوى منطقها الداخلي. وهكذا، فإن نقد حلاق ليس مجرد رفض “إسلامي” للحداثة، بل هو تشخيص دقيق لحالة مرضية في صميم الحداثة، وهو تشخيص يتلاقى مع أعمق تيارات النقد الذاتي في الفكر الغربي. إن “استحالة” الدولة الإسلامية هي استحالة منطقية وليست مجرد صعوبة عملية؛ إذ لا يمكن الجمع بين كيانين يقومان على مبدأين متعارضين: الأول (الحكم الإسلامي) يقوم على خضوع السياسي للأخلاقي، والثاني (الدولة الحداثية) يقوم على سيادة السياسي على الأخلاقي (وفقا لمنطق المصلحة الاقتصادية).
إن جوهر مشروع حلاق هو استعادة “أخلاقيات الفضيلة” (Virtue Ethics) في سياق سياسي. فقلب نموذجه للحكم الإسلامي هو فكرة تكوين “الذات الأخلاقية” من خلال “رعاية الذات” أو ما يعرف في التراث الإسلامي بـ”تزكية النفس”.5 فالشريعة، في فهمه، ليست مجرد مجموعة من القواعد القانونية، بل هي مسار لتهذيب الشخصية وتنمية الفضائل.16 وهذا يوازي تماماً دعوة ماكنتاير للعودة إلى تقاليد الفضيلة الأرسطية للتغلب على التفتت الأخلاقي للحداثة.11 إن فشل الناقد في رؤية هذا الارتباط يكشف عن جهله بأحد أقوى خطوط النقد الداخلي للحداثة الليبرالية الغربية. فالناقد يرى كلمة “شريعة” فيفكر في “قواعد”، بينما يرى حلاق، مثله مثل ماكنتاير، كلمة “فضيلة” فيفكر في “تكوين الشخصية”.
جدول 1: تحليل مقارن للنماذج الحاكمة في إطار وائل حلاق

تشريح "الليفاثان" الحديث: حلاق مُحاوِراً للفلسفة السياسية الغربية
إن القوة التحليلية لأطروحة حلاق لا تنبع من مجرد رفضه للدولة الحداثية، بل من قدرته الفائقة على تفكيكها من الداخل، مستعيناً بترسانة من المفاهيم النقدية التي طورها الفكر الغربي نفسه. فالشنقيطي وأمثاله يخطئون حين يظنون أن حلاق يتحدث عن “الغرب” ككتلة خارجية معادية؛ بل هو في الحقيقة يدخل في حوار نقدي عميق مع آباء الحداثة السياسية ومنتقديها، ليُظهر أن الدولة التي تم تصديرها إلى العالم الإسلامي ليست مجرد مجموعة من المؤسسات المحايدة، بل هي “مشروع” متكامل له أسسه الميتافيزيقية، وآلياته البيروقراطية، وتقنياته في صناعة الذات الإنسانية.
السيادة كلاهوت مُعَلمَن (كارل شميت)
يستلهم حلاق بشكل مباشر أطروحة الفيلسوف والقانوني الألماني كارل شميت القائلة بأن “كل المفاهيم الهامة في النظرية الحديثة للدولة هي مفاهيم لاهوتية معلمنة”.1 فمفهوم “السيادة” الحديث، الذي يُنسب إلى “الأمة” أو “الشعب”، ليس مفهوماً سياسياً بسيطاً، بل هو بناء ميتافيزيقي معقد. إنه يحل محل الإله في التقليد اللاهوتي، فيصبح هو السلطة المطلقة التي لا تعلوها سلطة، والقادرة على “الخلق من العدم” من خلال إرادتها التشريعية.1 الدولة، بهذا المعنى، هي “الإله الفاني” الذي يطالب من رعاياه بأقصى درجات الولاء والتضحية، بما في ذلك التضحية بالحياة نفسها في سبيل بقائها.1
هذا التحليل الشميتي يكشف أن الدولة الحداثية ليست كياناً “علمانياً” بمعنى أنها خالية من أي بعد مقدس أو مطلق. بل على العكس، هي قد “علمنت” (secularized) المفاهيم اللاهوتية وأعادت إنتاجها في المجال السياسي. لقد خلقت لاهوتها السياسي الخاص الذي يتمحور حول تقديس الأمة والدولة. وهذا يجعلها بالضرورة في صراع وجودي مع أي لاهوت سياسي آخر، كالإسلام، الذي يضع السيادة في الله وحده. إن ما يغيب عن الناقد السطحي هو أن الصراع ليس بين “الدين” و”السياسة”، بل بين لاهوتين سياسيين متنافسين، أحدهما يعلن عن نفسه (الإسلامي)، والآخر يخفي طبيعته اللاهوتية خلف قناع العلمانية والعقلانية (الدولة الحداثية).25
العقلانية البيروقراطية والقفص الحديدي (ماكس فيبر)
يستند حلاق في تشريحه لآليات عمل الدولة على التحليل الكلاسيكي الذي قدمه ماكس فيبر، والذي عرّف الدولة الحديثة بأنها الكيان الذي ينجح في احتكار “الاستخدام المشروع للعنف المادي” ضمن حدود إقليمية معينة.19 وتتم ممارسة هذا الاحتكار من خلال جهاز إداري وقانوني ضخم يعمل وفقاً لمبادئ “العقلانية البيروقراطية”: أي الكفاءة، والحياد، والقواعد الصارمة.28
لكن حلاق يذهب أبعد من مجرد الوصف، ليُظهر كيف أن هذه العقلانية البيروقراطية ليست مجرد أداة إدارية، بل هي منطق شامل يعيد تشكيل المجتمع بأسره، ويخضعه لسيطرة الدولة. إنها تخلق “قفصاً حديدياً” (iron cage) من القوانين واللوائح التي تخترق كل جوانب الحياة، من شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة.1 هذا المنطق يتعارض بشكل جوهري مع طبيعة الشريعة كما يفهمها حلاق. فالشريعة، في نموذجه، ليست قانوناً وضعياً جامداً تفرضه الدولة من الأعلى، بل هي خطاب أخلاقي وقانوني مرن، يتطور عضوياً من خلال اجتهادات الفقهاء وتفاعلهم مع أعراف المجتمع.19 وهنا، يستخدم حلاق فهمه العميق لتاريخ الفقه لدحض الصورة الكاريكاتورية التي رسمها فيبر وغيره من المستشرقين عن القضاء الإسلامي تحت مسمى “قضاء القاضي” (Kadijustiz)، والتي تصورته كقضاء اعتباطي وغير عقلاني. على العكس، يثبت حلاق أن الفقه الإسلامي كان يمتلك عقلانية ومنهجية صارمة، لكنها عقلانية أخلاقية وليست عقلانية أداتية بيروقراطية.30
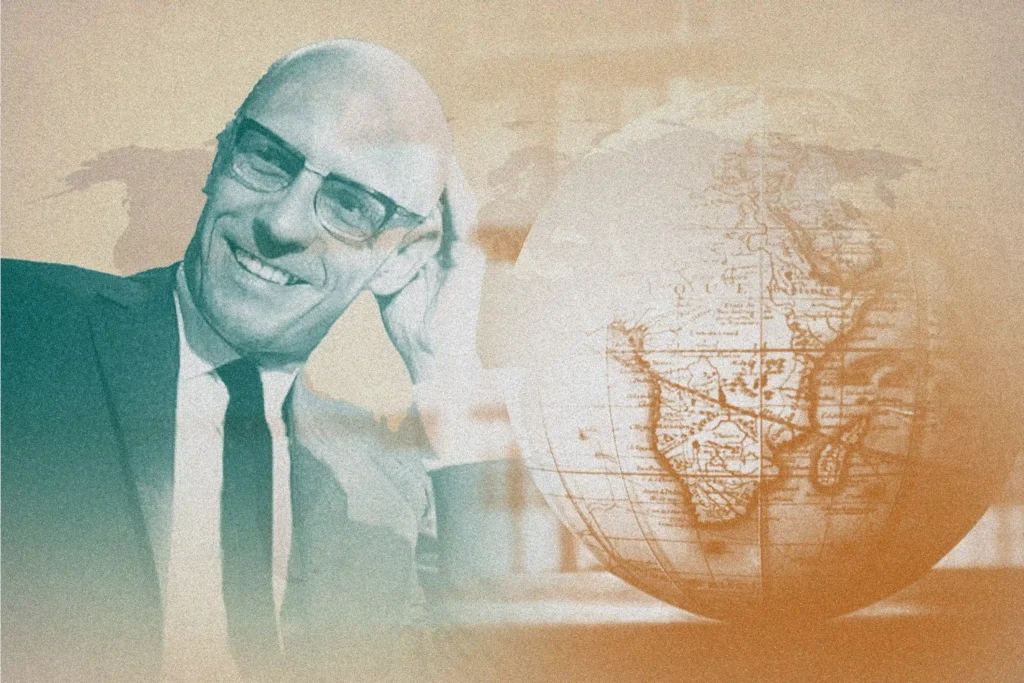
الحكومية وتشكيل الذات الخاضعة (ميشيل فوكو)
لعل أعمق مستويات تحليل حلاق هو استيعابه لأفكار ميشيل فوكو حول السلطة. فالدولة الحداثية، كما تعلم حلاق من فوكو، لا تحكم فقط بالقوة والقانون (السلطة السيادية)، بل تحكم من خلال تقنيات دقيقة ومنتشرة تهدف إلى إدارة وتشكيل حياة الأفراد والمجتمعات. هذا ما أسماه فوكو “الحكومية” (governmentality)، وهي فن الحكم الذي لا يكتفي بقمع الرعية، بل يسعى إلى “إنتاج” المواطن الصالح، والمنتج، والصحي، والقابل للإدارة.33
تُمارس هذه “السلطة الحيوية” (biopower) من خلال شبكة واسعة من المؤسسات كالمدرسة، والمستشفى، والمصنع، والسجن، والإحصاءات السكانية، وغيرها. كل هذه المؤسسات تعمل على تصنيف الأفراد، وتطبيع سلوكهم، وتشكيل ذواتهم بطريقة تجعلهم خاضعين ومنضبطين، لا بدافع الخوف من العقاب فحسب، بل بدافع من رغبتهم في أن يكونوا “طبيعيين” و”أسوياء”.23 إنها سلطة تخترق الجسد والنفس، وتنتج “الذات” الحديثة كأثر من آثارها.
وهنا تكمن المقارنة الأكثر جذرية التي يقدمها حلاق. ففي مقابل هذا “المواطن المُنتَج” من قبل آلة الدولة، يضع حلاق “الذات الأخلاقية” المسلمة في نموذج الحكم الإسلامي. هذه الذات لا تُنتجها سلطة خارجية، بل تتشكل من خلال عملية داخلية من “رعاية الذات” و”تهذيب النفس” (ما يقابل “تقنيات الذات” عند فوكو)، وهي عملية مستوحاة من نصوص الشريعة وممارسات التصوف، وتهدف إلى تحقيق الفضيلة والتقرب من الله، لا إلى الخضوع للدولة.5 إن الصراع إذن ليس فقط بين مؤسستين، بل بين تقنيتين مختلفتين جذرياً في صناعة الإنسان.
الذات المُحصَّنة في عالم منزوع السحر (تشارلز تايلور)
لتكتمل الصورة، يمكننا الاستعانة بمفاهيم الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور في كتابه الضخم “عصر علماني” (A Secular Age)، والتي تلقي ضوءاً كاشفاً على البعد الوجودي للقطيعة التي يصفها حلاق.24 يرى تايلور أن الحداثة أدت إلى تحول في “المخيال الاجتماعي” (social imaginary)، أي في الطريقة التي نعيش بها ونتصور بها العالم بشكل بديهي. لقد انتقلنا من عالم “روحاني” (enchanted) كانت فيه الحدود بين المادي والروحي، وبين الذات والعالم، مائعة وغير واضحة، إلى عالم “منزوع الروح” (disenchanted) نعيش فيه كـ”ذوات منعزلة” (buffered selves).24
الذات المنعزلة هي الذات الحديثة التي تشعر بأنها مستقلة ومنفصلة عن العالم الخارجي، الذي تراه كمجرد مادة خام يمكن السيطرة عليها واستغلالها بواسطة العقل الأداتي. هذا هو بالضبط نوع الذات الذي تفترضه الدولة الحداثية وتعمل على إنتاجه. في المقابل، فإن نموذج الحكم الإسلامي الذي يصفه حلاق يفترض وجود “ذات شفافة” (porous self)، تعيش في كون له معنى أخلاقي، وتتفاعل مع عالم تسكنه قوى روحية، وتكون هويتها مندمجة في جماعة أخلاقية أوسع (الأمة).
إن هذا التحليل يوضح أن التناقض الذي يتحدث عنه حلاق ليس مجرد تناقض سياسي أو قانوني، بل هو تناقض معرفي ونفسي ووجودي عميق بين طريقتين مختلفتين جذرياً في الوجود في العالم. إن الدولة الحداثية ليست مجرد هيكل سياسي؛ إنها التعبير المؤسسي عن تجربة وجودية معينة، هي تجربة الذات المحصّنة في عالم منزوع الغيب. وهذا يجعل مجرد استيرادها وزرعها في تربة حضارية قامت على تجربة وجودية مختلفة أمراً إشكالياً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً. إن حلاق، عبر توليفه الخلاق بين هؤلاء المفكرين، لا يطبق نظرياتهم بشكل آلي، بل يستخدمها للكشف عن البنية الكلية لمشروع الدولة الحداثية: مشروع له مبرره الميتافيزيقي (شميت)، ومنطقه الإداري (فيبر)، وتقنياته في صناعة الذات (فوكو)، وأساسه الوجودي (الأنطولوجي) (تايلور). وهذا التوليف هو ما يغيب تماماً عن قراءة الناقد السطحية.
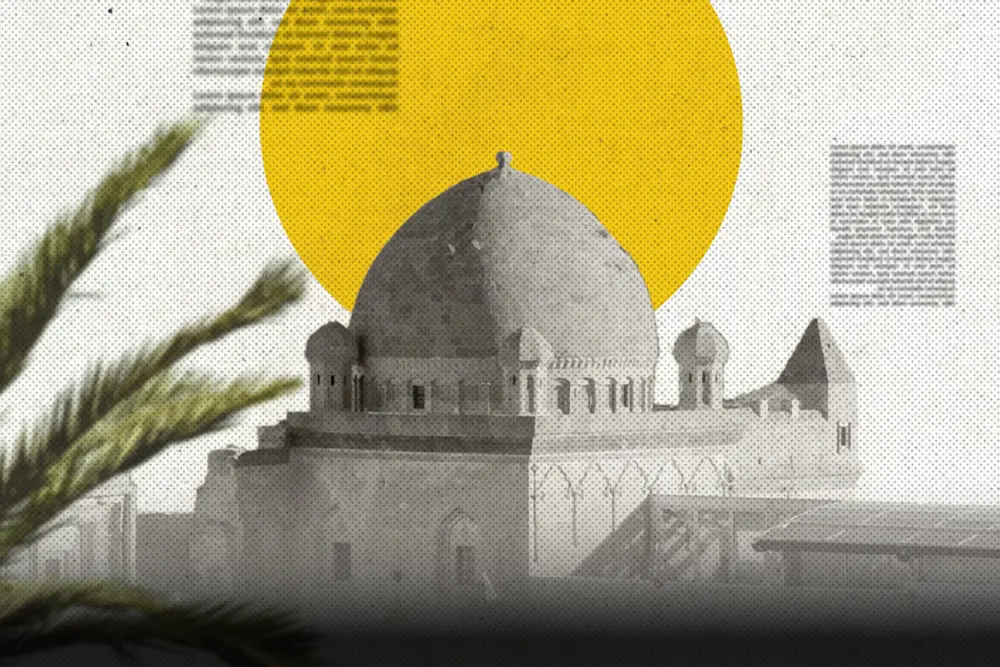
النقطة العمياء لدى الناقد الإسلاموي: حداثة لم تُمتَحَن في الفكر العربي المعاصر
إن إخفاق ناقد مثل “الشنقيطي” في فهم عمق أطروحة حلاق ليس مجرد قصور فردي، بل هو عرضٌ لأزمة أوسع وأعمق في الفكر العربي المعاصر، وهي أزمة التعامل مع الحداثة. فالدولة القومية التي نشأت في العالم العربي والإسلامي لم تكن نتاج تطور عضوي داخلي، بل كانت، في معظمها، إرثاً مباشراً للمرحلة الاستعمارية. لقد ورثت النخب الوطنية ما بعد الاستقلال هياكل الدولة من المستعمر كـ”أمر واقع” وحتمي، وتعاملت معها كأداة محايدة يمكن استخدامها لبناء الأمة وتحقيق التقدم.40 انصب النقد، في معظمه، على ممارسات هذه الدولة (كالاستبداد والفساد والتبعية)، ولكنه نادراً ما ارتقى إلى مستوى نقد كينونة الدولة ذاتها، أي تفكيك أسسها الفلسفية والمعرفية التي ورثتها عن نموذجها الأوروبي.42
هذا الموقف الفكري له جذوره في اللحظة التأسيسية للفكر العربي الحديث، أي فترة “النهضة” في القرن التاسع عشر. ففي تلك الفترة، تسربت مفاهيم الحداثة الغربية (كالتقدم، والأمة، والمواطنة، والعقلانية، والقانون الوضعي) إلى العقل العربي ليس كخيارات فلسفية قابلة للنقاش، بل كضرورات تاريخية لا مفر منها لمواجهة “التخلف” واللحاق بـ”العصر”.43 لقد تم استبطان هذه المفاهيم بشكل غير واعٍ، وأصبحت جزءاً من “المخيال الاجتماعي” للنخب المثقفة، بحيث غدت هي الإطار الذي لا يمكن التفكير خارجه. وهذا بالضبط ما يمنع اليوم من فهم نقد جذري مثل نقد حلاق، الذي لا يكتفي بنقد “تطبيقات” الحداثة، بل يجرؤ على مساءلة “أسس” الحداثة نفسها.
وهنا، يمكننا توظيف مفهوم الفيلسوف السوري صادق جلال العظم، “الاستشراق المعكوس” (Orientalism in Reverse)، كأداة تحليلية فعالة لفهم الموقف الفكري للشنقيطي وأمثاله.44 فكما انتقد العظم إدوارد سعيد بأنه، في معرض نقده للاستشراق، وقع هو نفسه في فخ إضفاء جوهر ثابت وماهية أزلية على “الغرب”، فإن كثيراً من المفكرين العرب، في نقدهم للغرب، يقعون في الفخ المقابل، وهو إضفاء جوهر مثالي وثابت على “الشرق” أو “الإسلام” كبديل جاهز.45 إنهم يقلبون ثنائية المستشرق (غرب عقلاني متفوق / شرق لاعقلاني متخلف) إلى ثنائية جديدة (غرب مادي منحط / شرق روحي أصيل)، لكنهم يحتفظون بالبنية الثنائية الماهوية ذاتها، وهي بنية حداثية بامتياز ورثوها عن الفكر الذي يزعمون نقده.
الشنقيطي، في نقده لحلاق، يمارس نوعاً من هذا “الاستشراق المعكوس”. فهو يفترض مسبقاً أن “الدولة” هي الشكل الوحيد الممكن للتنظيم السياسي، ثم ينتقد حلاق لأنه يقدم نموذجاً “غير واقعي” أو “مثالياً” من الماضي. إنه يفشل في رؤية أن حلاق لا يقارن بين دولتين، بل بين نموذجين مختلفين جذرياً للحكم والوجود. إن الناقد، بانشغاله في الدفاع عن إمكانية “أسلمة” الدولة الحديثة، يظل أسيراً للإطار المعرفي الذي أنتج هذه الدولة. إنه ينتقد الغرب، ولكنه يفكر بأدواته ومقولاته الأساسية.
تتجلى هذه السطحية المنهجية بشكل صارخ في مقارنة الشنقيطي بين التجربتين التركية والفرنسية، وهي مقارنة يقدمها كدليل على أن الإسلاميين هم دعاة الديمقراطية الحقيقيون في مواجهة “العلمانية الاستبدادية”. يرى الشنقيطي أن “القوى السياسية المتدينة في تركيا هي وقود المعركة من أجل تحقيق الديمقراطية”، بينما كان نظراؤهم الكاثوليك في فرنسا “يتحالفون مع النظام القديم والثورة المضادة”. هذه المقارنة، على وجاهتها الظاهرية، تخفي مغالطة عميقة وتكشف عن النقطة العمياء ذاتها التي ينتقدها حلاق.
فالشنقيطي يقرأ الصراع على مستوى الفاعلين (إسلاميون ضد علمانيين) ويفشل في رؤيته على مستوى البنى (منطق الدولة الحداثية ضد منطق المجتمع). إن ما يسميه “العلمانية الاستبدادية” في تركيا ليس انحرافاً عرضياً أو سوء فهم للديمقراطية من قبل النخب الكمالية، بل هو النتيجة المنطقية والحتمية لمحاولة فرض نموذج الدولة الحداثية -بكل حمولتها الفلسفية من السيادة المطلقة، والعقلانية الأداتية، وتقنيات السلطة الحيوية- على مجتمع ذي بنية أخلاقية (وجودية ومعرفية) مختلفة. لقد كانت الدولة الكمالية مشروعاً “هندسياً” بامتياز، يهدف إلى خلق “إنسان جديد” ومجتمع جديد على صورة النموذج الأوروبي. وهذا المشروع، بحكم تعارضه الجذري مع “الذات الشفافة” المتجذرة في المخيال الإسلامي للمجتمع، لم يكن ليُفرض إلا بالقوة والقهر. فالاستبداد الذي يشير إليه الشنقيطي ليس نقيضاً لمشروع الدولة الحداثية في تركيا، بل هو أداته الضرورية ووجهه الحقيقي. إنه العنف اللازم لعملية “التثقيف” القسري التي تمارسها الدولة على رعاياها لتحويلهم إلى “مواطنين” بالمعنى الحداثي.
وهنا يكمن الخلل في دفاع الشنقيطي عن “الديمقراطية”. فهو يتعامل مع الديمقراطية كآلية إجرائية محايدة (صناديق اقتراع، تداول سلطة) يمكن فصلها عن أسسها الفلسفية. لكن الديمقراطية، في سياق الدولة الحداثية، ليست مجرد آلية، بل هي تجسيد لمبدأ “سيادة الشعب”، وهو المفهوم الذي حلّ محل “سيادة الله” كما بيّن حلاق بالاستناد إلى شميت. إن المشاركة في اللعبة الديمقراطية الحداثية تعني القبول المسبق بأن السيادة النهائية تعود إلى “الإرادة العامة” للشعب، وأن القانون هو ما تسنه الأغلبية عبر ممثليها، وليس ما هو مستمد من مصدر إلهي متعالٍ. فالقانون هنا يُصنع ولا يُكتشف، وهو نتاج إرادة بشرية متغيرة لا حقيقة أخلاقية ثابتة. لذلك، عندما يحتفي الشنقيطي بـ “ديمقراطية” الإسلاميين في تركيا، فإنه يغفل عن أنهم، لكي يشاركوا في هذه اللعبة، اضطروا إلى القبول بفرضياتها الأساسية. لقد قبلوا بمنطق الدولة القومية، وبمبدأ السيادة الشعبية، وبفكرة أن الشريعة يجب أن تُترجم إلى “قوانين وضعية” تقرها أغلبية برلمانية. وبهذا، فإنهم لا يتحدون “القفص الحديدي” الفيبري للدولة الحداثية، بل يسعون فقط إلى إدارته بأنفسهم وتلوينه بصبغة إسلامية حتى يأذن الله بالفرج، فهذه اللعبة لا يمكن استدامتها طويلا ًما دامت خاضعة لمنطق الدولة الحداثية، فالدولة الحداثية تُنتج مجتمعاً حداثياً، كما يُنتج القالبُ شكلَ المادّة المصبوبة فيه. فلا يمكن لصبغة إسلامية خارجية أن تغيّر من طبيعة البنية التي تشكّل الوعي والسلوك والقيم والمعنى ذاته. وكما لا يمكن لعجينٍ وُضع في قالبٍ معدني أن يخرج بشكلٍ آخر، فإن محاولة أسلمة الدولة الحداثية تظل محكومة بشكلها الجوهري لا بمضمون النوايا. إنها محاولات تزيينية تُبقي على جوهر الحداثة وسلطتها، وتكتفي بتزيين جدران القفص الحديدي دون كسر قضبانه.
وهكذا، فإن المقارنة مع فرنسا مضللة للغاية. ففي فرنسا، كانت الدولة الحداثية نتاجاً لتطور تاريخي داخلي طويل، وتعبيرًا عن تحولات اجتماعية وفلسفية عميقة في المجتمع نفسه. أما في تركيا، فقد كانت “عملية زرع” لكيان غريب في تربة ترفضه. فالصراع في فرنسا كان بين تصورات مختلفة داخل الحداثة، بينما الصراع في تركيا هو بين مشروع الحداثة نفسه وبين مجتمع لم يستبطن بعد مسلماته. إن معاناة تركيا اليوم من الاستقطاب الحاد والتأرجح نحو الاستبداد ليست دليلاً على فشل “العلمانيين” ونجاح “الإسلاميين”، بل هي دليل دامغ على صحة أطروحة حلاق: إن “الدولة المستحيلة” هي مشروع عنيف بطبيعته، وأن محاولة التوفيق بين النموذجين المتناقضين لا تنتج تلاقحاً وتوفيقاً، بل تنتج حالة مزمنة من الصراع الأهلي والتشوه السياسي. فالشنقيطي، في احتفائه بـ “ديمقراطية” الإسلاميين، يغفل عن أنهم هم أنفسهم، بوصولهم إلى السلطة، يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام أدوات “القفص الحديدي” الفيبري للدولة الحداثية، فيعيدون إنتاج منطق الهيمنة الذي انتقدوه، ولكن بغطاء إسلامي.

مغالطة "تمسيح الإسلام": قراءة خاطئة لمشروع حلاق الأخلاقي
تصل “النقطة العمياء” لدى الشنقيطي إلى ذروتها في اتهامه لحلاق بمحاولة “تمسيح الإسلام”، أي تسويق “نوع من الإسلام المنزوع الدسم” الذي لا ينصر مظلوماً ولا يردع ظالماً، وهو مجرد “تلفيق من مواريث الورع البدعي والزهد الزائف”. هذا الاتهام لا يكشف فقط عن سوء فهم عميق لمشروع حلاق، بل يكشف أيضاً عن طبيعة الإطار الفكري الذي ينطلق منه الناقد، وهو إطار يختزل “السياسة” في “القوة” و”الصراع”، و”الدين الفاعل” في “الأيديولوجيا الحركية”.
إن لجوء الشنقيطي إلى هذه التهمة هو بحد ذاته مغالطة شخصنة (Ad Hominem) واضحة، تهدف إلى الطعن في دوافع الكاتب وخلفياته بدلاً من الاشتباك مع قوة حججه. لكن الأهم من ذلك هو تفكيك المنطق الكامن وراء هذه التهمة. فالشنقيطي يرى في تركيز حلاق على البعد الأخلاقي والروحي في الإسلام، وعلى شخصيات مثل الغزالي وطه عبد الرحمن، دليلاً على “انسحاب من التدافع” و”دروشة” و”خمول”. هذا التفسير خاطئ من أساسه، لأنه ينطلق من فرضية حداثية بحتة، وهي أن “السياسي” هو المجال الأعلى والفاعل، وأن أي تركيز على “الأخلاقي” أو “الروحي” هو بالضرورة تراجع عن السياسة وانكفاء عليها.
لكن مشروع حلاق يهدف تحديداً إلى قلب هذه المعادلة. فهو لا يدعو إلى إحلال الأخلاق محل السياسة، بل إلى إعادة تأسيس السياسة على الأخلاق. إن تركيزه على “تكوين الذات الأخلاقية” ليس دعوة إلى الانعزال في صومعة، بل هو تأكيد على أن أي مشروع سياسي إسلامي حقيقي لا يمكن أن يبدأ من السعي للاستيلاء على السلطة (أي الدولة)، بل يجب أن يبدأ من الشرط المسبق لكل سياسة راشدة: وهو وجود “ذوات أخلاقية” فاعلة. فالسياسة، في النموذج الذي يطرحه حلاق، ليست غاية في ذاتها، بل هي امتداد طبيعي للأخلاق. وعندما ينهار الأساس الأخلاقي، كما حدث في الحداثة، تتحول السياسة إلى مجرد صراع على القوة، وهو ما يرفضه حلاق.
أما استشهاد الشنقيطي ببعض العبارات التي تبدو “لاهوتية” مثل “الله نفسه تاريخي” أو “الفقراء جزء من الله” كدليل على “الروح المسيحية” لدى حلاق، فهو يكشف عن قراءة حرفية وسطحية تفتقر إلى أبسط أدوات التحليل الفلسفي. فحلاق هنا لا يتحدث بلغة اللاهوت العقائدي، بل بلغة الفلسفة النقدية والفينومينولوجيا. فقوله بأن “الله تاريخي” لا يعني أن ذات الله (سبحانه وتعالى) تتغير، بل يعني أن تجربة البشر وفهمهم وإدراكهم للذات الإلهية هي تجربة تاريخية تتشكل عبر الزمان والمكان والثقافة. وهذا مفهوم أساسي في علم التأويل الحديث. وبالمثل، فإن عبارة “الفقراء جزء من الله” ليست تعبيراً عن عقيدة “التجسد” المسيحية، بل هي استعارة بلاغية للتأكيد على المركزية الأخلاقية المطلقة للفقراء في الرؤية الإسلامية للعدالة، وأن الاهتمام بهم ليس مجرد عمل خيري، بل هو جزء من صميم العلاقة مع الله. إن قراءة الشنقيطي لهذه العبارات كعقائد لاهوتية حرفية هي دليل على عدم إلمامه بالخطاب الفلسفي المعاصر الذي يتحاور معه حلاق.
في نهاية المطاف، فإن تهمة “تمسيح الإسلام” هي الإسقاط النهائي للمأزق الفكري للناقد. فلأنه لا يستطيع أن يتخيل سياسة لا تتمحور حول الدولة، ولا قوة لا تتمثل في العنف المشروع، ولا فاعلية لا تتجسد في الحزب الأيديولوجي، فإنه يرى في دعوة حلاق للعودة إلى مركزية الأخلاق نوعاً من “الخصاء” السياسي للإسلام. إنه يفشل في إدراك أن حلاق لا يدعو إلى إسلام “أقل سياسية”، بل إلى فهم “أكثر أصالة” للسياسة في الإسلام، سياسة تبدأ من الذات وتنتهي في الله، ولا تتخذ من الدولة الحداثية صنماً تعبده.

الرد على الإشكاليات المنهجية واستيعاب الفروق الدقيقة
إن أي دفاع جاد عن أطروحة حلاق لا بد أن يتجاوز مجرد تكرار حججه، ليتصدى بشكل مباشر للنقود المنهجية التي وُجهت إليه، وأن يتعامل بجدية مع النقاط التي قد تبدو إشكالية في عمله. فالدفاع النقدي لا يعني التبني الأعمى، بل يعني تعميق الفهم من خلال الحوار مع الاعتراضات.
منهجية "النموذج الإرشادي" (Paradigm): دفاع فيبر-كوني
من أبرز الاعتراضات التي توجه لحلاق هو اتهامه بـ”الماهوية” (essentialism) و”اللا-تاريخية”، وذلك لأنه يقارن بين “نموذج” مثالي لما قبل الحداثة و”واقع” فعلي للحداثة، وهي مقارنة تبدو غير متكافئة منهجياً.5 هذا النقد، الذي عبرت عنه لمى أبو عودة وآخرون، يغفل عن الطبيعة التحليلية لأداة “النموذج” التي يستخدمها حلاق. إن حلاق لا يقدم سرداً تاريخياً وصفياً، بل يستخدم مفهوم “النموذج الإرشادي” (Paradigm) بالمعنى الذي نجده عند فيلسوف العلم توماس كون، ومفهوم “النمط المثالي” (Ideal Type) بالمعنى الذي نجده عند ماكس فيبر.6
الهدف من هذه الأداة المنهجية ليس تصوير الواقع التاريخي بكل تفاصيله وتعقيداته، بل استخلاص “البنية المنطقية” و”المبادئ التأسيسية” التي تحكم نظاماً فكرياً أو اجتماعياً معيناً.50 فحين يتحدث حلاق عن “نموذج الحكم الإسلامي”، فهو لا يدعي أن كل الممارسات التاريخية للحكام المسلمين كانت مطابقة لهذا النموذج، بل يستخلص المبادئ الأساسية التي شكلت “الإطار المرجعي” أو “المجال المركزي” الذي حكم النقاشات والتوقعات والممارسات في تلك الحضارة. وبالمثل، حين يصف “نموذج الدولة الحداثية”، فإنه يستخلص خصائصها الجوهرية (form-properties) التي تميزها كشكل سياسي فريد.1 إن المقارنة إذن هي بين بنيتين منطقيتين متناقضتين، وهذا عمل تحليلي مشروع تماماً في الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع التاريخي. إن اتهام حلاق باللا-تاريخية هنا هو أشبه باتهام عالم الهندسة باللا-واقعية لأنه يتحدث عن “المثلث المثالي” الذي لا يوجد في الطبيعة.
دحض تهمة "الشريعة الجامدة"
يرتبط بالنقد السابق نقد آخر، عبر عنه سعيد صالح كيماكجي وغيره، مفاده أن حلاق، في “الدولة المستحيلة”، يقدم صورة “جامدة” و”متجمدة” للشريعة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع مجمل مسيرته الأكاديمية التي كرسها لإثبات الديناميكية الهائلة للفقه الإسلامي ودحض أسطورة “غلق باب الاجتهاد”.10 هذا النقد يقع في خطأ منهجي فادح، وهو الخلط بين مستويات التحليل.
في أعماله التاريخية المتخصصة، مثل “الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحولات” (Shari’a: Theory, Practice, Transformations) و”السلطة والاستمرارية والتغيير في الشريعة الإسلامية” (Authority, Continuity, and Change in Islamic Law)، يعمل حلاق كمؤرخ للقانون، فيرصد بدقة آليات التغيير والتطور والاجتهاد داخل التقليد الفقهي عبر القرون.51 أما في “الدولة المستحيلة”، فهو يعمل كفيلسوف سياسي، يحلل “النموذج الإرشادي” أو “البنية العميقة” (episteme) للنظام. من الممكن تماماً، بل ومن الضروري، القول بأن نموذجاً ما يمتلك بنية منطقية أساسية ثابتة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود حركة وتطور هائلين داخل حدود تلك البنية.
فالديناميكية الهائلة للفقه والاجتهاد التي وثقها حلاق في أعماله الأخرى كانت تحدث دائماً ضمن إطار النموذج الأوسع الذي يفترض سيادة الله العليا وخضوع السياسي للأخلاقي. لم يكن الاجتهاد يهدف إلى تغيير هذه المبادئ التأسيسية، بل إلى تطبيقها على وقائع متغيرة. فالناقد هنا يخلط بين قواعد لعبة الشطرنج (النموذج الثابت نسبياً) والعدد اللانهائي من المباريات الممكنة التي يمكن لعبها (الممارسة التاريخية المتغيرة). لا يوجد أي تناقض بين الأمرين، والقول بوجوده يكشف عن عدم فهم لطبيعة التحليل البنيوي الذي يقدمه حلاق في هذا الكتاب.

الاختلاف مع حلاق: "الحديث" و"الحداثة" و"الحداثات البديلة"
لعل من أبرز النقاط التي أخذتها شخصيا على حلاق هي ميله إلى قرن الدولة الحديثة تبادلياً بالحداثة بشكل يكاد يكون حصرياً من خلال تجربتها الغربية. فعندما يتحدث حلاق عن “مأزق الحداثة الأخلاقي”، فهو يقصد في المقام الأول مأزق مشروع التنوير الأوروبي وما تلاه. وعندما يفكك “الدولة الحديثة”، فهو يركز على نموذج الدولة القومية السيادية الذي نشأ في أوروبا وانتشر عبر الاستعمار ولكن استخدام مصطلح الحديث عوضاً عن الحداثي قد يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة، وهي إغلاق الباب أمام إمكانية تخيل أو بناء “حداثات بديلة” أو “متعددة”. وهو ما جعل حلاق يبدو وكأنه يضع العالم الإسلامي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما رفض التحديث برمته والعودة إلى نموذج ما قبل حداثي (وهو ما ينفي هو نفسه إمكانيته)، أو قبول الحداثة الغربية مع كل تناقضاتها الأخلاقية. هذا الطرح، على قوته التشخيصية، جعلته يبدو أنه يدعو إلى نوع من الانسحاب من المجال السياسي بمعناه الواسع، والتركيز على بناء “جماعات أخلاقية” صغيرة ومحلية تمارس “رعاية الذات” بعيداً عن سلطة الدولة. هذه الدعوة، على نبلها، قد تبدو للبعض بمثابة نوع من “التيئيس” أو “الاستقالة السياسية” التي تترك الميدان مفتوحاً أمام القوى القائمة، سواء كانت دولاً استبدادية أو حركات عنيفة. إن أطروحة حلاق، بقوتها التشخيصية الهائلة، قد تفتقر إلى نظرية في “الفعل السياسي” (Political Action) تناسب العصر، مما يجعلها عرضة لاتهامها بالعدمية السياسية، ليس بمعنى إنكار القيم، بل بمعنى غياب أي برنامج عملي للتغيير على المستوى الكلي. فإذا كانت الدولة الحداثية هي “قفص حديدي” لا يمكن إصلاحه أخلاقياً، وإذا كان نموذج ما قبل الحداثة “غير قابل للاستعادة”، فما الذي يتبقى للمسلمين أن يفعلوه في حاضرهم؟ هذا الطرح لا يترك مساحة كافية لمسار ثالث: وهو بناء دولة حديثة غير غربية، دولة حديثة تستفيد من بعض مكتسبات العصر التقنية والعلمية، ولكنها تبني مؤسساتها السياسية والاجتماعية على أسس أنطولوجية وأخلاقية مختلفة، مستمدة من تراثها الخاص.
إن عمل حلاق، بهذا المعنى، هو عمل “تفكيكي” بامتياز، ولكنه قد لا يكون عملاً “بنائياً” بالقدر الكافي. إنه ينجح بشكل باهر في هدم الادعاءات الكونية للحداثة الغربية، ولكنه يغلق الباب أمام العقل المُسلم لتخيل دولة إسلامية حديثة. فبدلاً أن يكون تقريره هو “استحالة الدولة الإسلامية الحديثة” ، كان يجب أن يكون ” استحالة الدولة الإسلامية الحداثية” وعندها يصبح السؤال المطروح: “ما هو شكل التكوين السياسي الحديث غير الغربي الذي يمكن أن ينبثق من التقليد الإسلامي؟”
باختصار، يظل عمل حلاق إسهاماً فكرياً لا غنى عنه، لكن قيمته تكمن في كونه “مقدمة” ضرورية لأي فكر سياسي إسلامي مستقبلي، وليس الكلمة النهائية فيه. لقد نجح في تغيير طبيعة الأسئلة التي يجب أن نطرحها، وهذا إنجاز هائل. أما مهمة البحث عن إجابات عملية وبناءة، فهي المهمة التي تقع على عاتق جيل جديد من المفكرين والفاعلين، مسلحين بالرؤية النقدية التي قدمها حلاق، ولكن متجاوزين لحدودها في الوقت ذاته.
ما بعد الدولة المستحيلة: نحو تحرير المخيال السياسي
لقد سعينا في هذه المقالة إلى تقديم دفاع نقدي عن أطروحة وائل حلاق في كتابه “الدولة المستحيلة”، ليس من خلال تبنيها بشكل أعمى، بل عبر الكشف عن عمقها الفلسفي الذي غالباً ما تغفله القراءات السطحية. لقد أظهرنا أن نقد حلاق للدولة الحداثية ليس نابعاً من رفض أيديولوجي بسيط أو حنين رومانسي للماضي، بل هو نتيجة اشتباك معرفي عميق مع التراث الفلسفي الغربي الذي أنتج هذه الدولة. إن حلاق، في حواره مع شميت وفيبر وفوكو وتايلور وماكنتاير، يقف على أرضية صلبة من النظرية النقدية، ويستخدم أدواتها لتشريح “الليفاثان” الحديث وكشف مأزقه الأخلاقي المتأصل.
كما بيّنا، فإن إخفاق نقاد مثل “الشنقيطي” في استيعاب هذا العمق ليس مجرد سوء فهم، بل هو عرضٌ لأزمة فكرية أوسع، تتمثل في استبطان مقولات الحداثة السياسية الغربية كمسلّمات نهائية وغير قابلة للنقاش. إنهم ينتقدون الغرب بينما لا يزالون أسرى لمخياله السياسي، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن رؤية أن الدولة القومية ليست إطاراً محايداً، بل هي مشروع أنطولوجي وأخلاقي شامل يعيد تشكيل الذات والمجتمع على صورته.
إن القيمة الحقيقية لكتاب “الدولة المستحيلة” لا تكمن في تقديمه وصفة جاهزة لنظام حكم بديل — وهو ما لم يدّعِ فعله قط — بل تكمن في وظيفته “الهدّامة” (Deconstructive) بالمعنى الفلسفي الدقيق. إنه عمل يهدف إلى تحرير العقل والمخيال السياسي من سجن الدولة القومية كشكل أبدي ووحيد ممكن للتنظيم السياسي.2 إنه يفتح الباب أمام طرح أسئلة أكثر جذرية وأهمية من سؤال “كيف نُأسلم الدولة؟”، أسئلة من قبيل: “ما هو الحكم الصالح؟”، “كيف يمكن بناء نظام سياسي يكون فيه الأخلاقي هو المجال المركزي الذي يحكم كل المجالات الأخرى؟”، و”كيف يمكننا استعادة الذات الفاعلة أخلاقياً في مواجهة تقنيات السلطة الحديثة التي تسعى إلى إخضاعها وإدارتها؟”.
بهذا المعنى، يمكن قراءة مشروع حلاق على أنه يتجاوز حدود “الإسلاموية” التقليدية التي هي، في معظمها، حركة حداثية تسعى للاستيلاء على الدولة. قد يكون عمل حلاق، إذن، هو الأساس النظري لنوع من “ما بعد الإسلاموية” (post-Islamism) الحقيقية، التي لا تكتفي بمراجعة تكتيكات الحركة الإسلامية، بل تتجاوز هدفها المركزي المتمثل في الدولة القومية.59
في نهاية المطاف، “الدولة المستحيلة” ليس كتاباً يقدم إجابات سهلة، بل هو دعوة شجاعة ومقلقة لبدء التفكير من جديد. إنه ليس نهاية الطريق، بل هو بداية ضرورية لأي تفكير جاد ومسؤول في مستقبل الحكم والأخلاق والمجتمع، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في عالم يواجه مأزق الحداثة الذي شخصه حلاق ببراعة نادرة.
الهوامش:
- The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, accessed July 24, 2025, https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/wael-b-hallaq-the-impossible-state_-islam-politics-and-modernityc3a2e282ace284a2s-moral-predicament-columbia-university-press-2013.pdf
- New Texts Out Now: Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament – Jadaliyya, accessed July 24, 2025, https://www.jadaliyya.com/Details/29533
- Propaganda after Prophecy: The Politics of Truth in Contemporary Iran, 1941-2009, accessed July 24, 2025, https://escholarship.org/uc/item/95p0r4s1
- Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha 0231193882, 9780231193887 – DOKUMEN.PUB, accessed July 24, 2025, https://dokumen.pub/reforming-modernity-ethics-and-the-new-human-in-the-philosophy-of-abdurrahman-taha-0231193882-9780231193887.html
- Book Review of The Impossible State by Wael Hallaq – Scholarship @ GEORGETOWN LAW, accessed July 24, 2025, https://scholarship.law.georgetown.edu/context/facpub/article/2279/viewcontent/Book_Review_of_Wael_Hallaq_s_book.pdf
- Hallaq’s Challenge: Can the Shari’ah Save Us from Modernity? – American Journal of Islam and Society, accessed July 24, 2025, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/download/1109/442/1598
- Restating Orientalism: Forty Years After Edward Said – The Current, accessed July 24, 2025, http://www.columbia-current.org/restating-orientalism.html
- Musings on The Impossible State – Traversing Tradition, accessed July 24, 2025, https://traversingtradition.com/2018/11/12/musings-on-the-impossible-state/
- “Book Review of The Impossible State by Wael Hallaq” by Lama Abu-Odeh – Scholarship @ GEORGETOWN LAW, accessed July 24, 2025, https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1269/
- Book Review: Wael Hallaq’s “The Impossible State” by Said Salih …, accessed July 24, 2025, https://themaydan.com/2016/12/book-review-wael-hallaqs-impossible-state-said-salih-kaymakci/
- After Virtue by Alasdair MacIntyre | EBSCO Research Starters, accessed July 24, 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/after-virtue-alasdair-macintyre
- Review: Alasdair MacIntyre’s “After Virtue” : words and dirt, accessed July 24, 2025, https://www.words-and-dirt.com/words/review-alasdair-macintyres-after-virtue/
- (PDF) Thinking Islamic Governance with Continental Philosophy – ResearchGate, accessed July 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/332655388_Thinking_Islamic_Governance_with_Continental_Philosophy
- The Concept of Tazkiyat al-Nafs by Al-Ghazali as a Method in Moral Education, accessed July 24, 2025, https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/download/5954/2021
- Toward a Framework for Islamic Psychology and Psychotherapy: An Islamic Model of the Soul – PMC – PubMed Central, accessed July 24, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6132620/
- A Theory for a Virtue Ethics-Oriented Interpretation of the Qur’an, accessed July 24, 2025, https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=134956
- Neither Virtuous Nor Vicious: A Critique of Contemporary Virtue Ethics | Church Life Journal, accessed July 24, 2025, https://churchlifejournal.nd.edu/articles/neither-virtuous-nor-vicious-a-critique-of-contemporary-virtue-ethics/
- From Kingship to Mosque: Political Theology in the Islamic World – South Asia Times, accessed July 24, 2025, https://southasiatimes.org/from-kingship-to-mosque-political-theology-in-the-islamic-world/
- The Islamic State in Contemporary Thought: A Critical Analysis of Wael Hallaq’s Perspective, accessed July 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391318167_The_Islamic_State_in_Contemporary_Thought_A_Critical_Analysis_of_Wael_Hallaq’s_Perspective
- Moin on Hallaq, ‘Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge’ | H-Net, accessed July 24, 2025, https://networks.h-net.org/node/22055/reviews/5542145/moin-hallaq-restating-orientalism-critique-modern-knowledge
- The Concept of Public Law in Wael B. Hallaq’s Paradigm in Islamic Jurisprudence, accessed July 24, 2025, https://www.journalisslp.com/index.php/isslp/article/download/183/327/1262
- ethics, gender, and the islamic legal project – Yale Law School, accessed July 24, 2025, https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/kamel/katz_final_proofs.pdf
- Foucault Subject and Power.pdf – Kobe University, accessed July 24, 2025, https://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD2018%20readings/IPD1%202018%20No.8/Foucault%20Subject%20and%20Power.pdf
- Reading Taylor’s ‘A Secular Age’ – After the Future, accessed July 24, 2025, https://afterthefuture.typepad.com/afterthefuture/reading-taylors-a-secular-age.html
- Islamic Political Theology, accessed July 24, 2025, https://www.saet.ac.uk/Islam/IslamicPoliticalTheology
- 100 Years of Political Theology: An Islamic Perspective (by M. Owais Khan), accessed July 24, 2025, https://politicaltheology.com/100-years-of-political-theology-an-islamic-perspective-by-m-owais-khan/
- Divergent Statecrafts: Between Islamic Governance and Modern State Power – Ummatics, accessed July 24, 2025, https://ummatics.org/divergent-statecrafts/
- Maqasid and the Challenges of Modernity – SciSpace, accessed July 24, 2025, https://scispace.com/pdf/maqasid-and-the-challenges-of-modernity-9x9lkmy3tv.pdf
- Divergent Statecrafts: Between Islamic Governance and Modern State Power – Ummatics, accessed July 24, 2025, https://ummatics.org/wp-content/uploads/2024/11/Jaan-Islam-Divergent-Statecrafts-Islam-and-Modern-State-Nov-2024.pdf
- Introduction in: Hawwa Volume 18 Issue 2-3 (2020) – Brill, accessed July 24, 2025, https://brill.com/view/journals/haww/18/2-3/article-p117_1.xml
- Introduction – Brill, accessed July 24, 2025, https://brill.com/view/journals/haww/18/2-3/article-p117_1.pdf
- Against Kadijustiz: On the Negative Citation of Foreign Law, accessed July 24, 2025, https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.suffolk.edu/dist/3/1172/files/2015/10/Rabb_Article_PDF.pdf
- Engendering unification : family law and women’s legal … – SciSpace, accessed July 24, 2025, https://scispace.com/pdf/engendering-unification-family-law-and-women-s-legal-2z29jq6h81.pdf
- Sovereignty, Discipline, Security: Foucault and the Governmentality of U.S. Border Enforcement, accessed July 24, 2025, https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/about.illinoisstate.edu/dist/e/34/files/2020/09/FINAL-1-PDF.pdf
- Governmentality: Notes on the Thought of Michel Foucault – Critical Legal Thinking, accessed July 24, 2025, https://criticallegalthinking.com/2014/12/02/governmentality-notes-thought-michel-foucault/
- Foucault and ‘the Right to Life’: from Technologies of Normalization to Societies of Control, accessed July 24, 2025, https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/3340/3268
- The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali – ghazali.org, accessed July 24, 2025, https://www.ghazali.org/books/ethical.pdf
- A Secular Age – Brill, accessed July 24, 2025, https://brill.com/downloadpdf/book/9789004435087/BP000004.pdf
- Introduction (Chapter 1) – A Secular Age beyond the West, accessed July 24, 2025, https://www.cambridge.org/core/books/secular-age-beyond-the-west/introduction/C0D50B6B4B9209C8120D9877BE0445B2
- Irredeemable Failure: The Modern Nation-State as a Nullifier of Ummatic Unity, accessed July 24, 2025, https://ummatics.org/irredeemable-failure-the-modern-nation-state-as-a-nullifier-of-ummatic-unity/
- What Really Went Wrong – review – LSE Review of Books, accessed July 24, 2025, https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2024/09/24/what-really-went-wrong-the-west-and-the-failure-of-democracy-in-the-middle-east-fawaz-gerges/
- What really went wrong in the Middle East? | LSE Research, accessed July 24, 2025, https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/politics/us-and-middle-east
- A Review on Wael Hallaq’s The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament – IRF, accessed July 24, 2025, https://irfront.org/post/a-review-on-wael-hallaqs-the-impossible-state-islam-politics-and-modernitys-moral-predicament-6767
- Khamsin-08.pdf – Libcom.org, accessed July 24, 2025, https://files.libcom.org/files/Khamsin-08.pdf
- Occidentalism / Orientalism in Reverse: The West in the Eyes of Modern Arab Intellectuals Mohammed Abdullah Hussein Muharram The – DergiPark, accessed July 24, 2025, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/998646
- Orientalism and orientalism in reverse – Sadik Jalal al-‘Azm – Libcom.org, accessed July 24, 2025, https://libcom.org/article/orientalism-and-orientalism-reverse-sadik-jalal-al-azm
- 5 Reasons to Avoid Ad Hominem Arguments – FEE.org, accessed July 24, 2025, https://fee.org/articles/5-reasons-to-avoid-ad-hominem-arguments/
- Ad Hominem – Philosophy Home Page, accessed July 24, 2025, https://philosophy.lander.edu/logic/person.html
- Identifying and Characterizing Ad Hominem Fallacy Usage in the Wild – AAAI Publications, accessed July 24, 2025, https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/download/22180/21959/26243
- Wael B. Hallaq and the Question of Modern Nation-State in Islamic Legal Tradition: Empire of Law in Pre-Modern and Modern Muslim Legal Cultures – SOAS Research Online, accessed July 24, 2025, https://soas-repository.worktribe.com/output/373164/wael-b-hallaq-and-the-question-of-modern-nation-state-in-islamic-legal-tradition-empire-of-law-in-pre-modern-and-modern-muslim-legal-cultures
- Authority, Continuity and Change in Islamic Law – Hallaq, Wael B. – AbeBooks, accessed July 24, 2025, https://www.abebooks.com/9780521023931/Authority-Continuity-Change-Islamic-Law-0521023939/plp
- Sharī’a: Theory, Practice, Transformations by Wael B. Hallaq | Goodreads, accessed July 24, 2025, https://www.goodreads.com/book/show/6526776-shar-a
- Wael Hallaq – Wikipedia, accessed July 24, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Wael_Hallaq
- Multiple Modernities? The Case Against, accessed July 24, 2025, https://d-nb.info/1192008332/34
- Multiple-Modernities-by-S.N.Eisenstadt.pdf – Void Network, accessed July 24, 2025, https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/Multiple-Modernities-by-S.N.Eisenstadt.pdf
- MUSLIM ENTREPRENEURS AND ALTERNATIVE MODERNITIES: THE CASE OF MÜSİAD – Ceu, accessed July 24, 2025, https://www.etd.ceu.edu/2008/dogruoz_hakan.pdf
- Multiple Modernities and Postsecular Societies – Columbia International Affairs Online, accessed July 24, 2025, https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/it/v16i1/19.html
- Modernity and the (Im)Possibility of Transcendence – Deep Blue Repositories, accessed July 24, 2025, https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/167884/ffysudee.pdf?sequence=1
- Islamism, Post-Islamism, and Civil Islam | Hudson Institute, accessed July 24, 2025, https://www.hudson.org/national-security-defense/islamism-post-islamism-and-civil-islam
- To ‘Post-Islamism’? Between Piety and Liberty | musliminstitute.org, accessed July 24, 2025, https://musliminstitute.org/freethinking/freethinking/post-islamism-between-piety-and-liberty

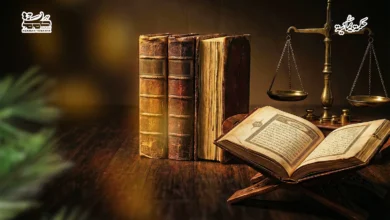
Güzel aydınlatıcı makale için teşekkürler daha iyisi samda kayısı umarım faydalı çalışmalarınızın devamı gelir.