
في زمن المأساة والعنف المتوحش، يصبح العقل الإجرائي/الأداتي عاجزًا عن احتواء دلالات الألم؛ لأنه لا يستطيع توصيفه إلا ضمن شبكة من الأسباب والمسبّبات، منفصلًا عن الأثر الروحي والرمزي الذي يحدثه هذا السلوك الحيواني في الكيان الإنساني. وإذا ما استُخدم هذا العقل في تحليل وقائع الإبادة والمحو للوجود الإنساني، دون اعتبار لمعنى العدالة أو قيمة الحق، فإنه يغدو جزءًا من آلة التبرير، وربما، وإن من حيث لا يدري، شريكًا في تواطؤ غير معلن يحاكي منطق الجريمة دون أن يدينها. الوقوف، اليوم، أمام التجلّي الكثيف للشر كما يظهر في الحالة الغزّاوية، لا يثير احتجاجا وجدانيا أو غضبا أخلاقيا فقط، وإنما يستدعي مساءلة فلسفية حقيقية تطال بنية الفكر الإجرائي المعاصر، وتضعه تحت محك الاستفهام حول جدوى الحياد المعرفي حين يكون الواقع مشبعا بألمٍ يتجاوز الإمكانات التحليلية الباردة.
ما يحدثه الكيان الصهيوني في غزة لا يمكن أن يقرأ من زاوية العلاقات السياسية أو الصراعات الاستراتيجية، فهو يتطلب نمطا من التفكير المتجاوز للأدوات ويخترق بنية التفسير نفسها. فالمأساة، حين تبلغ ذورتها، تتحوّل إلى اختبار صارم لقدرة الفكر على تحمل المسؤولية، وعلى الاعتراف بحدوده، وعلى تجاوزه لذاته من أجل استعادة الغاية الأخلاقية التي لا يمكن للمعرفة أن تشتغل بدونها، ذلك أن المعرفة بطبيعها لا تتولد في فراغ، ولا تنمو من أدوات حيادية تدّعي الموضوعية بينما تفشل في تمثّل المعاناة، والإنصات لصوت الضحية، وفي إدراك أن الحقيقة ليست معطى تقنيًا يمكن استحضاره خارج السياق الوجودي.
كل تفسير أو موقف لا يستبطن موقفا أخلاقيا، وكل تحليل لا يستدعي ضميرا، وكل خطاب لا ينحاز للإنسان ولكرامته، يتحوّل إلى صيغة من العدم، يعيد إنتاج الشرّ في ثوب من الحياد، ويسهم دون وعي في طمس الحقيقية، وتقويض الإمكانات والدلالات المعنوية للمعرفة. وحينما يتعامل العقل مع التوحش/ الشر كحدث قابل للتصنيف داخل بنية العلاقات الباردة، دون استشعار لوقعها الأنطولوجي، فإنه يفرّط في مسؤوليته، ويعطّل فاعليته، ويقصي نفسه من التاريخ الحقيقي الذي يصاغ بالدم والوجدان والشهادة. ولهذا، كان اختزال المعرفة إلى أدوات خالية من الغاية، وتحويل الفكر إلى منظومة إجرائية محايدة، ينزع عنها صفتها الإنسانية، ويحوّلها إلى نمط من الاشتغال الميكانيكي الذي يرى في العالم تجمعا للوقائع دون حمولة أخلاقية أو أفق قيم. وهذا ما يجعل العلم، في لحظة انحرافه عن غاياته الأنطولوجية، أداة لفصل الوسيلة عن الغاية، ولفصل التفسير عن الالتزام، الأمر الذي يعيد إنتاج المأساة على مستوى الخطاب كما تنتج على مستوى الفعل.
كل خطاب تحليلي يتجاهل أثر ما يحلله، ويتنازل عن مساءلة العدالة، يغدو صورة ناعمة لآلة الحرب، ويمتثل لها في الشكل دون أن يصرح بذلك في المضمون. ولئن كان العقل الأداتي يشتغل على إمكانات لا نهائية لتوليد الأساليب والأدوات، فإنه لا يمكنه أن يعزل عن الذات التي تنتجه، ولا عن السياق القيمي الذي يوجه اختياراته. إذ لا وجود لعلم خالص منفصل عن بنيات التكوين الثقافي والاجتماعي للباحث، ولا يمكن تصور فعل معرفي لا يتضمن قدرًا من الاختيار أو التوجّه نحو أثر ما، سواء أكان ذلك الأثر إيجابيًا أم سلبيًا. وبهذا، فإن الحياد المزعوم للمناهج لا يُـلغى على مستوى الفعل فقط، بل يُفضح على مستوى القيمة، لأن كل إجراء تحليلي هو، في جوهره، انخراط في موقف، ولو كان غير معلن، ينحاز إلى نمط من إدراك الواقع يقصي أو يبرز ما يراه جديرًا بالتفسير. كل خطاب تحليلي يتعامل مع العنف بوصفه معلومة، يتنكر لجوهر الفكر والمعرفة بوصفهما التزامًا، ويتحول من الفاعلية والمقاومة للعنف إلى تبريره والتطبيع معه، ومن مساءلته إلى الاكتفاء بتوصيفه. وهنا، تصبح المأساة حدثا إحصائيا يقرأ من خلال الجداول والرسوم البيانية، وكأنّ الدم لا يشتمل على خطاب، والقتل لا يقتضي شهادة، والإنسان لا يستحق أن يستحضر بوصفه غاية لا وسيطا في التجربة المعرفية.
حين يُعرّف الفكر ذاته كوسيلة محايدة، فإنه يفرّغ ذاته من أفقها الوجودي، ويحوّلها إلى بنية آلية تعيد إنتاج الواقع بوصفها حدثا لا يحيل إلى معنى، وفعلًا لا يحتاج إلى المساءلة. وهذا ما يجعل من الموقف العدمي للفكر استجابة مضمرة في بنية العقل المنفصل عن الغايات، ويحوّل المثقف أو الباحث إلى أداة تشتغل بموازاة الفعل المادي للسلطة، دون أن تمتلك الشجاعة الكافية للقول أو التوقف أو المقاومة للآفات السلطوية والاستعمارية. الحياد، حين يتخذ طابعا تقنيا، يفقد المعرفة روحها، ويجعل من المشتغل بها أداةً داخل منظومة تخدم منطق السيطرة، لا منطق الكرامة.
إن كل تحليل لا يسائل ذاته، ولا يعيد التفكير في الغايات التي ينتجها، هو تحليل يعيد إنتاج المأساة في اللغة، حتى ولو كان مدفوعا بالنية الحسنة. فلا يكفي أن تصاغ الأفكار بدقة، بل يجب أن تكون حاملة للضمير، ولا يكفي أن تجمع البيانات، بل يجب أن تصغي للنداء الكوني الذي تسكبه المأساة في وجدان من بقي حيا. وإن المثقف الذي لا يقول ” لا ” في وجه العنف والاستبداد والظلم، لا يكون شاهدًا على الحقيقة، بل شاهدة على نفيها، وإن الفكرة التي لا تقاوم الظلم تغدو جزءًا من آلة الصمت، والعقل الذي لا يسأل عن العدالة يكون قد اختار التواطؤ، وإن لم يصرّح بذلك.
لايمكن اختزال المعرفة في أدواتها؛ لأنها تتموضع في ضوء الغايات التي تسعى إليها، وحين تغيب هذه الغايات، تغيب الشهادة، ويغيب الإنسان من مركز السؤال، ويتحول الخطاب إلى آلة تكرار لا تنتج وعيا بل تطبع الظلم وتروّضه. ومن ثم، فإن مساءلة المعرفة تبدأ من مساءلة حيادها، من مساءلة قدرتها على الوقف مع الإنسان، على التوقف في تبرير الشر في الكون، على المقاومة، وعلى ألا تكون امتدادًا للآلية الشر والظلم، بل استعادة للغائية من النزول الإنساني للوجود. كل فصل بين المعرفة والقيم، بين التفسير والالتزام، هو فصل يقصي نداء للحقيقية، ويتركها عاريةً أمام أفق عدميّ لا يُنقذ الإنسان، ولا يُضيء له دروب الحرية والكرامة. المعرفة، إذًا، لا تعنى فقط بما هو كائن، بل بما ينبغي أن يكون، ولا يكفي أن تكون أدواتها دقيقة إن كانت غاياتها فارغة، ولا أن تكون مناهجها سليمة إن كانت منفصلة عن سؤال العدالة. والقول بأن الوقائع قد تعارض القيم، هو فصل تعسفي يختزل الفهم في مجرد توصيف خالٍ من المسؤولية، ويعفي العقل من أن يكون شاهدًا على الحقيقة، لا مجرد متتبع لأثرها دون النظر في غايتها.
ما يطلب من المعرفة في زمن المأساة ليس التحليل وحده، بل الشهادة، وليس الاستحضار فقط، بل التواطؤ الإيجابي مع الإنسان ضد القهر، مع الإنسان ضد النسيان، ومع الحق ضد التبرير. فلا حياد في وجه الألم، ولا علم في غياب الغايات، كما أنه لا معرفة في غياب الإنسان. ولهذا، فإن كل معرفة لا تسائل الشرّ هي معرفة تعيد إنتاجه، وكل فكرة لا تُجدد مساءلتها للعدالة هي فكرة مبتذلة لا تصلح للشهادة على الوجود الإنساني. المعرفة حين تتخلى عن مهامها الرسالية، لا تكون شاهدة على المأساة، وحاملة للمسؤولية الأخلاقية، ولا يمكنها ترتيب اللغة لصالح من فقدوا القدرة على النطق، وعلى الشكوى، وعلى البقاء في سجل الحضور، وإنما ناكرة للحقيقية. وفي سياق الإبادة المستمرة التي يتعرض لها شعب غزة، بوصفه منظارًا كاشفًا لغياب الحضور الأخلاقي والمعرفي في العالم الحديث. فالشاهدية المعرفية للإنسان، هي مسؤولية وجودية تتأسس على استحضار الغيب في إدراك الواقع، وعلى الالتزام الصادق في نقل الحقيقة دون تحريف أو مواربة. وهذا، نا يدفعنا للقول، الوحشية المسلطة للصهاينة على أهل غزة تمثل امتحانًا حاسمًا للفلسفة والمعرفة العالمية، التي فشلت، لا فقط في المواجهة، وإنما في أداء الحدّ الأدنى من فعل الشهادة على الظلم، بما يكشف عن خلل جوهري في بنية المعرفة المعاصرة ذاتها.

إن الفلسفة المعرفية التي سادت في العصور الحديثة، خاصة مع نزعة الوضعية والتجريبية، قد نزعت القداسة عن الحقيقة، وجعلتها أمرًا موضوعيًا منفصلًا عن الذات، وبهذا أسقطت مسؤولية الإنسان عن مضمون ما يشهد عليه. فتحوّلت المعرفة من كونها التزامًا أخلاقيًا إلى أن أصبحت مجرد أداة للضبط والسيطرة. هذا التحول في فهم المعرفة جعلها عمياء أمام الوحشية، محايدة في وجه المجازر، ومجرّدة من الضمير في مواجهة الإبادة. أولئك الذين يشهدون ما يقع في غزة من حصار وتدمير وقتل وتجويع، يكتفون بمراقبة الحدث، دون أن يرتقوا إلى مقام الشهادة، التي تتطلب الموقف الأخلاقي تجاه الإنسان؛ لأنهم لا يتخلقون بالصدق، ولا يتجرؤون على الإشهاد، ولا يتحملون مسؤولية الموقف أمام الغيب.
حين تصبح الجريمة كيانا وموقف أخلاقي يتغلغل في الخطاب التحليلي، فإن ذلك يحتم على الفلسفة أن تستعيد دورها النقدي، لا لتقويض المعرفة أو العلم، بل لإعادة توجيهه نحو سؤال القيمة، وسؤال المعنى، وسؤال العدالة. المعرفة الإنسانية، في لحظة التجرد من الغايات، تفقد قدرتها على النبوة، وعلى المجابهة، وتغدو ملحقًة بالواقع لا تستيطع تجاوزه، ولا مساءلته. لذلك، لا تكتمل المعرفة إلا حين تقترن بالمسؤولية، ولا يكتمل العقل إلا حين يعترف بحدوده، ولا يفهم الشر إلا حين يستعاد السؤال الوجودي في بنية التحليل، لا حين يستبعد بذريعة الموضوعية أو الحياد.
لا يمكن قراءة العالم بما هو عالم دون العودة إلى سياقه الوجودي، وإلى معناه في بنية الخلق والتدبير. فالفصل بين العالم والإله، أو بين الظاهر والحق، هو تعبير عن انحياز سلبي تحوّل في العصر الحديث إلى بنية مؤسِّسة للعلم بوصفه فعلًا تقنيًا منزوعًا من المسؤولية الأخلاقية.
هذا التحول هو ما كرّس نمطا من الاشتغال المعرفي الذي ينحصر في الإجراءات ويغفل الأثر، ويستبعد الغاية، ويقصي الحقيقية. والباحث حين يتعامل مع العالم بوصفه ظاهرًا محايدًا، لا يفسّر إلا ما يحدث، ويتجاهل لماذا يحدث، ولمن يحدث، وما الذي ينبغي أن يستفاد منه، وما هو الدور الموكول للمعرفة أمام الألم أو الافتتان أو التوحش.
إذا كانت الإجراءات العلمية تخدم قدرة الإنسان على التحكم، فإن هذه القدرة إن لم تقيد بحس المسؤولية، تحولت إلى تمرين على نفي الإنسان من داخل فعله، وإلى إنكار لما يجعله ذاتا قادرة على الاختيار والتأمل. والفرق جوهري بين من يفكر ضمن سياق مسؤول، يدرك أثر معرفته، ويعي وزن موقفه، وبين من ينفصل عن أثر فعله، ويحول ذاته إلى أداة تنفيذية محايدة لا تصغي للنداء الأخلاقي، ولا تستجيب للمساءلة الوجودية. فالعلم الذي يُعلّق صلته بالقيم يقع في فخ الحياد اللأخلاقي؛ لأنه يتجنب مواجهة الحقيقة في سياقها الكوني، ويتجاهل السؤال عن الله بوصفه أصل المعنى وغايته ومبدأ العدالة ومرتكز الرحمة.
حين يتخذ الحياد المعرفي/ العلمي صيغة مؤسسية، فإن العلم يتحوّل من فعل تفكيري إلى آلة تنتج ما يُعزز منطق التوحش. وهذا ما يجعل الخطاب العلمي، حين ينفصل عن القيم، فاقدا لروحه، وعاجزا عن الإنصات للوجود الإنساني في لحظاته القصوى، وعاجزًا عن أن يكون شاهدا على الألم والظلم والانتهاك. المعرفة، إن لم تكن مرتبطة بالغائية، تتحول إلى بنية تفسيرية صماء لا تستدعي أي موقف ولا توحي بأي أفق، وتترك العالم معروضا بوصفه سلسلة وقائع قابلة للتفكيك دون أن تؤدي إلى أي مسؤولية، بل إنها تخلق حالة من الانفصال التام بين الفهم والتفاعل، بين التفكير والشهادة، بين الإدراك والتحرّك. لهذا، كانت مأساة غزة كاشفة في عمقها عن نكوص في الوظيفة المعرفية للإنسان الحديث، وعن عجز في تحويل العلم إلى نور، وعن السقوط في خطاب ادعى الإنسانية بينما عجز عن حفظ حياة الإنسان.
كل معرفة لا تعي مكانتها في شبكة المعنى للوجود لا تملك من طاقة التغيير شيئا. ولهذا، فإن نسيان الله من المعرفة هو فعل نفي للذات، وإنكار للغايات، واستسلام لمنطق الهيمنة في ثوبه العقلاني، الذي يعيد تمثيل الواقع دون أن يكون قادرا على تغيير أفقه، أو تحرير الإنسان من كونه أداة في لعبة تشتغل دون توقف، ولا تملك من العدالة إلا ما يبرر استمرارها. ولكي تكون المعرفة جديرة بمكانة الإنسانية، لا بد أن تستعيد صلتها بالألم، وأن تخرج من منطق الأدوات إلى أفق المعنى، وتعيد مساءلة نفسها أمام المأساة، لا أن تكتفي بوصفها أو تحليلها ضمن منظومات محايدة لا تنقذ ولا تقاوم. المعرفة التي لا تكون مسكونة بالألم لا تضيء، والعقل الذي لا يسائل لا يتحرّر، والموقف الذي لا يعاني لا يشهد. ولهذا، فإن ما يظهر من شر لا يمكن أن يفهم في الحياد، ولا يدرك في الانفصال؛ لأنه يستلزم نمطا من التفكير ينحاز للإنسان لا للآلة، للعدل لا للتوازن، للحقيقة لا للفعالية، للمعنى الوجودي للإنسان لا للوسيلة. كل تحليل ينكر أثر السماء في الأرض هو ممارسة فلسفية لا تؤسس للحياد؛ لأنها تحوّل الفكر إلى آلة معرفية تشتغل على سطح الأشياء، وتقصي نداء الوجدان، وتبعد الذات من مواجهة الحقيقة التي لا تُفهم إلا بتجسيدها في سياقها الكوني. فالفكر الذي لا يرى في الوقائع أثرا للحق لا يفكك سوى المادة، ويظل حبيس منطق الملاحظة دون أن يعبر إلى الغاية، وأسير التوصيف دون أن يبلغ مستوى الشهادة على المعنى.
ومن هنا، يمكننت القول بأنه: لا يمكن فصل الدين عن المعرفة دون إفراغ الواقع من دلالته العليا، إذ أن الدين لا يقحم الميتافيزيقي في التفسير، بل يربط الظاهر بعمقه الغائي، ويعيد إدراج الإنسان في شبكة من المعنى التي لا يمكن فهم الألم دونها، ولا يمكن إدراك العدالة دون استحضارها. الشاهدية المعرفية للإنسان ليست مطلبا دينيا فحسب، بل شرطا للتحقق الإنساني، ومقياسا لاختبار الضمير، ومجالا لإعادة وصل المعرفة بالمسؤولية الأخلاقية والكرامة. ولذلك فإن الفشل في مواجهة الإبادة الصهيونية للغزاوين، ليس فشلا سياسيا أو إنسانيا فقط، بل هو فشل في أداء الوظيفة الجوهرية للشاهدية المعرفية التي تحدد مقام الإنسان بوصفه كائنا مؤتمنا على القول والفعل، وعلى الصدق في مواجهة الظلم حين يبلغ مداه حدّ الفناء.

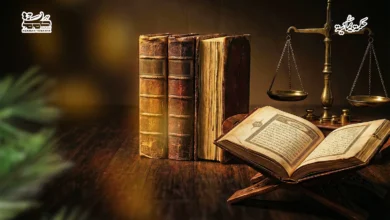
شكرا لك ،فالتوحيد اصل المعرفة الكونية والانسانية.