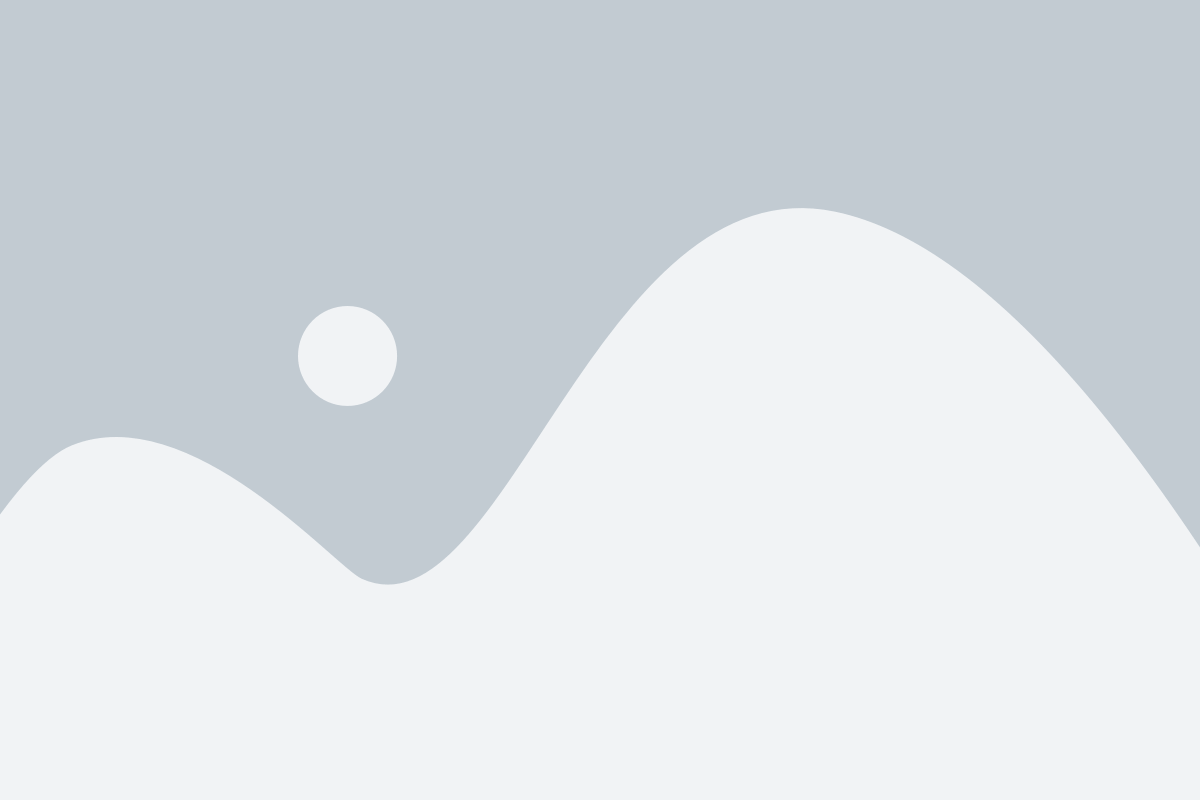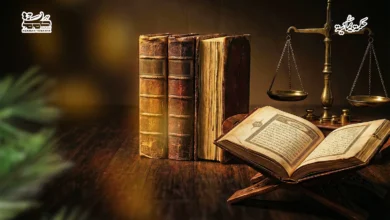في ماهية العنف المطلق
حينما تُشهرُ دولةٌ ما سلاحاً كيميائياً في وجه شعبٍ تدّعي تمثيله، أو حينما تحول مدنه إلى أنقاض، أو تشن حرب إبادة ضد شريحة من مواطنيها، فإننا لا نشهد مجرد فشلٍ سياسي، بل انهياراً كاملاً في المعنى التقليدي للسلطة، بل وقطيعة وجودية مع كل ما يجعل السلطة أمراً محتملاً. إن الفشل السياسي هو عجز عن تحقيق الرخاء أو العدالة، أما ما نحن بصدده هنا فهو انهيار وجودي، حيث تتخلى الدولة عن وظيفتها الأساسية كإطار للعيش المشترك، وتتحول إلى نقيضها المطلق. هو فعلٌ يتجاوز حدود الحرب المتعارف عليها – التي تُشن ضد عدو خارجي – ليُعلن عن تمزق العقد الاجتماعي تحولاً بالدولة من كيانٍ حامٍ إلى ضارٍ مفترس. تطرح هذه المقالة فرضية أن لجوء الجمهوريات العربية ما بعد الاستعمارية إلى العنف المفرط والمنهجي ضد مجتمعاتها – وتحديداً مصر في اليمن، والعراق ضد أكراده، وسوريا ضد مواطنيها، والجزائر في عشريتها السوداء، والسودان في دارفور، وليبيا القذافي في نهايتها – ليس مجرد تكتيكٍ عسكريٍ متوحش، بل هو التجلي الأقصى، والأكثر عُرياً، لمأزقٍ تاريخي في شرعية هذه الكيانات. وسنحاجج بأن هذا المأزق متجذرٌ في عملية استيرادٍ مبتسرة لنموذج الدولة الغربية الحديثة (الدولة الحداثية)؛ هذا النموذج الذي حين يُفرض كبنيةٍ طارئة وغريبة، بمعزلٍ عن التطور العضوي الاجتماعي والسياسي الذي أنجبه في سياقه الأوروبي على مدى قرون، فإنه يخلق دولةً، ما إن تواجه تحدياً لوجودها، حتى تنظر إلى مجتمعها ذاته كخصمٍ يستوجب التأديب، أو الترويع، أو الإفناء.
يستند الإطار النظري لهذا التحليل إلى حقل الدراسات ما بعد الاستعمارية ونظريات تشكّل الدولة، التي تفترض أن الدولة الحديثة المركزية في الشرق الأوسط قد بزغت في الغالب كـ “كيانٍ غريب” [1]. ويتخذ هذا الاغتراب صورته الأكثر حدة في حالة الجمهوريات التي وُلِدَت من رحم حركات قومية ثورية سعت إلى قطيعةٍ شاملة مع الماضي [2]. هذه الأنظمة، التي افتقرت إلى الشرعية التقليدية أو الدينية أو السلالية التي أسندت ظهور الملكيات في المنطقة، وجدت نفسها مضطرة للاعتماد على إيديولوجيات مجردة، وفي نهاية المطاف، على الإكراه الصريح للحفاظ على وجودها [3، 4، 5]. وحينما تهاوت هذه الإيديولوجيات تحت وطأة الواقع، وقُوبل الإكراه بمقاومة واسعة، انحدرت العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى حربٍ مفتوحة، مثّلت فيها حروب الإفناء الطور المرضي الأخير لهذا الصراع.
سنضع هذه التجربة الجمهورية في ميزان المقارنة مع تجربة الأنظمة الملكية في المنطقة. فعلى الرغم من أن الملكيات كانت سلطوية هي الأخرى، إلا أنها سلكت مساراً أكثر توفيقية وتدرجاً في بناء الدولة، حيث مزجت الهياكل البيروقراطية الحديثة مع شبكات السلطة التقليدية للنخب القبلية والدينية [2، 6]. وقد منحتهم هذه الاستراتيجية شكلاً من أشكال الشرعية أكثر مرونة، وضمن توزيع القوة السياسية على نطاق أوسع داخل المجتمع، وهو ما حال إلى حد كبير دون حدوث ذلك التمزق الكامل بين الدولة والمجتمع الذي يستلزم العنف المطلق. ويعمل هذا النموذج الملكي كأداة تحليلية مقابلة، تسلط الضوء على الأمراض الفريدة لمشروع بناء الدولة الجمهوري.
سيتم إثبات هذه الأطروحة عبر النظر في حالات متعددة، بدءاً بالحالة التأسيسية لتدخل مصر في اليمن، ثم تتبع الأصداء المدمرة لهذه الحالة المرضية في جمهوريات البعث في العراق وسوريا، وتوسيع التحليل ليشمل حروب الدولة على المجتمع في الجزائر والسودان وليبيا. ومن خلال هذا العرض المقارن، سيخلص التحليل إلى أن العنف المفرط هو السلاح الرمزي للدولة المنزوعة الشرعية، والتعبير المأساوي الأخير لسلطةٍ في حالة حربٍ جوهرية مع شعبها.
مساران في تشكّل الدولة: جمهورية القطيعة وملكية الاستيعاب
إن المسارات المتباينة التي سلكتها الجمهوريات والملكيات العربية في حقبة ما بعد الاستعمارية تتجذر في اختلافاتهما التأسيسية في بنية الدولة وطبيعة شرعيتها. فبينما يشترك النمطان في طابعهما السلطوي، إلا أن الجمهوريات قامت على نموذج القطيعة الثورية الذي وضعها في علاقةٍ عدائيةٍ أصيلة مع مجتمعاتها. أما الملكيات، على النقيض من ذلك، فقد قامت على نموذج الاستمرارية التقليدية واحتواء النخب، مما خلق نظاماً سياسياً أكثر ديمومة. ويفسر هذا التمييز الجوهري لماذا كانت الجمهوريات، حين تواجه مأزقاً وجودياً في شرعيتها، مهيأة بشكلٍ فريد لاستخدام أقصى أشكال العنف الداخلي.

الجمهورية الهشة: اغتراب الدولة وضرورتها الإيديولوجية
إن الدول الحديثة في المشرق العربي هي وليدة انهيار الإمبراطورية العثمانية والتسوية الاستعمارية التي فرضتها بريطانيا وفرنسا إثر الحرب العالمية الأولى [5، 7]. وقد أفضت هذه العملية إلى خلق دولٍ ذات حدودٍ مصطنعة تجاهلت في الغالب الحقائق الإثنية والطائفية، مما وسمها بأزمة شرعية منذ لحظة الميلاد [8، 9]. ورثت هذه الدول ما بعد الاستعمارية الأطر المؤسسية لأسيادها السابقين، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي التي لم تكن مصممة لحماية الأمة من الأخطار الخارجية، بل لحماية الدولة من شعبها [10]. هذا الإرث الاستعماري ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل هو الحمض النووي لهذه الدولة، حيث إن جهاز “المخابرات” ليس مجرد أداة، بل هو دولة عميقة داخل الدولة، لها مصالحها ومنطقها الخاص، وهي تنظر إلى المجتمع كمصدر دائم للتهديد وليس كمصدر للسيادة.
وقد بلغ هذا الاغتراب ذروته في الجمهوريات. تأسست الأنظمة في مصر وسوريا والعراق على إيديولوجيات قومية ثورية، كالناصرية والبعثية، التي توخت قطيعةً تامة وعنيفة مع الماضي [2]. كانت هذه الإيديولوجيات كلّانية، تهدف إلى صهر “أمة عربية” جديدة متجانسة من شعوبٍ متنوعة، وخلق “إنسان عربي جديد”. هذا المشروع الهندسي الاجتماعي يغير جذرياً طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فالأنظمة الجمهورية العقائدية لا تنظر إلى مواطنيها كرعايا يجب حكمهم أو كمصدر للسيادة، بل كخميرة أو مادة خام لصناعة “الشعب” المناسب لمشروعها الطوباوي. ومن هذا المنطلق، فإن أي حالة رفض أو تمرد من هذه “المادة الخام” لا تُقابل بالإصلاح الداخلي للنموذج، بل بالاستئصال والإفناء للتمرد، لأنها تمثل فشلاً في جوهر المشروع ذاته. وعليه، تطلب هذا المشروع بالضرورة محو الهويات ما قبل الوطنية (القبلية، الطائفية، الإقليمية) التي اعتبرتها عقبات رجعية في طريق الحداثة. وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف، شنت حرباً سياسية على النظام الاجتماعي القائم، ووصمت النخب التقليدية – زعماء القبائل، وكبار التجار، وعلماء الدين – بالرجعية والخيانة، ورأت ضرورة استئصالها واستبدالها بطبقة جديدة من النخب المستمدة من الحزب الحاكم والجيش [2]. كان هذا الفعل التأسيسي من “التدمير الخلاق” عملاً من أعمال العنف الداخلي الموجه ضد نسيج المجتمع ذاته. وهذا يعني أن هذه الجمهوريات، منذ ولادتها، لم تُبنَ على عقدٍ اجتماعي تفاوضي، بل على فرضية الصراع مع شرائح واسعة من سكانها.
وهنا تبرز مفارقة مركزية في بنية الدولة الجمهورية: فالنظام الذي يعلن الحرب على “الطائفية” و”القبلية” و”العشائرية” باسم الوطنية الحديثة، يصبح هو نفسه المنتج الأكبر والأخطر لهذه الانقسامات. عندما تفشل الأيديولوجيا الكبرى (كالقومية العربية أو الاشتراكية) في تحقيق وعودها بالرخاء والوحدة، وتفقد قدرتها على حشد الجماهير، يجد النظام نفسه في فراغ شرعي قاتل. وللبقاء، يلجأ إلى استراتيجية أكثر بدائية وفتكاً: صناعة الطائفية واستثمارها. فبدلاً من الاعتماد على الإقناع الأيديولوجي، يبدأ النظام في بناء قاعدة صلبة من الولاء تقوم على رابطة الهوية الضيقة (الطائفية أو العرقية أو القبلية) التي تنتمي إليها النخبة الحاكمة. ولتحصين هذه القاعدة، يتم بشكل منهجي تخوين المكونات المجتمعية الأخرى، وتصويرها كـ “طابور خامس” أو “عملاء للخارج” أو “أعداء للوطن”. وهكذا، يتحول الصراع السياسي على السلطة والموارد إلى صراع وجودي بين الهويات، وتصبح الدولة نفسها أداة في يد طائفة ضد أخرى. إن هذا التلاعب المتعمد بالهويات ليس مجرد تكتيك سياسي، بل هو استراتيجية حكم، وأداة لتبرير القمع المطلق، حيث أن أي معارضة للنظام يتم تأويلها على أنها خيانة طائفية تستوجب السحق، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام حروب الإفناء التي شاهدناها في العراق وسوريا.
وعلى عكس الملكيات، التي استطاعت الاتكاء على قرون من السلطة التقليدية والسلالية والدينية، كانت شرعية الجمهوريات قائمة على الأداء والإنجاز بشكلٍ شبه كامل [4، 5]. لقد قطعت وعوداً كبرى بالتنمية والاشتراكية والمجد القومي [4]. ولكن، مع تحصّن القادة الكارزميين الأوائل كطغاة وتلاشي الوعود الإيديولوجية وسط عسر الأحوال الاقتصادية والهزائم العسكرية والقمع السياسي، تبخرت شرعية الأنظمة [2]. وحين تفشل “شرعية الأداء”، تجد الدولة نفسها عارية تماماً إلا من أدوات قسرها. ومع انهيار أسسها الإيديولوجية، لم يبقَ من أركان حكمها سوى القوة القسرية للدولة – الجيش وأجهزة المخابرات المنتشرة في كل مكان. وقد خلق هذا مساراً مباشراً ومحفوفاً بالمخاطر من أزمة الشرعية إلى عنف الدولة. فالدولة التي تفتقر إلى ارتباطٍ عضوي عميق بمجتمعها، ولم تعد قادرة على إقناعه بالإيديولوجيا، لا تجد أمامها خياراً سوى إجباره على الطاعة بالقوة. إن اللجوء إلى العنف هنا ليس علامة قوة، بل هو الإقرار النهائي بإفلاس الدولة السياسي والأخلاقي.

الملكية المرنة: نموذج توفيقي للسلطة
على النقيض تماماً من الجمهوريات الثورية، بنت الملكيات العربية دولتها على مبدأ الاستمرارية. لم يكن ادعاؤها بالحكم قائماً على تفويض شعبي أو إيديولوجية حديثة، بل على مصادر تقليدية للشرعية: النسب السلالي، والسوابق التاريخية، وغالباً ادعاء السلطة الدينية (مثل لقب “أمير المؤمنين” لملك المغرب). يؤسس مبدأ “الدم فوق صناديق الاقتراع” أساساً واضحاً للسلطة، وإن كان ما قبل حداثي وغير متكافئ، إلا أنه مفهوم في السياق المجتمعي. ويتناقض هذا بشكل حاد مع “الجمهوريات الوراثية” مثل سوريا، حيث كان لا بد من تبرير خلافة الابن لأبيه لاحقاً على أسس براغماتية، أو مع جمهوريات أخرى نظمت انتخابات صورية، مما خلق جواً سائداً من الزيف والسخرية.
والأهم من ذلك، أن مشروع بناء الدولة الملكي كان قائماً على الاحتواء بدلاً من الهدم. فبدلاً من محاولة طمس البنية الاجتماعية التقليدية، أقامت الملكيات تحالفات دائمة مع شخصياتها الرئيسية. لقد أدمجت زعماء القبائل والعائلات التجارية القوية والأعيان الدينيين في شبكة قوية من المحسوبية والسلطة، مع تمركز العائلة الحاكمة بقوة في المنتصف [2]. هذه الاستراتيجية لا تشتري الولاء فحسب، بل تجعل هذه النخب شريكة في استقرار النظام ومستفيدة منه، وبالتالي حريصة على بقائه. كان لهذه الاستراتيجية تأثير عميق على العلاقة بين الدولة والمجتمع. فمن خلال الحفاظ على هذه الشبكات التقليدية، سمحت الملكيات باستمرار الهويات المتعددة الأوجه والمتداخلة – القبلية والإقليمية والطائفية – والتي لم يُنظر إليها على أنها تهديد وجودي للدولة، بل كأعمدة لاستقرارها [6]. وقد خلق هذا نظاماً سياسياً أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
ويكمن جزء أساسي من هذه المرونة في طبيعة الشرعية الملكية ذاتها. فلأن شرعية الملك لا تستند إلى تمثيل هوية قومية أو عرقية ضيقة (كالقومية العربية الصارمة التي تبنتها الجمهوريات)، بل إلى كونه “ملكاً” أو “سلطاناً” لجميع رعاياه بغض النظر عن أصولهم، فإن النظام الملكي يصبح بنيوياً أقدر على استيعاب التنوع. فالولاء في الملكية هو لشخص الملك وللسلالة الحاكمة، وليس لمفهوم مجرد لـ “الأمة” قد يستبعد الأقليات العرقية أو الدينية (مثل الأكراد أو الأمازيغ أو المكونات غير العربية الأخرى). هذا يسمح للملكيات بإدارة التنوع من خلال شبكات المحسوبية والتمثيل الرمزي، مانحةً هذه المجموعات شعوراً بالانتماء تحت مظلة العرش، وهو أمر تجد الجمهوريات العقائدية صعوبة بالغة في تحقيقه، حيث أن وجود هذه الهويات المتنوعة يعتبر في حد ذاته تحدياً لمبدأ “الأمة الواحدة” المتجانسة الذي قامت عليه.
تقدم النتائج المتباينة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 أوضح دليل على هذا الاختلاف الهيكلي. انهارت الأنظمة الجمهورية في تونس ومصر وليبيا واليمن تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، بينما نجت الملكيات جميعها، على الرغم من التحديات التي واجهتها [2، 3]. تمكن ملوك الأردن والمغرب من قمع المعارضة الجماهيرية بمزيج من القمع المحدود ووعود بالإصلاح وتنازلات دستورية طفيفة، لأن مكانتهم كحكام وطنيين شرعيين ظلت سليمة إلى حد كبير. وعندما قدم قادة جمهوريون مثل حسني مبارك أو علي عبد الله صالح عروضًا مماثلة، قوبلت بالسخرية والاستياء، حيث كان العقد الاجتماعي في بلادهم قد تمزق تمامًا لدرجة أن مثل هذه الإيماءات اعتبرت إهانات.
يكشف هذا عن التمييز الجوهري بين شكلي الاستبداد. فالاستبداد الجمهوري مشتق من جهاز دولة حديث وغير شخصي وبيروقراطي وهو “غريب” بشكل أساسي عن الهياكل والقيم التقليدية للمجتمع [1]. أما الاستبداد الملكي، وإن كان قسريًا بنفس القدر، فهو متجذر بعمق في هياكل السلطة العضوية والتقليدية للمجتمع [2، 6]. وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجه الجمهورية هو تحدٍ لأيديولوجية غريبة وآليتها القسرية. أما التحدي الذي يواجه الملكية فهو تحدٍ لنظام، على الرغم من كونه قمعيًا، إلا أنه متجذر جزئيًا في الأعراف المجتمعية المألوفة. ومن المرجح أن يتفاعل الأول بعنف الأسلحة الكيميائية الصناعي وغير الشخصي عندما تتعرض شرعيته لتهديد وجودي، لأنه يمتلك عددًا أقل من أدوات السيطرة الاجتماعية غير العنيفة التي يمكنه استخدامها في الأزمات.

تجليات العنف الجمهوري: مسار الفاجعة من اليمن إلى سوريا
إن الحالة المرضية للدولة الجمهورية الغريبة لا تتجلى في الفكر النظري فحسب، بل في سجل دموي ممتد عبر الجغرافيا والتاريخ العربي المعاصر. فما بدأ كنموذج أولي في جبال اليمن، سرعان ما تناسخ وتطور في صور أشد فتكاً في أنحاء أخرى، كاشفاً عن منطق واحد وإن تعددت أدوات العنف. إن تتبع هذا المسار يكشف عن تصعيد مروع: من محاولة فرض نموذج بالقوة، إلى حرب إبادة ضد هوية مختلفة، إلى حرب أهلية ضد خيار ديمقراطي، وصولاً إلى التطبيع الكامل للعنف المطلق كأداة وحيدة للبقاء.
كانت الحالة التأسيسية في اليمن (1963-1967) هي المختبر الأول الذي كشف عن هذه الحالة المرضية. فمحاولة جمال عبد الناصر تصدير النموذج الجمهوري بالقوة إلى مجتمع تقليدي لم تستطع آلة الحرب المصرية الحديثة إخضاعه، تحولت إلى مستنقع استراتيجي [13, 18]. وعندما فشلت القوة التقليدية، لجأت الدولة الجمهورية الوليدة بإسناد وتوجيه ناصري إلى سلاح الإرهاب المطلق: الأسلحة الكيميائية. لم تكن هجمات الغاز على قرى مثل كتاف مجرد تكتيك عسكري، بل كانت إقراراً بالعجز عن فهم أو إقناع أو هزيمة مجتمع رافض، فكان الحل هو ترويعه وإخضاعه عبر استهداف المدنيين بشكل مباشر، وهو المنطق الذي سيتردد صداه لاحقاً [15, 25].
تطور هذا المنطق إلى طور الإبادة الجماعية في العراق. ففي ظل نظام البعث، الذي نظر إلى الأكراد كهوية “غير متوافقة” تهدد نقاء مشروعه القومي العربي، لم يعد الهدف هو الإخضاع بل الإفناء. تجلت هذه النية في حملة الأنفال (1987-1988)، التي لم تكن مجرد عملية عسكرية، بل مشروعاً بيروقراطياً لتدمير أكثر من 4000 قرية وإعدام ما يقدر بـ 180,000 كردي [30, 33]. هنا، أصبحت الأسلحة الكيميائية أداة مركزية في آلة الإبادة، وبلغت ذروتها في مجزرة حلبجة عام 1988، حيث تم قصف مدينة بأكملها بمزيج من غازات الأعصاب والخردل، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين في لحظات [34]. لقد كانت حلبجة البرهان الدامي على أن الدولة الجمهورية، في أزمتها، مستعدة لحل مشكلة الشرعية عبر محو الشريحة السكانية التي تمثل هذه المشكلة.
وفي الجزائر، اتخذت الحالة المرضية شكلاً مختلفاً: حرب الدولة على المكونات الدينية المحلية. عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في انتخابات 1991، تدخل الجيش لإلغاء النتيجة، معلناً أن هوية الدولة الحداثية أهم من إرادة الشعب. هذا الفعل ألقى بالبلاد في “عشرية سوداء” (1992-2002) قُتل فيها حوالي 200,000 شخص. تحولت الدولة إلى آلة قتل غامضة، تستخدم فرق الموت والتعذيب والمذابح المجهولة الفاعل، في حرب قذرة أصبح فيها الخط الفاصل بين عنف الدولة وعنف الجماعات المسلحة شبه معدوم. لقد كانت حرباً شنتها الجمهورية للحفاظ على عقيدتها ضد شعبها.
أما في السودان، فقد تجلت الحالة المرضية كحرب إبادة من المركز ضد الهامش. نظام الخرطوم، الذي عرّف نفسه كدولة عربية إسلامية، نظر إلى سكانه في دارفور كهامش “أفريقي” متمرد. وعندما اندلعت انتفاضة دارفور عام 2003، كانت الاستجابة هي إطلاق العنان لميليشيات الجنجويد لتمارس سياسة الأرض المحروقة، مستخدمة القتل والاغتصاب الممنهج والتطهير العرقي كأدوات حرب. إن استخدام ميليشيا بالوكالة هو التعبير الأقصى عن اغتراب الدولة، حيث تسلّح جزءاً من شعبها لإبادة جزء آخر، في منطق استعماري داخلي.
وفي ليبيا، وصل المنطق إلى طور الانهيار الشخصاني. نظام القذافي، بعد أن تمكن من إزاحة القوى الاجتماعية الداخلية من المشهد السياسي، تحول بطبيعة الحال إلى استبداد شخصي مطلق. وعندما ثار الشعب عام 2011، لم تكن هناك دولة تتصرف، بل شخص واحد يرى الثورة كخيانة شخصية. خطاباته التي وصفت مواطنيه بـ “الجرذان” و”الصراصير” وتوعدت بسحقهم “زنقة زنقة”، كشفت عن التحلل الكامل لأي عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع.
وأخيراً، وصلت الحالة المرضية إلى طورها النهائي في سوريا، حيث تم تطبيع العنف المطلق. هنا، استخدم نظام الأسد كل الأدوات التي سبقته: الحصار والتجويع، والبراميل المتفجرة العشوائية، والميليشيات الطائفية، وبلغ الذروة في الاستخدام المنهجي والصناعي للأسلحة الكيميائية، مع أكثر من 336 هجوماً موثقاً [31]. لم يعد العنف الأقصى استثناءً، بل أصبح الأداة اليومية للحكم والبقاء. لم تعد الدولة في حرب مع المجتمع، بل أصبحت الدولة هي الحرب على المجتمع، في تعبير أخير ومأساوي عن إفلاس النموذج الجمهوري في اكتساب أي شرعية داخلية.

العقد الاجتماعي المسموم
لجأت الجمهوريات العربية، التي تأسست كل منها على عقيدة ثورية خلقت جهاز دولة غريبًا بشكل أساسي عن مجتمعها، إلى أقصى أشكال العنف عندما واجهت أزمة شرعية عميقة. وبعد أن عجزت عن السيطرة على السكان المقاومين من خلال القوة التقليدية أو الإقناع السياسي، شنت حروباً شاملة ضدهم. وهذا يقف في تناقض صارخ وبليغ مع الملكيات العربية في المنطقة. فعلى الرغم من كل ما لديها من عجز ديمقراطي وانتهاكات لحقوق الإنسان، فإن نموذجها المختلف لتشكيل الدولة، القائم على مزيج توفيقي من المؤسسات الحديثة والسلطة التقليدية، قد وفر عقدًا اجتماعيًا أكثر مرونة، وهو ما تجنب حتى الآن هذه الحالة المرضية المحددة.
إن اللجوء إلى العنف المفرط ليس عرضيًا؛ بل هو بيان سياسي حاسم. إن نشر الغاز السام ضد مدينة، أو إطلاق العنان لميليشيات إبادة في إقليم، أو قصف حي سكني بالمدفعية، كلها أعمال تسمم العقد الاجتماعي بشكل لا رجعة فيه. إنها تحول المواطنين ذوي الحقوق إلى رعايا يجب تأديبهم، أو إلى حشرات يجب إبادتها. إن الطبيعة الصناعية وغير الشخصية لهذا القتل هي برهان مرعب على سلطة الدولة المطلقة والشبيهة بالإله على الحياة نفسها. إنها ليست مجرد حرب، بل هي عملية محو، محاولة من الدولة إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي ليتناسب مع رؤيتها المشوهة، حتى لو كان الثمن هو تدمير المجتمع الذي من المفترض أن تحكمه.
والإرث الأكثر فتكاً لهذه الدولة لا يظهر فقط في عنفها، بل في الخراب الذي تخلفه حتى بعد سقوطها. فحينما ينجح المجتمع أخيراً في تفكيك هذه الآلة القمعية، يجد نفسه أمام معضلة وجودية. فالدولة الجمهورية السلطوية لم تكتفِ بتدمير أعدائها، بل دمرت بشكل منهجي كل أشكال التنظيم الاجتماعي المستقلة عنها. لقد حاربت السلطات التقليدية (القبلية والدينية والأهلية) وأضعفتها حتى لا ينافسها أحد، وفي الوقت ذاته، منعت ولادة أي قوى حديثة بديلة (كطبقة صناعية أو رأسمالية وطنية أو نقابات عمالية قوية أو مجتمع مدني فاعل) يمكن أن تشكل أساساً لدولة جديدة. والنتيجة هي مجتمع مُذَرّر، يتكون من أفراد وجماعات معزولة فاقدين للثقة ببعضهم البعض وبأي سلطة مركزية. إن هذا الفراغ التنظيمي والسياسي يجعل من إعادة بناء الدولة مهمة شبه مستحيلة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أمراء الحرب، والميليشيات، والتطرف، لتبدأ دورة جديدة من العنف على أنقاض العقد الاجتماعي المسموم.
إن استخدام هذه الجمهوريات للعنف المفرط هو العَرَض النهائي والمروع لعلاقة بين الدولة والمجتمع كانت محطمة منذ نشأتها. عندما تم استيراد نموذج الدولة الأوروبية الحديثة المركزية بالجملة إلى العالم العربي – منفصلاً عن قرون من التطور الاجتماعي والسياسي والفلسفي الذي أنتجه في الغرب – خلق هيكلاً حاكمًا يتعارض بشكل أساسي مع الحقائق المعقدة للمجتمعات التي كان من المفترض أن يحكمها. وبسبب افتقارها إلى الجذور التاريخية العميقة والشرعية العضوية، لم تستطع هذه الدولة الحداثية أن تحكم إلا من خلال ركيزتين توأمتين: الأيديولوجيا والقوة. وعندما انهارت الأيديولوجيا وقوبلت القوة بالتحدي، كانت حجة الدولة النهائية واليائسة هي العنف المطلق: سحابة من السم، أو برميل متفجر، أو ميليشيا مسعورة. كلها تعابير مختلفة لنفس المأساة: الدولة الحداثية في حرب مع ذاتها. إن إرث هذا العنف ليس مجرد أرقام للضحايا أو مدن مدمرة، بل هو تدمير للثقة، وتسميم للعلاقات الاجتماعية، وخلق جروح تاريخية ستظل تنزف لأجيال قادمة، مما يجعل بناء عقد اجتماعي جديد أمراً بالغ الصعوبة.
الهوامش:
- The failure of political Islam? | Middle East Eye, accessed July 17, 2025, https://www.middleeasteye.net/opinion/failure-political-islam
- 2. How Republics Fell and Monarchies Survived the Arab Spring …, accessed July 17, 2025, https://chicagopolicyreview.org/2016/05/05/how-republics-fell-and-monarchies-survived-the-arab-spring/.
- Collaboration and Community amongst the Arab Monarchies, accessed July 17, 2025, https://pomeps.org/collaboration-and-community-amongst-the-arab-monarchies
- 4. The Resilience of Arab Monarchy | Hoover Institution The Resilience …, accessed July 17, 2025, https://www.hoover.org/research/resilience-arab-monarchy
- 5. War and State in the Middle East (Chapter 8) – Does War Make States?, accessed July 17, 2025, https://www.cambridge.org/core/books/does-war-make-states/war-and-state-in-the-middle-east/CF348E2AEAE1106BD82265176A7AABF2
- 6. Monarchies versus Republics in the Arab Spring: a social identity approach for understanding leader fragility and mass mobilization., accessed July 17, 2025, https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/5522a2dc-f3dd-4312-9002-e43f71fe31fc/content
- 7. 2. The Emergence of the Middle East into the Modern State System | Politics Trove, accessed July 17, 2025, https://www.oxfordpoliticstrove.com/abstract/10.1093/hepl/9780198809425.001.0001/hepl-9780198809425-chapter-2
- 8. STATE-BUILDING IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA – Geneva Graduate Institute, accessed July 17, 2025, https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2024-01/Mohamedou%20-%20A%20Century%20of%20Elusive%20State-Building%20in%20the%20MENA%20-%202021.pdf
- 9. The State and the Problem of Legitimate Order in the Middle East, accessed July 17, 2025, https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9781800610064_0001
- 10. Post-Colonial States and the Struggle for Identity in the Middle East …, accessed July 17, 2025, https://www.fpri.org/article/2015/10/post-colonial-states-and-the-struggle-for-identity-in-the-middle-east-since-world-war-two/
- 11. Why are Arab monarchies seemingly more successful than Arab republics? – Reddit, accessed July 17, 2025, https://www.reddit.com/r/arabs/comments/7vcu2v/why_are_arab_monarchies_seemingly_more_successful/
- 12. The Arab Uprisings 10 Years Later: In Pursuit of Legitimacy | United States Institute of Peace, accessed July 17, 2025, https://www.usip.org/publications/2021/02/arab-uprisings-10-years-later-pursuit-legitimacy
- 13. The Proxy of My Proxy: Saudi Arabia vs. Egypt in North Yemen …, accessed July 17, 2025, https://adst.org/2015/07/the-proxy-of-my-proxy-saudi-arabia-against-egypt-in-north-yemen/
- 14. The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 | Center for Middle Eastern Studies – Harvard University, accessed July 17, 2025, https://cmes.fas.harvard.edu/publications/international-history-yemen-civil-war-1962-68 15.
- The chemical warfare legacy of the Yemen war – Taylor & Francis …, accessed July 17, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01495939108402836
- 16. Twentieth Century Conflict in the Fourteenth Century: Intervention in Yemen, accessed July 17, 2025, https://dl.tufts.edu/downloads/9g54xv12z?filename=mk61rt433.pdf
- 17. Yemen’s Endless Wars | History Today, accessed July 17, 2025, https://www.historytoday.com/archive/behind-times/yemens-endless-wars
- 18. Forgotten Gas Attacks in Yemen Haunt Syria Crisis | Weatherhead Center for International Affairs, accessed July 17, 2025, https://www.wcfia.harvard.edu/publications/forgotten-gas-attacks-yemen-haunt-syria-crisis
- 19. Case Studies, accessed July 17, 2025, https://media.defense.gov/2025/Feb/25/2003651742/-1/-1/0/20250211_NORTHYEMEN_1962-70.PDF 20.
- Psychological effects of chemical weapons: a follow-up study of First World War veterans, accessed July 17, 2025, https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/psychological-effects-of-chemical-weapons-a-followup-study-of-first-world-war-veterans/156E21F6CCC0C4D1BC4782F51AC89349
- 21. pmc.ncbi.nlm.nih.gov, accessed July 17, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1121425/#:~:text=The%20now%20routine%20journalistic%20association,forms%2C%20acute%20and%20long%20term.
- 22. Mental health of populations exposed to biological and chemical …, accessed July 17, 2025, https://www.who.int/publications/i/item/mental-health-of-populations-exposed-to-biological-and-chemical-weapons
- 23. NPR 5.3: CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS IN EGYPT – James Martin Center for Nonproliferation Studies, accessed July 17, 2025, https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/shoham53.pdf
- 24. The Tenuous Taboo: Egypt, ISIS, and Chemical Weapons in the …, accessed July 17, 2025, https://www.diplomaticourier.com/posts/the-tenuous-taboo-egypt-isis-and-chemical-weapons-in-the-middle-east 25.
- Lessons From Egypt’s Chemical War in Yemen | by Robert Beckhusen – Medium, accessed July 17, 2025, https://medium.com/war-is-boring/lessons-from-egypts-chemical-war-in-yemen-9d44ba9a4c8e
- 26. Yemen Chemical Attacks 1967: Mind Map | MyLens AI, accessed July 17, 2025, https://mylens.ai/space/ewearner22s-workspace-jgu3kb/chemical-attacks-in-yemen-1967-ywhqyz
- 27. Egyptian CW Attacks on Yemen – The Nuclear Threat Initiative, accessed July 17, 2025, https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/09/egypt_chemical_weapon_attacks_yemen.pdf
- 28. Chemical Weapons Program – Egypt – Nuke, accessed July 17, 2025, https://nuke.fas.org/guide/egypt/cw/index.html
- 29. Full article: Anfal and Halabja Genocide: Lessons Not Learned – Taylor & Francis Online, accessed July 17, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21520844.2023.2236922
- 30. Use of chemical weapons in the Syrian civil war – Wikipedia, accessed July 17, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_chemical_weapons_in_the_Syrian_civil_war
- 31. Syrian chemical weapons program – Wikipedia, accessed July 17, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_chemical_weapons_program
- 32. The Real Impact of Chemical Warfare | American University, Washington, D.C., accessed July 17, 2025, https://www.american.edu/sis/news/20241121-the-real-impact-of-chemical-warfare.cfm
- 33. Halabja massacre – Wikipedia, accessed July 17, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Halabja_massacre
- 34. Syria’s Chemical Weapons after Assad: A CAS Conversation – American University, accessed July 17, 2025, https://www.american.edu/cas/news/syria-chemical-weapons-after-assad-cas-conversation.cfm
- 35. 3 – Human Rights Watch, accessed July 17, 2025, https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFAL3.htm 36.
- Anfal campaign – Wikipedia, accessed July 17, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Anfal_campaign
- 37. Exposure to chemical weapons results in lifelong physical and mental ill-health, accessed July 17, 2025, https://www.news-medical.net/news/20190625/Exposure-to-chemical-weapons-results-in-lifelong-physical-and-mental-ill-health.aspx