
ليست كلّ الخيانة صاخبة؛ فبعض الخيانة صامتة؛ ملساء، مقنّعة بالحرص، تبرّر نفسها بالواقعية واللّياقة والمصلحة.
هكذا يفعل الداعية حين يقف على المنبر فيرضي العامة بما يحبّون سماعه، ويلتزم القضايا التي لا تغضب أحدًا ولا تثير سخط السّلطان، ولا تزعج الجماهير.
وهكذا يفعل المثقّف حين يحصر قلمه في نصوصٍ حالمةٍ عن القيم الكلية، ويتجنّب الاشتباك مع الواقع، خوفًا من أن يُصنّف أو يُلاحق أو يُقصى.
وهكذا يفعل المفكّر حين يظنّ أن مهمّته أن يكتب أفكارًا مجردة معلّقة في الهواء، لا تمسّ الأرض السّاخنة التي يقف عليها الناس.
هؤلاء جميعًا يظنون أنهم ينقذون أنفسهم، بينما يضيّعون ما هو أثمن؛ صدق الرسالة، وشرف الكلمة، وأمانة الفكر، إنهم يمارسون خيانة من نوع آخر؛ خيانة الرسالة التي زعموا حملها.
لماذا يختارون المنطقة المريحة؟
ليس كل الصمت عجزًا، ولا كل تردّد حِكمة؛ لكنّ المكوث الدائم في “المنطقة المريحة” دليلٌ على أنّ صاحبها آثر نفسَه على فكرته، وآثر راحته على مسؤوليته؛ إنّها المنطقة التي لا عواصف فيها ولا معارك، ولا غضب ولا سخط، لكنها أيضًا بلا أثر ولا جدوى، فلماذا إذن يختار كثير من الدّعاة والمثقّفين والمفكرين هذه الزاوية الباردة، في زمن تتطلب فيه الحقيقة حرارة المواجهة؟
أولًا: الخوف من الأثمان
إنّ الحقيقة ــ بطبيعتها ــ جريحةٌ نازفة، مؤلمة لمن يلامسها ومؤذية لمن يكشفها، وحين يقرر أحدٌ أن يمشي إليها، فلا بدّ أن يكون مستعدًا للثمن؛ أن يُهاجَم، أن يُساء إليه، أن يُجتزأ كلامه، أن يخسر جمهوره أو سلطته أو مكانته.
لكن الإنسان ــ في جبلّته ــ ضعيف أمام إغواء السلامة؛ فتراه يركن إلى الظل، ويختبئ في الإجماع، ويخاف أن تهبّ عليه رياح العداوات.
الداعية؛ الذي أُنيطت به أمانة تقريع الضمائر، يخشى أن ينفضّ الناس من حوله إن هو واجههم بعيوبهم التي يحبّون إنكارها؛ فيظلّ يختار من الكلام ألينَه، ومن النّصوص أسلسها، حتى يصير خطابه صدى لرغباتِهم لا صدى للحقّ.
والمثقف؛ الذي يفترض أن يكون عين المجتمع النّاقدة ولسانه الجريء، يجد نفسه محاصرًا بمراكز القوى التي تتحكّم في الثّقافة والفرص والمكانة، يخاف أن يفقد امتيازاته، أو أن يسقط من أعين أصحاب النفوذ إن خالف الموجة؛ فيفضّل أن يبقى في قلب التيّار، يكتب كلامًا جميلًا لا يُزعج ولا يوجع، حتى لو كان فارغًا من الحقيقة.
أما المفكّر؛ الذي زُوّد بعقل حادّ وروح طليقة، فيُرعبه أن يُتهم بالتّسييس أو الانحراف أو الغلو إن هو نبش في التّابوهات التي تتكوّم في قلب المجتمع؛ فيحصر جهده في تنظيرات بعيدة عن الأرض، يحشد الحبر في قضايا قديمة أو مكرورة، ويبقى بعيدًا عن جمر اللّحظة.
إنهم جميعًا يخشون الثمن؛ الثمن الذي لا مفر منه لمن أراد أن يكون أمينًا لفكرته، فالحقيقة لها ضريبة، والصّدق له كلفة، والوقوف في وجه القطيع المندفع كالموج الجارف قد يعني أن تُنهش؛ ولكنهم ــ في ركونهم إلى السلامة ــ يخسرون أنفسهم قبل أن يخسروا مكانتهم، لأن المنطقة المريحة، مهما بدت آمنة، هي قبر بارد للكرامة والجدوى والحقّ.
ثانيًا: إغراء التصفيق
إنّ التّصفيق سُكرٌ يصيب النّفس، يعلو بها في وهم المجد، ويغشي عليها من رؤية حقيقتها، حتى تغدو كمن يسير على سحاب وهمي لا يدري متى يهوى، ولقد خُلق الإنسان ضعيفًا أمام حبّ الثّناء؛ فإذا امتلأت القاعة بالهتاف له، وارتفعت الأكفُّ تصفّق لنبراته، خُيّل إليه أنه على صواب مطلق، وأنه باتَ حكيم الأمة ونبيّ الجماهير.
هنا تكمن الفتنة؛ فالجماهير لا تصفق للحقيقة، بل لما يريحها، لما يوافق أهواءها، لما يُطمئنها على قبحها بدل أن يفضحه، والمثقّف أو الداعية أو المفكر إذا أغواه التّصفيق، فإنه لا يلبث أن يتحول إلى ما يريده الجمهور منه لا ما تريده الحقيقة منه؛ فيختار من كلماته ألينها، ويُقصي من نصوصه أقساها، ويجنح في خطاباته إلى دغدغة المشاعر بدل إثارة الضّمائر.
فيصير مرآة مشوّهة تعكس للناس ما يحبّون أن يروا، لا ما ينبغي أن يروا، وربما يتوهم ــ في غمرة الهتاف ــ أنّه مُصلح، بينما هو مجرد مؤدٍّ على خشبة المسرح، يُسلّي الجمهور ببلاغة رخوة لا توقظ أحدًا.
الحقيقة ــ بطبيعتها ــ جريئةٌ، ثقيلةٌ، قاسية أحيانًا، مؤلمة أحيانًا أخرى، ومن يضعها في وجوه الجماهير يعلم أنه سيُقابل بالصّفير وربما باللّعن بدل التصفيق، ولذلك فإن شهوة التصفيق تحرّضه دائمًا على أن يكون مهرّجًا للجماهير لا مرشدًا لها، مطمئنًا لمحبّتهم ولو على حساب رسالته.
إن حبّ الجماهير فتنة لا يُدرك غورها إلا مَن قاومها؛ لأنها تفتك بالروح في صمت، وتقتل الصّدق في هدوء، والذين قاوموها عبر التّاريخ هم الذين استطاعوا أن يُغضبوا الناس أحيانًا ليوقظوهم من سباتهم، والمصلح في الناس أشبه بالموقِد في وسط الرّماد؛ كلما حرّك الجمرة أحرقته أيادٍ لا تحب أن ترى النار.
فالذين يلهثون وراء التصفيق لا يصنعون تغييرًا؛ بل يصنعون أوهامًا، ويبقون عبيدًا لرضا الجماهير، يبيعون رسالتهم عند أوّل صفقةٍ مع الهتاف.
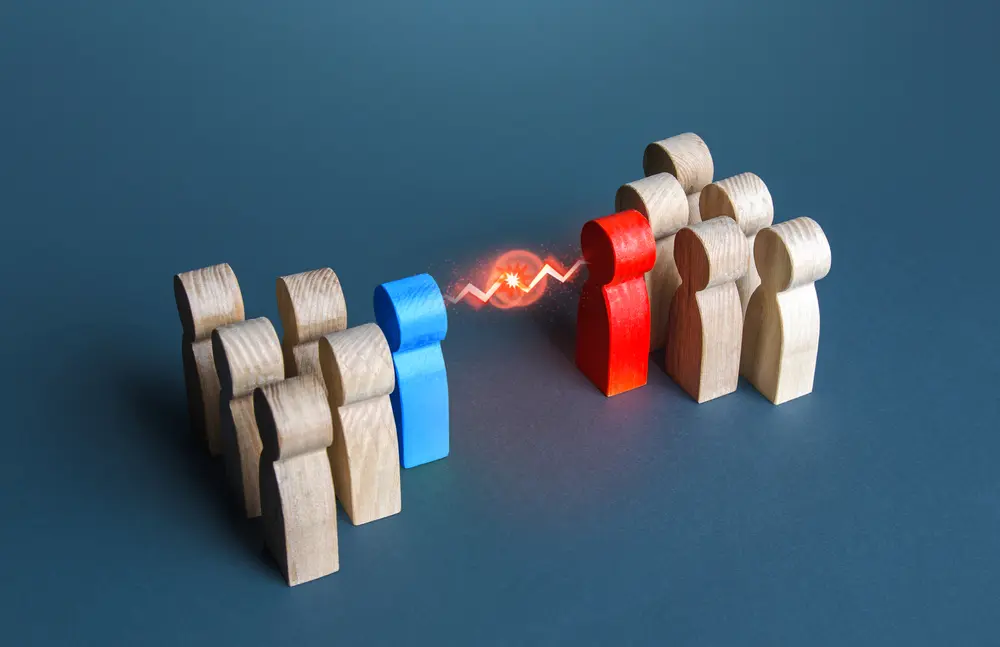
ثالثًا: الوهم بأن التغيير لا يحتاج صدامًا
إنّ أخطر الأوهام التي تخدر الهمم وتطفئ جذوة العزائم هي فكرة أن التّغيير يمكن أن يتم بلا ألم، بلا ثمن، بلا صدام مع الباطل المستحكم.
إنها مقولة عذبة، تبدو حكيمة في ظاهرها؛ التغيير تدريجي؛ فلنساير الواقع، ولنبقَ داخل الإجماع، ولنتجنب المواجهة، وهذه الفكرة تحمل نصف الحقيقة، والنّصف الآخر باطل يلبس ثوب الحِلم ليخفي الجبن.
نعم؛ التغيير يحتاج إلى حكمة، وتدرج، وصبر، ولكنّ التدرّج شيء، والركون إلى الجمود شيء آخر، والتدرج يكون حين تخوض المعركة على مراحل، لا حين تهرب منها كليًا، والصبر يكون حين تصبر على ألم المواجهة، لا حين تبرر لنفسك الهروب منها.
الواقع الذي نطمح إلى تغييره ليس خاليًا من قوى مضادّة، بل تحكمه مصالح راسخة وأهواء مهيمنة، ولن تنزاح هذه إلا بالصّراع معها، ولو على نحو متدرج.
أما الذين يحسبون أنّهم يستطيعون أن يغيّروا من داخل دائرة الإجماع، دون أن يصطدموا بالسطوة والظلم والعادات الفاسدة؛ فإنما يخادعون أنفسهم؛ لأن الإجماع ــ في معظمه ــ هشّ صنعته الأكاذيب، ويستبقيه الخوف، ولو كانت الحقيقة سهلة الهضم لما نُفي الأنبياء، ولما قُتلَ المصلحون، ولما سُجن الأحرار.
إن الذي لا يريد أن يثير الغبار؛ لا يشق الطريق، والذي يظن أن الباطل سيتنحى له جانبًا إن هو حدّثه بأدب، إنما يضلّل نفسه ويضلّل الناس؛ فالظلم غريزة مستحكمة، لا ينفك عنها إلا إذا كُسرت شوكته، والباطل كائن متغطرس، لا يلين إلا إذا وجد من يزاحمه على مكانه، وما أصدق قول المتنبّي:
الظُلمُ مِن شِيَمِ النُفوسِ فَإِن تَجِد
ذا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظلِمُ
لا يَسلَمُ الشَرَفُ الرَفيعُ مِنَ الأَذى
حَتّى يُراقَ عَلى جَوانِبِهِ الدَمُ
ولهذا؛ فإنّ إقناع النّفس بأنّ الصّدام ليس ضرورة، ليس سوى حيلة نفسية لصيانة الراحة، وحين يصير الصبر غطاءً للجبن، والحكمة مبررًا للتخاذل، فإنّنا نكون قد خسرنا المعركة قبل أن تبدأ.
فالتغيير ــ وإن كان بطيئًا في خطاه ــ لا بد أن يكون صداميًا في جوهره؛ لأنّ ما يُراد تغييره هو منظومة قائمة تقاوم التبدل، والذين اختاروا السّلامة من الصّدام، وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف جزءًا من الباطل الذي ظنّوا أنّهم يتحاشونه.

التغيير لا يصنعه المستريحون
إنّ التّغيير في حقيقته شرفٌ ثقيلٌ وألمٌ مستمر، لا يُطيقه الذين آثروا الدّعة والطمأنينة، ولا يقدر عليه من لبسوا ثياب الحكمة ليخفوا تحتها جُبنهم، فالتغيير لا يولد حصرًا في صالات الأكاديميين المعطّرة ولا على منابر الخطابة الملساء، ولا يخرج من دفء المكاتب والصالونات؛ إنما يولد في قلب العواصف، على حافّة الصراع، في الحيّز الخطر الذي يتهيّب النّاس دخوله.
التّغيير الجوهري لا يجيء من التّرف الفكري ولا من الحذلقة اللّفظية، إنّ التّغيير الحقيقي نزفٌ وعرق وجرأة؛ لأنّه اشتباك مع قوى متناقضة، وقيم مترسّبة، ومصالح عميقة.
إنّ الذين يريدون تغيير العالم دون أن يخوضوا معركته، كمن يريد أن يقطف الثّمر من شجرة لم يغرسها ولم يسقها ولم يحمِ جذورها من الريح.
إن كلّ مصلحٍ عظيم في التاريخ لم يقف في المنطقة الرمادية، ولم يقبل أن يكون مُسالمًا على حساب قضيته، ولا متوازنًا على حساب الحق، فلقد حملوا مشاعلهم وسط الظّلام، واندفعوا في وجه الريح، رغم أنّهم كانوا يعرفون أنّ هذا الطريق ملغوم، محفوف بالخسائر، وربما موت مبكر، أو عزلة قاسية.
أولًا: الاشتباك مع الواقع
الواقع ــ أيّ واقع كان ــ ليس بريئًا؛ إنه دائمًا مشحون بالتناقضات، محفوف بالمظالم، مليء بالمسكوت عنه والمزيّف والمزخرف، ومن يريد تغييره لا بد أن يشتبك معه كما هو، لا كما يتمنّى أن يكون.
الاشتباك مع الواقع معناه أن تنزل إلى ميادينه، أن تتعامل مع أدرانه، أن تدرك تعقيداته، وأن تواجه القوى التي ترعاه.
الاشتباك معناه أن تسمّي الأشياء بأسمائها، لا أن تكتفي بتعميمات باهتة، معناه أن تقول: هذا ظلم، وهذه عصبية، وهذه خيانة، وهذه جريمة، لا أن تكتفي بكلمات مثل: تحديات، وإشكالات، واختلافات؛ لأن الواقع لا ينزاح بمخمل الكلام.
الاشتباك معناه أن تقف ضدّ الظّلم، حتى لو كان في صفوف الأكثريّة، حتى لو اصطفّ الجمهور كله وراءه؛ أن تقول لهم: العدل ليس معكم وإن كنتم كثيرين، والحقّ ليس ما تهتفون به وإن علا صوتكم.
الاشتباك معناه أن تنحاز إلى العدل ولو كان ضدّ مألوف الجماعة، ولو كان ضدّ تقاليد الآباء، ولو كان ضد ما يُحسن الناس الظنّ به؛ أن تفهم أن المألوف قد يكون سجنًا، وأن الأكثريّة قد تكون طاغية، وأن الصّمت قد يكون خيانة مقنّعة.
الاشتباك معناه أن تدرك أنّ كلّ خطوة باتجاه إصلاح الواقع هي إزعاجٌ لمن ألفوا اعوجاجه، وأنّ كلّ كلمة صدق تُقال في وجه القبح تجرح غرور القبيحين، فالذين لا يشتبكون مع الواقع يتركونه يزداد قبحًا، ثم يشتكون من عتمة كانوا هم من أطال ليلها!

ثانيًا: السير في حقول الألغام
ليس في طريق الإصلاح ممرّات مرصوفة بالزهور، ولا معابر آمنة بلا كلفة، بل هو طريق محفوف بالشّكوك، مزروع بالألغام، لا يمشيه إلا من عزم على أن يقايض بسلامته الشخصية صدقَ موقفه.
إنّ القضايا الكبرى في حياة المجتمعات تشبه الجمر المستعر تحت الرماد؛ يعرف الجميع أنّها تحرق، ويتظاهرون بأنّها برد وسلام، ولهذا تجد الكلّ يتحلّق حولها عن بعد، يلمحونها في خطبهم العاطفية وأوراقهم الوردية، لكنهم لا يقتربون منها حقًا، خشية أن تنفجر في وجوههم.
الفساد مثلًا؛ سرطانٌ نخر الأوطان من جذورها، ومع ذلك لا يجرؤ كثيرون على تسميته بوضوح، لأنّهم يعلمون أن لكلّ خيط من خيوطه أصابع نافذة تحرّكه وتحرسه.
والتسلّط؛ هذا القبح المغلّف بالشعارات، يراه الكلّ والكل يئن منه سرًّا، لكن قلة هم الذين يضعون أصابعهم عليه، لأن ثمن ذلك أن يطاردوك بصيحة: أنتَ خارجٌ عن الصّف.
والتّواطؤ الخفي بين المال والسّلطة، بين الواعظ والمستبدّ، بين الإعلام والمستثمرين، هذه الشّبكة العنكبوتية التي تخنق الحقيقة، يلمحها النّاس ولا يسمّيها أحد.
وانحراف القيم؛ حين تتحول الشجاعة إلى وقاحة، والحريّة إلى فوضى، والدّين إلى ديكور للظلمـ فهذه انحرافات يزيّنها المجتمع لنفسه، ويهاجم من يوقظه منها.
وتزييف الوعي؛ حين يعلّمون الناس أن القيد زينة، وأن السّكوت حكمة، وأن السّكون نضج، وهذا أخطر الألغام، لأنه لا يدمّر جسد المجتمع، بل وعيه.
والنفاق الجماعي؛ حين يصبح الكذب فضيلة متّفقًا عليها، ويصبح الصدق تطرفًا؛ فكيف تصرخ وحدك في قاعة كلّها تصفّق للكذب؟
والاستبداد باسم الدين أو باسم الحرية؛ كلاهما يرتدي عباءة النّبل ليغطي وحشيته، فهل تجرؤ أن تفضحه؟
هكذا تبدو القضايا الكبرى؛ ألغامًا مدفونةً في قلب المجتمع، من يقترب منها يخيفه صوت العصافير الذي قد ينذر بانفجار، لكنّه يوقن في أعماقه أن تركها على حالها كارثة أكبر، ولذلك، فإن الاشتباك معها ليس رفاهية ولا بطولة عبثية، بل ضرورة وجودية؛ فلو لم يمشِ أحد في حقل الألغام، لبقيت الألغام مدفونة في التّربة لتنفجر لاحقًا في الجميع بلا رحمة.
إن من يريد أن يُصلح، لا بد أن يمتلك قلبًا لا يرتجف حين يدوس على أرض ملوثة بالظلم، وأن يمشي متوقعًا الانفجار، لكنه يمشي مع ذلك، وأن يدرك أن الثمن قد يكون عزلة، وتشويهًا، وملاحقة، لكنّه يختار أن يدفعه عن وعي لا عن غفلة؛ فالذين يكتفون بالدّوران حول الحقول، ويصفقّون للمسافة الآمنة، يتركون المجتمع نهبًا للألغام حتى تتفجر يومًا ما تحت أقدام الجميع، أما الذين يدخلونها، وإن ارتجفت أصابعهم، فهم وحدهم الذين يمهّدون الطريق للأجيال القادمة، ويزرعون لها ممرًا آمنًا حيث كان الموت كامنًا، فالحقول التي نخشى أن نسير فيها اليوم، هي التي سيسقط فيها أطفالنا غدًا إن لم نجرؤ على تطهيرها، والسير في حقول الألغام قدرُ الصادقين؛ فإما أن تدوسها بشجاعة لتطهّر الطريق، وإما أن تقعد متفرجًا على خراب مؤجل، وليس بينهما خيار ثالث.

ثالثًا: المشتبكون يصنعون التاريخ
التاريخ لا يذكر الذين خافوا العواصف واختبؤوا في الظّلال، ولا يخلّد أسماء من آثروا الصمت والنجاة.
التّاريخ يصنعه أولئك الذين مشوا إلى الصّراع بأقدامهم، وأشعلوا بأنفسهم نار المواجهة، لا الذين اكتفوا بالتّصفيق من بعيد أو بالتنظير في دفء الصالونات.
إن الذين صنعوا منعطفات التاريخ الكبرى، كانوا دائمًا مشتبكين مع زمنهم، منتصبين في وجه طغيان اللّحظة، مستعدين لأن يدفعوا حياتهم رخيصة ليبقى المعنى عاليًا، ولم يكونوا أنبياء معصومين، لكنّهم كانوا أكبر من خوفهم وأوفى لفكرتهم.
سقراط لم يكن مجرّد فيلسوف، بل كان شجاعًا بما يكفي لأن يزعزع يقين المدينة المزيف، ويعرّي تناقضاتها، ويزرع في ضمير تلاميذه أسئلة مؤلمة، وحين خُيّر بين أن يتراجع عن أفكاره أو أن يتجرّع السّم، اختار أن يموت ليبقى الحق حرًا، فصار أيقونة السؤال، ومعلّمًا للبشرية أن الفكر الحر لا يساوم.
الحسين بن علي رضي الله عنهما لم يكن يبحث عن عرش ولا عن ملك، لكنه كان يرى أن الصمت في حضرة الظلم خيانة لله والإنسان، فاختار أن يخرج على سلطان جائر، ولو لم يكن معه إلا أهله وأطفاله، وقدّم روحه قربانًا للعدل، لتبقى كربلاء درسًا خالدًا في أنّ الدّم أنقى من الذلّ، وأن الموقف أغلى من الحياة.
الإمام أحمد بن حنبل؛ في فتنة خلق القرآن؛ حين انكفأ كثير من العلماء أمام بطش السلطان، ثبت وحده في وجه السوط والمحنة، ورفض أن يزيّف الكلمة ولو تحت السياط، ضُرب حتى أغشي عليه، وحُبس؛ وحين مات شيعه الناس بمئات الآلاف، مثبتًا أن الصّمود على الحقّ، وإن بدا خسارة مؤقتة، فهو الذي يصنع المجد الباقي.
مالكوم إكس؛ لم يكن خطيبًا يجذب الجماهير بكلماته فحسب، بل كان روحًا ثائرة على الظلم، وبصيرة ترى ما وراء القشرة، فقد واجه عنصرية أمريكا، وفضح نفاقها، وحين عاد من الحج بنظرة أوسع، تجرأ حتّى على انتقاد من كانوا بالأمس رفاق دربه، واغتيل لأنه رفض أن يهادن، لكنه ظل رمزًا للصّوت الحر، الذي يختار الحقيقة ولو قتله الصّمت المحيط.
هؤلاء جميعًا وكثيرون غيرهم من مختلف التوجهات والانتماءات؛ أيقنوا أن الاشتباك مع الواقع ثمن لا بد منه للصّدق، وأن المثقّف أو الدّاعية الذي لا يغضب منه النّاس أحيانًا، هو في الغالب يبيع لهم الوهم لا الحقيقة، فهؤلاء لم يكتفوا بأن يتأمّلوا في الظّلم، بل اشتبكوا معه، ولو خسروا كل شيء في الظاهر، فقد كانوا يعلمون أن التاريخ لا يُكتب بالحبر وحده، بل بالدّموع والدم، وأن المجد لا تمنحه الجماهير لمن يرضيها، بل لمن يوقظها ويزعجها.
إن المشتبكين؛ وإن سقطوا في حياتهم، فهم وحدهم الذين يمنحون شعوبهم حياة، لأنّهم يتركون وراءهم دربًا مضيئًا يقدر الآخرون أن يسيروا فيه، ولو لم يوجدوا، لبقيت الأمم أسيرة جُبنها، تموت واقفة على عتبات الخوف، فالذين يشتبكون مع طغيان اللحظة، هم الذين يمنحون الأزمنة القادمة معنى.
فاختر أن تكون من هؤلاء؛ من الذين يكتبون التاريخ بجراحهم، لا من الذين يقرؤونه بتنهيدة ندم، لأن الصراع قد يكسرك جسدًا؛ لكنه يصوغك روحًا تضيء الدرب للآخرين.
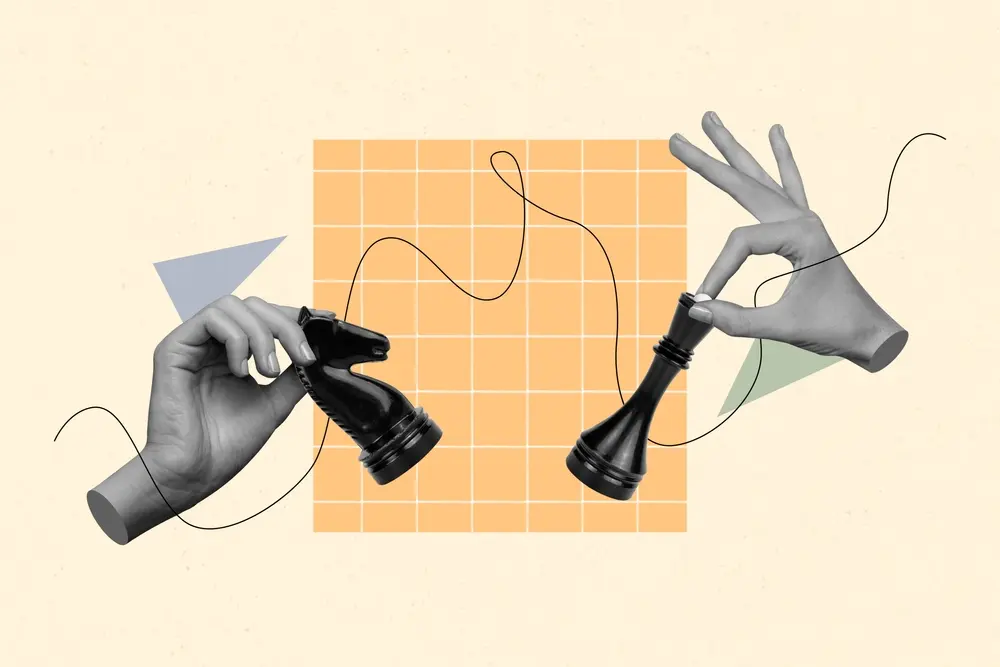
أثر المشتبكين في ضمير الأمة
إنّ الأمم مهما تراكمت عليها القرون، لا تموت حقًّا إلا إذا مات ضميرها، والضّمير العام ليس شيئًا يتيقّظ من تلقاء نفسه، بل يحتاج دائمًا إلى من يوقظه، إلى من يضع أصبعه على الجرح حتى لو تألّم الناس، ومن يهزّ الرّكود في بحيرتهم الساكنة ولو كرهوا الموج، فهؤلاء المشتبكون مع الواقع؛ الذين يرفضون الرّضا بالصّمت، هم ضمير الأمّة حين ينام الجميع، وهم صرختها الخافتة حين يطبق عليها الخوف.
ليس دورهم أن يُرضوا الناس؛ بل أن يُوقظوهم، وليس واجبهم أن يُدغدغوا مشاعر الجماهير، بل أن يعرضوا لهم مرآة الحقيقة بكلّ ما فيها من تجاعيد وندوب.
ولذلك كان أثر المشتبكين دائمًا أبعد من حياتهم، وأعمق من ضجيج لحظتهم؛ لأنهم يزرعون في أعماق الأمة يقظة لا تنطفئ بسهولة.
أولًا: استنهاض الوعي
الوعي في الأمم مثل العضلة؛ إن لم يُستفزّ، فإنّه يذوي ويترهل، وإن لم يجرّح غرورها الراكد؛ تستمر في غفلتها الراضية.
ولهذا؛ حين يجرؤ مثقف أو داعية أو مفكر على قول ما يخاف الجميع أن يقال؛ فإنّه في الحقيقة ينكأ جرح الأمة، يضغط عليه حتى يتدفق الألم؛ لأن هذا الألم هو علامة الحياة، وإنّ من يحبّ أمّته لا يخدعها، ولا يتركها تتخدّر بوهم أنّها بخير، بل يصارحها بأنّها مريضة، وأنّ عليها أن تواجه أمراضها بدل أن تتجاهلها.
إن كلمات الصّدق التي تُلقى في وجه الغفلة، وإن كانت جارحةً في ظاهرها، إلا أنّها تحمل في باطنها رحمة؛ فهي توقظ العقول وتنبّه القلوب، وتفتح للناس نافذة على ضوء لم يروه من قبل، وما أكثر الذين كانوا يظنون أنفسهم واعين، حتى جاء من يقول لهم الحقيقة كما هي، فإذا هم يكتشفون أنّ كلّ ما عاشوا فيه كان خداعًا جميلًا.
إن المشتبك مع الواقع يشبه الطبيب الجرّاح؛ يدخل على الجرح بالمشرط، ويفتحه على قيحه وألمه، لا ليشفيه فورًا، بل ليمنعه من التقيّح والموت.
ومن هنا؛ فإن صرخة المثقف المشتبك ليست عداءً للأمة، بل حبّ شديد لها؛ لأنّه يفضّل أن يراها متألمة في الحقيقة، على أن تبقى مطمئنة في وهم قاتل.
هكذا؛ كانت كلمات الأنبياء جراحًا مفتوحة في لحظاتها، لكنها شفت أممهم في ما بعد، وهكذا كانت خطب الثّوار، قاسية على الجماهير أوّل الأمر، لكنّها أنقذتها من ذلّها، وهكذا تبقى الحقيقة؛ مُرّة حين تُقال، لكنّها الدواء الوحيد للنّوم الطويل، فإن من يحب أمته حقًّا لا يتركها تغرق في وهم الراحة، بل يوقظها بصوت الحقّ، ولو جرحها هذا الصوت.

ثانيًا: بناء النموذج
إنّ الكلمات مهما بلغت من البلاغة؛ تبقى عاطرة في الهواء ما لم تجد لها لحمًا وعظمًا يمشيان على الأرض، والناس في أعماقهم؛ لا يصدّقون التّنظير المجرد، ولا يطمئنّون إلى الشّعارات الفخمة؛ ما لم يروا في حياتهم شخصًا يجسد ما يُقال، ويعيش ما يدعو إليه، ولذلك؛ كانت أعظم خدمة يقدّمها المشتبك لأمته هي أن يكون هو نفسه نموذجًا حيًّا لما يدعو إليه.
إنّ الناس بطبيعتهم ضعفاء أمام خوفهم، ميّالون إلى السّلامة، يبرّرون لأنفسهم التّخاذل بألف ذريعة. لكن حين يطلّ عليهم رجلٌ صادق، يشتبك مع الباطل بلا مواربة، ويثبت على موقفه ولو كان وحده، ويرضى أن يدفع ثمن كلماته من جسده وسمعته وأمنه، فإنّهم يستشعرون فجأة أنّ الطريق ممكن، وأن الشّجاعة ممكنة، وأن الوقوف في وجه التيار ليس خرافة.
إن المشتبك يصير قدوة، ليس لأنّه معصوم؛ بل لأنه سبقهم خطوة واحدة في مواجهة الخوف، وأثبت لهم باللّحم والدّم أن المبدأ لا يعيش في الكتب فقط، وأن المواقف لا تبقى نظريات.
ولذلك؛ فإنّ الأجيال لا تحتفظ بأسماء الواعظين المتملّقين، ولا بالمثقّفين المهادنين، بل تحفظ في ذاكرتها أسماء الذين وقفوا على خطّ النار، الذين جادوا براحتهم ليرفعوا الكرامة، الذين عاشوا كما ينبغي للإنسان أن يعيش؛ مستقيمًا على الحقّ، حتى لو انكسر جسده.
هؤلاء؛ حتى لو ماتوا غرباء أو شُتموا في حياتهم، يتحوّلون بعد موتهم إلى معالم على الطريق، فهم الدّليل الصامت الذي يشير إلى أنّ المبدأ يستحق، وأنّ الحرية ليست كلمة جوفاء، وأن العدل لا يُوهب بل يُنتزع.
إنّهم يصيرون في ضمير الأمة مرآةً تذكر الناس دومًا بما يمكن أن يكون عليه الإنسان حين يتحرر من خوفه ويخلص لفكرته، فالناس لا تحتاج إلى معلمين يبيعونها نصائح، بقدر ما تحتاج إلى رجالٍ يلقّنونها الشجاعة بأفعالهم.
وهكذا يبني المشتبك النموذج الحي؛ يصبح الصّدق الذي تتلمسه العيون، والمبدأ الذي يمشي على قدمين، والصوت الذي لا يخبو ولو خفتت الأصوات، وهكذا تخرج الأمة من سباتها، حين ترى أن في مقدورها أن تكون مثله؛ إن أرادت
ثالثًا: حماية المستقبل
إنّ المستقبل ليس زمنًا يأتي وحده كما يأتي الصّباح، بل هو حصاد ما نزرعه اليوم، ظلّ أفعالنا وظلال صمتنا، والأمم التي تصمت على انحرافاتها، وتؤجّل مواجهة أمراضها، إنّما تكتب بيدها على جبين غدها مآسي مؤجلة وأزماتٍ كامنة، سرعان ما تتفجّر في وجه أبنائها.
إن الصّمت عن الباطل لا يطفئه؛ بل يغذّيه، والسكوت عن الظلم لا يقتله، بل يورثه أكثر شراسة في الأجيال التالية، ولهذا؛ فإن المشتبكين اليوم، الذين يغامرون براحتهم ويصرخون في وجه الفساد ويكشفون الزّيف ويكسرون التّواطؤ، إنّما يحمون أبناءنا وأحفادنا من دفع فواتير جبننا نحن؛ فهم يقتحمون النّار نيابة عن الذين لم يولدوا بعد؛ ليخلّفوا لهم أرضًا أقل شوكًا، وسماءً أقل دخانًا، ودروبًا أقل خوفًا.
فلو تركنا الحقول مليئة بالألغام، كما وجدناها، فما الذي سنتركه لأولادنا سوى جراح أعمق ونكبات أشد؟!
المشتبكون لا يعيشون لذواتهم فقط، بل يطلّون على الغد من شرفات الصدق، فإنهم يفهمون أن كلّ عقدة نغض الطرف عنها اليوم، ستلتف غداً حول رقبة جيل بريء، وأنّ كلّ ظلمٍ نهادنه، سيستأسد غداً على أطفالنا، وأنّ كلّ انحراف نقبله، سيصبح في الغد طبيعة ثابتة، وعرفاً محصناً ضد التغيير.
ولهذا؛ فإن صوتهم الجريء اليوم هو في حقيقته وصية للأجيال؛ أن هناك من أحبّكم قبل أن تولدوا، فحمل عنكم عبء الصّراع، وعبّد لكم الطريق بالعرق والدمع، فمن يشتبك اليوم، يكتب للأجيال القادمة حقّها في تنفّس هواءٍ أصفى، ومن يصمت اليوم، يورّث أبناءه صرخة ألمٍ مدفونة في طين الغد.
إنّ المشتبكين يحرسون المستقبل بوعيهم، ويحمونه بشجاعتهم، فالمستقبل لا تحميه الأمنيات، بل تفتحه مواقف الرجال الذين لم يرضوا أن يناموا على ظلم يثقل كاهل الغد، وما أشرف أن يكون إرثك لأمتك جرحًا صادقًا في صدر الباطل؛ بدل أن تترك لها قيودًا صدئة وأبوابًا موصدة.

على حافة الصدق
على حافة الصدق؛ يقف الإنسان في لحظة مواجهة نادرة، مجردًا من كل أقنعته، محاصرًا بأسئلته التي ظل يهرب منها طويلًا؛ هل كنتُ صادقًا مع نفسي ومع فكرتي، أم كنت بارعًا فقط في إرضاء الآخرين؟ هل قلت ما كان يجب أن يُقال حقًّا، أم ما أحبّوا أن يسمعوه؟ هل كنت أمينًا على المعنى أم وفيًّا لموقعي ومكانتي؟
عند تلك الحافة يكتشف المرء أن الصّدق مكلف وأن الرّاحة مغرية، لكنه يكتشف أيضًا أن الذين يصنعون الفرق ويكتبون أسماءهم في ذاكرة الأمّة لم يكونوا أبدًا من الذين اختبؤوا في الظّلال أو استراحوا عند حافة الطريق، بل كانوا أولئك الذين اقتحموا حقول الألغام وأحرقوا أقدامهم على جمر الحقيقة، ولم يتراجعوا عن قول ما ينبغي أن يُقال مهما ثقل الثّمن أو طال الألم؛ فليختر كلّ واحد منّا إذن في أيّ صف سيقف، صفّ المستريحين الذين يبيعون الوهم ليشتروا السّلامة، أم صفّ المشتبكين الذين يوقظون الضّمير مهما أغضبوا النّاس وأوجعوا الجرح؛ لأن الصّدق؛ مهما بدا وحشيًّا ومؤلمًا، هو وحده الذي يمنح للحياة معنى وللذكرى خلودًا.

