
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم، وبعد:
لطالما انشغل العقلُ الإسلاميّ في العصر الحديث، بمناقشة وتحليل الأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين وتأخرهم عن ركب الحضارة، وقد أشار بعضُ المفكرين إلى أنَّ لحظةَ الصدام بين الشرق والغرب إنما تعودُ إلى وقت دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798، وما صاحبَها من صدمةٍ حضاريَّة هزَّت العالَم الإسلاميّ.
وفي أعقاب اندحار هذه الحملة العسكرية سنة 1801، طُرِح أكبر سؤالٍ في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث وما زال يُطرح إلى اليوم: (لماذا تأخر المسلمون وتقدَّم غيرهم؟)، وبمرور السنوات ازداد هذا الطرحُ حِدَّةً وإلحاحاً على كافة المستويات السياسية والثقافية، وأصبح يشكلُ هاجساً تعيشه النخب المثقفة والشرائح الاجتماعية البسيطة سواءً بسواء.
وعلى مدى العقود اللاحقة، أعادَ المفكّرون العرب والمسلمون طرحَ هذا السؤال في صِيَغٍ مختلفة وقوالب متجددة، وقد تباينت إجاباتهم تبعاً لمدارسهم الفكرية وطريقتهم في النظر إلى مسببات التأخُّر؛ فمنهم مَن حمَّل الغرب المسؤوليةَ عمَّا آلت إليه أحوال المسلمين عموماً، وعن تأخُّرهم خصوصاً، ومنهم مَن بحث في عوامل هذا التأخُّر في الثقافة الغالبة لدى المجتمعات العربية والإسلامية، أو في طبيعة هذه المجتمعات، أو في نظام الحُكم، أو في جميع هذه الأسباب.
وقد كان طرحهم لهذا السؤال إيماناً منهم بأنَّ العاقل هو مَن ينظر في التاريخ نظرةَ المستفيد والمستقي من وقائعه، فيأخذ أسباب النجاح ويعمل بها، ويتدبر أسباب الفشل والتأخُّر فيجتنبها، فالذي لا ينظرُ إلى الخلف ولا يدرس أسباب الفشل سيُكرر هزائمه وهزائم غيره، ومَن لا يتأمّل أسباب عدم نجاحه وانتصاره فسيكون عبئاً على أُمَّتِه، وسبباً من أسباب هزائمها.
وبرغم صعوبة البحث في الأسباب المَرَضِيَّة التي أدت لتأخُّر العالَم الإسلامي، نتيجةً لارتباطها بأسبابٍ فكرية أساسها ما في الأنفُس من معتقداتٍ وثقافات، إلا أنَّ ذلك لم يمنع هؤلاء المفكّرين من خَوضِ غِمار هذا البحث ومحاولة تحليل الأسباب الحقيقيَّة لذلك التأخُّر.
والمتأمل في حقيقة الأجوبة الواردة على سؤال تأخُّر المسلمين، يجد أنَّها جاءت على ثلاثة مذاهب رئيسية تمثل أقصى اليمين والوسط وأقصى اليسار. وقد جاء هذا التعدد في الأجوبة تعبيراً عن عمق الأزمة، ومحاولةً للنفاذ إلى أغوار الواقع الإسلامي المتردّي..
حيث يرى أصحاب المذهب الأول أنَّ العالَم الإسلامي لم يتخلّف إلا لأنَّه ابتعدَ عن دينه، وأهملَ شريعته وأنَّ دواءه يكمن في العودة إلى الإسلام الحقيقي الصحيح والتمسك بالماضي، وإحياء التراث واستنساخ حِقَبِهِ الذهبية، والاكتفاء بما عنده من مقومات، وقد آثرَ أصحابُ هذا المذهب الاحتماءَ بالتراث الذي أضْفَوا عليه هالاتٍ من التقديس واعتقدوا أنَّه الحق ولا حقَّ بعده، واختاروا التقوقع والانغلاق على الذات وعدم الانفتاح على الآخر ورفضه رفضاً مطلقاً، مع الإصرار على أنَّ المسلمين لن يعود إليهم عزُّهم إلا باقتفاء آثار الآباء والأجداد.
أما أصحاب المذهب الثاني، فقد حَمَلوا اتجاهاً مناقضاً ومعاكساً لأصحاب المذهب الأول؛ إذ رفعوا شعار أنَّ خروج العالَم الإسلامي من التخلف واللحاق بركب الحضارة المعاصرة لا يمكن أن يتم إلا باحتذاء الغرب شِبراً بشِبر وذِراعاً بذراع، وقد دعا أنصارُ هذا المذهب إلى اقتباس الحضارة الغربية بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، ورَمَوا التراثَ بالعُقمِ والجُمُود، ودَعَوا إلى هدم صرحه ومحوه من الذاكرة، والانسلاخ منه إيماناً منهم بأنَّ عِلَّة المسلمين في إسلامهم، وأنَّ تخلُّفهم يكمنُ في تديُّنِهم، وأنَّ التراث سلاسل تقيِّدهم لتحرمهم من الحركة والتغيير، فرفضوه برمَّته بما في ذلك قِيَم الوحي المعصومة.
وبقي أخيراً أصحاب المذهب الوسط، الذين حاولوا الوقوفَ بين أصحاب المذهبين؛ فرفضوا جمودَ الأولين وجحودَ الآخرين، وآمنوا أنَّ الحياةَ تتغير كل يوم، وكلُّ تغييرٍ تتبعه حركةٌ تناسبه، وأنَّ هناك ثوابت ترتكزُ عليها الأمَّة لا يجب أنْ تطالها الأيدي بالتبديل، وعلى هذا الأساس اعتبروا وجود التراث في المشروع النهضوي ضرروة لا غِنَى عنها؛ لأنَّه يحفظُ للأمَّةِ كيانها الديني والتاريخي من الذوبان، ويحمي شخصيتها الحضارية من التحلل، وكلُّ ذلك من الأسس العامة التي يقومُ عليها بناء المجتمع، ويمكنُ فيها مبررُ وجوده وسرُّ بقائه، ودعوا في الوقت ذاته إلى الانفتاح على الحضارة المعاصرة انفتاحاً مدروساً، والاقتباس من علومها ومعارفها ومخترعاتها وخبراتها الإنسانية، واستقدام كل ما هو ضروري لتغيير حياة المسلمين نحو الأحسن، وكانت رؤيتهم تقومُ على الجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، والانفتاح على العالَم المعاصر دون الذوبان فيه، والثبات على الأهداف والمرونة في الوسائل.
لقد كان انحطاط العالَم الإسلامي وسقوطه في وهدة التخلُّف إفرازاً طبيعيًا لعوامل ذاتية داخلية ما فتئت تنخرُ بنيانه حتى أنهكت قواه وأسلمته لحالة الانحطاط التي وصل إليها في العصور الحديثة، وقد شمل هذا الانحطاط جميع مجالات الحياة وشؤؤنها، وألقى بظلاله القاتمة على كل القطاعات الحيوية في الأمَّة، في العقيدة والأخلاق والتعليم والسياسة والاقتصاد والاجتماع.
وعلى الرغم من الانهيار الشامل الذي أصابَ الحضارة الإسلامية بعد أن فقدت خطوط اتصالها بمذهبيَّتها، وانحسرت أمام موجات النكوص، إلا أنَّ عوامل القوة الذاتية فيها لم تمت وبقيت كامنةً في أعماقها، تطفو على السطح بين آونةٍ وأخرى، وتظهر في شكل حركات تجديد، تعبّر عن القلق الحضاري الذي ينتاب ضميرَ الأمة الجمعي، وتمثل ردة فعلٍ على مظاهر الانحراف والفساد، وتحاول مراجعة الماضي، وتقويم الواقع، ونقد الذات للوقوف على أسباب التقهقر والسقوط، والتمهيد، لإعادة بناء الكيان المتهدم، إلا أنَّ إكراهات الواقع الثقيلة كانت أقوى منها جميعاً.
ترجع المحاولات الأولى لفقه أسباب تأخُّر المسلمين إلى نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديداً عقب مرور عقدٍ على الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، الذي شهد الإعاقةَ الأولى لمشروع التحديث على النمط الأوروبي الذي بدأه مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا في بداية ذلك القرن؛ إذ كشفت بعض الدراسات الحديثة عن أسبقية محاولة المفكر المصري عبدالله النديم في ارتياد ميدان الإجابة عن سؤال العصر، وذلك على عكس ما كان شائعاً من أسبقية المفكر اللبناني شكيب أرسلان في ارتياد هذا الميدان.
لم يكن النديم وأرسلان هما الوحيدان اللذان تقدَّما للإجابة عن ذلك السؤال، وإلا فهناك طائفةٌ واسعة من مفكّري العصر الذين اتخذوا من ثوابت الأمة العقدية، ومن إيمانهم بضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ أساساً ومنطلقاً للنظر والبحث عن مسببات التأخُّر.
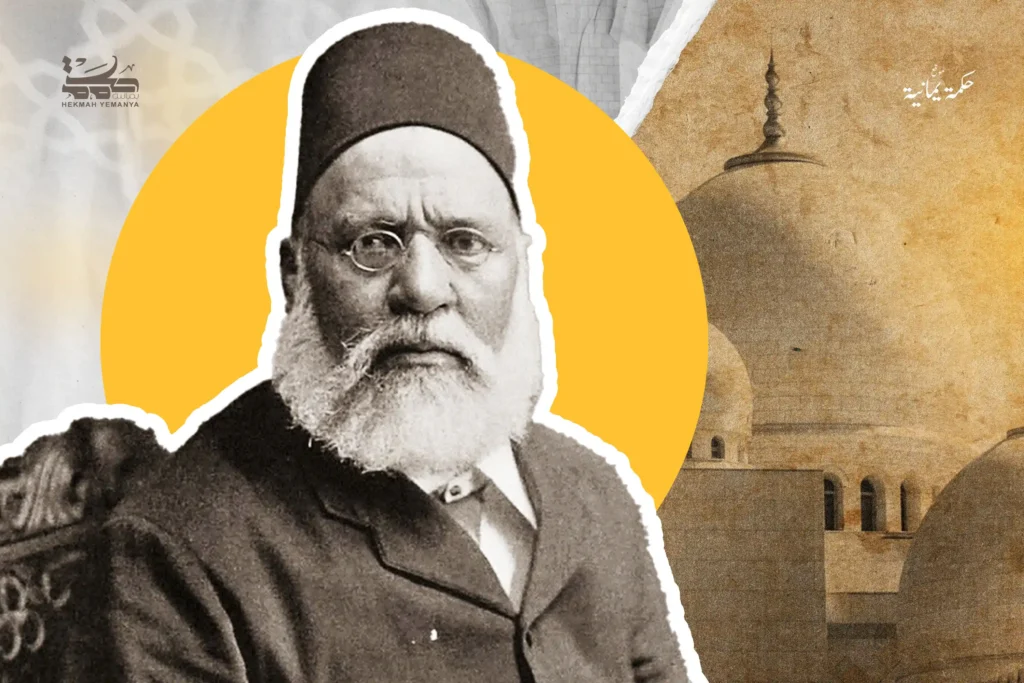
عبدالله النديم: مفكرٌ مصريّ في طليعة الرواد الذين نبَّهوا شعوبَ الشرق على الخطأ الذي وقعوا فيه عندما تنكَّبوا طريق التقدم، وساروا في عكس اتجاهه ولم يأخذوا بأسبابه، فسقطوا في وهم أنَّ كلاً من التقدم الأوروبيّ والتخلُّف الشرقي إنما هي ضربةُ لازبٍ ليس منها فِكاك.
أودعَ النديم زُبدةَ أفكاره حول فقه التقدُّم والتأخُّر الحضاري في مقالةٍ نشرها في صحيفة (الأستاذ) سنة 1892، وفيها ظهرت عنايته بالبحث في العِلل التي أوجبت تأخر المسلمين وتراجعهم، فلم يجد سبيلاً للتوصل إلى هذه العلل إلا بمعرفة الأسباب التي ساقت أوروبا إلى التقدم، وهي في نظرِهِ ستة أسبابٍ هي:
● إطلاق حرية الفِكر والكتابة.
● تجميع رؤوس الأموال في مؤسساتٍ وشركاتٍ مساهمة.
● تشجيع التنافس والابتكار في علوم التمدُّن.
● تعميم التعليم وتوحيده.
● إقامة مجالس الوزراء ومؤسسات الشورى.
● إقامة المؤسسات لأهل الفكر والعلم والثقافة.

محمد فريد وجدي: مفكّرٌ مصري من رواد المفكرين الذين تناولوا جذور الأسباب التي أدت إلى تأخُّر المسلمين في المدنية، كما كان من أوائل مَن تحدَّثوا عن سلامة المقومات الفكرية الإسلامية، وقدرتها على البقاء والاستمرار، ودورها في إنشاء الحضارة المعاصرة، وذلك في كتابه (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنيَّة) الذي أصدره في وقتٍ مبكر سنة 1898، ثمَّ ما لبث أن غيَّر اسمه إلى (المدنية والإسلام) في طبعته الثانية سنة 1901، وقد كتبه في البداية باللغة الفرنسية ثم قام على ترجمته لاحقاً إلى العربية.
أوردَ فريد وجدي جملةً من الأسباب التي رآها موجبةً لتأخُّر المسلمين عن ركب الحضارة، وقد استهلَّ حديثه بأنَّ هذه المسألة قد بحثها قبله كُتَّابٌ فطاحل، إلا أنَّ أكثرهم أغضَى كلَّ الإغضاءِ عن ذات العِلَّة، فنجده قد حصرَ تلك العِلَلِ فيما يلي:
● عدم الفهم الصحيح لحقيقة الدّين.
● ضعف النظام التعليمي.
● التقليد الأعمى للغرب.
● الجهل بمدنيَّة الإسلام.
● الغفلة عن مقصد الحياة.

عبدالرحمن الكواكبي: مفكّرٌ سوريّ قدير وواحدٌ من أبرز رواد الفكر الإسلاميّ في العصر الحديث، وأحد أهم مَن تطرَّقوا بالبحث والتحليل العميق لأسباب تأخَّر المسلمين في القرون الأخيرة. تجلَّت عنايته بدراسة أسباب تأخُّر المسلمين في كتابه الفذ (أم القرى) الذي وقف فيه من المسلمين موقفَ الطبيب من المريض، يفحصُ داءه ويتعرف أسبابه، ويصف علاجه في أسلوبٍ قصصيّ جذَّاب، فهو بحثٌ مبتكر، يدلُّ على كبر عقله وقوة تفكيره، وسعة اطلاعه، وصدق غيرته على العالَم الإسلامي.
وقد أشار الأديب المصري أحمد أمين إلى أنَّ أنصع صفحةٍ في تاريخ حياة الكواكبي، هي شعوره بفساد أحوال المسلمين، وتخصيص جزءٍ كبير من حياته في تعرّف أحوالهم في جميع أقطار الأرض، وتشخيص أمراضهم وتلمُّس العلاج لهم.
نشر الكواكبي دراساته في مقالاتٍ كُتبت في المجلات والجرائد، ثمَّ جُمعت في كتابين: الأول (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) والثاني (أم القرى)؛ أولهما في نقد الحكومات الإسلامية، أما الثاني ففي نقد الشعوب الإسلامية؛ ذلك أنَّه شعر بفتور الأمة وسلبيتها في جانب التنظيمات والاجتماعات على المستويين النظري والعملي، في الوقت الذي نسي فيه المسلمون بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية الحج. فما كان منه إلا أن تخيَّل انعقاد جمعيةٍ من المسلمين في مكة المكرمة، حضرها ممثلٌ أو أكثر لكل قُطرٍ إسلامي.
خلص الكواكبي في كتابه إلى حَصرِ أسباب فتور المسلمين في ثلاثة أنواعٍ أساسيَّة، وهي أسبابٌ دينية، وسياسية، وأخلاقية..
فَمِن الأسباب الدينية: تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمَّة، تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة، تأثير فتن الجدل في العقائد الدينية، تشويش أفكار الأمَّة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين.
ومن الأسباب السياسية: فَقْد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمَّة، ميل الأمراء للعلماء المدلّسين وجهلة المتصوفين، حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم، فقد قوة الرأي العام بالحَجْر والتفريق.
ومن الأسباب الأخلاقية: الاستغراق في الجهل والارتياح إليه، فقد التناصح وترك البُغض في الله، انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية، فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد.

بديع الزمان سعيد النُّورسي: عالِمٌ ومجاهدٌ تركيّ وأحد أبرز دعاة الإصلاح الديني والاجتماعي في العالَم الإسلامي حديثاً، كما أنه مِن أهم مَن وقفوا على أسباب تأخُّر المسلمين في عصره.
ظهرت عنايته بتحليل أسباب تأخُّر المسلمين في مضمار المدنية، فتبيَّن له أنَّ السببَ الأول في ذلك يرجع إلى تباين الأفكار واختلاف المشارب لدى منتسبي ثلاث شُعبٍ كبيرة، يُعدُّون مرشدين عموميين للجميع، وهم: منتسبو المدارس الحديثة، والمدارس الدينية، والتكايا.
كان بديع الزمان يُشاهد عدم جدوى الطرق القديمة المتبعة في المدارس الدينية أو في حلقات العلماء، ويرى كيف أنَّ الطلاب لا يتزوَّدون من العلوم الحديثة شيئاً، فيتأسَّف ويغتمُّ لذلك، فاقتنع بأنَّ الخطوة الأولى للإصلاح يجبُ أن تبدأ بإصلاح نظام التعليم؛ إذ كان يرى أنَّ المدارسَ الحكومية تُدرِّس القوانين العلمية دون التأكيد على أنها نواميس إلهية، وأنَّ المدارس الدينية تُدرِّس العلوم الدينية دون الإشارة إلى العلوم الحديثة، لذا فالإصلاح يبدأ من قيام المدارس الحكومية بتدريس الدين بجانب العلم لكي لا ينحرفَ الطلاب إلى الشك والإلحاد، وذلك إلى جانب قيام المدارس الدينية بتدريس العلوم الحديثة لكي لا ينحرفَ طلابُها إلى التعصُّب وضيق الأُفُق.
وقد أشار بديع الزمان في خُطبته الشهيرة بالجامع الأُموي بدمشق سنة 1910، إلى أهم الأسباب التي رآها موجبةً لتأخُّر المسلمين وتراجعهم الحضاري، إذ يقول: لقد تعلُّمت الدروسَ في مدرسة الحياة الاجتماعية البشرية، وعلمتُ في هذا الزمان والمكان أنَّ هناك ستة أمراضٍ جعلتنا نقفُ على أعتابِ القرون الوسطى، في الوقت الذي طارَ فيه الأجانب – وخاصة الأوروبيون – نحو المستقبل”، وهذه الأمراض هي:
● حياةُ اليأس الذي يجدُ فينا أسبابَه وبعثَه.
● موتُ الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية.
● حبُّ العداوة.
● الجهل بالروابط النورانية التي تربطُ المؤمنين بعضهم ببعض.
● سريان الاستبداد سريان الأمراض المُعدِية المتنوعة.
● حصر الهِمَّة في المنفعة الشخصية.

سعيد حليم باشا: أحد أبرز السياسيين المرموقين في الدولة العثمانية، فهو حفيد محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، ووالدُه أحد أعضاء مجلس الدولة في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، وهو في الوقت نفسه أحد كبار العقول الفكرية الإسلامية في بدايات القرن العشرين.
ظهرت عنايته البالغة بالبحث في أسباب تأخُّر المسلمين، في رسالته (لماذا تأخَّر المسلمون؟) التي بدأ العملَ فيها كمقالاتٍ نشرها في مجلة (سبيل الرشاد) سنة 1918، ثمَّ نُشِرت مجموعةً في السنةِ نفسها.
وقد سجَّل سعيد حليم باشا في هذه الرسالة ملاحظةً مفادها أنَّ حديث التأخُّر والتقدم ومشكلة تخلُّف العالَم الإسلامي كان حديث زمانه، ولأنَّ تخلُّف المسلمين كان عاماً، ولأنَّ البحث في أسباب تخلُّفهم لم تكن موضوعية وحياديَّة؛ فقد أعاده البعضُ للقاسم الجامع بينهم وهو الإسلام، وبذلك أخذت قضية تخلُّف المسلمين شكلاً دينياً.
فنجده قد ردَّ تخلُّف المسلمين إلى عوامل اجتماعية واقتصادية ومادية، يمكن تعويضها بالتربية والتعليم، لكنه في الوقت نفسه رَفَضَ تحليلات الغربيين بردِّ هذا التخلُّف للإسلام نفسه، فذلك نقلٌ للمشكلة إلى سياقٍ ميتافيزيقي وإهمالٌ للعوامل الموضوعية، وهو بنفس الوقت هجومٌ غربيّ باسم المادية على الإسلام لا يقلُّ عن الهجوم الصليبيّ باسم المسيحية قبل ذلك.
وبإلقاء نظرةٍ فاحصة على كامل الرسائل التي وصلتنا لسعيد حليم، نجد أنَّ هناك أسباباً عامة لتأخُّر المسلمين، يمكن إجمالها في النقاط التالية:
● التقليد الأعمى للغرب.
● سيطرة الفِكر المادي.
● ظهور دُعاة التجديد.
● سوء فهم الشريعة.
● الجهل بقوانين الطبيعة.
● فساد النظام التعليمي.

محمد الطاهر ابن عاشور: أحد أعلام هذا العصر وركنٌ من أركان الحركة الإصلاحية، فهو مفخرة تونُس العلميَّة، فيها عزم على إنجاز مشروعه الإصلاحي من خلال التعليم في جامع الزيتونة العتيق، وقد بلغ شأواً بعيداً في مضماره، هو سليل أسرة كريمة بالدين، جليلة بالفقه، توارث أهلوها المناصبَ العلميَّة والسياسية. نشأ نشأةً زيتونيَّة، وتدرَّج في سُلَّم معارفه تدرُّجاً سريعاً.
ضمَّنَ الشيخ ابن عاشور آراءه التربويَّة والتعليميَّة في كتابه (أليس الصبح بقريب)، الذي بدأ التفكير في تأليفه سنة 1902، وفيه ردَّ أسباب تأخُّر التعليم إلى سببين أساسيين:
● الأسباب العامة التي قَضَت بتأخُّر المسلمين على اختلاف أقاليمهم وعوائدهم ولغاتهم، ولكنَّ هذا بحثٌ يشغلُ بياض مجلدات ومرجعه إلى التأخُّر العام في العالَم الإسلامي.
● والآخر يرجعُ إلى تغيُّر نظام الحياة الاجتماعية في أنحاء العالَم تغيُّراً استدعى تبدُّل الأفكار والأغراض والقيم العقلية، وهذا التغيُّر قد استدعى تغيُّر أساليب التعليم ومقادير العلوم المطلوبة، وقيمة كفاءة المتعلمين لحاجات زمانهم.
كما نجده قد تعرَّض بالنقد لمستويات التعليم في عصره، حيث لاحظَ غفلةً عن إعطاء كلّ مستوى من مستويات التعليم ما يحتاجه من المنهج اللائق، مما له أثرٌ بالغُ في تقويم الفِكر؛ وذلك بالاعتناء بما يجعل ذهن التلميذ مراعياً لما تجبُ مراعاته من القواعد التربويَّة عند كلّ مرحلةٍ من مراحل التعليم، وقد نقد الشيخ هذه المراحل نقداً وجيهاِ، من ذلك:
● غياب ملكة النقد في مرحلة التعليم العالي. .
● إهمال التمرين والعمل بالمعلومات في المرحلة الثانوية.
● غياب الحفظ في المرحلة الابتدائية.
● عدم مراعاة المصالح الصحيَّة
● الجري وراء الشهادة من غير تحصيلٍ علميّ.

محمد أسد: مفكّرٌ ورحالةٌ من أصل نمساوي، وواحدٌ من أعظم المفكّرين اشتغالاً بقضايا الإسلام الكبرى جهاداً وتأليفاً في القرن العشرين. وقد ظهرت عنايته بتتبُّع أسباب تأخُّر المسلمين في كتابه (الإسلام على مفترق الطرق) الذي أصدره أولَ مرةٍ سنة 1934.
صارحَ محمد أسد المسلمينَ في هذا الكتاب بحقائق قلَّ إنْ جرؤ غيرُهُ على التصريح بها، إنَّه درسٌ دقيقٌ لحالِ المسلمين اليوم من الناحية الثقافية والروحية، وهو يدعو المسلمين إلى العودة إلى حقيقة دينهم؛ لأنَّ الدين الذي استطاع أنْ يجمع العرب منذ أربعة عشر قرناً، ويجعل منهم قوةً عظيمة في السياسة والعلم والاجتماع يستطيعُ أنْ يقدّم لهم اليوم ما قدَّم بالأمس؛ دستوراً للحياة لا يجدون مثله في النُّظم التي تعرَّضت منذ فجر التاريخ حتى اليوم لتهذيب البشر.
توصَّل محمد أسد إلى قناعةٍ بأنَّ الآراء الشائعة في الغرب عن الإسلام تتلخَّص فيما يلي: (انحطاطُ المسلمين ناتجٌ عن الإسلام، وبمجرد تحررهم منه العقيدة الإسلامية وتبني مفاهيم الغرب أساليب حياتهم وفِكرهم؛ فإنَّ ذلك سيكونُ أفضل لهم وللعالَم). إلا أنَّ ما وجده من مفاهيم وما توصَّل إلى فهمه من مبادئ الإسلام وقِيَمه أقنعه أنَّ ما يردده الغرب ليس إلا مفهوماً مشوّهاً للإسلام، فاتضح له أنَّ تخلُّف المسلمين لم يكن ناتجاً عن الإسلام، ولكنْ لإخفاقهم في أنْ يحيَوا كما أمرهم الإسلام. ويمكن استعراض الأسباب التي أدَّت بهم لذلك من خلال النقاط التالية:
● ترك اتباع روح التعاليم الإسلامية.
● الإعراض عن السنة النبوية.
● قطع الصلات بالماضي.
● القصور في تصوُّر مفهوم العبادة.
● محاولة تكييف الإسلام حسب مقتضيات المدنيَّة الغربيَّة.
● تنشئة أجيال المسلمين على الثقافة الغربيَّة.
● الخضوع للفلسفة الأوروبيَّة.
● التفاؤل المفرط بقَبول المدنيَّة الغربيَّة للإسلام.

شكيب أرسلان: مفكّرٌ وأديبٌ لبناني، عرفه العالَم الإسلامي أميراً للبيان ولساناً ينقلُ بصفاءٍ ودقةٍ كلمة الإسلام، وذلك من خلال مقالاته ومؤلفاته وترجماته وتحقيقاته، واشرأبَّت إليه الإعناق في كلّ معضلة، وافتقده المصلحون الاجتماعيون، والزعماء السياسيون، أمام كل مشكلة.
أرسل أحد وجهاء جزيرة جاوة الإندونيسية رسالةً إلى صاحب مجلة (المنار) السيد رشيد رضا سنة 1929، يقترح فيها أن يستكتب أرسلان في أسباب ما صار إليه المسلمون من الضعف والانحطاط والذل، وأن يبين أسباب رقي أهل أوروبا وأميركا واليابان، وما إذا كان يمكن للمسلمين مجاراة هؤلاء في سباق الحضارة، مع المحافظة على دينهم الحنيف. فأحالَ السيد رشيد رضا الرسالةَ إلى أرسلان، الذي انكبَّ على إعداد الجواب خلال ثلاثة أيام، وقد حَمَلَ عنوان: (لماذا تأخَّر المسلمين ولماذا تقدَّّم غيرهم).
وقد تساءل أرسلان باستنكارٍ: “كيف ترى في أمَّةٍ ينصرُها الله بدون عمل، ويفيضُ عليها الخيرات التي كان يفيضها على آبائها، وهي قد قعدت عن جميع العزائم التي قد كان يقومُ بها آباؤها؟!، وذلك يكونُ أيضاً مخالفاً للحكمة الإلهية والله هو العزيز الحكيم، وما قولكَ في عِزَّةٍ دون استحقاق، وفي غلةٍ دون حرثٍ ولا زرع، وفي فوزٍ دون سعي ولا كسب، وفي تأييدٍ دون أدنَى سببٍ يوجبُ التأييد؟!”.
ويمكن إجمال الأسباب التي رآها شكيب أرسلان موجبةً لتأخَّر المسلمين، في النقاط التالية:
● الجهل.
● الجُبن والهلع.
● العلم الناقص.
● فساد الأخلاق.
● الجمود والجحود.
● فقد الثقة بالنفس.

أبو الحسن الندوي: مفكّر هنديّ بارز، وأحد أعلام المصلحين في القرن العشرين. اجتمع له من العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم -، والفقه في الدين؛ ما زكَّاه لاتفاق كلمة علماء المسلمين على أنَّه أحد المصلحين المجددين في هذا العصر.
نشأ الندوي في وضعٍ كان العالَم الإسلاميّ يئنُ فيه تحت وطأة الاستعمار الأوروبيّ العسكري والفكري والتعليمي، ولكنَّ الله أكرمه فنشأ في بيتٍ عُرِف بتقاليده العلمية والدينية والروحية والجهادية عبر القرون. وقد كان الشيخ من المعنيين بمسألة توصيف أحوال الأمَّة الإسلاميّة مقارنةً بأحوال باقي الأمم الشرقية والغربية، وهو ما ظهر في كتابه (ماذا خسر العالَم بانحطاط المسلمين)، الذي تحدث فيه لأولِ مرةٍ أنَّ تقدُّم المسلمين كان نعمةً وبركةً على العالَمِ بأسرِه، فلمَّا أصابهم الانحطاط تعدَّى خسرانُه إلى العالَم بأجمعِه.
وفي ضوء ما أورده الندوي في كتابه، يمكن استخلاص مجموعة من العوامل التي رآها قد تسبَّبت في ذلك الانحطاط، وهي التي يمكن حصرها في النقاط التالية:
● افتقاد شروط الزعامة الإسلامية.
● ضعف الوعي في الأمَّة.
● الرُّكون إلى الجاهلية الأوروبية.
● الغفلة عن الاستعداد الروحي.
● الرضا بالحياةِ الدنيا.
● التخلي عن الزعامة العلميَّة.
● قلة الاحتفال بالعلوم العمليَّة المفيدة.

محمد الغزالي: مفكّرٌ مصريٌّ معروف، عُرِف بأنَّ أحد الحاملين لهمومِ إصلاح الأمَّة الإسلامية وإعادة بعثها من جديد خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حتى وُصِفت كتاباته بأنَّها تحملُ عاطفةَ الأمِّ على وليدها المريض الذي تخشَى أنْ يفترسه المرض.
سلكَ الغزاليُّ في الكتابة الدينيَّة منهجاً يجمعُ بين العلم والأدب، مع عرض الثقافة الإسلامية عرضاً ممزوجاً بقضايا العصر، ويمكن اعتبار المحور الأساسي الذي دارت حوله معظم كتاباته هو (الإسلام والطاقات المعطَّلة). أما عنايته بأسباب تأخُّر المسلمين، فقد ظهرت جليةً في كتابه (سِرُّ تأخُّر العرب والمسلمين) الذي أصدره سنة 1985، والذي أقرَّ فيه بكثرة هذه الأسباب، ما بين سياسيَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة، وهي التي يمكن حصرها في النقاط التالية:
● الأخذ بقُشور الدّين دون لُبِّه.
● غلبة التقاليد الاجتماعية المنافية للشريعة.
● التقصير في حمل أعباء الدعوة إلى الله.
● عدم الاستفادة المُثلى من وقائع التاريخ.
● البحث الدائب عن الشقاق والخِلاف.
● ضحالة المستوى الثقافي.
● غياب التخطيط الصحيح لإعادة بناء الأمَّة.
● ترك الساحة لأرباب المذاهب الماديَّة.
وبذلك يظهر أنَّ أبرز ما ميَّز الطرح الفكريّ المعني بفقه أسباب تأخُّر المسلمين، والذي عالجَ به التيار الإصلاحيّ الوسطي حالةَ الأمَّة المتردية؛ هو التركيز بشكلٍ كبير على الأمراض الداخلية، والعكوف على تحليل الوضع الذاتي للأمَّة، والاجتهاد لإيجاد مكمن الخلل فيها؛ إيماناً منه أنَّ الانتكاسة التي أصابتها كانت نتيجة أخطائها وانحرافاتها، وقد زادها الاستعمار الغربيّ ضعفاً على ضعف، ثمَّ تحديد آليات التعامل مع الحضارة الغربيَّة ومنجزاتها.

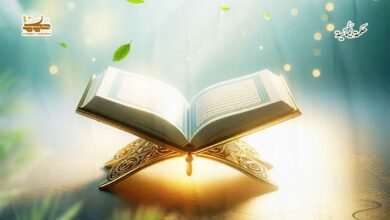
وفقك الله يا هندسه احمد و أفاض عليك من علمه ، إنه نعم المولي ونعم النصير.
وماذا عن مالك بن نبي المفكر الجزائري ؟؟