
صدرت هذه الأنة الأولى موجهة إلى سيف الإسلام أحمد، على أمل أنه صادق فيما كان يظهره من تطلعه للإصلاح وإزالة المظالم، ونشر العدل، وبث الروح الوطنية في شباب الجيل الحاضر لمستقبله كإمام بعد أبيه، كما كان يتظاهر في أجوبته على رسائل الأستاذ نعمان، وعلى أن الروح المنغلقة إنما كانت مخبوءة في شخص أبيه.
يا صاحب السمو:
يرفع المهاجرون من رعيتكم المخلصين إلى مسامعكم شكواهم، ويبثون ما في نفوسهم، ويشرحون آلامهم غير هيابين ولا وجلين، معتقدين أنهم يخاطبون منقذًا عظيمًا وزعيمًا مخلصًا ورحيمًا.
يا صاحب السمو:
إن أشد آلام الإنسان هو الألم الذي لا يستطيع أن يشكوه، فما أشدَّ آلام رعيتكم، وما أعجزهم عن الشكوى، بل ما أخوفهم من الأنين والتوجع والتأوه. هؤلاء رعيتكم يناشدونكم الله العدل والإنصاف، فقد انقطع أملهم بعد الله إلا منكم، وقل رجاؤهم إلا فيكم، فهل لكم أن تجعلوا حدًا للمصائب النازلة بهم، والمظالم التي أقضت مضاجعهم وسلبت راحتهم وأقلقت بالهم، وكانت هي أكبر عامل في تفضيلهم البلاد الأجنبية على وطنهم، والهجرة على الإقامة.
يا صاحب السمو:
لقد صبرنا حتى سئمنا الصبر نفسه، وكادت الشعوب التي تمتلئ أرصفتها وموانيها وميادينها وشوارعها بنا أن تجأر بالشكوى وتصيح بملء فيها من عناء احتمالنا ومزاحمة سكانها. عار علينا أننــــــــا عار على هذا الزمن.
يا صاحب السمو:
لقد خجلنا من المقام في الغربة عالة على الأجانب، نتقلد أشق الأعمال وأتفهها، وبلادنا الغنية بثرواتها ومعادنها وخيراتها كانت أحق بجهودنا وكدنا وتعبنا لو وجدنا مجالًا للعمل. فإلى متى ترضون لرعاياكم الاستمرار على هذه الحالة المحزنة، ينتظرون فضلات الأمم ويستجدون الشعوب؟ نحن نناشدك الله إلا ما أصغيت سمعك لشكوانا، ولو كان فيها ما لا يطاق سمعه ولا يحتمل وقعه، فالمريض المشرف على الهلاك يضطر لبث آلامه تفصيلًا وإجمالًا حتى يتمكن طبيبه من العلاج.
يا صاحب السمو:
لماذا نكتم عن سموك المظالم التي فشا أمرها وعرفها الأجانب قبل الوطنيين، ولمسوا الضعف في الأمة، فأصبحوا يصفقون فرحًا ويتآمرون فيما بينهم على تخدير الأعصاب حتى يتمكنوا من تنفيذ أغراضهم لا سمح الله؟ فنحن حين نشكو آلامنا ونعلن حقيقة حالنا، لسنا نقصد تشويه سمعة الحكومة والبلاد كما يقول من لا يهمهم أمر وطنهم ولا يرقبون إلًّا ولا ذمة في أمتهم. وها هي حكومات الدنيا أكتع وأبتع على مرأى ومسمع منا، تقيم أحزاب المعارضة لها، وتفرض لهم الرواتب ليبينوا خطأها ويناقشوها الحساب، كما أنها تعطي الحرية الكاملة للكتاب وأصحاب الجرائد والصحف والتأليف أن يصدقوها النصح، وينشروا آلام الأمة وعيوب المجتمع والحكومة. ولم يُسمع من هذه الحكومات – على اختلافها – أنها اعتبرت تبيين أخطائها وغلطاتها تشويه سمعة.
يا صاحب السمو:
من ينكر اليوم أن في البلاد مظالم يجب أن تزول، وفقرًا مدقعًا يجب أن يعالج، وعطالة تملأ السهل والجبل في حاجة إلى مقاومة شديدة، وأمراضًا فاتكة في الأخلاق والنفوس، وثروة مهملة لا ينتفع بها أحد، واحتكارًا للمناصب والوظائف، وتكالبًا على ذلك حتى غدا كبار الموظفين عبارة عن مديري شركات تجارية، والوظائف سلع تعرض للبيع والشراء. من ينكر اليوم أن سيل الهجرة الجارف يجتاح الرجال والشباب، وعصا الجوع تسوقهم وسط الظلم، يسردهم وينفرهم، فهل من عطف وإشفاق؟ هل هناك عدل يعود الناس إلى ظله ويتدثرون ببرده، أم الحالة لا تزال هي هي، ورجال الظلم هم هم؟
يا صاحب السمو:
إننا لم نفضّل الغربة على الإقامة عن رضى واختيار، بل هاجرنا عن ضرورة شديدة كادت أن تودي بنا، أغلقت في وجوهنا أبواب العدل، وانسدت علينا طرق الإنصاف، وضُرب بيننا وبين جلالة إمامنا وخليفة نبينا صلوات الله وعلى آله الطيبين الطاهرين بحجاب، ووقف لنا العمال والحكام وزبائنهم وأذنابهم بكل سبيل وقفة الذئاب أمام الشياه، تنظر ذات اليمين وذات الشمال، فلا ترى غير ظلم وظلام، يأخذ أموالنا كل موظف ظالم بإحدى يديه، ويسومنا العذاب باليد الأخرى، يجيعنا ليشبع، ويذلنا ليعتز، ويفقرنا ليغنى، ويسد في وجوهنا مناهل العلم لتنفسح أمامه مناهج الظلم. لذلك رأينا الخلاص بخروجنا من ديارنا وأبنائنا.

السبب الأول للهجرة: الخـــطــــــاط
بدأنا به لأنه أول بلية وأعظم رزية عرفناها وأصبنا بها، وإن عُدل عنه في الأيام الأخيرة، ولكن بعد خراب البصرة، فقد قتل الحمية، وأمات الغيرة، وداس الفضيلة، وأذل الناس، وبغض إليهم الحياة، وحبب لهم الموت، واضطرهم للخروج من بلادهم جماعات ووحدانًا. ومن وقوفكم على معناه وحقيقته تشاركوننا في عظم النكبة به.
قد تكون كلمة “الخطاط” مجهولة لا يعرف معناها، ولا يوجد لها في اللغة العربية وقواميسها أصل، وإنما توجد في قاموس العمال، ولذلك يفهمها الرعية حق الفهم ويعرفونها تمام المعرفة. فالخطاط معناه احتلال العسكر لبيوت الرعية وتكليفهم بخدمتهم، بل وتحمل نفقاتهم.
هذا معنى الخطاط بالاختصار، وإليك التفصيل:
من المعروف أن المقرر للجندي كل يوم جزء ضئيل من النقد وحبوب الذرة أو الشعير أو غيرهما من سائر الحبوب الموجودة في المخازن والمدافن، فيحتفظ الجندي بالنقد ويذهب بالحب إلى بيت الرعوي، وإن شئت فقل إلى بيته، لأن الفلاح قد تخلى عنها وأصبح كالعبد هو وزوجته وأولاده، لا شغل لهم إلا خدمة العسكري والوقوف عند أوامره. تقبض الزوجة تلك الحبوب التي لا تسد رمق عصفور، فتوفرها من طعام زوجها وأولادها، وتصرف غالب الوقت لتصفيتها وتنقيتها، وعرضها على الشمس ليسهل طحنها، ثم تذهب لجمع الحطب من رؤوس الجبال الشاهقة والأودية البعيدة، وتعود لمباشرة العمل. أما الزوج فهو يسعى في تحصيل الإدام من لحم وسمن ونحوهما، لأن العسكري محترم مقدس يجب أن يكرم طول حياته، فهو “مجاهد في سبيل الله”، هكذا يلقب. وإذا فرغت ربة البيت من تهيئة الطعام، قُدّم لحضرة المجاهد، وبخلال أكله ينصرف الزوجان للبدار بالقهوة وما يلزم لها. هذا غذاء الجندي، ومثله العشاء والفطور صباحًا.
وهكذا طُرحت البركة في تلك الحبوب، وأصبح العسكري يحمد الله ويدعو لولاة الأمر بالنصر والتمكين، ويتعجب من السر الإلهي والبركة العظيمة التي طُرحت في تلك النفقة الضئيلة، بل إن الدهشة والعجب من هذه البركة والمعجزة الخارقة عند العمال أنفسهم، وما عرفوا أن البركة في الرعوي وزوجته اللذين لا يعرفان للراحة طعمًا ولا للحياة هناءة.
وهل تظنون هذا العبث والاستعباد؟ إنه إذا حصل في بعض الأيام أقل عجز عند الفلاح وأهله عن توفير أسباب الراحة للعسكري والمبالغة في إكرامه، نزل بهما ضربًا ورفسًا، وأهان كل واحد منهما أمام الآخر، بل أمام الله والعالم. وإذا استغاث أحدهم أو بكى، اجتمع عليه بقية الجند المخططين في البيوت الأخرى بجوار زميلهم، فينهالون عليه بالضرب والسب والشتم. وإذا تدخل أحد جيران الفلاح أو أقاربه، أصابه ما أصاب قريبه. وقد يتجرأ بعض الأشخاص بعرض هذا العبث على أحد العمال أو الموظفين، فلا يسمع إلا سبًّا فاحشًا وكلامًا جارحًا: “ما لأبوك والفضول يا ناصبي”، “هذا عسكري الإمام”، “الرعوي ما يصلحه إلا هذا”، “القبيلي ما لأمه إلا الهيانة”. وقد يُحبس هذا الفضولي ويُضرب ويُهان بسبب عطفه على أخيه وتبرمه من ضرب العسكري “البطل” و”المجاهد في سبيل الله”.
فيا صاحب السمو:
هل تنتظرون لرعيتكم قيامًا بعد كل هذه الأعمال؟ إننا بكل أسف نعلن لكم أن العمال تعمدوا هذا الخطاط تعمدًا، برغم استغنائهم عنه وعدم الحاجة إليه، فالثكنات من عهد الدولة العثمانية موجودة في عموم المراكز، غير أن رجال تلك الدولة الأعجمية الأجنبية لم يتخذوا الجند لمحاربة الرعية، بل للدفاع عنهم والذود عن كيانهم. فكانوا ينشئون الثكنات في المراكز، ويعلمون الجند المحافظة على الكرامة وعزة النفس، والتفرع عن الدناءة، وعدم إظهار الفاقة والحاجة عند الفقراء والمعوزين، وكانوا يوسعون عليهم بالإنفاق، ويخصصون لهم خدما ينقلون معهم أينما ساروا وحينما أقاموا.
أما رجالكم الذين عولتم عليهم بإراحة الأمة والبر بها، والشفقة عليها، فهم كما ترون بعكس الأعاجم على خط مستقيم. ولا حاجة لزيادة الشرح، فالغرض ذكر أسباب الهجرة والمصيبة التي أذلت الفلاح، وأماتت عواطفه، وأطفأت شعوره، وأفقدته إحساسه، وليعرف صاحب السمو كيف مزق الموظفون شمل الشعب، وسلطوا بعضه على بعض، وأذلوا طائفة بيد الأخرى، وأجبروا الآخر على استباحة حرمة أخيه. هذا هو السبب الأول للهجرة.
لقد ظلم الفلاح ظلمًا بيّنًا، وأبيح ماله ودمه وعرضه، ففزع إلى من بيدهم الأمر لإنصافه، فزادوه خيالًا وأوسعوه نكالًا، ثم لجأ إلى جلالة الإمام يستغيث ويستنصر، فوجد حوله زبائن الموظفين وأعوانهم يحولون بينه وبين الوصول إلى مولاه، بل إنهم يرجعونه إلى من ظلمه ليضاعف عذابه ونكاله. لذلك فضل الهجرة كي يأمن على حياته التعسة الشقية، فالإنسان ضنين بحياته مهما كانت قيمتها، تاركًا وراءه أطفالًا ونساء للطبيعة تقسو عليهم.

السبب الثاني: التنافِيذ
وهذه هي المصيبة الثانية، والطامة الكبرى، والبلاء المستمر، والنقمة الدائمة. وللترابط بينها وبين “الخطاط” ألحقناها به.
إنه لا يوجد إلى اليوم مواصلات تلفونية، سلكية أو لاسلكية، تربط المراكز بالقرى. غاية الأمر أن هناك الخط السلكي المعروف منذ عهد الدولة البائدة، وهو الوحيد في البلاد ومحتكر لكبار الموظفين فقط.
ولما كان الأمر كذلك، اتخذ الموظفون الجند واسطة بينهم وبين الفلاحين، وجعلوهم المواصلات الوحيدة، مع أن جلالة الإمام عيّن في كل مركز من مراكز اليمن بضع مئات من الجنود لحفظ الأمن والسهر على مصالح العباد وحفظ النظام وصيانة الأرواح والأموال، لا للغرض الذي وضعه الموظفون.
فكل ضريبة تُفرض على الرعوي، ينفذها العامل أو من يقوم مقامه بعسكري أو اثنين أو ثلاثة، بحسب قلة المطلوب أو كثرته. وهذا العسكري، بمجرد استلامه أمر التنفيذ — وهو ورقة تحرر بيده من الموظف المسؤول عن إدارة تلك الجهة — يأمر العامل بقطع راتبه ونفقته اليومية لأنه سيكون ضيفًا له. وأجره يقدَّر بطول المسافة أو قصرها، وتسمى هذه الأجرة بـ”المسافة”، ثم “الممسا”، وهي عبارة عن ضريبة ليلية يدفعها الفلاح للجندي مدة إقامته عنده. وهذه الأجرة تتفاوت: فإن كان عسكريًا عاديًا فلها قدر معلوم، وإذا كان عريفًا أو نقيبًا تضاعف، وإذا كان قاضيًا أو سيدًا تضاعف أضعافًا كثيرة.
كما أن الضيافة يعود اختيارها إلى العسكري لا إلى الفلاح. وهذه المهنة الوحيدة التي حمل الجندي لها السلاح. ثم إن “التنفيذ” ليس مقصورًا على طلب الضرائب فقط، بل أي أمر يريده العمال أو الحكام أو نوابهم من الرعية، لابد من إرسال العسكر، فهم المواصلات الوحيدة، حتى لو قصد أحد الموظفين عمارة بيته أو حراثة أرضه أو أي عمل من الأعمال، فإنه يستدعي الرعية “سُخرة” بواسطة العسكر.
هذا معنى التنفيذ، وسنذكر آثاره:
يأخذ الجندي الأمر بيده ويؤم منزل الفلاح المنفذ عليه، وإذا وصل إليه، فلا تحية ولا استئذان، بل إن وجد الباب مفتوحًا دخل، وإن كان مغلقًا لا ينادي أحدًا، وإنما يتناول بندقيته المعترضة على كتفه فيضرب بها الباب فيشقه نصفين أو يكسر قفله ويدخل. وقد يكون السكان نائمين أو مكشوفين، فللناس في بيوتهم حالات.
أما الأطفال فلا تسمع إلا صياحهم وعويلهم، لأن الجندي لا يكتفي بكسر الباب، بل هناك سب وشتم بصوت عال غليظ منذ أن يدخل المنزل، وتلك هي تحيته لأخيه المسلم ومواطنه العربي. ثم يطوف غرف المنزل — إن كان فيه عدة غرف — ليختار ما يوافقه، ولا يمر على شيء أمام عينه فيعجبه إلا اختطفه.
ثم لا يكاد يستقر حتى يطلب: “مذبوح” و”قات” و”تتن” و”سمن”. أي يريد كبشًا مذبوحًا لا دجاجًا، والقات — وهو الشجر المعروف الذي تعود الخاص والعام على مضغه وقت الراحة حتى إنهم يفضلونه على الزاد وينفقون فيه جل أموالهم — يصر الجندي على طلبه.
ويقف الزوجان أمامه يتلقيان الأوامر، والذعر والخوف يملآن قلبيهما وعقولهما. ثم يتسللان للخروج هائمين في القرية بحثًا عن الضيافة المفروضة، لأن ما عندهما لا يوافق العسكري، أو ربما لا يجدان شيئًا، وقد يكونان باتا مع أولادهما على الطوى لشدة الفقر الذي عم البلاد.
وعند حصولهما على تلك المطالب يعودان إلى منزلهما للطبخ والخدمة وتهيئة الزاد للحاكم بأمره المطلق التصرف، والويل لهما إن تأخرا قليلًا أو نقص جزء من الأنواع المطلوبة.
وإذا جاء وقت النوم لا يرضى الجندي بغير الغرفة الخاصة بالفلاح وأهله وأولاده، فيتنازلون عنها ويتصدرون اصطبل البهائم بين أرواثها وأبوالها، إذ لا يمكن خروجهم إلى بيوت الجيران، فقد يحتاج حضرة الجندي شيئًا أثناء الليل، فيسهر الفلاح إلى جانبه “لتعميرة البوري” أو تبديل المداعة.
ولا يكاد الصبح يسفر حتى يقوم الفلاح وزوجته لتهيئة الفطور، لأن تأخيره يجلب عليهما مُرّ العذاب. وكل هذه الضيافة مقدمة على إفهام الرعوي سبب التنفيذ عليه، بل لا يمكنه السؤال عن ذلك حتى ينتهي من الضيافة.
العسكري، كما ترى، غير مفكر بالرجوع إلى المركز، لأنه يكتسب من وراء بقائه الأكل اللذيذ، والنوم الهني، والفراش الوطيء، والنقد الكثير. وإذا حاول الفلاح الذهاب إلى الحكومة تعرض له العسكري ومنعه من ذلك لتتوفر له “المماسي”.
والحاصل أن طول الإقامة أو قصرها يعود إلى نظر العسكري، حتى إذا سأم الضيافة وملّها أذن للفلاح بالذهاب إلى الحكومة، وهو يستمر في المنزل يستخدم ربة البيت ويستعبدها، حتى يأتيه الفلاح “بالرفع” — وهو ورقة تحرر بيده تقابل ما تحرر بيد العسكري وتشعر بمغادرة المنزل.
وإذا تحصل على “الرفع” عاد كئيبًا حزينًا، كل همه الخلاص من “المماسي” وأجرة المسافة. وتقدير طولها أو قصرها والعسكري هو الحكم فيه، إن شاء عدل وإن شاء جار، ولا يستطيع الفلاح أن يبدي رأيًا أبدًا، بل لو ظهر منه أقل خلاف بادره العسكري بالصفع على قفاه وكتفه وساقه أمامه كالماشية، وهو لا يبدي ولا يعيد، أضيع من يتيم وأعجز من أرملة.
ومن أعظم المصائب أنه قد يجتمع على الشخص الواحد في آن واحد عدة “تنافيذ”: العامل له حق التنفيذ، والحاكم مثله، والموظف في المالية، ومأمور البقية، والمشايخ، والعرائف… وهكذا.
ويُجبر المسكين على ضيافة كل واحد على حدة، إذ لا يمكن اختلاط الجميع، فإن أذواقهم تختلف، وشهياتهم تتفاوت: فهذا يريد كبشًا، وذاك دجاجًا، والثالث بيضًا… إلخ. والفلاح ملزم بهذا كله، ومحتم عليه تسليم أجرة كل واحد من العسكر حسب القرار بذلك.
أفبعد هذه الأحوال والمظالم الغريبة تعجبون — يا صاحب السمو — من هجرة اليمنيين آلافًا وعشرات الآلاف؟ فما مقامهم وحياتهم؟
مُــلَّ المقام فكم أعاشر أمةً
أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستجاروا كيدها
وعدوا مصالحها وهم أجراؤها
إن الموظفين لم يجنوا على الأمة فقط بهذه الأساليب، بل جنوا على الجندي أيضًا، وأفسدوا أخلاقه بإطلاق العنان له على افتراس أخيه، وإهانته وإذلاله، وأظهروه بمظهر الوحش المفترس والسبع الضاري. ولو عقلوا لرأوا أنهم يجنون على أنفسهم، ويخربون بيوتهم بأيديهم، ويعرضون أمتهم للانقراض وحكومتهم للزوال.

السبب الثالث: فداحة الضرائب
و(الزكاة) أو (الواجبات) أو (العُشر) أو (حق بيت المال) ألفاظ مترادفة، ومعناها واحد، وهو سلب الرعية بلا شفقة ولا رحمة، ولا إنصاف ولا عدل، ولا قياس ولا تقدير. تنوّعت الأسماء، والسلب واحد.
تضيق العبارة ويفنى البيان دون الكلام في هذا الموضوع طويل الذيول، كثير الفروع، ولكن لا بد من الإشارة إلى ذلك بقدر ما يتّسع له المقام. لقد بات من المقرّر أنه ليس للحكومة مورد من موارد المال إلا من أرض الفلاح، ومزرعة الفلاح، وعناء الفلاح وكدّ الفلاح؛ فهو قوتها، وكنزها، ومتجرها الذي لا تعرف سواه. وها نحن نلفت نظر صاحب السمو إلى ما لقيه الفلاح المسكين جزاء إمداده لحكومته، فوق ما سبق من نكباته.
يباشر الفلاح في أول العام حراثة أرضه بكدّه وجهده، تعينه زوجته وأولاده، ويشاركونه في تحمّل الحر والبرد، ويصرفون الشهور في تنقية الحقول وتصفيتها من الحشائش التي تضرّ بالزراعة، وتقليب الأرض وتعريضها للشمس والهواء، ونقل السماد إليها وبذرها، وتعهدها بالعناية، والسهر على حفظها، حتى إنهم لا يرتاحون من العمل طيلة العام، ولا يعرفون أقل مساعدة من أحد.
التخمين والمخامنة
ثم لا يكاد يبدو صلاح الثمر حتى يعلن العمال تعيين المخامنة (الخراصين)، ويبعثون دعوتهم إليهم كي يوزعوهم بالقرى لتقدير حاصلات المزارع من الحبوب، لتكون الزكاة عادلة لا تعدو الواجب شرعًا. يتسابق الخراصون أو (المخامنة)، وهم والفقهاء، إلى أبواب الحكومة، بالعمائم البيضاء، والسبح الطويلة، والأكمام الواسعة، كلٌّ يدّعي الأمانة وأنه أحق بالخرص من غيره لحرصه على حق بيت المال، فالمقرّب المحبوب هو الحريص على توفير ذلك الحق.
إن العامل ليدعو هؤلاء (المخامنة) إليه، ويأخذ منهم العهود والمواثيق بعدم تجاوزهم الحق، وأن يكون رائدهم العدل والإنصاف، ثم يحرّر بيد كل واحد أمرًا بالتخمين، ويعين بجانبه بعض العسكر ليتكسبوا جميعًا ويحترفوا في بيوت الفلاحين. ولا يكاد يصل الخراص محل عمله حتى يلتف الناس حوله، كلٌّ يدعوه إلى منزله ويواسيه ويتقرّب إليه بالهدايا كي يرفق به ويعدل، وهو يتظاهر أمامهم بالورع والتقوى، والعدالة والإنصاف، ويمنيهم الأماني، ويهمس بأذن كل واحد بمفرده، ويضرب له على صدره، ويذم الحكومة بينهم وأنها ظالمة لا ترحم الرعوي ولا تعطف عليه. وهكذا يضحك على عقول البُله المساكين ويستدرّ الرشوة بجميع جوارحه، حتى إذا ملأ جرابه أرسل نظره على المزارع وسجّل في دفتره مقدارًا يعرف أنه يرضي الموظف الذي عيّنه للتخمين ويكسب به ثقته وحسن ظنه، لأنه يعرف أن الحكم بيده، وليس للرعية شيء. ولذلك يهمّه مراعاة جانبه، فهو لا يسجّل في دفتر التخمين العُشر، بل يثبت الثلث والثلثين، وقد يضع الحاصل جميعه باسم العُشر.
ثم يرجع إلى العامل حاملاً دفتره المملوء ظلمًا وجورًا، فينال رضاه، ويكسب عطفه، والمدح والثناء على أمانته وديانته. أما لو اقتصر – والعياذ بالله – على وضع العشر أو الخمس أو النصف، فليس جزاؤه إلا البصق في وجهه، واللعن والطرد، وتسجيل اسمه خائنًا، وقليل الدين، وساقطًا من نظر الحكومة. إذن فالمخمن (الخراص) مجبور على الظلم والجور ومكلف بذلك.
الكشاف والكشف
ثم هل يكتفي بما قدّره الخراص؟ لا، ولكن يُبعث في أثره (الكاشف) ليكشف ما كتمه المخمن، والقصد إعاشته، وفتح سبب له ينتفع من ورائه، فإنه يتبع سنن من قبله شبرًا بشبر، ويمثل الدور الذي مثله سلفه سواء بسواء، ضيافة ثقيلة، ورشوة مضاعفة، وقد يضع تقديرًا لغلات الأرض أعظم من تقدير المخمن لينال الحظوة عند الموظف الذي قلّده هذا المنصب العظيم.
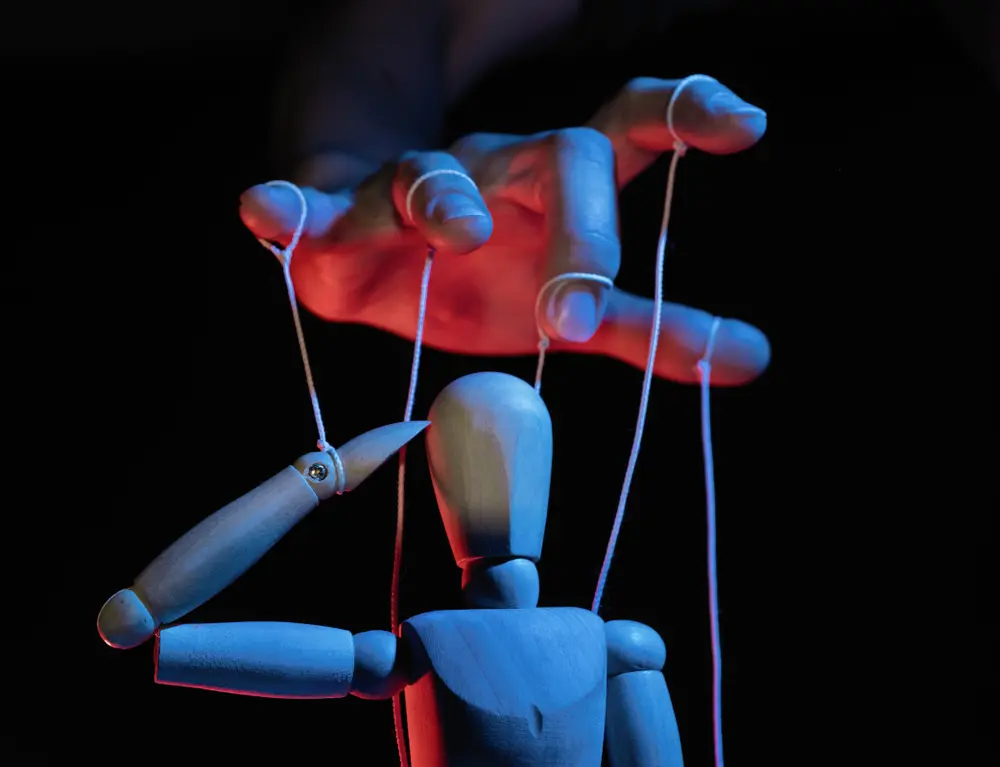
بيت المال، أو جهنم، أو مصب دماء الرعية
بعد التخمين والكشف، يأتي دور (بيت المال)، فإن جميع الدفاتر التي تضم تقدير الخراصين والكشاف تُحوَّل من العامل إليها ليقابلها الموظفون مع دفاتر العام الماضي. فإن كانت تحتوي على أكثر مما قدّر في السنة السالفة عملوا بها، وإن احتوت على أقل من ذلك رفضوها وخاطبوا الرعية أن يسلموا ما دفعوه قبلاً. وإن ظهرت متساوية معها، أجريت لها العملية الجراحية المعتادة، فيضاف أولًا ما لا بد منه احتياطًا، فربما أن يكون الخراصون تهاونوا بحق بيت المال، ويلي ذلك ضم العائد، وعشر العشر، وحق العلف والرهينة، ثم يجري (التسعير) وهو تقدير قيمة الزكوات؛ لأنها في الغالب لا تُدفع عينًا، بل تُؤخذ قيمتها من الفلاح، وللمالية سعر مخصوص يختلف كثيرًا عن سعر السوق، والفلاح مجبور على دفع قيمة الزكاة نقدًا بالسعر الذي تفرضه الحكومة، وهو ثلاثة أضعاف سعر السوق. والحاصل أن الرعوي يدفع قيمة حاصلات الأرض مضاعفًا، بل يضطر لبيع أرضه ومسكنه كي يوفي الزكاة ويغادر البلاد.
(المشايخ) أو (العرائف) أو (العقال)
أو (السوسة التي تنخر في جسم الرعية)
عند انتهاء بيت المال من عمله وانقضاء مهمته، تُسلَّم الدفاتر إلى العرائف الذين استخلصهم العمال لأنفسهم، فيخاطبون بما اشتملت عليه تلك الدفاتر؛ لأن ما سُجِّل فيها هو القضاء المبرم الذي لا يجوز نقضه أبدًا، ولا تخفيفه بحال من الأحوال، حتى لو جرفت السيول الأرض، أو أصيبت الزراعة بآفة سماوية. وهنا، لا بد للعريفة من إضافة نصيبه، باسم غرامة وأجرة ونحوها.
نعم، قد يتورع بعض العرائف عن القيام باستيفاء الضرائب لفداحتها الجائرة، ولكن سرعان ما يبرز للميدان من يرشح نفسه للقيام بهذا الأمر، والتشرف بخدمة العمال، وإرضائهم بهلاك عشيرته وأهله. وما أكثر المتنافسين في هذا الأمر، وما أشد الخصام والتنازع على هذه الوظيفة وأمثالها، حتى إنك لترى الأخوين أو القريبين قد انقسما قسمين، كلٌّ يؤلِّب شرذمة من الناس حوله ويضمهم إليه لاختياره عريفة عليهم، ويبذلون في ذلك الرشاوى، ويذلون أنفسهم عند الموظفين كي يمكّنوهم من امتصاص دم إخوانهم، وسلب البقية من أموالهم.
هؤلاء العرائف ورثوا هذه الوظيفة من آبائهم، وأولئك تحصّلوا عليها من الحكومات البائدة، حتى أصبحت (المشيخة) و(العِريفة) – في نظرهم – حقًّا من الحقوق المقدسة المحترمة التي لا يجوز التنازل عنها وتركها والتخلي عنها، مهما جلب ذلك الخراب والدمار على أنفسهم وقومهم.
ولقد بلغ من حرصهم على هذه الوظيفة الجوفاء تعريض أنفسهم لكل تهديد، وإزعاج، وإهانة ممن فوقهم، ولكنهم لا يحسّون ولا يشعرون، بل نجدهم يتبجحون بين الناس قائلين: “إن الإهانة وكسر الناموس بباب الحكومة شرف”، ويتجلّدون أمام أعدائهم… والأعداء – بنظرهم – قومهم وبنو عمومتهم، لأنهم سيشمتون بهم إذا تركوا المناصب، وربما خلفوهم فيها.
والأنكى من هذا كله، أن أكثر هؤلاء المشايخ يحرصون على طلب الوظيفة الفارغة التي ليس لهم من ورائها خير أبدًا، ويركضون وراءها ليل نهار، لا يهدأ لهم بال، ولا يقر لهم قرار. ثم هم يتركون أراضي خصبة خلفها لهم آباؤهم، ويدعونها للطبيعة تنسخ عليها، وتجعلها قيعانًا قاحلة لا تصلح للإنبات.
فأين رجال الحكومة الحريصون على سعادة البلاد ورخائها أن يغلقوا أبواب الوظائف في وجوه أمثال هؤلاء، ويوجهوهم إلى العمل في مزارعهم، التي لو عملوا فيها بالمحراث لأطعمتهم نبات كل شيء، وأدرّت عليهم الرزق المضاعف؟
هذا – يا صاحب السمو – لا يُنتظر من رجال الحكومة، بل إن العمال ليفتخرون بموقف العرائف المحزن وتناحرهم، ويسرّهم الخلاف والانقسام، كأنما هؤلاء الذين بين أيديهم يتناحرون ويتخاصمون ليسوا إخوتهم في الدين والوطنية واللغة والجنس.
بل الموظف يعد نفسه كمندوب سامٍ جاء من أوروبا إلى الشرق ليوسّع شقة الخلاف، لا ليجمع الشمل ويوحّد الكلمة. فإن من المحزن المبكي بذل هؤلاء الموظفين الجهد في توسيع النزاع وإضرام نار الفتنة، لغرض دفين، وهو احتكار الوظائف لمحسوبيهم وجعلها وقفًا عليهم، بحجة أن أولئك لم يتفقوا. فإنهم عند اشتداد الخصام واحتدامه بين المغفلين البُله، الذين يتنازعون على قرية يسكنها بضعة أشخاص وكأنها إمبراطورية عظيمة، يرفضونهم جميعًا، ويدعون أحد الأقارب والأعوان فيُقلَّد وظيفة العريفة بلا قيد ولا شرط.

(المأمور)
هذا اللقب يُطلَق على محاسبٍ وأعوان الموظفين الكبار أو أقاربهم، ومن يمتّ إليهم بصلة، أو يتكسّب لهم. ولقبهم به مؤقت، وهو عند الفلاحين بديل عن العرائف.
قد يكون المأمور مجردًا من كل خبرة وفهم ودراية، وليس فيه من الصفات المؤهلة له سوى انتمائه إلى العامل الفلاني أو القاضي الفلاني، أو من بيت “زعطان” و”فلتان”. وهناك صفة أخرى لا بد أن تكون من أبرز صفاته، وهي عدم الشفقة والرحمة على عباد الله.
يأخذ المأمور أمره بيده، ويتوكل على الله، وهو محاط بقلة من الجند. حتى إذا وصل الجهة المعينة، خطّط العسكر في بيوت الأهالي، وخطّط هو نفسه في بيت العريفة السابق، أما منافسه اللاحق فيتلقى المعلومات ويتفرغ لقبض الواجبات، إما شهرًا وإما شهرين على حسب الحاجة. وهو والجند، في هذه المدة، كلهم ضيوف على الأهالي، ثم يعودون إلى المركز وقد جمعوا لهم من الأجر والمماسي والرشاوى ما يؤمِّنون به مستقبل عامهم.
أما حق بيت المال، فهو – بنظر المأمور – أمر مخيَّر فيه: إن شاء أوصله، وإن شاء عبث به وتصرف فيه، وأخذ الشطر الأكبر منه، ثم سجّله في دفتر البقية بذمة الأهالي.
(البقية) أو (المشكلة الخطيرة)
هذه الكلمة تُطلق على ما تدّعي المالية بقاءه عند الفلاحين من الضرائب. وهي مشكلة اليوم ومعضلتها التي لم يُعرف لها حل ولا نهاية، ولا شك أنها القضاء الأخير على الأمة والبلاد والبقية الباقية، كما أسلفنا آنفًا.
إن المأمور الذي يتقاضى الضرائب هو المسؤول عنها والمفوَّض فيها؛ إن شاء سلَّمها تمامًا إلى بيت المال، وإن شاء احتفظ لنفسه بجزء كبير منها وتقاسمه مع الموظفين الذين لا يجهلون أمره، ووزعها بحسب تكاليف كل موظف. وإذا قاسم، استطاع أن يصرخ بملء فمه أن أكثر الضرائب لا تزال باقية بذمة الرعية.
ولا شك أن المأمور آمن على نفسه من المساءلة لسببين:
1. أنه قد قاسم بالغنيمة الرجال المسؤولين، فلن يجرؤوا على التشديد عليه كي لا يفضحهم.
2. أن الرعية لا تملك حجة تثبت أنهم أوفوا ما عليهم من الضرائب، فقد جرت العادة أن المأمورين يقبضون الزكوات والضرائب الحكومية من الرعية، ولا يكتبون بأيديهم شيئًا، بل يعدونهم بالسندات الرسمية من بيت المال.
فإذا لم يثق الرعوي، ولم يطمئن وامتنع من التسليم، سلّطوا عليه العسكر وأمروهم بالبقاء في بيته حتى يُسلِّم ما يطلبه المأمور. وهذا الوعد بالسند الرسمي ليس إلا وعدًا كاذبًا ومماطلة خائبة، والغرض منه ابتلاع حق بيت المال، علاوة على الرشاوى الباهظة والاختلاس الفظيع، ثم تسجيل ذلك “بقية” على الرعوي المسكين.
وهكذا كل موظف، لا فرق بين كبير وصغير، يقبض حقوق بيت المال أضعافًا مضاعفة، ويَعِد الرعية بالسندات إلى وقت آخر، ثم يرفض طلبهم ويتركهم بضع أسابيع، فيعيد الكرة عليهم بإيفاء الواجبات وتسليم البقية. ولا يزالون، في كل عام، يسجّلون البقية. وكلما دفع الرعوي ضريبة هذا العام، قيل له إنها ستُقطع من بقية العام الماضي. ولهذا، لا تزال “البقية” عقدة لم تُحل حتى الساعة.
وهل يُعقَل أن الرعوي، الذي ينقاد لكل شخص من هيئات الحكومة، يتجاسر على تأجيل حق بيت المال؟ أو هل سيسمح له ببقائه من عام إلى آخر وهو لم يتحصل على السماح له بحقه؟ إن هذا لعجب!

(بقية الضرائب)
المخضر، والنحل، وزكاة الباطن، والمواشي، والفطرة، والتجارة… هذه بقية الضرائب نوجزها إجمالًا، وهي تؤخذ باسم الزكاة وتستوفى بواسطة المأمورين أو العرائف أو المالية رأسًا، والعسكر من وراء ذلك، فلهم دخل في كل شيء.
• زكاة الخضروات ويسمونها “المخضر”، وتشمل الفواكه على اختلافها: نخل، عنب، زيتون، رمان، تين، قات، بن، بسباس، بصل، ثوم، كُرّاث، وكل ما نبت على وجه الأرض. وهذه يقدّرها الخراصون والكشافون بالصورة التي مضت في زكاة الزرع.
• زكاة النحل وهي باعتبار عدد البيوت التي يُستخرج منها العسل بألوانه، وتسمى تلك البيوت “العيدان”، وعلى كل عود منها ضريبة مخصوصة.
• زكاة الفطر في آخر يوم من رمضان، وليس للرعوي أن يدفع صدقة فطرته لمنقطع حوله، أو لنفسه، مهما كانت حاجته، بل لا بد أن يسلم قيمتها إلى بيت المال، وهي تلزم كل فرد على نفسه وزوجته وأولاده، وكل من تلزمه نفقته.
• زكاة البقر والغنم والجمال، وعلى كل ماشية ضريبة خاصة يجب تسليمها كل عام. أما الخيل والبغال والحمير والكلاب والقطط والفئران وسائر الحشرات، فقد أسقطوا عن الرعية زكاتها رحمةً بهم! ولعلهم يدخرونها إلى وقت الشدة.
• زكاة الباطن أي المال المكنوز مع الرعية، إذ جزموا وقرروا أنه لا يخلو إنسان من مال احتياطي مكنوز، وذلك لا بد أن يكون على زوجته حلي، أو على بناته وأطفاله، فهو مكلف بدفع الزكاة على ذلك.
• زكاة التجارة وهي عبارة عن قيمة العَرْض الموجود، وزكاتها خارجة عما يؤخذ عليها في الجمارك من الضرائب الفادحة.
هذه الضرائب تُستوفى من الفلاح كل عام بالصورة المذكورة، والأساليب المتنوعة، والوسائل المنكرة، والفلاح لا حرفة له ولا عمل ولا مورد إلا من مزرعته، التي كادت أن تصبح أثرًا بعد عين لزهده عنها وإهماله لها وهجرته إلى الخارج. ورجال الحكومة لا يعرفون غير الأخذ من الرعوي، أما أن يهيئوا له عملًا ويريحوه من العناء، فهذا ما لا يجوز عندهم أبدًا.
وبعد كل هذه المظالم، التي لا يعرف الرعية غيرها، ولا يمر عليهم شهر دون مطالبة بها، وإرسال العسكر عليهم باستمرار منذ عشرين عامًا، هل يتوجه عليهم لوم أو عتاب بسبب الهجرة؟
يا صاحب السمو:
هذا قليل من كثير، والمعوَّل عليكم في إزالة هذه الأسباب التي شرحناها. وإذا عرفنا القضاء عليها، رجعنا للعمل في بلادنا بجد ونشاط وهمّة لا تعرف الملل، تحت ظل الراية المتوكلية، التي لا نريد أن نعيش إلا تحتها، ونموت تحتها، والله علينا شهيد ورقيب
اليمنيون في المهجر
* نقلًا عن كتاب: “لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين”.
للمناضل الراحل علي محمد عبده
(من صفحة 128-145)

