
أولًا / الرحالة اللبناني أمين الريحاني
(كتاب/ ملوك العرب)
الأديب اللبناني أمين الريحاني زار البلاد العربية سنة 1922، وتجول في ممالك الملك الحسين بن عبد الله في الحجاز، ومملكة الإمام يحيى حميد الدين في شمال اليمن، وبلاد نجد تحت حكم السلطان عبد العزيز آل سعود، والملك فيصل بن الحسين ملك العراق، إضافة إلى عدد آخر من السلاطين في لحج والخليج العربي.
وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية لتلك الرحلات الطويلة، وهل كانت لدعوة الملوك العرب للتوحد أو أنها كانت لخدمة الأهداف الأمريكية كما يتهمه البعض، إلا أن الريحاني الأديب سجل للتاريخ ملاحظات دقيقة في كتابه الشهير “ملوك العرب ” عن كل ما سمعه وشاهده عن الإنسان العربي والأرض العربية في تلك الفترة الحساسة التي تلت الحرب العالمية الأولى، وحدوث تغيرات هائلة قلبت البلاد العربية رأسًا على عقب. ويهمنا هنا أن نعرف كيف كانت بلادنا اليمن في تلك المرحلة من أحوال اليمنيين وممارسات السلطة الإمامية معهم. وقد حفظ لنا الكتاب عددًا منها، اخترنا أبرزها للعلم والعظة.
أفقَرَنَا الإمامُ وعُمَّاله
أما استقبالنا في يريم، التي كانت تُدعى مَرْيمه في عهد حمير، فقد كان مثل استقبالنا في إب، وذا مظهر، فوق ذلك، فريد. فقد خرج لملاقاتنا أولاد المدرسة مع شيخهم الفقيه، فاصطفوا إلى جانب الطريق، ينشدون ويهللون مرحبين. ما فهمت من النشيد غير كلمة: “نصر الله المسلمين، رسول الخير الأمين”، ولكني علمت أن الأولاد هم من الرهائن عند الإمام. إنه لحكم عسكري قاسٍ شديد، بل حكم اشتباه وارتياب، فلا عجب أن يخلص العمال لرئيسهم الأكبر، ولكل واحد ولده عنده أو أخ أو قريب عزيز.
سألنا صاحب سمسرة في الطريق: هل عندكم حليب؟ فقال: لا غنم عندنا ولا بقر ولا معزى، ولو كان عندنا فليس من يرعاها. شبابنا في عسكر الإمام، وأولادنا هاربون من التجنيد، والعمال أخذوا أغنامنا كلها زكاة وضرائب لبيت المال.
ولكننا عندما وصلنا إلى ذمار، قابلنا أمير الجيش فيها ابن الوزير الثاني، السيد عبد الله، صنو ابن عمه في ماوية، فسمعناه يقول: “هذه بلادنا، وهي بفضل حضرة الإمام بلاد العدل والدين والصدق والوفاء. الحكم الكامل العادل تراه عندنا في اليمن، فلا خمر ولا فسق ولا زنى، ولا قتل ولا سرقة، ولا ربا ولا رشوة ولا اغتصاب. كل ذلك لأننا محافظون على ديننا، عاملون بكتاب الله، مجاهدون في سبيله تعالى.
نحن نقول ونفعل، وغيرنا يقولون ولا يفعلون، أو أنهم يقولون الحق ويفعلون الباطل.
العرب كذابون ساقطون، يفضلون مال الأجانب على الجهاد في سبيل الله. نحن حاربنا الأتراك مرارًا، وجاهدنا الكفار الخونة في تهامة، وسنحارب كل من يحاول اختلاس فتر من أرضنا أو هضم ذرة من حقوقنا. سنحارب حتى الموت. نحارب، وإذا غُلبنا نتقهقر. نحارب ونرجع إلى الشمال، نحارب ونعتصم بالجبال، نحارب ونلجأ إلى الصحراء، وإذا لم يبقَ لنا غير موطئ الأقدام نحارب حتى الموت، مؤمنين بالله، واثقين برحمته، وطيدي الأمل بعونه. ولماذا لا يعمل كذلك سائر العرب؟”.
إمام غني وشعب فقير
إن الضرائب والميزانية تشهد أن الحضرة الشريفة غنية، غنية جدًّا، لأنها مثل الأكليروس عند النصارى، تأخذ ولا تعطي.
في أيام الدولة العثمانية كان أهل اليمن يدفعون الزكاة فقط، وكانت العشائر معفاة منها. أما اليوم، فهم كلهم يترحمون على الأتراك.
قد أسمعتك شكوى الجندي وشكوى الفلاح، وإليك الآن حديثًا لرجل غريب، كان يلبس فوق ردائه معطفًا إفرنجيًا من الجوخ، أكل الدهر عليه وشرب، وهو في رقاعه وطوله ووسعه وأزراره البيضاء والسوداء آية في الزي والاختراع، وكان الرجل يشد فوق هذا المعطف الجنبية (الخنجر) ويحمل بدل البندق العصا.
استوقفت هذه القيافة المبتكرة نظري، فسألت الرجل عن مهنته، فقال: “مهنة الأجاويد”.
فقلت: زدني علمًا. فقال: “نعطي ولا نأخذ”. فاعتذرت واستغفرت. فقال: “تريدها بلغة الفقهاء؟” قلت: “بلغة من فضلك أفهمها”. فأجاب وهو يهز برأسه: “حياتنا هبة من الله، ونحن نهبها الإمام. لا نربح ولا نخسر”. فقلت: “ولكن للهبة طرقًا وأساليب”. فقال ضاحكًا وهو يلطم صدره بيده: “كلها عندي. أنا أصلًا كما يقول الفقيه”. وماذا يقول الفقيه؟ يقول: “أنا أصلًا واحدٌ أمَّارٌ بالسوء”. أما أنا فثلاثة، وفي كلهم الخير: ثلثي يا أفندي شيخ، وثلثي فلاح، وثلثي جندي، والمجموع سيد.
نعم، أنا سيد، وإن كان السادة ينكرون ذلك علي، الثلث الأول: خدم الإمام فجمع له الزكاة.
جمعتها بهذه – وهز بيده العصا – جمعتها «ظلط» (نقودًا)، جمعتها مالًا (مواشي)، جمعتها أعشارًا، وحتى ثمارًا، وما أكلت، والله، ثمرة مما جمعت، ولا لطخت يدي بنقطة دم من شاة أو حمامة، كلها للإمام.
والثلث الثاني: دفع الزكاة، وكنت أدفعها مسرورًا مستأنسًا، فلا أرجم العشار، ولا أخبئ الحمام، دفعت خيرًا كثيرًا، وما بقي شيء بعد خمس سنين من الأرض أو المال أو الظلط، كلها للإمام.
والثلث الثالث يا أفندي: خاض من أجل الإمام ساحات الوغى. وفيَّ شاهدان، هو ذا الأول، وذا الثاني” – قال ذلك وهو يكشف عن صدره ورجله ليريني الجرحين – “وما عدت إلى بيتي وفي جيبي «بخشة»(1)واحدة، لا والله. خمس ريالات، هذا الرسم، ولكن الريال فضة، والعين لا ترى الفضة. نقيضها بخشات، ست بخشات كل يوم، والباقي للإمام. وبما أني مجاهد، كنت أشتري القات من كيسي، هم يوزعون القات على «النظام» (العسكر النظامي) القات والشعير (الحنطة). أما المجاهدون، فلله أمرهم وعلى الله، ست بخشات كل يوم، والظلط مخزون، مخزون اليوم شديد”.
“نقول للحضرة الإمام: من شروط الإمامة السخاء. فيقول لنا، وهو العالم الأكبر: ومن شروط السخاء وضع الحقوق في موضعها، ليس بالتبذير. الإمام رجل كبير عظيم، ينظر إلى المستقبل بعينين، له مقاصد كبيرة، ونحن كلنا للإمام، نعطيه، نعطيه، ولا نأخذ منه إلا ما شاء أن يتفضل به. الحياة هبة من الله، ونحن نهبها الإمام شاكرين. هذه هي الحقيقة، ينبئك بها هذا السيد. فقد صرت سيدًا يا أفندي لأني لا أخدم اليوم الإمام بغير الكلام”.
أما الحقيقة كلها فهي أن الشكوى من الضرائب عامة، وقليل من ينظر إليها نظر هذا السيد الظريف. فالإمام يأخذ من المسلم أعشار الأرض عينًا، والمخضرات، أي الثمار – والقات منها – تُثمن فيدفع أصحابها العشر نقدًا. ثم زكاة المواشي والدواجن و«القراش» (الدواب)، وزكاة التجارة والمخازن، ثم الزكاة الأصلية(2) ومنها الفطرة، أي زكاة البدن، وتدفع في رمضان، وزكاة الحُلي، حُلي النساء من ذهب وفضة، وفوق ذلك كله إعانة الجهاد عند الحاجة.
أضف إلى ذلك الرسم المفروض على اليهود، وإن كان قليلًا، فاليهود في اليمن ذميون يدفعون الجزية، وهي ثلاث درجات: ثلاث ريالات في السنة على الغني، وريالان على المتوسط، وريال ونصف ريال على الفقير.
كل هذه الضرائب تُدعى في اليمن زكاة، إلا أنهم يقسمون الزكاة قسمين: ما يُدفع عينًا وهو العشور، وما يُدفع نقدًا.
كل ما يُجمع من العشور والأموال يُحفظ في بيت المال، الذي له فروع في كل الأقضية، وفي هذه الفروع، أي المستودعات، دائمًا كثير من الحبوب والبن وغيرها من لوازم المعيشة، التي لا يُصرف شيء منها إلا بأمر من الإمام. على أن من حسنات بيت المال أنه يُقرض المحتاجين مما فيه، ويستوفي الدين منهم من الموسم الجديد دون فائدة، وهي في اليمن ممنوعة إطلاقًا في التجارة وفي المعاملات كلها، ممنوعة شرعًا وعملاً.
وما سوى القروض، فلا يُنفق من بيت المال إلا القليل، لأن عند الإمام مصدر خراج آخر هو الجمرك ورسم القوافل، فكل ما يدخل إلى صنعاء من عدن أو من الحديدة اليوم يدفع رسمًا معلومًا، وكذلك كل جمل وكل دابة محملة. فمن هذه الرسوم يُنفق الإمام على حكومته.
أما بيت المال، فلا تمسه يد صالحة أو أثيمة، كل ما فيه مدخور بعون الله، وبفضل الإمام والرهائن، مدخور لليوم المنتظر، غليوم العرب الإمام، ألمان العرب الزيود.

التعليم بين زمني الأتراك والإمام
ولكنه (أي الإمام يحيى) في حبه للعلم، لا يحب – على ما يظهر – تعميمه. لم نرَ مدرسة واحدة في المدن والقرى التي مررنا بها. أما عذر الإمام في ذلك، فهو أنه منذ تولى الحكم وهو وأعداؤه في احتراب، فكيف له أن يهتم بالمدارس؟ ولكن أهل اليمن يهتمون كل الاهتمام بالمساجد وبالصلاة وبالقات، فلو أنصفوا، لو أحسنوا إلى أنفسهم، لساووا – في الأقل – بين التعليم والتدين.
أما ما يتلقنه الأولاد في المساجد، فينحصر بالقرآن واللغة والفقه، لكن الفقه لا يدرسه هناك غالبًا إلا من هم أولاد السادة، وليس الفقيه دائمًا فقيهًا، فالفقيه هناك مثل الأولاد عندنا، وغالبًا تكون مهنته أن يعلم القرآن واللغة فقط.
ومن هذه الجهة يقسم أهل اليمن إلى ثلاث طبقات: العلماء والفقهاء ويدعون بالقراء، والعامة. ويقسم العلماء قسمين: قسم يتولى أمر التعليم والإرشاد وأكثرهم من الفقهاء، والقسم الثاني هم أهل الحل والعقد، وهم السادة، وبيدهم مقاليد الأحكام الشرعية والسياسية والعسكرية.
أما العامة، فهم الذين يعلمهم القراء الكتاب وشيئًا من اللغة، ويعلمهم السادة الطاعة والمحافظة على كل ما فيه تعزيز سيادتهم في البلاد، لذلك تراهم يكرهون السيد ويسخرون من الفقيه.
حدَّثت ذات يوم ولدًا ذكيًا، وما أكثر الذكاء في الأولاد هناك، ولكنه كالأرض الطيبة غير المزروعة، فسألته ما إذا كان يشتهي السفر، فقال: “عندنا والحمد لله ما يغنينا عنه”. فقلت: “ولكن الأسفار تفقه وتفكه”. فقال: “الذي عندنا يكفي لمعاشنا فقط”. فسألته كيف يبذل الزيادة لو كانت، فأجاب: “والله يا سيدي أنا أحب المدارس، كان عندنا أيام الأتراك مدارس منظمة يعلمون فيها الجغرافيا والحساب، وكانوا يعطوننا الكتب والألواح والحبر والأقلام والدفاتر والطباشير، كل شيء، وكله مجانًا. والله يا سيدي أنا محزون، لا مدارس اليوم عندنا، ولا معلم غير الفقيه، والفقيه سفيه، لا يحب التعليم، ويأخذ مع ذلك ثماني ريالات في الشهر، وينام في المسجد والكتاب بيده، والورق والحبر والكتب ذهبت مع الأتراك. فلو كان عندي مال زائد، كنت أفتح مدرسة، وأعزل الفقيه، وأجلب الكتب والدفاتر والألواح والطباشير، وأوزعها على الأولاد مجانًا”.
• ولماذا لا يفتح الإمام المدارس؟ الإمام غني.
• بلى، ولكنه… (سكت الولد ومد يده مقبوضة، ثم قال:) فهمت؟
• وهل عند الإمام خيرات؟
• خيرات، خيرات.
• وهل هو عالم كبير كما يقولون؟
• أشتهي أن يكون لي هذا القدر (وهو يضم أصابعه بعضها إلى بعض) من علمه.
الحديدة ترفض الإمام
قلت إن الحديدة تخشى أن تُظهر ميلها وهي في هذا المثلث السياسي، فقد أقدمت على ذلك مرة، وكانت منها الأولى والأخيرة. عندما ضرب الإنجليز البلد وأنزلوا فيها عساكرهم الهندية، ظن الناس أنها بداية الاحتلال، فسُرَّ التجار بذلك، خصوصًا الهنود منهم. وبعد ذلك، بعد أن غيَّرت الحكومة الإنجليزية في سنة واحدة ثلاثة قناصل في الحديدة، ومنهم صاحب التعويضات الذي مر ذكره، وكلهم في الحمق والتصلف واحد، غيَّر التجار والأهالي رأيهم بالإنجليز.
فلما سُئلوا رسميًا، كما سُئل السوريون مرة: “من تريدون أن يحكمكم؟” أجابوا بصوت واحد: “الترك”. فقال القنصل: “هذا مستحيل”. فقالوا: “نبغي إذن الحكومة المصرية، نبغي الانضمام إلى مصر”.
ثم جاء أحد أعوان المعتمد في عدن يمثل آخر فصل من رواية الاستفتاء، فجلس في القصر ودعا إليه تجار المدينة وأعيانها، وسألهم ثانية، فأجابوا كما أجابوا سابقًا. فأُفهموا أن رجوع الترك إلى الحديدة أمر مستحيل، وكذلك حكم المصريين فيها.
في تلك الأثناء، أي قبل انتهاء الفصل الأخير، دخل المدينة معتمد السيد على رأس طابور من العساكر الإدريسية، فخُتمت الرواية في الشهر الأول من سنة 1921 بالاحتلال الإدريسي، الذي استمر منذ ذاك الحين.
ليست هذه النتيجة الوحيدة لذاك الاستفتاء، إن له نتيجة أخرى ظهرت خصوصًا في التجار الذين جهروا بميلهم إلى الأتراك وإلى المصريين. فعندما تأسست الحكومة الإدريسية في المدينة، استدعى العامل إليه التجار الخمسة الذين تولوا الزعامة وتكلموا باسم الأهالي، وأشار عليهم أن يزوروا حضرة السيد في جيزان، فاعتذروا وترددوا. ثم استدعاهم ثانية، وبينما هم ينتظرون في دار الحكومة، أحاطت بهم العساكر.
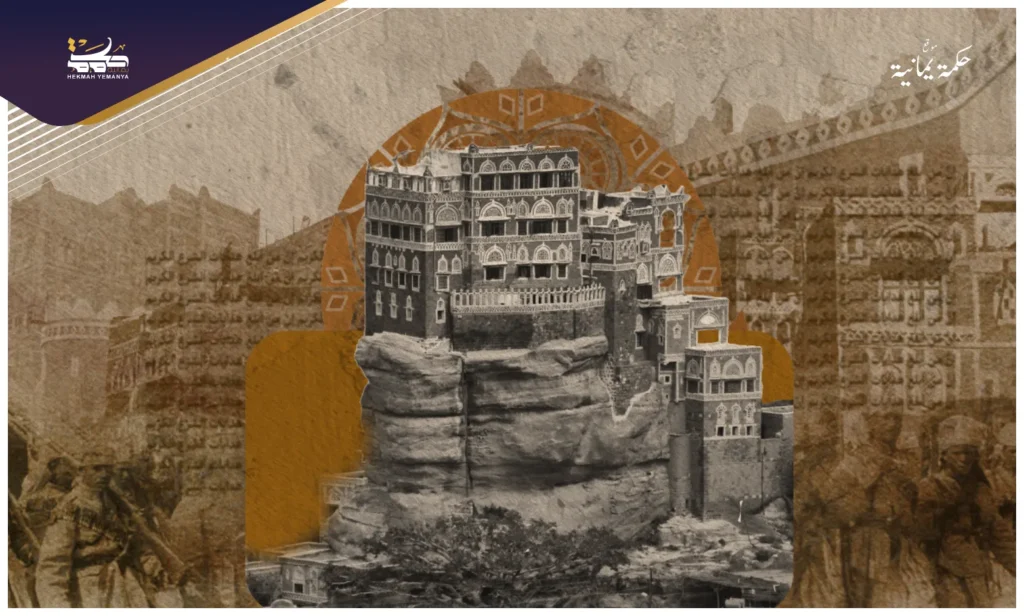
ثانيًا / المجاهد الإسلامي عبد العزيز الثعالبي
(كتاب/ الرحلة اليمنية)
زار المجاهد التونسي الشهير اليمن سنة 1924م ضمن جولة واسعة قام بها في بلاد المشرق العربي، بهدف إقناعهم بالتوحد في إطار جامعة إسلامية واحدة تلم شتاتهم وتفرقهم، وتجعلهم قادرين على مواجهة دسائس الاستعماريين الغربيين للسيطرة على البلاد العربية ونهب ثرواتها.
وأثناء زيارته لمملكة الإمام يحيى، سجل عديد ملاحظات عما رآه وسمعه من أحاديث الناس وأحوالهم وشكاويهم من حكم الأئمة السلاليين، وظلم عمالهم وحكامهم وعساكرهم في حق المواطنين، حتى آيسوهم من الحياة والعمل، وفيما يلي نموذج من تلك الحكايات:
محادثة صريحة مع نسوة يمنيات
لم أكد أستقر في البيت حتى وافاني إليه الزائرون على اختلاف منازلهم، وجاءني المداحون وطلاب العطايا والصلات، بحيث لم أتمكن من الغداء إلا وقت صلاة العشاء. وفي تلك الساعة آذنت العساكر ألا يسمحوا لأحد بمقابلتي، وعلمت فيما بعد أنهم كانوا يعتقدون أنني من رجال الدولة التركية وقد جاؤوا يتلمسون الأخبار والتعليمات لأنهم ينتظرون منهم النجدة لتخليصهم من حكم الإمام!
منعت الناس من الخارج، ولم أدرِ أن هناك جموعًا أخرى كانت تنتظر في الداخل. ففي الساعة التاسعة أقبل الحاج محسن ومعه نسوة كثيرات، وقال: إن بناتك يردن زيارتك، فهل تسمح لهن؟ فأذنت لهن، فدخل عليَّ نحو اثنتي عشرة امرأة، فلبثن في حضرتي إلى منتصف الليل، ولا أظن أنني التقيت برجال أسمى من بعض الفتيات اللائي كنَّ بينهن، خصوصًا بنت الحاج محسن صاحب البيت، فقد كانت تتكلم بصراحة عن كل شيء، وتنتقد أمورًا كثيرة انتقادًا صحيحًا دعامتاه الفطرة والذوق.
سألتني أولًا عن رأيي: هل يعود الأتراك إلى اليمن؟ فأخبرتها أن الأتراك لا يعودون، وإنما الواجب على أهل اليمن أن يكونوا هم أتراك بلادهم. فقالت: وكيف؟ ونحن جهال لا نعرف شيئًا، لا نعرف كيف نعيش، فضلًا عن كيف نشتغل ونكتسب، ولا أتكلم عن مسألة تسيير الحكومة ووضع نظام للبلاد. إن أهل اليمن لا يهمهم شيء غير الكسل وقتل الوقت في أكل القات، حتى إن الفقير الذي لا يجد مالًا لشرائه يبيع كساءه وطعامه، ويشتري بثمنهما قاتًا. وهل تفتكر أن أمة هذه حالها يوكل إليها أمرها وتؤتمن على سلامة بلادها؟ نحن نود الأتراك لأن وجودهم في البلاد ضمان لبقائنا فيها، وأما حكم الزيدية فنحن لن نرضى به أبدًا ولا يمكن أن يدوم. فهم بدويون لا يدرون قيمة للحرية، ولا يذوقون طعمًا للعدل، دأبهم أن يوقروا كواهلنا بالجبايات وينعموا بها. وماذا فعلوا في البلاد، وقد مضى على حكمهم سنوات طويلة، وهي كافية لإصلاحها وقلب نظمها رأسًا على عقب؟ أنشأ لنا الأتراك مدارس للعلوم والصناعات، فقفلوها، وأنشأوا لنا المحاكم والإدارات المنظمة، ففسخوها ومسخوها. وهذه أراضينا الواسعة الغنية التي كانت تُزرع في عهد الدولة التركية صارت أرضًا مواتًا بسبب الظلم ومبالغة المحققين في تقدير الأعشار(3)، فإنهم يقدرونها بأضعاف ما يحصل منها، ولا يسمحون لشكوى الشاكين منا، بل يغتصبون منهم رأس المال وما أنتجوه. لهذا وأمثاله تكاسل الناس عن العمل، وأخلدوا للبطالة والإهمال، وأصبح الفقر والفاقة سائدين، يهدداننا بأسوأ منقلب. لذلك فإننا لا نرى وسيلة لتفريج كربتنا إلا بعودة الأتراك لحكم البلاد.
فقلت لها: “هذه أمنية ثابتة، لكنها لا تكفي لحمل الأتراك على الرجوع إليكم، إذا لم تكن لهم في أنفسهم هذه الأمنية، وأنا لا أظنها موجودة، لأنهم لم يخرجوا من اليمن إلا بعد أن يئسوا منكم، فقد قتلتم من رجالهم في نحو اثنتي عشرة سنة نحو مائتي ألف عسكري من خيرة جيوشهم وأبطالهم، حتى أنهم كانوا يسمون اليمن (مقبرة العساكر التركية)، فهل هذه الحالة تشجع على الرجوع إليكم؟”
فقالت: “لا تتهمنا باطلًا، فإننا لم نقاتل الأتراك، بل كنا نموت إلى جانبهم فداء لهم، وإنما قاتلهم الزيدية، وهم أعداؤنا وأعداؤهم، ونحن لا نبتغي شيئًا غير إسقاط حكمهم والتخلص منهم، وكل الذين جاؤوا يسلمون عليك إنما جاؤوا ليسألوك رأيك في هذه المسألة، لكنهم تهيبوك”.
فقلت لها: “قولي لهم: إن الأتراك لا يعودون إلى اليمن، وما على اليمنيين إن كانوا يريدون التخلص من الظلم إلا أن يخلصوا أنفسهم بأيديهم، وإلا فهم جديرون ببكائكن وترحمكن عليهم”.

ثالثًا / المجاهد الجزائري الفضيل الورتلاني
الورتلاني لأحمد الشامي:
هل جئت اليمن لإقناع الإمام بتأسيس مجلس شورى والبدء في تحقيق نهضة اليمن الشاملة، أم جئت لإقناع الإمام بفتح مدرسة وصيدلية والسماح بقراءة الصحف؟
المجاهد الجزائري الفضيل الورتلاني هو أحد رموز المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، كان عالمًا خطيبًا مفوهًا، كلفه الشيخ عبد الحميد بن باديس بالسفر إلى فرنسا للعمل بين أوساط الجالية الجزائرية هناك، وإنقاذها من الذوبان في الحياة الفرنسية ونسيان انتمائها الإسلامي العربي. ولما تنبهت السلطات الفرنسية لنشاطه، قررت اعتقاله، لكنه هرب بنفسه بعد أن أفشى له أحد الجزائريين المتأثرين به ممن يعملون مع الفرنسيين بالخبر، فلجأ إلى القاهرة واستقر فيها ناشطًا مع حسن البنا.
وفي عام 1947 جاء إلى اليمن بتنسيق بين الأحرار اليمنيين وبينه، والأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، بغرض دراسة الأوضاع العامة في اليمن، والإسهام في تحديد طريقة الأخذ بأيدي اليمنيين لإنقاذ بلادهم مما هي عليه من استبداد سياسي، وانتشالها من التخلف والفقر والجهل والمرض.
عند وصوله إلى تعز، كلف ولي العهد أحمد حميد الدين الشاعر أحمد الشامي بمرافقته، وربما لمعرفة حقيقة ما جاء من أجله الورتلاني، فقد كان الشامي محل ثقة ولي العهد. لكن الورتلاني استطاع بمنطقه القوي وروحه الأخاذة أن يؤثر على نفسية الشامي وعقله، ويضمه لحركة الأحرار من جديد، بعد أن كان قد هرب إلى عدن، وانضم إلى الزبيري والنعمان في تأسيس حزب الأحرار اليمنيين، قبل أن يختلف هو وزيد الموشكي معهما، ويعودا إلى تعز.
وفي كتابه رياح التغيير في اليمن، شرح الشامي كيف غيَّره الورتلاني من تابع مفتون بولي العهد إلى مناضل من أجل بلده وحريتها، وشرح جهود الورتلاني في دعم القضية اليمنية، وفي توحيد جهود الأحرار في الداخل والخارج على هدف واحد، هو إنشاء دولة إسلامية حديثة تقوم على الشورى وحكم الدستور بدلًا من الحكم الفردي المستبد.
الدرس الأول: لماذا؟
وإن أنسى، فلن أنسى موقفه (أي الورتلاني) معي ذات ليلة بعد وصوله إلى تعز بيومين، وكان قد نزل بدار الضيافة القديمة الرابضة في حضن جبل صبر، والمطلة على مدينة تعز، وكانت الإضاءة لا تزال بمصابيح الغاز.
قال لي: افتح النافذة نتفرج على الوادي والمدينة والجبل، وفتحتها فإذا بنا نطل، بل نغوص بأعيننا في ظلام دامس. فقال لي: لماذا يخيم هذا الظلام ويطبق على مدينة تعز الجميلة؟ ولماذا يطل علينا جبل صبر الأخضر وكأنه شبح الرعب والفناء ونحن لا نزال في ساعات الليل الأولى؟
أما كان أفضل لو كانت مصابيح الكهرباء تتلألأ هنا وهناك؟ لماذا لا تسبح المدينة بين الأنوار بدلًا من أن تغرق في الظلام؟ أما كانت تستحق ذلك مثل الحج وعدن، وهما من اليمن، وليستا بأفضل مناخًا ولا هواء، ولا أطيب ولا أجمل ولا أخصب من تعز؟ ولو أنك قد زرت لبنان لأعجبتك في الليل أكثر مما تعجبك في النهار، ولرأيت جبلها في الليل تتناثر فيه أنوار القرى وكأنه روضة، أزهارها وثمارها مصابيح الأنوار، وجبل صبر أفخم وأضخم من جبل لبنان!
لماذا لا يشقون الطرقات وينيرونها بالمصابيح الكهربائية كما صنعوا في دار الإمام ودار عامل تعز؟ لماذا لا تكون كل بيوت المدينة كذلك؟ ولماذا ليس لديكم تليفونات ولا راديوهات، بَلْه المدارس والمستشفيات، بَلْه المعاهد الفنية والجامعات؟
قلت: هذا ما نطالب به ونسعى لإيجاده، ونأمل مساعدتنا من قبلك عليه بأن تنصح الإمام وولي العهد والمسؤولين لكي يقتنعوا بعمله وتنفيذه.
ونظر إلي نظرة عميقة، وعلى ضوء مصباح الغاز وانتشار فراشات الليل التي هربت من ظلام الليل إلى الغرفة عندما فتحت النافذة، لائذة بمصباح النور، نفذت إلى أعماقي أشعتها، وقال: أغلق النافذة فقد اكتأبت لرؤية الظلام!
ثم أردف بصوت حازم: يا سيد أحمد، إن هذه أشياء بدائية وأمور بديهية لا يغفل عنها الحاكم، ولا يفتقر إلى نصح أو إرشاد لكي يفعلها، وإذا لم يعملها بطبعه كإنسان، فلن يجدي معه نصح أو إرشاد.
وقد جئت إلى اليمن ناصحًا ومنذرًا، ولكني كنت أظن أنني سأنصح الإمام بتأسيس مجلس شورى، ووضع نظام للحكم، وإصلاح أجهزة الدولة، وفتح مفوضيات وقنصليات دبلوماسية وتجارية في الخارج، وإرسال بعثات علمية وزراعية وصناعية إلى الجامعات في مصر وأوروبا، وتأسيس المصانع والشركات التجارية، واستثمار موارد البلاد الطبيعية التي ستنهض باليمن، وترفع مستواها العلمي والاقتصادي والزراعي والعمراني.
ولم أكن أتوقع أن نصحي وإرشادي سيكون من أجل إقناع الإمام بإنشاء طريق أو ميناء، أو عمارة مستشفى أو صيدلية، أو تزويد البيوت بأنابيب المياه للشرب، والتيار الكهربائي للإضاءة، والإذن للمواطنين بقراءة الصحف واقتناء أجهزة الراديو، لأن هذه الأمور حقوق بدائية طبيعية للبشر في عالم اليوم، وليس هناك شعب ولا دولة بغيرها، بل ولا شأن ولا علاقة لرئيس الدولة بها، والذي يشرف على التخطيط لها وتنفيذها وتطويرها وتحسينها هي المصالح والمجالس البلدية في كل قرية ومدينة.
وهل سيعقل زملائي في جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية، وهي تجاهد لاستقلال الجزائر وسائر المغرب العربي، أنني وصلت اليمن وتركت أعمالي في الجبهة، وأتعبت نفسي من أجل أن أقنع الإمام بأن يسمح لليمنيين بشراء أجهزة الراديو، أو بإنشاء طريق معبدة للسيارة، أو فتح صيدلية توفر للمواطنين الدواء؟
الهوامش:
- الريال النمساوي يقسم إلى ثمانين بخشة، والبخشة الخاصة ضربت في صنعاء والليرة العثمانية تساوي تسعة ريالات نمساوية تكون قيمة الريال أحد عشر فرقاً تركياً وقيمة البخشة ثلاث بارات.
- يبلغ مجموع الزكاة الأصلية خمسمائة ألف ريال أي خمسين ألف جنيه.
- كانت الضرائب في اليمن في عهد الأئمة تُجْبَى حسب أساليب عتيقة تجعل تقديرها يجري تحت رحمة المُقدِّرين واستبداد الجنود المُكلفين بتحصيلها. فهم ينزلون في بيوت القرويين ويرغمونهم على إطعامهم ولا يبرحون القرى إلا بعد تحصيل ما يفرضونه على أهلها من الضرائب المجحفة.

