
المسلمون والكتب:
عُرف المسلمون، وعلماؤهم خاصة، بحبهم للكتب واقتنائهم لها، لأنها إحدى أدوات العلم والحافظة له. وهذه المحبة للعلم كانت ثمرة لبناء المجتمع المسلم الذي يقوم على العلم الحق، وأنه يُقرِّب إلى الله تعالى، فهو جزء من العقيدة الإسلامية، ومقوم أصيل في بنية المجتمع المسلم وحياته.
وهذا الذي ذُكر في اقتناء العلماء للكتب واهتمامهم بها واستيعابهم لها، في كل بقعة من العالم الإسلامي المتسع، وكذلك في الأندلس، يَرِد الحديث عنه وافرًا عند مؤلفي التراجم من أمثال الحميدي (٤٨٨هـ) في جذوة المقتبس، والضبي (٥٩٩هـ) في بغية الملتمس، وابن القرضي (٤٠٣هـ) في تاريخ علماء الأندلس، وابن بشكوال (٥٧٨هـ) في الصلة، وابن الأبار (٦٥٨هـ) في التكملة لكتاب الصلة، وابن عبد الملك المراكشي (٧٠٣هـ) في معجمه الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة، وابن الزبير (٧٠٨هـ) في صلة الصلة، وابن الخطيب (٧٧٦هـ) في الإحاطة في أخبار غرناطة، والمقري (١٠٤١هـ) في نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرهاعلى لسان الدين ابن الخطيب، وآخرين غيرهم كُثر، ممن نجد بعضهم معتمدًا عليه في هذا البحث.
فلدينا ثبت طويل جدًّا، في كتب التراجم والأخبار والميادين الأخرى، من العلماء الذين كانت لهم عناية باقتناء الكتب، وهم أنفسهم من المؤلفين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم الفخمة – كما وحجمًا وكيفًا – التي رفعتهم إلى مصاف العلماء الأعلام.
فكان من مستلزمات مكانتهم العلمية أن تكون لهم مكتباتهم الخاصة. كما لاحظنا أن جامعي الكتب كانوا من أهل العلم، حتى ولو لم يكن ذلك تخصصهم أو ميدانهم الذي عُرفوا به، لانشغالهم بالوظائف العامة كالقضاء والوزارة وغيرها، أو الأعمال العامة كالبستنة والتجارة وغيرها، وذلك أمر طبيعي لمكانة العلم، ولأن المجتمع متعلم وبالمعرفة شغوف.
وكل هذا كان يتم، وبمدًى واسع، وكثرة عجيبة، وشمول مدهش، رغم عدم توفُّر الطباعة، وما تكلِّف صعوبة الاستنساخ من الوقت والمال، وضعف وسائل النشر والإعلام، وبُعد الشُّقة، وطول المسافة، وحال وسائل الاتصال والانتقال.
فيذكر ابن بشكوال عن أبي محمد قاسم بن محمد بن سليماني بن هلال القيسي (٤٥٨هـ) من أهل طليطلة، ما يشير إلى كثرة مؤلفاته وجمعه للكتب، وأنه استنسخ ذلك بنفسه، حيث نسخ كتبه بخطّه، وكان كثير الكتب في الفقه والآثار، حسن الضبط لها، ثقة في روايته، وكانت له حلقة في الجامع يعظ فيها الناس.
وابن أبي الحباب كان حافظًا، صحيح الرواية، جيد الضبط لكتبه(٢).
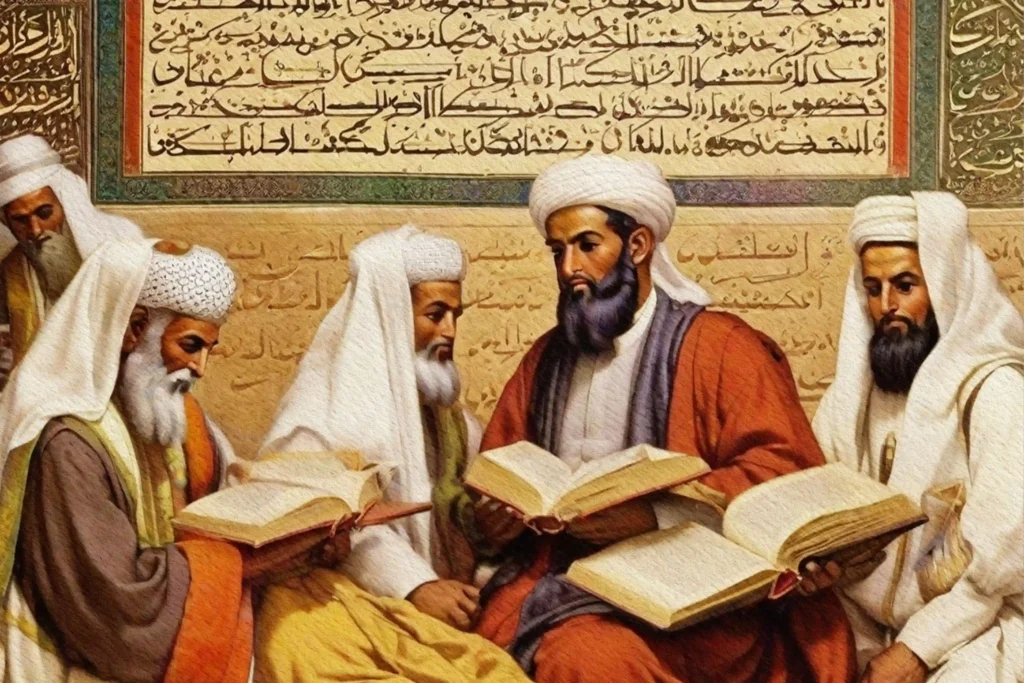
نماذج من العلماء المسلمين:
واشتهر بعض العلماء بضبطهم لما جمعوا من الكتب الأمهات التي اعتُبرت أصولًا. من هؤلاء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموي المعروف بابن ميمون (٤٠٠هـ)، الذي جمع من الكتب كثيرًا في كل فن، وكانت كلها بخط يده، وكانت منتخبة مضبوطة صحاحًا، أمهات لا يدع فيها شبهة مهملة، وقلّ ما يجوز عليه فيها خطأ ولا وهم.
وكان لا يزال يتبع ما يجده في كتبه من السقط والخلل، بزيادة في اللفظ أو نقصان منه، فيُصلحه حيثما وجده ويعيده إلى الصواب. وكانت كتبه، وكتب صاحبه إبراهيم بن محمد، أصح كتب بطليطلة (٣). ومن الطريف أنه يوم وقع الحريق في سوق طليطلة احترقت دار ابن ميمون، إلا البيت الذي كانت فيه كتب أحمد، وكان ذلك الوقت في الرباط، وعجب الناس من ذلك، وكانوا يقصدون البيت وينظرون إليه(٤).
وكذلك أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة (٥٦٥هـ)، كان حسن الخط، من أهل الإتقان والضبط. وحُكي أنه كانت عنده أصول حِسان بخط عمه، مع الصحيحين بخط الصدفي في سفرين. قال: “ولم يكن عند شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتها”(٥).
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن الأزدي، ويُعرف بابن صاحب الصلاة (٦٢٥هـ)، من أهل شاطبة. وهو غير عبد الملك صاحب الصلاة (٥٩٢هـ)، مؤلف كتاب المنّ بالإمامة. فقد كتب ابن مسعود بخطّه علمًا كثيرًا(٦)، وهي عبارة واضحة الدلالة على جمع الكتب وامتلاك مكتبة استنسخ كثيرًا من أسفارها بنفسه، وهي لا تدل على امتهان حرفة الكتابة أو الوراقة.
ومثل ذلك كان محمد بن إسماعيل المتيشي (٦٢٥هـ)، الذي كان مليح الخط والضبط، مشاركًا في علم الحديث والرجال، فاضلًا زاهدًا، يقول الشعر، وكتب علمًا كثيرًا، وأخذ عنه الناس، وكان أهلًا لذلك(٧).
وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي (٦١٠هـ)، نقّد كتب العلم عن جماعة كثيرة، أزيد من مئة وثلاثين، من أعيانهم المشرقيين: أبو طاهر السلفي، صحبه واختص به، وأكثر عنه.
وحُكي أنه لما ودّعه في قفوله إلى المغرب، سأله عمّا كتب عنه، فأخبره أنه كتب كثيرًا من الأسفار ومئين من الأجزاء، فسرّ بذلك(٨).
ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عبيد بن أيوب الدبّاج (٣١٧هـ)، من أهل قرطبة. وكان يتعاطى عمل الديباج، فلذلك كان يُعرف بالدبّاج(٩). اعتمد على غيره في النسخ، إذ كانت كتبه بخط الورّاقين(١٠).
فلقد مارس التجارة إلى جانب العلم رغم تقدمه فيه وتدريسه له. فقد كان عالمًا ثقة جليلًا، وشيخًا طاهرًا نبيلا، وحين حلّ بالقيروان، سمع منه أكابر الناس، وحفوه بالعناية والرعاية، وأكرموه وتلقوا عنه فرحين به ومعتزين.

مكانة العلماء في الإسلام:
كان هذا حال العالم الإسلامي في كل بقعةٍ منه، لا في الأندلس أو المغرب وحدها، فكانت رعايةُ العلم وأهله، مكرَّمون لما يقومون به من واجب في احتواء العلم، وفي بثّه، والحِفاظ عليه نطقًا وهيئةً ودقةً واستقامةً وقدوة.
وبغير تمثّل العلم الحق، وسلوك دروبه، ما كان ينظر المجتمع المسلم إلى من احتواه وعاءً، إنما إلى من احتواه سلوكًا والتزامًا، يراه الناس فيه متمثّلًا، ثم يُقبلون على الاستماع إليه، والتلقّي عليه.
فكما كان العلم فريضةً في المجتمع المسلم، كذلك الالتزام به، بل إنّ العلم للالتزام، والتسلّك به، والتمسّك بأوامره، وهكذا فُهِم العلم عند المسلمين.
وبهذا كانت مكانة العلماء، وما يعرفون غير هذا. ومن أجل هذا تعلّموا. وكان لهذا العلم سمات ومتطلّبات والتزامات، كلّها تنبع من نفس العين، تفيض بهُدى الله، وتغمر الأرض اخضرارًا، فيضًا من الخير الأمين، والهُدى المنير، والنَّدى الظليل.
وبغير هذا السَّمت والتجرُّد، وبعيدًا عن الدرب والهُدى، لا نجد لمَن حوى في رأسه علمًا، أو امتلأ صدره نُصوصًا، مكانةً في ذلك المجتمع الرَّبّاني الذي يقوم على الخير امتثالًا، وبالحق التزامًا، ويهدي الله سلوكًا.
تتزيّا الأمة الإسلامية بكلّ ذلك وشاحًا أبيض ناصعًا، يلفّها، ويرتفع بها، ويحفّها في مسيرتها الكريمة، مبتغيةً رضا الله، معمّرةً أرضه، فتحقّق إنسانيةَ الإنسان، دريًّا فريدًا، وثّابًا لا يعرف التوقّف أو الخمول، أو التردّد والخوف، أو المُساومة والنفعية، إنما يتحرّك بعقيدة الإسلام، سالكًا دربها الشرعي، متّجهًا إلى الله رب العالمين.
وبهذه الآفاق الواسعة التي ضمّت البلدان الإسلامية الممتدّة في عالمٍ واسعٍ، عرف هذه المعاني، فعاشها، وطُبِع بها متميّزًا عن غيره، ممتازًا عمّا سواه، كان الخير وأهله، والعلم وحملته، والحق وجنوده، في كل بقعة من هذا العالم الوسيع، يجد عين المكانة، لا امتياز إلا لمن امتاز بالعلم والخير والتقوى التي ترفع الإنسان.
لا ينظرون إلى أيّ نسبٍ من قوم أو أرض أو حسب، إلا لنسب الإسلام، به تتميّز الأمور، وتُعرَف القيم، ويرتقي الإنسان.
فكان كلّ عالمٍ، في كلّ فنٍّ وعِلمٍ وتخصص، يتجوّل في أيّ بقعة من عالمه الإسلامي، وكأنّه في بُستانٍ مملوءٍ بالأزهار والأثمار، تُغرّد فيها الأطيار، ويستريح حيث يريد، لا يجد ما يُقلقه أو يُزعجه، بل يجد التكريم والتقديم بما اكتسب من علمٍ خير، وما امتاز به من تقوى وعملٍ صالح.
كلّهم بذلك وبغيره يقتربون إلى الله ربّ العالمين، ويسيرون في دُرُوبه، يملأ نفوسهم حبّه.
ولذلك كان العالم المسلم، وغيرُه، ينتقل من بقعة إلى أخرى، ويتولّى الوظائف والأعمال، ويتبوّأ المكانة، ويُوضَع في خير مثابة، بما أهّله علمُه، وما بدا عليه من سَمْتٍ تقيٍّ كريم، وما عاش من مواقف إسلامية تفخر بها النفوس، وترتفع بها الرؤوس.
وهذا الذي تُدعى إليه اليوم، أن يكون العلم عند الناس، حرًّا كان أو موجّهًا، في كافة معاهدنا بمراحلها، وكافة وسائل المعرفة في بلداننا، خيرًا فاضلًا ربّانيًا، حتى تتولّى من جديد إقامة الحضارة الإنسانية الكريمة الإسلامية، التي تنتظرها البشرية، وحُرِمت منها منذ جاءت إلى غير هذا الدين.
ومسؤولية المسلمين قبل غيرهم، في إقامة هذا الصرح، والدعوة إليه، والعمل له، أن يتمثّلوا هذه المعاني بأنفسهم، ليقرؤها الناس سلوكًا قبل الاستماع إليها، لنكون خير دعاة، وخير حماة، وبُناة للمجتمع الإسلامي القادم، إن شاء الله.
وذلك خيرٌ من كلّ احتفالٍ يتهيّأ له العالم الإسلامي بالقرن الخامس عشر الهجري.
ولا بأس بكلّ ذلك، ولكن: أخذ النفس بالإسلام، وبناء حياتها عليه، وإقامة أمورها فيه، إيمانًا واحتسابًا، وعملًا ودعوةً، وجهدًا وجهادًا؛ ذلك لكي يعيش هذا الدين في النفس، يتمثّله المسلم في الحياة، ويُقيمه في كيانه، مُحتفِلًا بسلوكه فيه، وبمعتقده، ويتحرّك به في الحياة في كل لحظة.
ذلك هو الاحتفال الحقّ لنصرة هذا الدين.
وفّقنا الله لذلك، ومكّننا منه، وأبعدنا عن كلّ ما يُنقص من هذه الحالة، وجمعنا على شريعته، ووفّقنا لحمل رايته، وجعلنا ممّن يتشرّفون بإقامة المجتمع ودولته، نحن ومن نتولاهم من الإخوة والأبناء والأحباب.
ووفّقنا الله للقيام بكلّ ذلك، إن شاء الله تعالى، وبعونه ومنّته.
آمين، والحمد لله ربّ العالمين.
الهوامش
- ا الصلة : ٤٧٣ (١٠١٩)
- الصلة : ٢٠ (٣٥)
- الصلة : ۲۲ (۳۷)
- الصلة : ٢٢
- نفح الطيب : ١٥٩/٢ – ١٦٠
- (١٦٢٥) التكملة : ٦٢٢/٢ ٦٢٥)
- (1) التكملة : ٦٢٣/٢) (۱۲۷) (١٦٢٧)
- نفح الطيب : ١٦١/٢
- تاريخ علماء الأندلس : ۳۷/۲ (۱۱۹۹)
- تاريخ علماء الأندلس : ۳۷/۲ – ۳۸

