
1- كانت طليعة الشَّباب الأحرار اليمنيين قبل الحرب العالمية، وأثناءها يقتحمونَ بأفكارهم الشَّابة المتفتِّحة عالمًا ضخمًا معقدًّا جديدًا عليهم، مليئًا بالألغاز، والاحتمالات والمتاهات. هم ينتمونَ ببيئتهم، وأسرهم، ومجتمعهم، وعواملهم الوراثيَّة، ودولتهم إلى ما قبل خمسمائة عام أو تزيد؛ ولكن كُتبَ عليهم أن يفتحوا أعينهم على عصر آخر غير العصر الذي ينتمونَ إليه، وأن يكونوا جسرًا يعبر الشَّعب عليه، ويقطع مسافة قرون طويلة، وتلكَ رسالة من أصعب الرِّسالات التي يتحمّلها جيلٌ من الأجيال.
إنَّ هذا الجيل المخضرم لا يستطيع أن ينهضَ بالعبء إلا إذا نجحَ في أمورٍ ثلاثة:
الأول: أن ينضجَ فهمه، وانتماؤه لروح شعبه، وروح العصر القديم الذي ينمي إليه شعبه نضجًا تامًّا.
الثاني: أن يتغلغل فهمه إلى روح الحضارة الحديثة لا أن يعيش على السَّطح منها.
الثالث: أن تكون عنده نزعة روحية ترتفع به فوق مستوى أهوائه الذاتية، ومنافعه المادية، لكي تكون هذه النزعة بالنسبة إليه كمحطة للفضاء التي يُراد لها أن تكون مرحلة بين الأرض والقمر… فرغم أنها تنتمي إلى الأرض ونواميسها عمومًا، وتضحي في سبيلها، فإنها تتسامى إلى فوق مستويات حياتها الروتينية الجامدة، كما هي لا تتحدر إلى جاذبية القمر، وإن كانت تدنو منها، وتراها كما لا يراها أهل الأرض؛ وبغير مثل هذا التسامي لا يستطيع الجيل المخضرم أن يقاوم عوامل الضغط الهائلة من عالمين إثنين:
عالم شعبه المعرق في القدم الذي تسوده نواميس الموت والتحجّر؛ وعالم الشعوب العصرية الحديثة التي تلوح له بسحر حياة لا يستطيع أن يحياها بطريقة طبيعية كما هي، مهما تكلّف وتكيّف ولو عاشها فإنه دون شك سيعيشها إنساناً غير متكامل لأنه سيكون مخلوقًا شائهًا ينقصه الضمير وينقصه الخلق أيضًا.
وبدون شك فإنَّ فهمه لروح شعبه الذي ينتمي إليه يقتضي فهماً كاملاً لظروفه السياسية والاجتماعية، والدينية وإذا استثنينا شؤون الدين الذي توجد مراجعه في الكتب، فإن جميع الظروف الأخرى السياسية والاجتماعية ظروف غامضة منغلقة على نفسها، وعلى أهلها.
ولا يستطاع حل ألغازها، وفتح مغاليقها، واكتشاف نواميسها، إلا عن طريق التَّجرِبة، والتَّعامل مع القوى السياسية التي تمثل سلطان القديم كله إلى جانب دراسة روح الشعب عن طريق ممارسة الحياة التي تحياها الجماهير ممارسة صادقة عميقة، لا ممارسة مسرحية.
2- فمن خلال الحس الوطني العميق لمعنى المهمة، التي كُتب على الشباب قبل عشرين عامًّا أن يضطلعوا بها، مارسنا التجربة الحيّة على الطبيعة، ونبشنا ركام شعبنا، وحطام تاريخنا ورواسبنا إلى الأعماق.
لقد كانت التجربة الأولى هي تجربة الرعيل الأول من رفاقنا، نبع فريق منهم من الأرض اليمنية عن طريق المطالعات للكتب الحديثة، ووفد آخرون عائدين من بغداد، بعد أن أنهوا دراستهم العسكرية، كانت تجربتهم التبشير بأفكار عصرية بحتة ونقلها إلى شعبهم كما هي، وهو شعب – كان – لم يعرف أي شيء عن العصر الحديث، وكان لهذا الأسلوب ردّ فعل شعبي ورسمي مضاد، وشاعت عنهم حكاية الاختصار للقرآن كذباً، وبهتاناً، ولكنها شاعت لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات ضد قبول مثل هذه الإشاعات. وكان كل هذا شيئاً طبيعياً، لأنها التجربة الأولى، وسهل على الحكم الرجعي أن يلغي وجودهم بالسجن، وكان الشعب يطلب ما هو أكثر من السجن. ولم يستطع الشباب بمجرد هذه التجربة أن يكتشفوا معدن الحكام على حقيقته.
3- تدارسنا هذه التجربة بعد الرعيل الأول، فأدركنا أنه لا يتم عمل ولا تقدم ولا تنجح دعوة عن غير طريق الدين الذي يستمد الحكام منه سلطتهم وقلنا: إنه لا بد لنا من إحدى الحسنيين، فإما أن يسمح الحكام للفكرة بالانتشار فهو النجاح السلمي على مستوى الحكومة والشعب معا، وإما أن يرفضوها، ويقاوموها وهي دعامة حكمهم فسيضطرون لهدم هذه الدعامة ويصبح حكمهم بغير أساس.
ولكننا وجدنا أنفسنا في السجن رغم هذا التكتيك؛ ووجدنا الشعب يتخلى عنا، ورأينا أن تحجره، وانصياعه للحكام أبعد مما تصورناه.
ورأينا أن التاريخ سيحكم علينا بالتهوّر والتسرّع إذا لم نكرر التجارب بطرق أكثر ليناً، فالعامل الإنساني يجب أن يراعى حتى بالنسبة إلى حكام يسيطرون على مقدرات الشعب بغير حق، والله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون عليهما السلام. وهو يبعثهما إلى فرعون: ((فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ)) [طه: الآية 44].
ومن هنا نشأت فكرة التطامن للعاصفة بعد أن وجدنا أنفسنا سجناء «جبل الأهنوم». وظهرت الثقة بمقدرة الشعر على إقناع الحكام بأننا لسنا أعداء، بل إننا أبناؤهم البررة. وإننا على استعداد لأن نكون كسائر أفراد الشعب مستمعين مطيعين، نراهم كما يراهم الناس.
والهدف من ذلك إعادة التجربة بأسلوب يحفظ على الحكام كبرياءهم، حتى إذا كانت الكبرياء هي التي تحول دون تسامحهم مع نشاطنا المرجو، فإننا نكون بهذه المداراة قد ساعدناهم على أن يكونوا طيّبين معنا.
وقد نجح الشعر هنا في إقناعهم بأننا لسنا لهم بالأعداء فأطلقوا سراح البعض بعد تسعة أشهر، ولكنهم ظنوا أننا سوف نرضى عنهم، ونتعايش معهم بمجرد أن يغدقوا علينا من أموال الدولة ومناصبها، فلم يتغيروا بعد إطلاقنا من السجن في شيء ما غير الاستعداد لمساومتنا من الناحية الشخصية.
4- وبذلك انتهت مدة تجربتي مع الإمام يحيى بالذات بعد أن أدركت بعمق وبيقين أنه يعادي كل تطور، وكل إصلاح وأنه لا ينتفع معه رفق، ولا لين، ولا استعطاف ولا ثناء، إذا كان المطلوب منه أن يحقق إصلاحاً، ولو على الأسس الدينية.
لقد كانت تجربة خصبة عميقة كسبنا منها الأساس الأول للثورة، وهو اليقين باستحالة تغيير الإمام يحيى عن غير طريق القوة.
ولم يكن هذا اليقين الثوري ليحصل إلا بعد المرور على كل هذه التجارب، وأهمها في رأيي استعطاف الشعر بكل ما فيه من تأثير عاطفي شديد.
إن محاولة إقناع الإمام يحيى بواسطة الفكر الديني ثم المدائح الشعرية التي قدمت إليه في هذه المرحلة التجريبية كلها تُعتبر وثائق تاريخية، تدل على المحاولات الجادة لإقناع الإمام بالحكمة، وبأرق الوسائل الودية كي يسمح بالتطور الإصلاحي المنشود، ولا يستطيع أحد في المستقبل القريب أو البعيد أن يزعم بأن الإمام يحيى عارض الإصلاح خوفاً على الدين، فإن التجربة قدمت نفسها كدين، أو يزعم بأنه تشدد واستبد، وأصر على طغيانه لأنه صُدم شخصيا، أو جرح كبرياؤه، فالشعر شاهد حي سيبقى برهاناً تاريخياً على أن الإمام يحيى – الذي لقي مصرعه بعد سنوات قليلة من المدائح، والاستعطاف – كان قد أعطي أكثر مما يستحق من الثناء والاحترام، وأتيحت له الفرصة، ووفرت له الكرامة، وقدمت إليه الأفكار، والنصائح في جو من الود، والاستعطاف، والإكبار، لا يدع له مجالاً للتعليل والاعتذار، وأنه بإصراره رغم كل ذلك وعناده، واستبداده، يُعتبر المسؤول الذي جعل الخلاص منه بالقوة هو الطريق الوحيد، الذي لا طريق سواه.
5- أنا أعرف أن الذين يعيشون في ثورة اليوم، ووعي اليوم من شباب اليمن بالذات يضيّقون من محاولاتنا لتبرير الثورة على الإمام يحيى، فهي قد أصبحت من البديهيات.
ولكن إذا كانت الأمور بعد عشرين عاماً تبدو لنا واضحة جلية، ويبدو فيها وجه الحق بيّناً ساطعاً. فهي لم تكن كذلك من قبل… كان كل ما في اليمن يبدو مشوشاً غامضاً مظلما، بل كان عالماً من الألغاز، والطلاسم والمتاهات.

وكان إحساسنا المزدوج المضطرب بين العالم القديم، والجديد، وكانت حيرتنا بين طقوس العبودية التي يعيشها جيلنا يومئذ، وبين مثل العصر الحديث الذي تسللنا إليه مبهورين ذاهلين، كل ذلك يفرض علينا مسؤولية التحقق بأنفسنا، وبالتجربة الحياتية الذاتية من الأمور الآتية:
1- هل الإمام يحيى بطل قومي، تزعّم الثورة ضد الأتراك وتربّع على العرش لأهداف سامية كما كانت سمعته الخارجية والداخلية تزعم له ذلك (1) …؟
2- هل الإمام يحيى الذي تزعّم الثورة ضد الأتراك صالح لتزعّم ثورة تطورية؟ ولو مترفقة بطيئة متزنة تجنب الشعب آلام المخاض الثوري العنيف؟
3-هل الإمام يحيى رجل قابل للأخذ والرد والتفاهم مع الناصحين المتوددين، أم أنه عنيد مستبد، متأله، يرفض أن يعطي أحداً حق النصح، والمشورة، وإبداء الرأي!
4- هل العزلة، والتأخر، والفساد في اليمن آتية تلقائياً لعوامل تاريخية، وجغرافية، دون أن يكون للحكام دور أساسي في تجميدها، وحمايتها أم أن للحكام دوراً يتحمّلون جزاءه ومسؤولياته؟
5- هل عند الإمام يحيى نزعة الاستبداد، والتسلط والإصرار على خنق الشعب، أم أن الشعب هو الذي يخنق نفسه، ويرفض الحياة والتطور؟
6- هل كان يمكن أن تتطور البلاد سلمياً، وبالتدريج وبالتفاهم مع الإمام يحيى، والتودد إليه، أم لا بد أن يأخذ التطور طابعاً ثورياً لا هوادة فيه؟
7- ومن جهة أخرى، فهل كان الشعب مستعداً أن يجابه الإمام بمطالبه، ويقف مع الأحرار، دون أن يسلمهم إليه، ويتركهم تحت رحمته، ويبرر كل تصرفاته الاستبدادية…؟
6- لا شك أننا لو أغمضنا أعيننا، وألغينا من تاريخ اليمن الحديث هذه الفترة البدائية من محاولات الشبيبة اليمنية، واحتكاكها بالإمام توجيهاً، وتبشيراً واستعطافاً، ومدحاً وتطرفاً، واعتدالاً، وسجوناً، أو غلالاً.
ثم بدأنا استعراض التاريخ فقط منذ أعلنت الحركة المعارضة العنيفة من عدن، والقاهرة، التي أدت أخيراً إلى مصرع الإمام يحيى، وبعض بنيه، ورجاله، ثم إلى فشل الحكم الثوري الدستوري، والمذابح البشعة، والفتن، والنهب، والسلب، والخراب، والدمار.
ثم ما أعقب ذلك كله من حكم الإمام أحمد الرهيب.
لو فعلنا ذلك لما استطعنا أن نفهم المبرر العادل للأعمال الثورية العنيفة، بل ولحكمنا على الأحرار بالتهوّر، والمجازفة بالأرواح والأموال والمصائر، وافتعال ثورة لا ضرورة لها، ولا يقين فيها.

ولقد كان شعر المدح في هذه الفترة البدائية هو الرائد والمستكشف الأول، وهو المجسّ العميق الدقيق الذي تغلغل إلى أغوار نفس الإمام، وأعطانا المقاييس، والمعايير لتقدير الحد البعيد الذي ذهب إليه الطاغية من التأله، والقسوة والاستعلاء، والإصرار.
وبالنتيجة الحتمية كان الشعر هو الذي أعطانا القدرة على الانتقال النفسي من مرحلة إلى مرحلة، وهزّ مشاعرنا، ورواسبنا، وتلكآتنا، ومخضها مخضاً وأشعلها وصهرها، وحوّلها إلى يقين ثوري عميق أصيل.
7- ولم تكن طليعة الأحرار وحدها هي التي تمارس هذه التجربة الانتقالية الصادقة العاقلة، بل كان الشعب معها يتطور وينتقل، ويرصد الخطوات، ويحاكمها، ويحكم فيها طبقاً لما يراه ويشهده.
ولو كانت الأحداث التي يشهدها الشعب هي مجرد الاعتقالات، وضروب البطش، والتنكيل لكانت عناصر المشهد التاريخي ناقصة بالنسبة إلى الشعب أفدح النقص. إذ لا يستطيع أن يجزم، ويحكم على الإمام يحيى بالقوة والعناد دون أن يشهد ضراعة الأحرار إليه، وترفقهم بسنّه ومكانته، ولم يكن هذا كله ليتم، أو يعرف للشعب إلا عن طريق الشعر السيّار الذي يقرؤه الصغار والكبار.
وقد بقي سؤال آخر في الصميم وهو: –
هل الشعب كان يقبل من الشباب أن يتهوّروا ويتطاولوا أو يتحدوا شعور الإمام يحيى من بداية التجربة…؟ أم كان الشعب يريد الإصرار على الترفق والتأدب مع السلطة الروحية، والزمنية…؟
الذي أجزم به أن الشعب لم يكن يطيق أية قسوة على الإمام بقول أو عمل، وكان يعتبرها طيشاً، وينفر منها أشد النفور، بل ولم يكن يرى لها في حياته مبررا، في حين كان شعر المدائح والاستعطاف، والتشجيع يلقى استحساناً عاماً من المواطنين.
ونحن فلم نكن إلا جزءاً من الشعب، وصدى من أصدائه، ومحاولة من محاولاته البدائية في سبيل النمو والتطوّر.
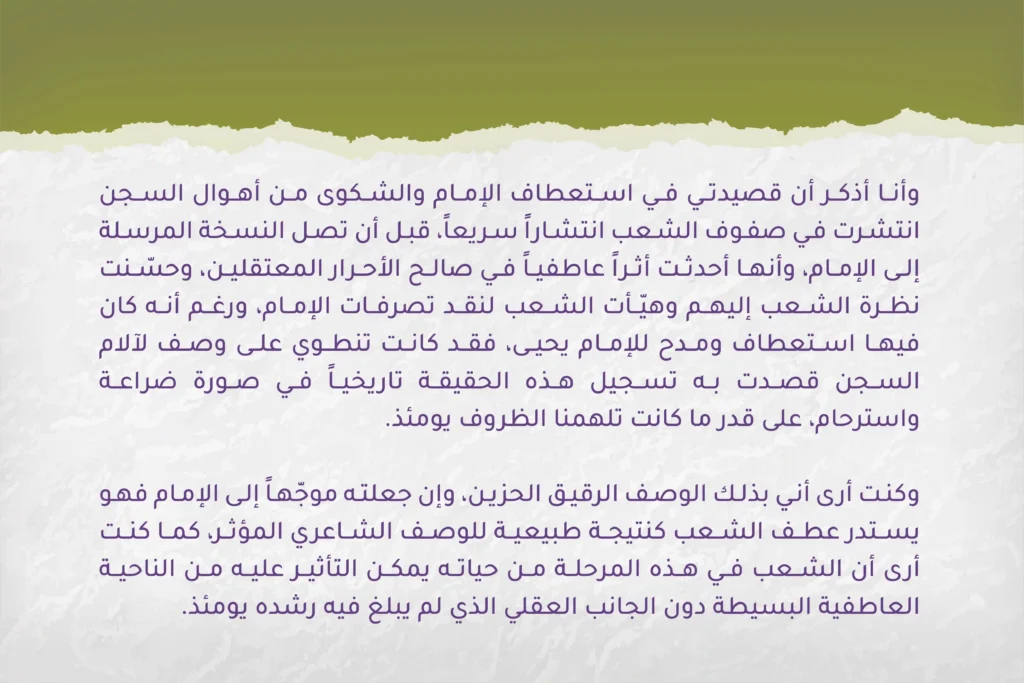
وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من أهوال السجن انتشرت في صفوف الشعب انتشاراً سريعاً، قبل أن تصل النسخة المرسلة إلى الإمام، وأنها أحدثت أثراً عاطفياً في صالح الأحرار المعتقلين، وحسّنت نظرة الشعب إليهم وهيّأت الشعب لنقد تصرفات الإمام، ورغم أنه كان فيها استعطاف ومدح للإمام يحيى، فقد كانت تنطوي على وصف لآلام السجن قصدت به تسجيل هذه الحقيقة تاريخياً في صورة ضراعة واسترحام، على قدر ما كانت تلهمنا الظروف يومئذ.
وكنت أرى أني بذلك الوصف الرقيق الحزين، وإن جعلته موجّهاً إلى الإمام فهو يستدر عطف الشعب كنتيجة طبيعية للوصف الشاعري المؤثر، كما كنت أرى أن الشعب في هذه المرحلة من حياته يمكن التأثير عليه من الناحية العاطفية البسيطة دون الجانب العقلي الذي لم يبلغ فيه رشده يومئذ.
ومن جهة أخرى فإن المبالغات في المدح، والشكوى، والاستعطاف يقدم إلى الأجيال صورة رمزية لبشاعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين الذين أوقعتهم الأقدار تحت رحمته فاضطرهم بقسوته، واستبداده ومنطقه المتأله إلى أن يمدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبيعته إلى لون رمزي من ألوان الهجاء .
8- ووراء ذلك كله فتلك هي سن الطفولة الأدبية، والوطنية وذلك هو منطقها الذي عشناه.
وإذا كان في الناس اليوم من قد تطوروا، واجتازوا هذه المرحلة بعيداً فلا يستطيع أحد أن يدعي بأن الشاعر متأخر عنهم في هذا التطوّر، وهو من التواضع، والخجل الشديد مضطر في سبيل تبرير المراحل الأدبية الماضية، أن يذكر من لم يتذكر بأنه ولله الحمد ممن ساهموا في صنع التطور الثوري، وفي ابتداع المعايير الثورية التي يوزن بها الرجال، والحق أن هذا الشاعر عرضة لأن يتهم بالتطرّف، أكثر مما يتهم بأنه صانع الحكام في طفولته قبل أن توجد معارضة أو معارضون.
9- وإذا كانت مرحلة التجربة مع الإمام يحيى قد أعطتنا اليقين الثوري بالنسبة إليه، وتأكدنا بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة للخلاص من حكمه، فقد بقي أنه وإن كان رأس الدولة، فهو قد كان الرأس اليانع للموت بحكم سنّه، وهو مع ذلك شطر الدولة، أما الشطر الثاني فهو ابنه أحمد وهو الأهم، والأخطر.
ومن هنا نرى أن التجربة لن تتم صورتها إلا بالانتفال إلى ولي العهد أحمد بن الإمام يحيى الرجل المؤمل للمستقبل.
في شهر ذي القعدة سنة 1381 هـ، مايو سنة 1962 كلنا قد أصبحنا أحراراً أبطالاً حتى نفايات حاشية الإمام، وأهله، وذووه، وكلنا يستطيع أن يكتب حكم التأريخ بشجاعة على أحمد بن يحيى حميد الدين، ويكتب المقالات الطوال، عن أعاجيب أطواره، وجرائر حكمه.
والشيء الوحيد الذي يعجزنا جميعاً، هو الإتيان بالجديد المجهول في هذا الشأن.
ولكنا في عام 1361 هـ كنا نرى في هذا الرجل بطلاً، في وقت كنا نحن وشعبنا في أشد العجز عن خلق الأبطال، وصنع البطولات.
كان ولي العهد أحمد رمز الأمل، ومناط الرجاء في القضاء على أسباب الفساد المعروف عن حاشية الإمام يحيى. وكان رجال هذه الحاشية يرتعدون من المستقبل كلما تذكروا «أحمد» حتى لقد أرسل عصابة من رجاله وحرسه، فأحرقوا قصر أحد رجال الحاشية. بعدما أشتد تذمر الناس منه، وهو «السيد علي لطفي».
ومن جهة أخرى فهو البطل الأسطوري. فيما كانت تزعم له البلاد كلها من مواقف بطولية خيالية في حروب عديدة. ومن ثم كانت الأنظار تتجه إلى بطولته كلما تذكر الناس الجنوب اليمني المحتل وحاجتهم إلى بطل يحرره من الاحتلال الانجليزي.
بل كان يرشح أكثر من ذلك لقهر الحكام السعوديين ليس من أجل استرداد الأرض اليمنية التي استولوا عليها فحسب، بل ولطردهم من الجزيرة العربية، وإنهاء سلطانهم البدوي، المتوحش على الحرمين الشريفين.
وهذا كله عدا تعلق الفئات الواعية بالمستقبل الذي تنتظره البلاد على يده من تطور، وتحرر وإصلاح.
10- في هذا الجو بالذات، انتقلت بعد خيبة الأمل من صنعاء الإمام يحيى إلى تعز ابنه أحمد ولي العهد، البطل المؤمل المرموق.
ولقد وجدنا في هذا الرجل العجيب فعلاً ما يخدع، وما يغش، وما يُذهل، وتعاظمت في أنظارنا ظواهر تصرفاته ومطامح شخصيته، وألغاز تصريحاته الرمزية، التي توحي بالتذمر من رجعية أبيه، وفساد حكمه.
لقد استطاع هذا الرجل، الممثل الداهية؛ أن يجعل البلاد تعيش – من ألاعيبه – في مسرحية مبرمة فصولها، محكمة أدوارها. فهو يغضب من أبيه، ويثور، ويبكي أحياناً. ويتوعد أحيانا، وأنه ليتأوه على سجناء الشباب حتى كأنه أخ لهم حميم! وكان يقوم بدور إطلاق سراحهم، وتأمين ساحتهم، ومطارحتهم الأفكار، والأشعار في مجالسه في تواضع وانطلاق وتحرر .
كنت فعلاً في سن النوازع الروحية معجباً بشخصيته مأخوذاً بها، وكنا ننتظر أن تكون تجربتنا معه ناجحة، وأن يكون هو العوض للشعب عن خيبة الأمل، في أبيه، وأن يكون هو المرحلة الآمنة، التي يتطور فيها مصير بلادنا في سهولة، وأمن من الأخطار.
وعلى هذا الأساس قدّمت إليه عصارة غالية من شعري، أنفخ فيه روح الطموح، والبطولة وأمنحه حماس الثقة، وأحرّكه بأحلام الشعر، وأشواق المجد، بل وأحلم بأنه قد أصبح بطلا في دنيا فني، وعالم خيالي ولم يكن ذلك لأني أطلب منصبا، أو مغنماً شخصياً، فلم أتقلد منصبا، ولم أقبل وظيفة، ولم أكسب منه مالا، وإنما أتلمس لبلادي منطلقا لمجد، وسبيلا لتطور وإصلاح.
هذا شأن الإنسان في بداياته، وتطلعاته، وبحثه عن وجوه الحق،
ومعالم الطريق. وهكذا كان الشأن، والموقف لشباب جيلنا كله في ذلك الحين: ((وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ)) [التوبة : الآية ]114
* مقابسة من الأعمال الكاملة للثائر محمد محمود الزبيري

