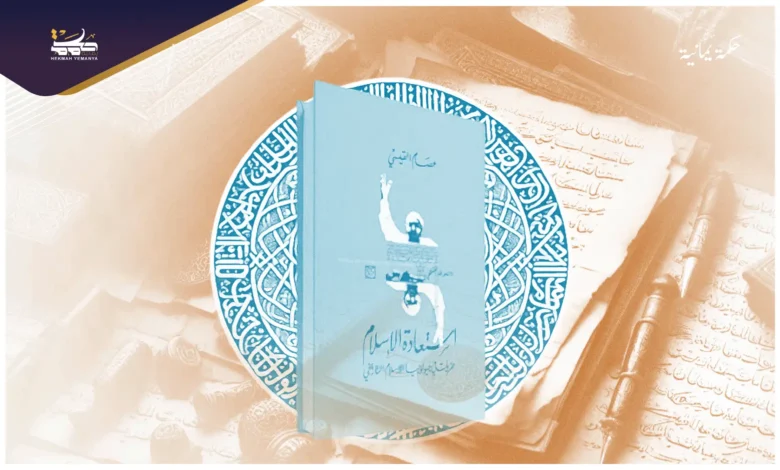
أشرنا إلى أنَّ الكاتب عصام القيسي، في كتابه (استعادة الإسلام)، ألقى باتِّهام كبير على علماء الإسلام، كونهم لا يملكون الحسَّ والمنهج النقدي القادر على كشف مستوى الاختراقات والاختلالات الدقيقة في مهدها. و”أنَّ الخبرة النقدية للنخبة الإسلامية المثقَّفة في القرون الأولى لم تكن بالمستوى الذي يؤهِّلها لرصد التحوُّلات الدقيقة والبطيئة في العقل الإسلامي، أو إدراك الحقائق ذات المستوى الفلسفي الكلِّي -وهي الأخطر، مثل حقيقة العلاقة الجدلية بين الوحي والزمن. وإن أدركوا بصورة عفوية الفرق بين المفاهيم القرآنية ومصاديقها الزمنية! بل لم تكن مؤهَّلة حتَّى لحماية المجال الإسلامي مِن سيل الإسرائيليَّات التي تدفَّقت عليه!“. ص29- 30. وأشرنا في المقال السابق إلى مستوى الدِّقة لدى هؤلاء العلماء -مِن جيل الأمَّة الأوَّل- في حفظ النصوص الدينية، كتابًا وسنَّة، وحفظ أسانيد الأحاديث والروايات والأقوال، بحيث بُني عليها علم الرجال وهو أعظم منهج نقدي للمرويَّات، وتمييزهم للمصطلحات والمعاني والدلالات حدًّا جعلهم ينخلون أقوال الفرق، وعقائد الملل المتقدِّمة، وأفكار الفلاسفة والمتكلِّمين مِن الثقافات الأخرى، وينغمسون في جدل حولها وحول مضامينها. وبلغت هذه الحاسَّة النقدية حدًّا امتلأت معه المكتبة الإسلامية بالنتاج النقدي العقدي والفقهي والحديثي واللغوي والتاريخي والفلسفي، حتَّى أصبحت بحرًا زاخرًا بالمؤلَّفات التي ذهب بكثير مِنها الحروب والكوارث الطبيعية، وسرقة الدول الاستعمارية لها، فيما بقي كثير مِنها في غياهب التجاهل والنسيان. ولولا هذه الحساسية النقدية كيف كان القيسي سيتمكَّن مِن تمييز الروايات الإسرائيلية؟! دون أسانيد وأسماء وتنبيهات النخبة الإسلامية وتوثيق السابقين لها، وكأنَّه كان سيخترع العجلة التي لم يسبق لها؟!
إنَّ الحساسية النقدية والمنهج النقدي هو الذي نقَّح كتب العقائد وكتب التفسير وكتب الفقه وغيرها مِن علوم الشريعة، وجعلها طويلة وضخمة المتون، حتَّى استعصت على الكسالى. وهناك دراسات جامعية رصينة في عدد مِن جامعات العالم الإسلامي حول المناهج النقدية لعلماء الإسلام في كلِّ فنٍّ وعلم، إمَّا للأشخاص وإمَّا للمؤلَّفات وإمَّا لقواعد الفنِّ نفسه، فهل اطَّلع عليها الكاتب وأحاط بها علمًا؟! وفنَّد جدواها في مؤلَّفات متخصِّصة بحيث أنَّ أحكامه التي أوردها في كتابه هذا نتاج اطِّلاعه وقراءته وتقييمه لهذه الرسائل الجامعية الرصينة؟! أم أنَّه ألقى أحكامه هذه عن قصر معرفة بهذا النتاج الأكاديمي الكبير والمتين، في مصر والمغرب والشام والعراق والخليج والجزائر وغيرها.
ثمَّ كيف تسنَّى له نقد كلِّ العلماء في كلِّ الفنون؟! وهو ليس بالمتخصِّص في تلك العلوم المختلفة عدا عن كونه قارئًا وباحثًا فيها، وبالتالي فهو في زمرة المثقَّفين وليس الخبراء المختصِّين الذين يمكن أن تصدر أحكامهم عن إحاطة وشمول بجهود علماء أهل كلِّ علم وفنٍّ. خاصَّة أنَّه لا ينقل كما هو حال الباحثين الكبار آراء غيره مِن رجال الاختصاص، تقديرًا لجهودهم واعترافًا بالتخصُّص وأهله.
هذه القضية الجوهرية سينشأ عنها إشكالات كثيرة في النقل والفهم والتحليل والاستنباط، إذ أنَّ أخطاء المقدِّمات والمدخلات تنعكس على النتائج والمخرجات؛ فكيف إذا ما أضفنا لذلك أنَّ منهج النقد والبناء لم يقم على أسس منهجيَّة واضحة وصارمة، ينصُّ عليها المؤلِّف في مقدِّمة كتابه، كي نحاكم كتابه عليها، وإنَّما هي أمور سنعتمد على ذكائنا لاستنباطها واستخراجها ضمنيًّا مِن خلال القراءة والتنقيب في ركام مِن الحفريات المنتقاة!
الصورة الواضحة والنقل المغشوش!!
يرى القيسي أنَّه “ليس مِن السهل على الباحث -اليوم- أن يشكِّل صورة ذهنيَّة مطابقة لعصر الصحابة والتابعين إذا أراد ذلك. لانعدام الوثائق التاريخية المكتوبة من ذلك العصر. باستثناء القرآن (1) ، وبعض النقوش والقصاصات المكتشفة حديثًا. وهي غير كافية بالطبع لإعطاء صورة واضحة لواقع جيلي الصحابة والتابعين. خصوصًا في تلك النواحي التي تحتاج إلى دقَّة في الملاحظة، وإلى عقل كلِّي النظر. أمَّا الصورة التي تشكَّلت لدى المسلمين عن تلك المرحلة فقد رسمها أبناء عصر التدوين الإسلامي، الذين جاؤوا بعد مئة سنة -في الحدِّ الأدنى- مِن عصر الصحابة والتابعين. والصورة التي يرسمها أبناء عصر التدوين لا بدَّ أن تتأثَّر بشروط عصرهم المعرفية والمذهبية والإدراكية” (2).
إنَّ القيسي يضع شرطًا تعجيزيًّا أمام مَن يتمسَّك بمرويَّات السنَّة والتاريخ، وهي أنَّ معظم ما دوِّن مِن مرويَّات وأحداث دوِّن بعد عصر النبوَّة، لا في عصر البنوَّة ذاته! وكأنَّ العرب كانوا مشتغلين بالعلم، وكانت الكتابة فيهم شائعة، وأنَّهم لم يكونوا أمَّة “أمِّيَّة” كما صرَّح القرآن الكريم. وهو بهذا التقعيد العجيب ينافي كلَّ ما بنته الحضارة المعاصرة مِن معارف وعلوم على معارف حضارات سابقة دوِّنت أغلب علومها ومعارفها في وقت لاحق، ولم يمكن تأخُّر التدوين عائقًا عن إسناد كثير مِن الأفكار والآراء والأقوال والمعارف إلى قائليها، بما في ذلك الكتب المقدَّسة عند أهل الكتاب والتي دوِّنت في وقت لاحق!
لقد تناقلت البشرية عبر تاريخها القديم معارفها وتراثها شفهيًّا اعتمادًا على ذاكرتها الحيَّة، فكان السماع والحفظ والنقل والإسناد هو المعتمد في علومها، باعتبارها الوسائل المتاحة والأكثر سهولة ويسرًا. وهذا لم يمنع المؤرِّخين -في كثير مِن الثقافات- مِن اعتماد تلك المروِّيَّات كأساس لسرد أحداث التاريخ وتفسير حركته، بقدر مِن النقد الموضوعي الذي لا ينقض الأساس.
وإذا كان مِن الصعب تشكيل “صورة ذهنية مطابقة لعصر الصحابة والتابعين“، كما يقول القيسي، نظرًا “لانعدام الوثائق التاريخية المكتوبة من ذلك العصر”، فكيف تسنَّى له تشكيل صورة ذهنية مطابقة لإسلام الصحابة والتابعين ومِن ثمَّ القول بأنَّ هناك انحراف عنها؟! فإذا عُدِم الأصل كيف تمَّ القياس وإصدار الحكم؟! خصوصًا أنَّ “القرآن” لا يتيح لنا صورة واسعة لذلك العهد، إذا ما أبعدنا النصوص العامَّة التي تتناول اليوم الآخر، وقصص الأمم السابقة وأخبارها، ومشاهد الكون، والمواعظ القرآنية، ومسائل الغيب والتوحيد، إذ لن تتبقَّ لنا سوى بضع صفحات تتحدَّث عن الغزوات وبعض الأحداث، وعدا عن ذلك لا يعطينا القرآن الكريم صورة دقيقة وتفصيلية عن تلك المرحلة وإسلام الصحابة الأوَّل الذي يريد القيسي استعادته!
ثمَّ أليس مِن العجيب أن يكون القيسي واثقُا مِن “بعض النقوش والقصاصات المكتشفة حديثًا“، والتي لا يمكن معرفة ظروفها وصحَّة إسنادها إلى كاتبيها، وظروف كتابتها، ولا يرتضي أن يأخذ عن الكتب التي دوِّنت بعد جيل الصحابة -رضي الله عنهم، مِن قبل رجال أفذاذ، جيلًا بعد جيل، مع مساحة مِن التوثيق والتدقيق والتحقيق، بحيث تمنحنا تلك الكتب المدوَّنة في السيرة والحديث والتاريخ صورة شاملة ومطابقة لعهد الصحابة والتابعين، مع شيء مِن جهود التحقيق والنقد المنهجية. “نقوش” سيحكِّمها القيسي بعد (11) قرن على أمَّة كاملة، في حين أنَّ جهدًا علميًّا ضخمًا لا يعترف به! “قصاصات مكتشفة” ستعطينا صورة مطابقة وواضحة في حين أنَّ ملايين الصفحات الحديثية والسيرية والتاريخية ستكون عاجزة عن تقريب الصورة وإيضاحها ومطابقتها!

ما الدافع مِن هذا التشكيك الكلِّي بالتراث؟!
يقول عصام: “هذا لا يعني أنَّ الصورة التي لدينا عن عصر الصحابة والتابعين (معيوبة) إلى حدٍّ لا يمكن إصلاحه، وإنَّما نعني أنَّها غير شاملة وغير دقيقة بما فيه الكفاية؛ إلَّا أنَّ تصحيحها ممكن مِن داخل التراث نفسه، وذلك بإعادة بنائها مِن القرائن المتوفِّرة، بغرض تقديم مقولة أكثر تفسيرية لتناقضات النظرية التراثية، وهو ما نسعى إليه في السطور القادمة، ونحن نتتبع القرائن والظواهر الدالة على حدوث انحرافات في مسيرة المسلمين بالإسلام“، ص33.
إذن الهدف مِن طرح التراث جملة وإفقاد المصداقية به هو إحداث قطيعة معه، ثمَّ اختيار “قصاصات” مِنه لتقديم “مقولة أكثر تفسيرية لتناقضات النظرية التراثية”! ورؤية لإسلام جديد! لأنَّ السؤال الطبيعي هو: إذا كان هذا التراث كلُّه مطروح، وخضع للتحريف والتأويل والحيل، فمَن سيملك الحقيقة بعد (11) قرنًا لصورة الإسلام في زمن الصحابة والتابعين؟!
ومبدأ الاختيار الانتقائي مِن “التراث”، لمجرَّد الموافقة والمخالفة، لا على أساس الثبوت والصحَّة والموثوقيَّة، هو ذاته منهج بني إسرائيل، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بصورة انتقائية، وهو الأمر الذي ذمَّه الله تعالى فيهم: ((أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الكِتَابِ وَتَكفُرُونَ بِبَعضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُم إِلَّا خِزيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَومَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ))، البقرة: 85. وهو منهج ((الـمُقتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ))، الحجر: 90- 91، والذين ((تَقَطَّعُوا أَمرَهُم بَينَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيهِم فَرِحُونَ))، المؤمنون: 53.
والمنهجية الانتقائية الديموغائية هي منهجية موجودة عند كلِّ فرق الإسلام، فقد استدلَّ الخوارج بالقرآن الكريم -وهو أعظم مرجع للأمَّة- على آرائهم المتطرِّفة الباطلة، كما استدلَّ الشيعة به على مذهبهم بتأويلات باطلة، كما استدلَّ به عبر التاريخ الحكَّام الجبابرة وعلماء بلاطهم. نقول ذلك لأنَّ القيسي أعطى لذاته فقط التميُّز للقيام بدور الناقد الفذ، ونزعها عن أجيال بأكملها، إذ يقول: “لقد تشكَّل نموذج جديد للرؤية في هذا العصر، وتشكَّلت حساسية معرفية جديدة، فهل كان لدى أبناء ذلك العصر القدرة على رؤية عصر الصحابة والتابعين كما هو مِن دون تلوين؟! ثمَّ هل كان لديهم مِن الحساسية المنهجية ما يساعدهم على إدراك التحوُّلات الدقيقة التي جرت في العقل الإسلامي وتراكمت طوال مئة سنة الماضية؟! لا شكَّ عندي أنَّ الإجابة بالنفي!“، س32.
الرأي ما أرى:
في محاولة للردِّ على مَن يصفهم القيسي بأصحاب نظريَّة “الوحيين”، ويقصد بهم بحسب ما أورد في الهامش “السُّنِّيين”(3) ، في استدلالهم بالقرآن الكريم، يقول: “يبدو القرآن “لمـَن تأمَّله مكتفيًا بذاته، ولا أثر فيه لأيِّ نصٍّ صريح يتحدَّث عن مرجعيَّات تشريعية أخرى كالحديث أو الإجماع، وكلِّ ما قدَّمه التراثيون (4) في هذا الباب كان مجرَّد تأويلات ظنِّيَّة لظواهر بعض الآيات“، ص33. ويذهب بحسب أدلته -التي يُسوِّقها في إطار إثبات نظريَّته- إلى أنَّ “القرآن هو الممثِّل الشرعي والوحيد لرسالة النبي محمَّد“.. كونه “أكثر صراحة ووضوحًا مِن تلك الأدلَّة التي قدَّمها التراثيُّون لتأصيل حجِّيَّة الحديث “(5)، ص34.
وعند عرضه لأدلَّته التي يستند إليها، لا يورد عصام أقوال العلماء حولها بشكل استقصائي بحيث يمنح القارئ فرصة للاطِّلاع على الأقوال الأخرى وأدلَّتها وردودها على مخالفيها، وإنَّما يأت القيسي بـ”قفشات” مِن هنا وهناك، يوظِّفها في إطار ما يسعى له، دون إنصاف مع أصحاب الرأي الآخر -“التراثيُّون”- الذين زخرت كتبهم بإيراد أدلَّة الخصوم قبل أدلتهم لمناقشتها وتمييز ما فيها مِن حقٍّ وبيان ما فيها مِن خلط، ثمَّ الردُّ عليها بأدلتهم، ثمَّ الاستدلال لمذهبهم بحججهم المستندة للنقل والعقل!
اكتفى القيسي بدمغ كلَّ ما قدَّمه “التراثيُّون” -دون تمييز- بأنَّه “مجرَّد تأويلات ظنِّيَّة لظواهر بعض الآيات“! وعلى القارئ أن يأخذ بهذا الحكم الذي أصدره القيسي ويسلِّم به، وأن يترك تراث (11) قرنًا وراء ظهره، ولا يلتفت له. فليس ثمَّة إلَّا رأي واحد، أمَّا الرأي الآخر فلا داعي لمناقشته، وسيكفيك الكاتب بحكم “دمار شامل” ضدَّه.
كباحث وصاحب نظريَّة كان يفترض على القيسي أن يعرض على القارئ البناء المعرفي الذي ذهب إليه “السنِّيون” خلال (11) قرنًا، بأدَّلته وحججه المختلفة، في أتمِّ صورة وأكملها، إنصافًا مع مخالفيه، ثمَّ يفنِّدها دليلًا دليلًا، وحجَّة حجَّة، بحيث نطمئن -نحن القرَّاء- أنَّنا أمام ردٍّ وافٍ لحجج أغلقت علينا حقيقة الإسلام ونقاءه، وانحرفت به لقرون، وأضلَّت الأمَّة جمعاء حتَّى اختفى إسلام الرعيل الأوَّل؛ لأنَّ الدعوى عليهم كبيرة جدًّا، وترقى لاتِّهامهم كما ذكرنا بتحريف الإسلام، بل وتبديله، بل وطمس حقائقه الكبرى خلف أحاديث وروايات مكذوبة وإسرائيلية وتاريخية لا ترقى أن تكون وحيًا!
إنَّ هدم هرم التراث وسوره العظيم الذي شارك في تشييده وبنائه آلاف العلماء والأئمَّة والجهابذة مِن مفسِّرين ومحدِّثين وفقهاء وأصوليين ليس أمرًا سهلًا يقوم به باحث بمقال عابر يحشد فيه تعابير أدبية وظنونًا عابرة يراها حقائق دون أن يقوم ساق أدلَّتها بذاته، على قدر مِن البناء والإتقان لما يقابله. ومجرَّد اتِّهام أجيال كاملة بعبارات استنقاص، مِن قبيل “عدم الحساسية النقديَّة” و”التراثيُّون” و”فقهاء خطِّ الانحراف”، لا تجعل مِن مطلق التهمة عبقريًّا فذًّا قادرًا على هدم ما بنوه!
والعجيب أنَّ الكاتب الذي يريد أن يطَّرح كتب الأحاديث باعتبارها تراثًا يسدُّ عنَّا إسلام الجيل الأوَّل يعود للتنقيب فيها لما ينصر رأيه، دون أن يحكي لنا ما الذي يجعل المرويَّات التي يختارها حجَّة لآرائه دون سواها، وكيف يثق بمروِّيات يصف حملتها بأنَّهم أصحاب “حيل”، كما كرَّره في عدَّة صفحات؟! ألا يمكن أن تكون تلك المرويَّات مِن بين “الحيل” المدرجة إذا لم تكن أساسًا موضوعة أم مكذوبة؟! والكاتب هنا أمام خيارين إمَّا أن يقول أنَّه سيعتمد على أقوال أهل الحديث وعلم المصطلح في توثيق تلك الروايات وبالتالي فهو هنا يؤكِّد على موثوقيَّتهم وأمانتهم وقوَّة منهجهم النقدي للروايات سندًا ومتنًا، وإمَّا أن يقول إنَّ أخذه هنا بها هو مِن قبيل الاستشهاد بأقوال الخصم ضدَّه، فيكون مِن اللَّائق والحالة هذه أن يأخذ تفسير المخالف لهذه الروايات، ونظرته إليها كاملًا دون نقص، وعلى لسان المخالف نفسه لا مِن خلال النقل عنه بصورة انتقائية ومنتقصة (6)؛ خصوصًا أنَّ هذه المرويَّات ذات سياقات ولها ظروفها وتأويلاتها المناسبة، وتوجد نصوص معارضة لها، فهل كان ينبغي عرض تلك النصوص المبتورة دون عرض هذه القضايا الجوهرية المؤثِّرة في تلقِّيها؟!
يقول القيسي، وهو يستدلُّ بزيادة حجم الأحاديث كلَّما بعد عهد النبوة على عدم حجيَّة الحديث عمومًا: “حتَّى أنَّ كبار المشتغلين بالحديث كانوا يشتكون مِن هذه الزيادة، ويشكُّون في أمرها. بل اعتبرها البعض عملًا مِن أعمال الشر التي تُلهي عن الحقِّ. وقد سجَّل ابن عبدالبرِّ هذه الشكوى على ألسنة العديد مِنهم، في كتابه (جامع بيان العلم وفضله). مِن ذلك قول سفيان الثوري: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير، ولكنَّه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر. وقوله أيضًا: ليس طلب الحديث مِن عدد الموت ولكنَّه علَّة يتشاغل به الرجل. كما قال: أنا فيه -يعني الحديث- منذ ستِّين سنة وددت لو خرجت مِنه كفافًا لا عليَّ ولا لي. وقال: وددت لو أنَّ يدي قطعت ولم أطلب الحديث”. ويعلِّق القيسي بقوله: “والذي يشتكي ليس فقيهًا مغمورًا، بل سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وأبرز شخصيَّات الجيل الثالث، الذي قال عنه الذهبي: هو شيخ الإسلام، إمام حافظ، سيِّد العلماء العاملين في زمانه“، ص46.
والعجيب هو أنَّ القيسي لم يرجع في نقل أقوال سفيان الثوري إلى المصدر الرئيس، وهو كتاب (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبدالبر (7)، بل إلى مصدر وسيط، وهو كتاب (مشكلة الحديث السنِّي والشيعي)، لمؤلِّفه يحيى محمَّد، وهو باحث وكاتب شيعي عراقي، لا يرى بحجِّية الحديث النبوي، ويدعو للعودة إلى القرآن والعقل، وقد تنقَّل مِن العراق إلى لبنان إلى إيران، ودرَّس في الحوزات العلمية، ويدعو إلى فهم جديد للدين! (8) وللشيعة مشكلتهم العقائدية والتاريخية مع الحديث وحملته، فكيف يذهب القيسي وهو باحث متمكِّن إلى النقل عن هكذا طرف، لأمر كان له غنية في نقله عن مصدره الأصيل؟!
القول ونقيضه:
يقول القيسي الرأي أو الفكرة ثمَّ لا يلبث أن يأتي بما ينقضها دون شعور مِنه، ويتكرَّر هذا في تناوله لأطروحته الشائكة.
فهو كمثال يقول: “تاريخ الشريعة حفظ لنا الكثير مِن العلامات الدالَّة على وجود اختلاف بين إسلام القرون الأولى وإسلام القرون التالية له“. وعلى فرضية أنَّه يقصد بـ”تاريخ الشريعة” مدوَّنات الفقه فإنَّ هذه المدوَّنات حفظت “الكثير مِن العلامات الدالة”، إلَّا أنَّه يرجع ليقول: “ونقل عن بعض السابقين مِن أبناء الأجيال الثلاثة الأولى ملاحظات تدلُّ على أنَّهم رصدوا، بصورة عفويَّة وغير واعية، بعض التغيًّرات في إدراك المسلمين للإسلام؛ لكنَّهم فسروا ذلك تفسيرَا قاصرًا، ولم يدركوا السرَّ الكامن وراءه ممَّا أوقعهم في بعض التناقضات“. ص30- 31. فنحن بين لفظين مختلفين متضادَّين: الكثير وبعض! فهل ما رصدوه كان كثيرًا أم بعض.. تردَّد الكاتب!
ثمَّ رغم كلِّ التُّهم التي ألقاها على التراث ذهب يبحث فيه عمَّا ينصر فكرته، فهو ينتزع كلامًا لسفيان الثوري -وسفيان هذا إمام في الحديث- عن سياقه وظرفه، ويؤّوِله بعيدًا عن مقصده ونهجه الذي لا تثبته مقولة واحدة! ويأخذ هذا النصَّ مِن كتاب (جامع بيان العلم وفضله) لكن عن مصدر وسيط يشير له في الحاشية كي لا يحيل القارئ لقراءته مِن مصدره الأصلي الذي يناقض فكرة القيسي التي يسعى لها! ثمَّ ينعت سفيان الثوري وغيره بقوله: “هذه بعض نوبات الحقِّ لدى المولعين بتتبُّع روايات الحديث، ممَّن عرفوا بالمحدِّثين“! ص47. في حين كان يفترض به أن يقدِّم تفسيرًا منطقيًّا لنوبات الحقِّ هذه إن كانت لا تصمد أمام ولعهم بتتبُّع روايات الحديث -كما هو تعبيره!

الاستخفاف بالرجال:
ليس أضرَّ على العقل البشري مِن استخفافه بعقول العلماء جملة، وبعيدًا عن لغة العلم وأدب الخطاب، فكيف إذ اجتمع مع هذا الاستخفاف الاتِّهام والطعن؟! وهذا ما يلمسه القارئ لكتاب القيسي مبثوثًا في صفحات كتابه. فهو يقول (ص34): “ومع وضوح هذا المعنى في الآية إلَّا أنَّ المفسِّرين لم يفطنوا إليه، إن لم نقل إنَّهم تحايلوا عليه أحيانًا!“. ويقول (ص35)، بعد نقل كلام لبعض المفسِّرين: “ومِن الواضح أنَّ الترقيع هو سيِّد الموقف!“. وهو ترقيع لخدمة مذاهبهم، يقول (ص39): “وقد فطن الشيوخ إلى ما في هذه الآية مِن تهديد لنظريَّة الوحيين فعملوا كالعادة على صرف معانيها بما يخدم مذهبهم. ومِن ذلك قول ابن تيمية…“. ويرى (ص40) أنَّ القوم لم يطبِّقوا قواعد التفسير التي أقرُّوها، وأنَّهم لو طبَّقوها “لوجدوا أنَّ القرآن يصف طائفة مِن آياته بالحكمة“. ويقول في (ص42): “ولأنَّ هذه الحقيقة الصادمة ثابتة عند فقهاء خطِّ الانحراف بالأسانيد الصحيحة في الكتب المعتبرة، ومِن الصعب إنكارها، فقد لجأوا لحيل شتَّى بغرض إبطال مفعولها“!
ويمضي عصام في إيراد أسماء الأعلام مِن صحابة وتابعين وعلماء وأئمَّة دون أيِّ وصف يليق بمقاماتهم، إلَّا إذا احتاج أن يسند رأيه بمقولة ينتقيها مِن أقوالهم، فيأتي بهذا الوصف نقلًا لا على لسانه! كما أنَّه لا يُتبع ذكرهم بترضٍّ أو ترحُّمٍ! وفي هذا جفاء واضح مع القوم، تؤكِّد أنَّ التعامل مع هذا الخطِّ السنِّي الممتدِّ مِن العهد الأوَّل حتَّى اليوم بدون أيِّ قيمة علمية أو مكانة روحية أو موثوقيَّة إخبارية أو ملمح مِن ملامح الفطنة إلَّا في حيلهم وتأويلاتهم الفاسدة التي أرادوا مِن خلالها حرف الإسلام عن مسارها!
إنَّه لا يعترف بمدى الخدمة التي قام بها علماء الحديث والاصطلاح في تنقية الأحاديث عبر قرون، لتمييز الثابت سندًا إلى الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن المكذوب، فيقول -بعد أن تكلَّم عن قلَّة عناية الفقهاء بالحديث، مستشهدًا بالإمام أبي حنيفة -رحمه الله: “غير أنَّ إقلال أبي حنيفة مِن الحديث لم يكن عن جهل به، بل عن إدراك لما شابه مِن أكاذيب وأوهام لا يكشف زيفها إلَّا الله“! ص49. إذن لم يكشف العلماء عنها، ومرَّت على الأمَّة هكذا وجاء القيسي ليتلقَّى عن الله -تعالى- الإلهام ليكشف ما شاب تلك الأحاديث المكذوبة! كيف؟! وبأي معيارية ومِن خلال أي مدوِّنات للرجال وموسوعات للتاريخ والأسانيد سيميز المكذوب مِن الثابت؟! الله أعلم.
هل هذه النفسية المتشكِّكة والمستهترة برجال الأمَّة، والطاعنة في نواياهم، والمستقلَّة لعلومهم، نفسيَّة منصفة وعادلة وعلميَّة وبنائيَّة وقادرة على استعادة الإسلام المختطف بجفاء الخطاب والروح؟! وللحديث بقيَّة.
الهوامش:
- لا يصف القيسي القرآن الكريم بأي كلمات تبجيل أو تكريم، وهو الداعي إلى الرجوع إليه، وكأنَّه كتاب عاديٌّ جدًّا، لا يحمل أيَّ قداسة أو منزلة. فأيُّ استعادة لمكانة للقرآن الكريم بهذا الخطاب الجاف مِن أيِّ روحانيَّة وتوقير؟!
- تحت عنوان “مِن إسلام القرآن إلى إسلام السنَّة”: ص32.
- ذكرت في مقال سابق أنَّ مشكلة القيسي ليست مع الخوارج ولا الشيعة ولا المعتزلة ولا الفرق الأخرى، بل هو يستهدف بحملته “أهل السنة والجماعة”.
- لا أعلم ماذا يقصد القيسي بوسم القائلين بمرجعيَّة السنَّة بكونهم “التراثيُّون”؟! هل هي محاولة للتأثير على عقل المتلقِّي بشكل غير مباشر لفصله عن أن يتأثَّر بهم أو يستمع لأطروحاتهم باعتبارهم “ماضويُّون” كما يقول الحداثيون عنهم مثلًا؟! أو “الرجعيُّون” كما يقول عنهم اليساريون مثلًا؟!
- يفترض أن يقول “السنَّة”، لأنَّ العلماء القائلين بمرجعيَّة الوحي ومصادر التشريع مِن علماء أهل السنَّة والجماعة يستخدمون تعبير “السنَّة”، والحديث جزءٌ مِنها، حتَّى أصبح وصف “السنَّة” علمًا مميِّزًا لهم على كافَّة الفرق الأخرى.
- عندما يستدلُّ القيسي ببعض المرويَّات لصالحه لا يتحدَّث عن سندها، ولا يبحث في مدى ثبوتها، وما ورد عليها مِن نقد أو ردٍّ، وهذا خلل منهجي في الأمانة العلمية والموضوعية المنهجية.
- وهو متوفِّر في الشبكة الإلكترونية إذا لم يكن بإمكانه اقتناؤه ماديًّا.
- انظر:
– الفيلسوف العراقي يحيى محمد، علي المقدادي، الحوار المتمدِّن، في: 9/12/2021م، متوفر على الرابط التالي:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740301
– العودة الى دور العقل في قراءة التراث الاسلامي.. يحيى محمد نموذجًا، قاسم قصير، دار الأمير، على الرابط التالي:
- هامش
- هامش
- هامش

