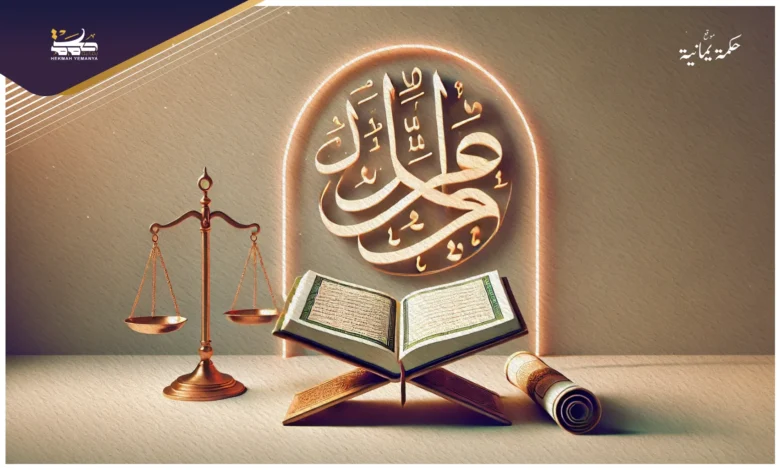
في سياق نقاش قضية “الشريعة” في العصر الحالي، وأطروحات الإسلاميين وغيرهم حولها، تنطلق مقولة يكررها بعض الباحثين في المجال يومًا بعد يوم، سواء كانوا باحثين غربيين أو باحثين عربًا ومسلمين، وملخّص هذه المقولة: أنّ فكرة “إقامة الشريعة” أو “تطبيق الشريعة” هي فكرة حديثة طرحتها الحركات الإسلامية في العصر الحديث ولم يعرفها التقليد الفقهي الإسلامي قديمًا. وفي هذا السياق يتم التشكيك أحيانًا بدلالة مصطلح “الشريعة” نفسه، والزعم بأنّه لم يكن يدلّ في التراث الإسلامي القديم على أحكام الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام، وأنّ ذلك تم لاحقا في عصور المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري.
وهي محاولة للتشكيك في أصالة أطروحة “الشريعة” التي هي الأطروحة الشائعة في حسّ غالبية المسلمين حتى لو لم يكونوا من أفراد الحركات الإسلامية الحديثة. وهدف هذا الطرح المشكّك بمفهوم الشريعة هو إثارة السؤال التالي: إذا لم يكن مصطلح الشريعة عند الأجيال الأولى من علماء المسلمين بالمعنى المطروح اليوم، فمن أين جاء هؤلاء الإسلاميون بمصطلح “الشريعة” بمعنى تطبيق أحكام الحلال والحرام أو الجانب العملي في الإسلام؟
وقد كرّر الدكتور معتزّ الخطيب، أستاذ المنهجية والأخلاق، في حوار أجريَ معه على موقع “معهد العالَم للدراسات” هذه المغالطة فقال: “لم تكن لفظة “الشريعة” شائعة في الزمن الأول أي زمن تدوين العلوم الإسلامية، فمن اللافت مثلاً أننا لا نجد تعبير الشريعة أو الشرع في كتب تأسيسية مثل “الرسالة” و”الأم” للشافعي أو “الأصل” لمحمد بن الحسن الشيباني أو في الكتابات المبكرة الأخرى، ولكنها تَرِد في بعض كتابات القرن الرابع الهجري تعبيراً عن الإسلام كدين قبل أن يتم اختزالها في الفقه أو البعد العملي منه (الحلال والحرام)”.
ما سأفعله في هذا المقال هو بيان خطأ هذا الكلام جملة وتفصيلا، وبأنّ المتقدّمين استخدموا مصطلح “الشريعة” أو “الشرع” بمعنى شريعة الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام، كما هو في كتاب الله، ولم يكن ذلك من ابتداع المتأخرين أو الإسلاميين، ولم يُختزل مصطلح الشريعة بعد القرن الرابع الهجري.
مصطلح الشريعة في الكتابات التأسيسية
لا بد من التأكيد أولا أنّه من العجيب جدّا أن يُتجاوز القرآن الكريم، باعتباره الكتاب التأسيسي الأول في الإسلام، حين نتطرّق إلى مصطلح “الشريعة”، فقد ذُكرت الشريعة فيه بمعنى الجانب العملي من الإسلام وبمعنى الحلال والحرام، قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (الجاثية: 18). وقال سبحانه: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: 48). وسياق هذه الآية واضح في أنّ “الشرعة” أي “الشريعة” هي جانب الأحكام أو الجانب العملي من الدين؛ لأنّه لا يمكن أن تختلف العقائد – كالإيمان والتوحيد واليوم الآخر – بين رسالات الأنبياء! يقول ابن قتيبة (ت 276 هـ) في كتابه “غريب القرآن”: “شِرعة وشريعة هما واحد”.
أما الإمام الشافعي (150-204 هـ) وأقرانه من القرن الثاني والثالث الهجريين فقد ذكروا “الشريعة” بهذا المعنى، أي بمعنى الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام، قبل أن تُطلق في القرن الرابع عند بعض العلماء على جملة الدين أو بمعنى “العقيدة” كما في كتاب “الشريعة” للإمام الآجري (ت 360 هـ) على سبيل المثال. أي أنّ الترتيب الزمني الصحيح هو أنّ الشائع في مصطلح الشريعة في القرآن وفي مصنّفات علماء القرن الثاني والثالث الهجريين هو أنّها جاءت بمعنى الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام، وليس كما قال الدكتور معتز الخطيب أنّها اختُزلت بالبُعد العملي من الإسلام (الحلال والحرام) بعد القرن الرابع الهجري! والشواهد على ذلك كثيرة، وسأنقل منها ما يفي بالغرض مبتدئا بالإمام محمد بن الحسن الشيباني ومثنّيا بالإمام الشافعي؛ لأنّ الدكتور معتزّ ذكرهما تحديدا ونفى أن يكونا قد ذكرا “الشريعة” في كتبهما.
الشريعة عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي
أمّا الإمام محمّد بن الحسن الشيباني (131-189 هـ) فقد ذكر الشريعة في كتابه “الأصل” بخلاف ما زعمه الدكتور معتزّ، بل وذكرها بمعنى الجانب العملي من الإسلام، قال رحمه الله في كتابه “الأصل”، كتاب الأيمان: “وإذا حلف الرجل بحدّ من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمينٌ ولا كفارة، ولا يكون اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره”.
وأمّا الإمام الشافعي (150-204 هـ) فيقول في كتاب “الأم” في “باب نكاح الشغار”: “فزعمنا نحن وأنت أن التحليل منسوخ، فتجعله قياسا على شيء غيره ولم يأتِ فيه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم خبر؟ فإنْ جاز هذا لك جاز عليك أن يقول لك قائل: حُرّم الطعام والجماع في الصوم والصلاة وحُرّم الجماع في الإحرام فأُحرّم الطعام فيه أو أُحرّم الكلام في الصوم كما حُرّم في الصلاة. قال: لا يجوز هذا في شيء من العلم، تمضي كل شريعة على ما شُرِعَتْ عليه، وكل ما جاء فيه خبر على ما جاء. قلت: فقد عمدتَ في نكاح المتعة وفيه خبرٌ فجعلته قياسًا في النكاح على ما لا خبر فيه، فجعلته قياسا على البيوع وهو شريعة غيره، ثم تركت جميع ما قِستَ عليه وتناقض قولك”.
فها هو الشافعي ومُحاورُه يتداولان مصطلح “الشريعة” بمعنى الحلال والحرام في كتاب “الأمّ” بخلاف ما يزعم الدكتور معتز الخطيب!
وجاء في كتاب “جماع العلم” للشافعي أيضا، باب “فرائض الله تبارك وتعالى”: “قال الشافعي: فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فُرضت عليه، ثم تفرّقت شرائعها بما فرّق الله عزّ وجلّ ثم رسوله صلّى الله عليه وسلّم. فيفرّق بين ما فرّق منها ويجمع بين ما جمع منها، فلا يُقاس فرع شريعة على غيرها. وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة”. ثم يذكر الشافعي بعض أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والنكاح، ويستدلّ في سياق ذلك بحديث: “لا يمسكنّ الناس عليّ بشيء؛ فإني لا أحلّ لهم إلّا ما أحلّ الله، ولا أحرّم عليهم إلا ما حرّم الله”.
والملاحَظ ليس فقط أنّ الإمامين الشيباني والشافعي قد ذكرا مصطلح “الشريعة”، وذكرُه كافٍ في إبطال ما زعمه الدكتور معتزّ، بل ذَكراه بمعنى الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام!
الشريعة في مصنّفات الأئمة المتقدّمين
ونحبّ أن نبيّن أنّ هذا المعنى للشريعة، باعتبارها شريعة الحلال والحرام أو الجانب العملي من الإسلام، كان شائعًا جدا عند أئمة الإسلام قبل القرن الرابع الهجري، بخلاف ما قاله الدكتور معتز الخطيب، وسنذكر المصطلح ومفهومه لدى بعض الأئمة المتقدّمين من القرنين الثاني والثالث، لنؤكّد بأّن المعنى المطروح للشريعة اليوم هو هو المعنى المطروح في مصنّفات أولئك الأئمة المتقدّمين.
الإمام عبد الرزّاق الصنعاني (126-211 هـ): روى في تفسير قوله تعالى {لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا}: “معمر، عن قتادة في قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} قال: «الدينُ واحد، والشريعة مختلفة»“.
الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (157-224 هـ): قال في كتاب “الأموال” في سياق: “والذي عندي في ذلك أنّ شرائع الإسلام لا يُقاس بعضها ببعض؛ لأنها أمهات، تمضي كل واحدة على فرضها وسنّتها، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة”. ثم ذكر بعض أحكام الصلاة والزكاة وغيرها.
الإمام أحمد بن حنبل (164-241 هـ): روى الإمام أحمد في “المسند” حديث عبد الله بن عباس الذي يحكي فيه خبر ضمام ابن ثعلبة، الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسأله عن كونه رسولا، ثم عن التوحيد، ثم عن الصلاة وفرائض الإسلام وشرائعه، وقد جاء في الحديث كما أورده الإمام أحمد في مسنده: “قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين ولّى: “إنْ يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنّة”.
وأنوّه إلى أنّني أذكر النصّ رغم كونه حديثًا وليس من كلام الإمام أحمد؛ لأنّ الاحتجاج هو في استخدام الشريعة بمفهوم الجانب العملي من الإسلام في مصنّفات الأئمة المتقدّمين من القرنين الثاني والثالث الهجريين.
الإمام محمد بن نصر المروزي (202-294 هـ): قال في كتاب “تعظيم قدر الصلاة” في سياق: “وقد حفظ في بعض هذه الأحاديث من شرائع الإسلام ما لم يحفظ في بعض، فيمكن أن يكون الذين قصروا عن حفظها كلها تعلّموا الإسلام قبل أن يفرض من شرائعه ما حفظ غيرهم، ويمكن أن يكونوا حفظوه فبدأوا أساسه وعمده ومعالمه وسكتوا عمّا يتبع ذلك، غير أنّ ذلك كله وغير ذلك من شرائع الإسلام التي حفظها غيرهم من الإسلام”.
محمد بن علي الحكيم الترمذي (توفي نحو 295 هـ): قال في “نوادر الأصول”: “وإنّ الله تعالى دعا العباد الى دار السلام بعد أن دعاهم إلى الاقرار بتوحيده فأجابوه، وإنما أجابه من هداه، ثم شرع لكل رسول طريقا إليها، وهو الحلال والحرام، فالحلال مرضاته والحرام مساخطه، وإذا استقام العبد في سيره في شريعته أدخله الجنّة، فقوله “لا يأتيني عبٌد لا يُشرك بي شيئا بواحدة من هذه الشرائع” أي: شريعة زمانه ورسوله…”. وقال في “نوادر الأصول” أيضا: “وإنّ الله عز وجل كلّف العباد أن يعرفوه، ثم اقتضاهم بعد المعرفة أن يدينوا له، فشَرَع لهم شريعة الحلال والحرام، والدين هو الخضوع”. ومن الواضح أنّه يطرح “الشريعة” بمفهوم الحلال والحرام، أو الجانب العملي في الإسلام.
الإمام الطبري (224 – 310 هـ): يقول في تفسير قوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: 48): “والشرعة هي الشريعة بعينها، تجمع الشرع شِرَعًا، والشريعة شرائع. ولو جمعت الشرعة شرائع، كان صوابًا، لأنّ معناها ومعنى الشريعة واحد”. وروى في تفسير الآية عن قتادة قوله: “{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، يقول: سبيلًا وسنّةً. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحلّ الله فيها ما يشاء، ويحّرم ما يشاء بلاءً؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد والإخلاص لله، الذي جاءت به الرسل”. ونحن نذكر هذا في استشهادنا لاستخدام الإمام الطبري لمصطلح الشريعة بهذا المعنى، مع أنّ الرواية منسوبة لقتادة الذي ولد عام 61 وتوفي عام 118 للهجرة، فتأمّل!
ممّا سبق من كلام بعض مشاهير أئمة الإسلام المتقدّمين في القرنين الثاني والثالث الهجريين يتّضح بما لا يدع مجالا للشك أنّ أئمة الإسلام المتقدّمين استخدموا مصطلح “الشريعة”، وقد استخدموا هذا المصطلح بمفهوم “الحلال والحرام” أو الجانب العملي من الإسلام، بخلاف ما زعمه الدكتور. مما يدلّ على أنّها مقولة تفتقر إلى التحقيق العلمي.
ومن هنا، يكون استخدام الدعاة لمصطلح الشريعة بمعنى إقامة أحكام الحلال والحرام استخدامًا صحيحًا، وهو استمرارية طبيعية للفقه الإسلامي منذ عهد نشأته الأول، فلم يحدث أيّ تحريفٍ لمفهوم الشريعة، ولم يخترع “الإسلاميون” شيئًا جديدًا، بل ظلّ الاصطلاح ومعناه على ما هو عليه. وحين يسعى المسلمون إلى إقامة الشريعة في واقعهم الذي عُطّلتْ الشريعة عن مجالات كثيرة منه، يكون هذا فعلًا طبيعيًّا ينطلق من فهمهم لدينهم وواجبهم تجاه ربّهم عزّ وجلّ. بل العجيب ألّا يكون ردّ الفعل هذا تجاه الواقع المخالف للشريعة، والذي تبنّت فيه أنظمة الحكم المهيمنة على بلاد المسلمين نماذج تشريعية وقانونية أخرى مستوردة من الغرب ومخالفة للشريعة!


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتوافقق تماما مع حضرتك ولكننى قرأت المقال لاعتقادى أنه يتناول فكرة أخرى بالنسبة لتصور الحركات الإسلامية الحديثة عن الإسلام فقد ظهرت الجماعات والحركات لاجل العودة بالشريعة الى واقع المجتمع والواضح ان تصور كل جماعة يأتى ليغطى منحىً واحدا أو
أكثر من مناحى الشريعة فهم قطعا لم يخترعوا مصطلح الشريعة لكن مفهوم التطبيق تباين من تصور لاخر كما ان تلك المفاهيم جعلتهم فى عزلة عن المجتمع وتقوقعوا على انفسهم ودب فيهم الاعتقاد بالفهم المطلق والوحيد للاصلاح المنشود فتقاطعوا فيما بينهم وأخذ بعضهم على بعض وللأسف وتشبعوا بالإيمان بالصحة المطلقة لمفهومهم وكأن لسان حالهم لو كان خيرآ ما سبقونا اليه..وإلى مزيد من الكتابة فى إصلاح أفكار ورؤى الحركات الإصلاحية الحديثة…
أسأل الله لى ولكم التوفيق