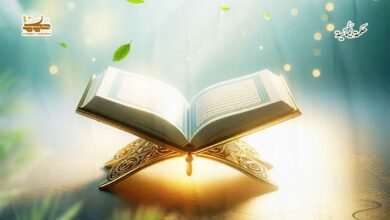في خضمِّ الجدل الطويل حول علاقة الإسلام بالسلطة، ظلت بعض المواقف والقراءات مهمَّشة أو مُغيَّبة، إمّا بسبب سطوة السلطان أو غلبة التأويل المذهبي. غير أن القراءة الدقيقة للموروث السياسي الإسلامي تكشف عن تيار لا تسلطي مضمر، يتعامل مع الدولة باعتبارها ضرورة مدنية مشروطة، لا قدرًا مقدسًا، ويرى أن السلطة تفقد شرعيتها متى ما تجاوزت الإجماع، أو استباحت الكرامة، أو نصّبت نفسها وصيةً على الناس باسم الدين أو النص أو الغلبة.
في هذا السياق، تتبلور ملامح ما يمكن تسميته بـ الأناركية الإسلامية؛ وهي ليست دعوة إلى الفوضى أو إسقاط الدولة، بل نقد جذري لكل سلطة تستند إلى الإكراه الديني أو السياسي، وتصور تحرري يرى أن المجتمع قادر على إدارة شؤونه بالعدل والتعاون دون حاجة إلى وصاية قهرية.
ويمكن تعريفها كالتالي:
“الأناركية الإسلامية هي الإيمان بأن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع المدني، وأن الناس سواسية في الكرامة والأهلية للاجتهاد، ولا يملك أحد تفويضًا إلهيًا للوصاية على الأمة. وأن المجتمع قادر على إدارة شؤونه بالتعاون والعدل دون حاجة إلى سلطة قهرية، مما يجعل الدولة ضرورة مدنية لا تستند في شرعيتها إلى النص الديني بل إلى الإجماع الشعبي، الذي لا تكفي فيه الأغلبية العددية البسيطة، وتكتسب مشروعيتها من التعاقد الاجتماعي، وتفقد السلطة شرعيتها عند إخلالها بعقد المشروعية.”
وهذا التعريف ليس تعريفًا اعتباطيًا من وحي خيال كاتب هذا المقال، فكل جزئية في التعريف مسنودة بمقولة أناركية في مذاهب أهل السنة والجماعة، والمعتزلة، والخوارج، وغيرهم، وقد سبق التطرّق لبعضها في الحلقة الأولى من هذه السلسلة.
وانطلاقًا من هذا التعريف، يسعى هذا المقال إلى تتبّع المنهج الإصلاحي في الأناركية الإسلامية، واستكشاف أصوله الكامنة في مواقف الصحابة المعتزلين للفتنة بعد استشهاد عثمان، وتحليل رؤية أبي بكر الأصم التي تمثّل أكثر الأطروحات تماسكًا في تأصيل شرعية السلطة من منطلق تعاقدي لا تسلطي، يرفض النصوص الأحادية، والغلبة، والنسب، كمصادر للشرعية.
في زمنٍ تعاني فيه مجتمعاتنا من انقسام سياسي حاد، ومن عسكرة الدين وتقديس الدولة، قد يكون من المهم أن نستعيد هذا التيار المنسي، لا كماضٍ نمجّده، بل كرؤية نقدية قابلة للتفعيل والمساءلة، تسهم في بناء تصوّر جديد للسلطة، يعيد الاعتبار للأمة، ويجعل الإنسان مركزًا للشرعية والكرامة معًا.
شرعية السلطة ومشروعية العنف: سؤال الأصل والمآل
الاعتراف بشرعية السلطة يتضمّن إقرارًا ضمنيًا بحقّها في استخدام ما يُسمّى بالعنف المشروع – بما في ذلك القتل – سواء باسم القانون في الدولة الحديثة، أو باسم «سدّ الذرائع» و«ما لا يتمّ الواجب إلا به» كما في نماذج الفقه السياسي التقليدي. وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما مصدر هذه المشروعية؟
بينما أسند الفكر السياسي الشيعي شرعية السلطة إلى الله، وأوجب عليه تعيين الإمام، فإن بقية فرق الأمّة أعادت السلطة إلى الأمّة ذاتها. وقد تأسست شرعية الخلافة عند أبي بكر وعمر على الإجماع، وتعزّزت بمشروعية الممارسة، وبلغت شرعية الإجماع ذروتها في بيعة عثمان، غير أنّ خلافًا واسعًا نشأ حول مشروعية بعض ممارساته أو ممارسات أعوانه للسلطة في نهاية عهده، وبعد استشهاده انقسم الاجتماع السياسي الإسلامي وغابت شرعية الإجماع. وأصل شرعية الإجماع هو أصلٌ سابقٌ لأصل مشروعية ممارسة السلطة.
من الفتنة إلى الاعتزال: قراءة أناركية لما بعد استشهاد عثمان
شكّل اغتيال الخليفة عثمان بن عفّان نقطةً مفصليّة في التاريخ السياسي الإسلامي، حيث انهار لأول مرّة نموذج شرعية الحكم القائم على إجماع الصحابة، وانفتح المجال على انقسامات حادّة أفرزت فتنًا عسكرية وأزمات شرعية ما تزال تداعياتها ماثلة إلى اليوم.
في هذا السياق المضطرب، برز موقف فريد من نوعه، تمثّل في اعتزال طيف واسع من الصحابة القتال بين الفرقاء، ورفضهم الانخراط في الصراع المسلّح بين علي ومعاوية، أو بين علي والزبير وطلحة.
لم يكن هذا الاعتزال مجرّد حياد، بل كان موقفًا أخلاقيًّا واعيًا، يتضمّن رفضًا ضمنيًا لمشروعية الاحتكام إلى السيف، في ظلّ غياب شرعية جامعة، وغياب وضوح الراية، وانقسام الأمّة بين أطراف متنازعة. ويُلاحَظ أنّ هذا الموقف ظلّ مظلومًا في التحليل الفقهي والتأريخ السياسي، رغم أنّه يمثّل إحدى أكثر اللحظات الفكرية نضجًا في التاريخ الإسلامي المبكّر.

الصحابة المعتزلون للفتنة: أقلية مهمّشة أم أغلبية مغيّبة؟
يستند من يقلّل من عدد المعتزلين إلى روايات شيعية غير محقّقة، أو مقولة لابن حجر العسقلاني لا تستند إلى دليل علمي، وفي المقابل روى عبد الرزّاق الصنعاني عن مَعْمَر بن راشد بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنّه قال: لما حدثت الفتنة كان عدد الصحابة عشرة آلاف، لم يُشارك منهم أربعون رجلًا بل لم يبلغوا ثلاثين (1). ويصف ابن تيمية هذا السند بأنّه أصحّ الأسانيد، وروى الشعبي بسند صحيح أنّه قال: «لم يشهد الجمل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير علي، وعمّار، وطلحة، والزبير، فإن جاؤوا بخامس فأنا كذّاب» (2). ويُحتمل أن يزيد العدد قليلًا عن تحديد الشعبي لعدم إمكانية إحاطته بجميع المشاركين. هذه الروايات تشير إلى أنّ الاعتزال السياسي لم يكن حالة فردية أو أقلية منزوعة التأثير، بل أقرب إلى موقف جمعي واسع، يتضمّن رفضًا لشرعية الاحتراب، ويشكك في مشروعية العنف السلطوي في غياب إجماع الأمّة.
ولقد كان السبب الرئيس لهذا الاعتزال أنّ الصراع لم يكن بين جماعة تمثّل أغلبية الأمّة وفئة باغية صغيرة، بل بين فريقين من الصحابة وجمهور واسع من المسلمين، كما ورد ذلك في شهادة أحد المعتزلين: «لما كان قتال علي ومعاوية كنت رجلًا شابًّا، فتهيّأت ولبست سلاحي ثم أتيت القوم فإذا صفّان لا يُرى طرفاهما، فتلوت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها﴾، فرجعت وتركتهم» (3).
دلالات الموقف الاعتزالي: مقاومة سلمية لسلطة فاقدة للشرعية
أكّدنا في بداية هذا المقال أنّ شرعية السلطة مقترنة بحقّها في ممارسة العنف المشروع، وتجريد السلطة من حقّها في ممارسة العنف المشروع يعني تجريدها من شرعيتها السياسية. وقتال البغاة على الحكم الشرعي قتال مشروع في الفقه الإسلامي، ولكنه يتحوّل إلى فتنة عند عدم اتضاح الراية في غياب الشرعية السياسية التي تمنحه المشروعية، ومن يتأمّل تبرير الصحابة للاعتزال السياسي يلاحظ استنادهم إلى أحاديث النهي عن المشاركة في الفتنة، وبعض هذه الأحاديث تشير صراحة إلى فتنة اقتتال طائفتين من المسلمين، وتفضيل اجتناب الفتنة وتأثيم القاتل والمقتول، كما أشادت أحاديث أخرى بتنازل الحسن لمعاوية ومساهمته في الصلح بين المسلمين وإعادة شمل الاجتماع السياسي للمسلمين، وأشارت بعض الروايات إلى ندم بعض الصحابة الذين شاركوا عليًّا في القتال، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن شقيق بن سلمة حين سُئل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، وبئست صفين (4).
ويمكن أن نخلص من تحليل إجمالي لمواقف الصحابة المعتزلين للقتال إلى ما يلي: 1- أن الاعتزال السياسي للفتنة لم يكن حيادًا سلبيًا أو انسحابًا من المسؤولية، بل موقفًا أخلاقيًا واعيًا برفض الانخراط في قتال داخلي لا يحظى بإجماع الأمّة، ولا يستند إلى شرعية موحّدة. 2- كان موقفًا مبدئيًا قائمًا على رفض مشروعية سفك الدماء عند عدم اتضاح راية المحقّ من المبطل. ولهذا رفض أحد المبشّرين بالجنة القتال حتى يأتوه بسيف يعرف المحقّ من المبطل. 3- كان تأكيدًا على أنّ اللا رئاسة خير من رئاسة تسلطية تفرض نفسها بقوّة الإكراه وسفك الدماء. 4- كان تأسيسًا لـ «فقه المقاومة السلمية» للسلطة حين تفقد شرعية الإجماع الشعبي، وتأكيدًا على أنّ الشرعية السياسية لا تتأسس بمجرد الفضل والصلاحية والأسبقية في الإسلام بدون عقد اجتماعي.
الأناركية الإسلامية والشرعية السياسية: إعادة الاعتبار لإرادة الأمّة
كانت مدرسة الأناركية الإسلامية واضحة ومنسجمة مع مبادئها في تفسير واقع الانقسام السياسي في مجتمع المسلمين بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، فقد أكّد الإمام أبو بكر الأصم أنّ غياب الإجماع على اختيار علي رضي الله عنه يُسقط ولايته السياسية على جميع المسلمين، وإن صحّت ولايته على أهل العراق ومن اختاروه واليًا عليهم.
فقد كان الأصم ممن يرى شرعية تعدّد السلطات السياسية، وبهذا الطرح، رفض الأصم الإقرار بشرعية الإمامة العامة لعلي رضي الله عنه لعدم اجتماع الأمّة عليه، واعتبر أنّ إمامة معاوية اكتسبت شرعيتها من الإجماع اللاحق، لا من النصّ أو القوّة.
يقول: الأصم كان أبو بكر إمامًا ثم عمر ثم عثمان، وأن عليًّا لم يكن إمامًا لأنّه لم يُجتمع عليه، وأن معاوية كان إمامًا بعد علي لأن المسلمين اجتمعوا على إمامته في ذلك الوقت (5). ورفض الأصم الاستناد في إثبات الشرعية إلى أحاديث الآحاد، مثل حديث «الخلافة بعدي ثلاثون عامًا» (6).
وقد تناقض الكثير من أهل السنّة والمعتزلة الذين دافعوا عن أصل الشورى والاختيار ثم أقرّوا بشرعية الإمامة العامة لعلي بن أبي طالب بموجب النصوص الدالة على أفضليته، أو بناءً على حديث آحاد مشكوك في صحّته يحدّد سنوات الخلافة الراشدة، مع إقرار معظمهم بعدم حصول الإجماع وحصول الانقسام والفتنة والقتال والاعتزال. فالشرعية السياسية لا تتحقّق بالفضل والعدل والسابقة ولا بمجرّد الاعتقاد بالأحقية.
وكان الأصم صريحًا في التأكيد على أصل الإجماع للشرعية السياسية في أكثر من سياق، وقد أجاب مَن سأله عن رأيه في تحكيم علي بن أبي طالب في صفين بقوله: «إن كان تحكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ، وإن كان ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب».
وواضح من كلام الأصم أنّ صوابية التحكيم مرتبطة بإعادة الأمر إلى الناس الذين هم أصحاب المصلحة ليختاروا من يُمثّلهم. وقال الأصم في قتال علي وطلحة والزبير ومعاوية: «إن كان قاتلهم ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا على إمام فقتاله لهم على هذا الوجه صواب». وقال عن معاوية: «إن كان معاوية قاتل عليًّا ليحوز الأمر إلى نفسه فهو ظالم، وإن كان قاتل ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا على إمام فقتاله على هذا الوجه صواب» (7).
ويُعدّ هذا التأكيد على ربط الشرعية السياسية بالشرعية التعاقدية النابعة من إرادة جماعية، أحد أبرز تجليات الموقف الأناركي الإسلامي الذي يقدّم تصورًا مغايرًا لمركزيّة السلطة، وموقفًا ثابتًا متماسكًا من مصدر الشرعية، لا يعاني من الاضطراب الذي وقع فيه الآخرون.
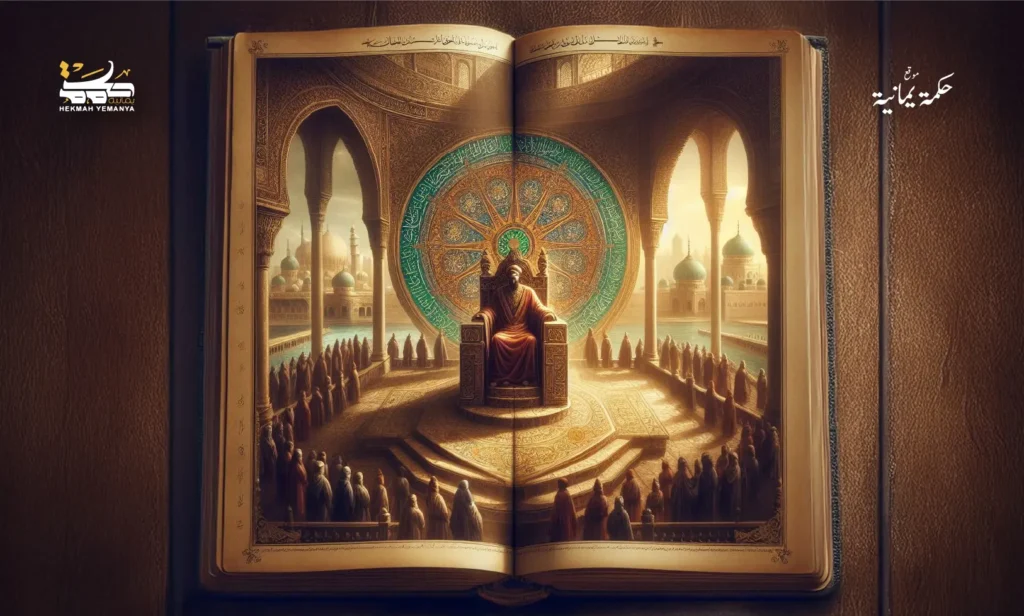
الأغلبية أم الإجماع؟ نحو فهم أناركي لمصدر الشرعية
ميّز أعلام أهل السنّة كابن تيمية والغزالي بين «بيعة الاختيار» التي يقوم بها أهل الحلّ والعقد بترشيح أحد الأئمة، و«بيعة الانعقاد» التي لا يكتمل بها الحكم إلا بموافقة الأغلبية الجماهيرية، و«بيعة الانقياد» الثالثة التي يتمّ إكراه الأقلية عليها. ووفقًا للغزالي وابن تيمية، فإنّ هذه الأغلبية الجماهيرية شرط أساسي لاكتمال شرعية الرئاسة.
فهذا الإمام أبو حامد الغزالي يرى أنّ الأغلبية الجماهيرية كافية، كما في قوله: «ولو لم يبايعه – يقصد أبا بكر – غير عمر، وبقي كافة الخلق مخالفين، أو انقسموا انقسامًا متكافئًا، لا يتميز فيه غالب عن مغلوب، لما انعقدت الإمامة» (8). ويُستفاد من كلام الغزالي أنّ تمييز الأغلبية العددية يكفي لانعقاد الرئاسة، لكن الأصم لا يرى هذا التمييز كافيًا.
فقد ذهب إلى أبعد من ذلك في رفضه الاكتفاء بالأغلبية العددية، واشترط أن تصل الأغلبية إلى درجة الإجماع لانعقاد الرئاسة، مستبعدًا تأثير القلّة غير المعتبرة على هذا الإجماع، وبهذا الاستبعاد لا يُعد اشتراط الإجماع مثاليًا ولا تأسيسًا للفوضى.
هل كانت أناركية الأصم فوضوية؟ تصحيح للجويني وتفنيد للاتهامش
أشرنا في الحلقة الأولى إلى أنّ تتبّع مجمل مواقف الأصم يكشف الخطأ الذي وقع فيه الإمام الجويني في التشنيع على الأصم واتهامه بالفوضوية. فالأصم لم يكن يدعو إلى الفوضى، بل كان ملتزمًا بمنهجٍ أخلاقيّ متسق مع ضميره العلمي، ومبادئه الفكرية الرافضة للعنف السلطوي غير المشروع.
ومن أدلّة عدم فوضوية الأصم مخالفته للمعتزلة في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين أكّد على عدم شرعية التغيير باليد في وجود دولة الإجماع، وتأكيده على حقّ السلطة التي تحصل على شرعية الإجماع في قمع بغي التمرّد.
إنصاف ابن خلدون للأناركية: تحليل أخلاقي لتجربة رافضي التسلّط
ومع اختلاف ابن خلدون مع الأصم والمدرسة الأناركية في تيار أهل السنّة والخوارج والمعتزلة؛ إلا أنّه كان أكثر إنصافًا في تبريره لمواقف الأناركيين حين قال في مقدمته: «والذي حملهم على هذا المذهب إنّما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلّب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذمّ ذلك والنعي على أهله ومرغّبة في رفضه» (9).
الواقعية الأخلاقية في فكر الأصم: لا دولة بلا ضرورة، ولا سلطة بلا تعاقد
نود هنا أن نؤكد أنّ الأصم لم يكن مثاليًا في أناركيته، وأنّ مقولته الشهيرة: «لو تناصف الناس لما احتاجوا إلى الإمام» لا تعني أنّه لا يؤمن بضرورة السلطة، ولكن يريد التأكيد على أنّ تسلّطية الدولة شرّ لا بدّ منه، وليست فضيلة أو غاية، بل وسيلة، والدولة ليست نهاية التاريخ ولا قدرًا محتومًا.
ومن يتأمّل مجمل أفكار الأصم يدرك أنّه كان أبعد المتكلّمين عن النزعة المثالية التي ظهرت في مدارس الخوارج والاعتزال. فقد خالف الأصم المعتزلة في تجويزه لإمامة المفضول في وجود الفاضل بحصول المفضول على الإجماع الشعبي، وخالف المعتزلة في تأكيده على إيمان عصاة المسلمين.
وأما رؤيته الأناركية التي يبدو من ظاهرها الدعوة إلى مجتمع مثالي، فعند التأمل العميق نجد أنّ هذه الأقوال ليست دعوة للمثالية في حقيقتها كما فهم ذلك القاضي عبد الجبار وغيره، فقد أراد التقليل من القيمة المركزية لفكرة الإمامة؛ وتجريدها من قداسة الغائية الدينية، والتأكيد على مدنية الاجتماع السياسي في الإسلام.
فهذا القاضي عبد الجبار يرى أنّ قول الأصم يفضي إلى القول بوجوب الإمامة، حيث جاء في المغني: «والمعلوم من حال الناس خلاف ذلك – أي القدرة على التناصف –، فإذن عُلم من قوله – أي الأصم – أن إقامة الإمام واجب» (10).
ويتفق ابن أبي الحديد مع رأي القاضي عبد الجبار في توجيه كلام الأصم: «إنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمّة؛ لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم، فقد قال بوجوب الرياسة على كلّ حال» (11). مع عدم تسليمنا بهذا الإطلاق في كلام القاضي وابن أبي الحديد.
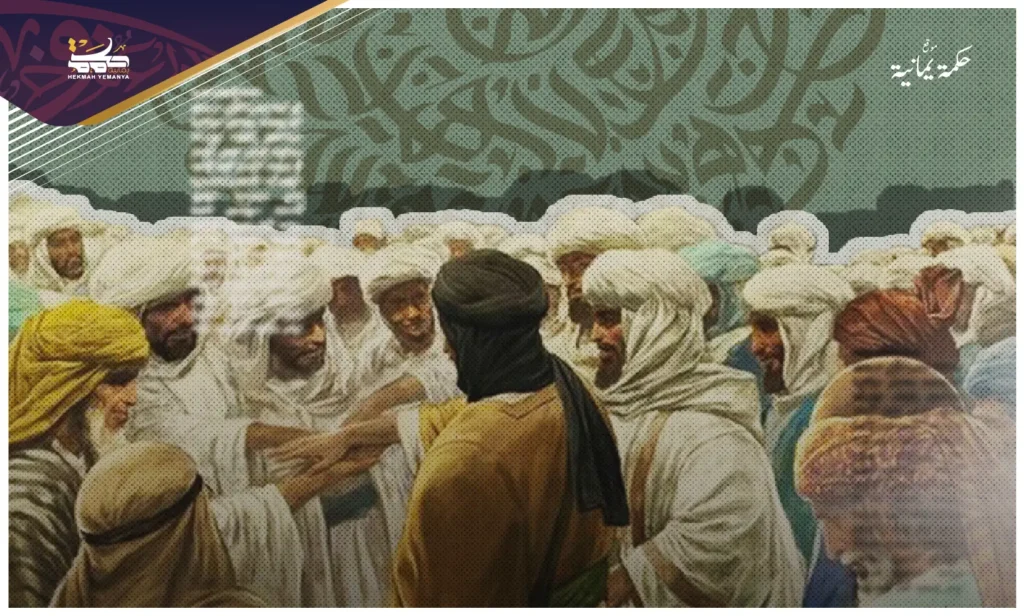
الأناركية الإسلامية في الحاضر: نحو إعادة تشكيل الاجتماع السياسي
في ظل تفكّك الدولة، وتعثّر مشاريع الانتقال السياسي، وغياب شرعية السلطة في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي، تُطرح «الأناركية الإسلامية» لا كحلم طوباوي، بل كرؤية أخلاقية وعملية بديلة، تُعيد تعريف العلاقة بين المجتمع والدولة، وترفع منسوب المسؤولية المدنية، وتقلّل من مركزية السلطة.
ويمكن الاستفادة منها في ضوء تعريفنا لها وما جاء في هذا المقال والمقال السابق من خلال المحاور الآتية:
1. تفعيل دور المجتمع دون انتظار السلطة
تؤكّد الأناركية الإسلامية أنّ غياب الدولة لا يعني غياب الواجبات الجماعية، بل يُحتّم على المجتمع المدني أن يتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، خاصة في إقامة العدل، وحماية الحقوق، ومقاومة الظلم.
فالأمّة – من هذا المنظور – هي التي تتحمّل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينبغي لها أن تعطل وظائفها بانتظار الإمام الغائب، أو القائد المخلّص، أو عودة الدولة. وقد عبّر أبو بكر الأصم عن ذلك بوضوح حين قال: «إذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطؤوا، ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة لكثرتهم، جاز لهم أن يقيموا الأحكام.»
2. بناء الوعي بالمسؤولية الذاتية والتحرر من الاتكالية
تسعى الأناركية الإسلامية إلى زحزحة ثقافة الاعتماد على السلطة، وتحفيز روح المسؤولية داخل الفرد والمجتمع. وهي تؤمن أنّ كفاءة المجتمع وعدالته وتكافله يمكن أن تُعوِّض غياب السلطة الرسمية. ويعبّر الفكر الأناركي الإسلامي عن هذه الرؤية بقوله: «فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى، واشتغل كل واحد من المكلّفين بواجبه وتكليفه، استغنوا عن الإمام ومتابعته، فإنّ كل واحد من المجتهدين مثل صاحبه في الدين والإسلام والعلم والاجتهاد، والناس كأسنان المشط.»
3. تعزيز بناء الأمّة عند تعذّر بناء الدولة
في حالات الانهيار السياسي، يصبح رهان الأمّة على إعادة بناء الدولة مرتهنًا بالظروف، وقد يطول دون أفق. هنا تطرح الأناركية الإسلامية خيارًا استراتيجيًا يتمثل في إعادة بناء المجتمع كجسد جماعي متماسك، يدير شؤونه عبر التعاون والمؤسسات المدنية، ويؤسّس لنموذج من الحكم الذاتي غير التسلّطي، يُهيئ الأرضية لشرعية سياسية قائمة على التوافق لاحقًا.
4. إعادة الاعتبار للإنسان والمساواة في الكرامة والحق
ترتكز الأناركية الإسلامية على مبدأ المساواة التامّة بين الناس في الكرامة والكفاءة والاجتهاد، وتنبذ كل أشكال التمييز القائم على النسب أو الطائفة أو الطبقة أو القرابة من السلطة.
وفي هذا السياق، تتجلّى رؤية مساواتية واضحة في قولهم: «فإن كل واحد من المجتهدين مثل صاحبه في الدين والإسلام والعلم والاجتهاد، والناس كأسنان المشط.» وهو ما يفضي إلى مقاومة التشريعات السلطوية الجائرة، ورفض أي ممارسات تنتهك كرامة الإنسان باسم المصلحة أو النص أو الطاعة.
5. التحرر من قداسة الحاكم وبناء شرعية تعاقدية
أحد أعمدة هذا التصوّر اللاتسلّطي هو نزع القداسة عن الحاكم، ونقد أساطير التفويض الإلهي، أو العصمة السياسية أو الدينية، التي تبرّر الاستبداد أو الحكم الوراثي.
فالأناركية الإسلامية تشدّد على أنّ الشرعية لا تُبنى على النسب أو الغلبة، بل على التوافق الشعبي الحر، والتعاقد الاجتماعي القابل للمساءلة. وهي بهذا تضع حدًّا نهائيًا لكل سلطة تدّعي المشروعية عبر إسناد غيبي يستند إلى تأويلات باطنية، أو إسناد خارجي، أو دعاوى تفويض وراثي.
ونخلص ممّا سبق إلى أنّ الأناركية الإسلامية، بمضمونها اللاسلطوي، وأخلاقياتها التعاقدية، تفتح أفقًا جديدًا في التفكير السياسي الإسلامي، يُعيد الاعتبار للأمّة، ويجعل الكرامة والمشاركة والمساءلة أساسًا للشرعية، لا النسب أو النص أو القوّة. وفي زمن التحوّلات الكبرى وانهيار اليقينيات السلطوية، تصبح هذه الرؤية رافعة فكرية لإعادة تشكيل الاجتماع السياسي من القاعدة إلى القمّة، لا من فوق إلى تحت.
الهوامش:
- الجامع، معمّر بن راشد، رواية عبد الرزّاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الأعظمي، المجلس العلمي – الهند، توزيع المكتب الإسلامي – بيروت، ط2، 1983، نسخة المكتبة الشاملة.
- المصنّف – ابن أبي شيبة الكوفي – ج 8 – الصفحة 710.
- ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج18، ص182؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج4، ص209؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ج2، ص219.
- صحيح البخاري: 7308.
- أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق ريتر، ص456.
- الحديث من رواية سعيد بن جهمان عن سفينة، ضعّفه ابن خلدون، وقال البخاري عن سعيد بأنّ في حديثه عجائب، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه ولا يُحتجّ به، وقال ابن عدي: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره.
- أبو الحسن الأشعري، مرجع سابق.
- أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الدار القومية، القاهرة، 1964، ص176–177.
- ابن خلدون، المقدمة، ص240، دار الفكر، بيروت، ط1، 1981.
- المغني، ج20، قسم 1، ص48.
- شرح نهج البلاغة، 2: 308.