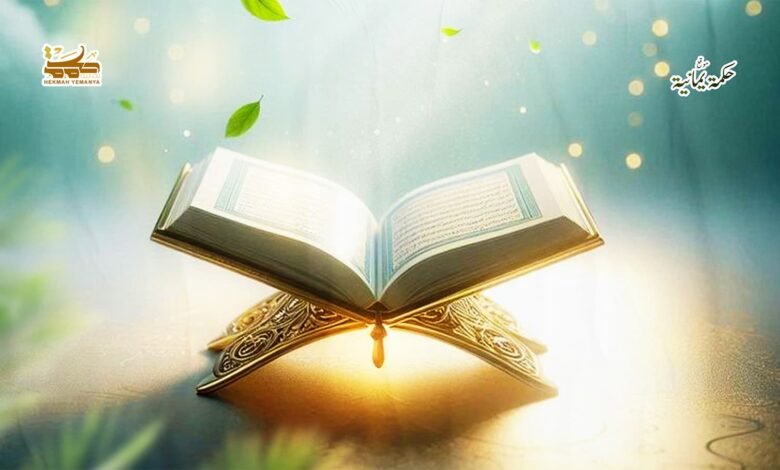
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وبعد:
(1) أسئلة للقائلين بـ”تفويض المعنى” في آيات وأحاديث الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى
فإنَّ مِن أجلِّ ما ينتفع العبد به سؤال نفسه، والتباحث معها تأمُّلًا وتفكُّرًا وتدبُّرًا واعتبارًا وتذكيرًا، فإنَّ الإنسان ناصح لنفسه متى خلى بها بعيدًا عن الناس، وقصد الحقَّ في ذاته، دون تأثير خارجي، مِن ترغيب أو ترهيب، أو طلب رضا أو تجنُّب سخط، أو مخافة خطأ أو رجاء شهرة. خصوصًا في تلك المسائل المهمَّة التي تتعلَّق بأصول الإيمان التي ينبني إيمانه عليها. ومِن شأن ذلك أن يُثمر عملًا صالحًا في الوعي والشعور والوجدان (القلب)، قبل الجوارح والحركة والقول والفعل.
ومِن بين أهمِّ تلك القضايا مسألة معرفة الله تعالى سبحانه، بأسمائه وصفاته، وأفعاله وأقواله، وشرعه وقدره، كما أخبر عن نفسه، وأخبر عنه رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ أوَّل أركان الإيمان “الإيمان بالله”، ولا يتمُّ “الإيمان بالله” ولا يتميَّز عن إيمان المشركين إلَّا بمعرفة واضحة دقيقة شاملة كاملة، بقدر ما أخبر الله تعالى عن نفسه، وأخبر عنه رسوله الكريم. لهذا امتلأ القرآن الكريم بدرجة رئيسة بألفاظ وعبارات وأخبار عن ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأقداره وشرعه، بحيث لا تخل مِن ذلك سورة بل آية. فالذات الحاضرة موضوعًا في جميع القرآن الكريم دون استثناء هي الذات الإلهية، حتَّى في تناول القرآن الكريم لأمور الكون والعباد.
هذه الأخبار، كما بقيَّة الأخبار المتعلِّقة بأركان الإيمان الأخرى (الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر)، جاءت بلغة واضحة بيِّنة بليغة، بلسان عربي مبين، باعتبارها منظومة شاملة متكاملة غير منفكَّة في دلالاتها عن بعضها البعض إلا بالقدر الذي يميِّز مقام الخالق عن مقام المخلوق، لأنَّ ما طرحته الأديان المحرَّفة والملل الوثنية المصطنعة عن الذات الإلهية مِن أخبار ومعارف ومعلومات كثير جدًّا، يستلزم بيان الثابت مِنها مِن غير الثابت، والمعنى الصحيح الذي يجب قبوله، والمعنى السقيم الذي يجب رفضه.
وخير مَن يخبر عن الله تعالى هو ذاته سبحانه، وخير محلٍّ للإخبار الموثَّق الثابت الصحيح هو كتبه المنزلة، والقرآن الكريم هو آخرها والمهيمن عليها، المحفوظ مِن أيِّ تحريف وتبديل وتغيير. وخير مَن يخبر عن الله تعالى كذلك رسله وأنبياءه، لأنَّهم متَّصلين بالوحي متلقِّين عن الروح الأمين، وهم خير مَن يعرف المعاني والدلالات التي يأتي بها الوحي، فالأنبياء والرسل أكمل الناس عقلًا وأعرفهم باللسان الذي ينزل الله به كتابه إلى عباده، ثمَّ هم الآمن على أداء الرسالة لفظًا ومعنى.
وعلى هذا، يمكن التعرُّف على الله تعالى، في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأقداره وشرعه، مِن خلال الوحيين (الكتاب والسنَّة)، ولا ثالث لهذين المصدرين. فمَن قال: (إنَّ الله أعرف المعارف) كان ولا بدَّ أن يثبت طريقًا واضحة بيِّنة للمعرفة بالله وعنه سبحانه. فمَن عطَّل المعاني، أو نفاها، أو أوَّلها على غير عرف اللغة ومعهود المتكلِّم، أو ادَّعى عدم وضوحها وأنَّها مِن المشكل أو المتشابه الذي يوكل أمره إلى الله، أنَّى له حصول المعرفة بالله سبحانه؟! إذ المعرفة نتاج المعاني والمعاني تتلقَّى بالكلام والاتِّصال، ولا تنشأ في الوعي أو تخلق في الخيال.
ثمَّ، إنَّ العقلاء مجمعون على أنَّ الكلام يأتي لمعنى مقصود به المخاطب لا المتكلِّم، وإلَّا فلا معنى لأن يتكلَّم المتكلِّم مع المخاطب بألفاظ لا يفهم معناها، بل إنَّ اللغة بالأساس جعلت وعاء للمعاني. ولا يليق أن يشار إلى كلام الله تعالى بأنَّه غير بيِّن، أو غير واضح، أو لا يُفهم له معنى، أو لا معنى له، أو أنَّه مشكل على جميع المخاطبين وفتنة لهم جميعًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
وإنَّ أخطر ما بدأ يتسلَّل في الساحة العلمية بين طلَّاب العلم، وأبناء الدعوة، مذهب التفويض الذي نشأ بعد بروز مدارس التعطيل والتمثيل، والتكييف والتحريف، كيما يخرج مِن دوَّامة الردِّ على هذه المناهج الضالَّة بحلٍّ “أنسب”! فوقع في خطأ جسيم لا يقلُّ سوءًا عن تلك المناهج الضالَّة، ألا وهو منهج “التفويض”. فنظرًا للجدل الواسع والعريض الذي نشأ في الأمَّة منذ القرن الثاني الهجري، وأهدر الطاقات وعطَّل العقول عن ميدانها الحقِّ، وأوغل الصدور ومزَّق الكلمة، رأى عدد مِن العلماء أنَّ المذهب الأسلم تفويض المعاني في آيات وأحاديث الأسماء والصفات لله تعالى، خروجًا مِن الخلاف، وورعًا مع الذات الإلهية، ورعاية لمقامها. غير أنَّه ورغم شرف المقصد ونبل المراد إلَّا أنَّ ما وقع فيه عدد مِن علماء الإسلام الأجلَّاء، كمخرج مِن الأزمة، لم يكن موافقًا ومتَّسقًا مع النهج القرآني والرسالي، إذ أنَّ الرسالات والكتب السماوية لم تأت بمبدأ الانسحاب في شأن الإيمان بالله والتعريف به حقَّ المعرفة، بل خاضت جدلًا واسعًا وعميقًا ودقيقًا في الردِّ على كلِّ الدعاوى والأقاويل والافتراءات والأكاذيب، رافضة المساومة عليها أو التنازل فيها أو الانسحاب مِن ميدانها، لأنَّ الإيمان بالله مَن أعظم القضايا المؤثِّرة في الكيان البشري، فرادى ومجتمعين، ومتَّى خفت ضياؤها وطمست معالمها أصاب البشر ضلال عظيم وشقاء كبير.
وهذا المقال لا يستهدف الدراسة التاريخية، ولا التقعيد العقدي، بقدر ما يستهدف إثارة العقل للوقوف على ما ينبغي أن يُسأل عنه، ويُبحث فيه، ويُتحاور حوله؛ لهذا اعتمدت على تقديم الأسئلة التالية في هذا الشأن:
هل تثبت الآيات والأحاديث، التي هي محلُّ النزاع مع المخالفين، معنى في ذاتها أم أنَّها لا تحمل معنى في ذاتها؟ فإذا كانت تحمل معنى في ذاتها، وقد وردت بكلام العرب ولسانهم الفصيح البيِّن البليغ، فهل هو جار على معهود العرب ومعانيهم أم لا؟ فإذا كان المعنى جار على معهود العرب ومعانيهم فما المانع مِن فهمه؟ وإن لم يكن جار على معهود العرب ومعانيهم فكيف يكون أعربي وأعجمي؟! وإن كانت لا تحمل معنى في ذاتها فلأيِّ قصد أُقحِمت في القرآن الكريم، وهو خطاب تعليم ومعرفة وبيان أتى للفائدة؟ وقد قيل في تعريف الكلام بأنَّه (لفظ جاء لمعنى)، والقرآن كلام؟
ثمَّ؛ هل هذه القاعدة تشمل كلَّ ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى مِن عبارات وجمل، أي ما يتعلَّق بالإخبار عن نفسه وعن صفاته وعن أقواله وأفعاله، أم هي لبعض دون بعض؟ فإن كانت لكلِّ ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى فكيف نعرف الله؟ وكيف نقول بأنَّه (أعرف المعارف)؟! وإذا لم يُعرِّفنا هو عن نفسه، ولم نعرف عنه مِن كلامه، فمِن أيِّ طريق عرفناه وعرفنا أسماءه وصفاته وخصائصه وأفعاله وأقواله؟! وإن كانت لبعض ما يتعلَّق بحقِّ الله تعالى لا بالكلِّ فمَن يُقرِّر هذا البعض؟! ولماذا هذا التفريق؟! وما هي القاعدة التي يُعتمد عليها في هذا التفريق؟!
وإذا كان الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب للتعريف بذاته، حيث تصوَّر الناس عنه تصوُّرات شتَّى، ونسبوا إليه مِن الصفات والأسماء والأفعال والأقوال ما يجوز وما لا يجوز، فكيف يأت التعريف به منقوصًا أو بألفاظ لا تُفهم معانيها على حقيقتها، والمراد ردُّ الناس للحقيقة والصواب؟ وكيف نردُّ على المخالفين مِن المشركين والكافرين والقائلين في حقِّه بغير علم بآيات وأحاديث لا ندرك معناها؟!
وهل يصحُّ أن يُقال إنَّ الله تعالى خاطب عباده بعبارات وجمل لا يعرفون لها معنى في أهمِّ قضايا الدين، ألا وهي الإيمان به؟ وفي أعظم المعارف ألا وهي المعرفة به؟! وهل يصحُّ أن يقال إنَّ الله تكلَّم بكلام بلَّغه لعباده لا تصلح لهم به فائدة لأنَّ الكلام بلا معنى مفهوم لهم لا فائدة ترتجى مِنه؟!
ثمَّ، هل عدم معرفة المعنى علَّة في المتكلِّم نفسه، أم علَّة في قصده ومراده، أم علَّة في كلامه ورسالته، أم علَّة في المبلِّغ عنه، أم علَّة في المتلقِّي الأوَّل، أم علَّة في العباد عمومًا، أم علَّة في لغة الكلام والتخاطب؟!
وهل تلقَّى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- كلامًا لم يفهمه؟! وبلغَّه دون فهم له بدعوى التفويض؟!
وهل تلقَّى الصحابة -رضي الله عنهم، وهم العرب الأقحاح، كلام الله دون أن يتبادر لديهم سؤال عن المعنى الذي يوصف بالمتشابه والمشكل؟!
وهل تقبَّل الكفَّار وأهل الكتاب والمنافقون إيراد كلام في القرآن الكريم لا يُدرك معناه؟! إذن لعابوا القرآن وسخروا مِن النبي وأصحابه؟!
ثمَّ، ماذا يعني تفويض المعنى لله تعالى؟ وهل ورد هذا التفويض في كلام الله تعالى في القرآن الكريم والسنَّة النبوية؟! وهل نُقِل هذا عن الأنبياء والرسل؟! وهل كان متعارفًا عليه عند الصحابة -رضي الله عنهم؟!
وماذا يُقصد بتفويض المعنى لله تعالى: هل يُقصد به إغلاق السؤال عن المعنى؟ أم إغلاق البحث عن المعنى؟ أم إغلاق الفهم عن المعنى؟ أم إغلاق الخيال عن المعنى؟
التفويض يعني ردُّ أمر لك إلى غيرك، وفي القرآن الكريم: ((وأفوِّض أمري إلى الله)) أي أكل أمري إلى الله، فما هو المفوَّض: المعنى الذي أراده الله؟ أم المعنى في ذات اللغة؟ أم المعنى الذي يفهمه العبد ذاته؟! فالقول له قائل أراد إيصال معنى مِن خلاله، وله لغة صيغ بمقتضاها ليحمل المعنى الذي أراده القائل، وله متلقٍ يفهم المعنى مِن خلال اللغة وسياق الكلام ومعهود القائل وغير ذلك، فأيُّ هذه الأمور التي يفوِّضها المفوِّض إلى الله تعالى؟!
ثمَّ، العبد مأمور بفهم المعنى، ومكلَّف بمقتضياته ولوازمه ومضامينه، فالقول بعدم فهم المعنى تعطيل لمقتضياته ولوازمه ومضامينه؟! فأيُّ مقتضى ولازم ومضمون بعد ذلك يصحُّ وقد أشكل المعنى بكلِّه؟! والله تعالى منزَّه أن يقول كلامًا لا يدرك المخاطب معناه ومراده، ولا يمكنه فهمه وفقهه. ومنزَّه سبحانه أن يكون كلامه الذي أتى بلسان عربي مبين مخالفًا اللغة وقواعدها وأصولها ومعانيها التي وضعت لها، ومقتضياتها في أساليبها وأدائها، فيكون ذلك خلاف ما أخبر.
فبقي أن يقول المفوِّض: إنَّ الله تعالى قال كلامًا لمعنى أراده، وقاله بلغة العرب تبيانًا لعباده على أصول اللغة وقواعدها وأصولها ومعانيها التي وضعت لها ومقتضياتها في أساليبها وأدائها، غير أنَّي وجميع المكلَّفين لا نفهم هذا المعنى لهذا نردُّ فهمنا له إليه؟! ونفوِّض المعنى له؟!
فيكون السؤال: ما الفرق بين هذا القول وقول مَن قالوا لنبيِّهم: ((قَالُوا يَا شُعَيبُ مَا نَفقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ))، هود: 91. وما الفرق بين مَن يقول هذا القول وبين مَن قال الله عنهم: ((فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ القَومِ لَا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثًا))، النساء: 78. ثمَّ مَن مَنحهم الحقَّ أن ينطقوا نيابة عن غيرهم فيقولوا: إنَّ العباد لا يدركون المعنى مِن ألفاظ القرآن وعباراته فلأجل ذلك كان التفويض هو المنهج الحق؟! والأصل أن يقولوا: نحن اخترنا التفويض لأنَّ عقولنا لم تع المعنى المراد وهو مذهب ترجَّح لدينا ويسع الآخرين خلافه إذا أمكنهم أن يدركوا المعنى.
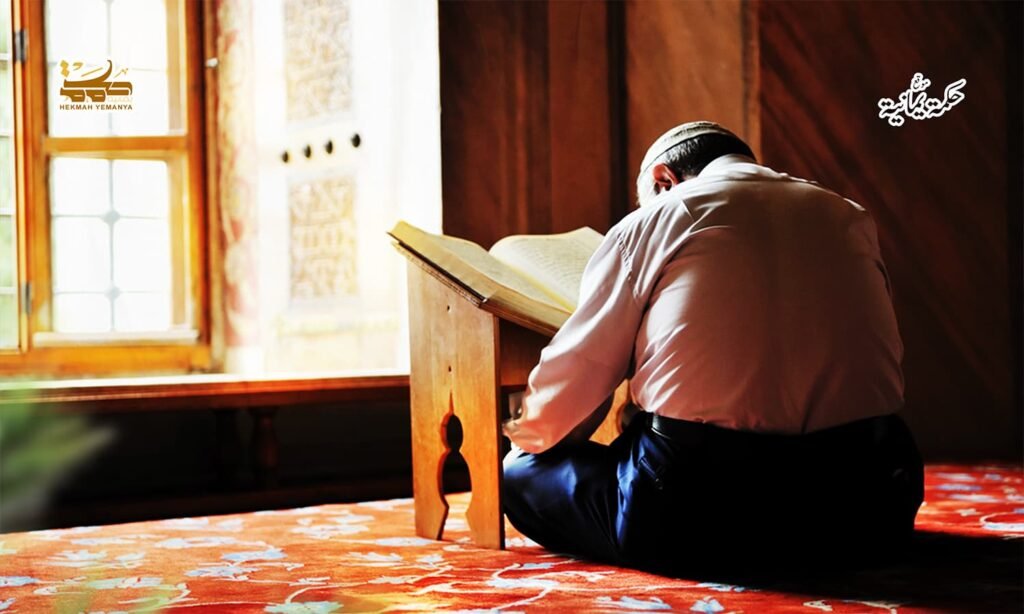
(2) لذَّة المعاني في الفهم الصحيح
إنَّ المعاني الجميلة والبليغة والحسنة لا تدرك إلَّا بالفهم الصحيح، فإذا أخطأ الفهم وضلَّ فقدت لدى المتلقِّي جمالها وبلاغتها وحسنها. لهذا فقد كان بلغاء العرب يعرفون مِن القرآن الكريم ما لا يعرفه سواهم، لأنَّهم كانوا يفهمونه فهمًا صحيحًا غاية في الإدراك والوعي. ولا عجب أن ألقت قريش في طريق الناس شبهة أنَّه محمَّدًا -صلَّى الله عليه وسلَّم- شاعر، فإنَّ أبلغ الناس قولًا، وأحكمهم وصفًا، وأجملهم سبكًا، الشعراء، فهم أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم بهذه التهمة كلامًا بشريًّا، للحطِّ مِن قدره مِن حيث لا يشعر المتلقِّي، كي يسحبوا عنه قيمة الرسالة الإلهية. فالشعر لدى العرب هو أسمى وأعلى طرق الخطاب والقول، ولا يتأتَّى إلَّا لأفصحهم وأبلغهم وأجودهم عقلًا وخيالًا.
والجاهل باللغة لا يتلذَّذ بالكلام الفصيح البليغ الباذخ، إلَّا كما يتلذَّذ الأعمى بمنظر الربيع والأصمِّ بألحان الغناء. وقد بُعِث النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بمكَّة، حيث تلتقي ألسن العرب، وتجتمع لهجاتهم، وتتبارى ثقافاتهم مِن الجنوب والشمال والشرق والغرب، في مناسبات التجارة والأسواق، ومناسبات الحجِّ والزيارة. ولم تترك قريش، ولا أهل الكتاب، ولا المنافقون، شيئًا يمكنهم أن يعيبوا به الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم، أو القرآن الكريم، أو دعوته عمومًا، إلَّا قالوه أو ألمحوا إليه، ولم يرد لا في القرآن الكريم، ولا في الأحاديث النبوية، أنَّهم استشكلوا عليه آية أو حديثًا في حقِّ الله سبحانه وتعالى، وأسمائه وصفاته، وأقواله وأفعاله، إلَّا في عدد محدود مِنها، أوردها القرآن الكريم وردَّ عليها، وفيما عدا ذلك، كانوا يسمعون القرآن الكريم يتحدَّث عن أسماء الله وصفاته، وأقواله وأفعاله، فلم يرموه بالتجسيد أو التمثيل أو التكييف. وإن جاز جهل مشركي العرب بذلك لعدم ورود كتاب سابق عليهم، فإنَّ اليهود والنصارى كانوا أحرص على هكذا اتِّهام لو وجدوه، ولاتَّخذوه مسبَّة يعيِّرونه به وهو الذي جلَّى أباطيل تجسيداتهم وتمثيلاتهم وتكييفاتهم، فقد جحدوا رسالته وكذَّبوا بنبوَّته، ومع ذلك لم يدَّعوا فيه ذلك، علمًا بأنَّهم سألوه وجادلوه فيما هو دون ذلك مِن قضايا.
وأنَّى لشخص يرتِّل القرآن الكريم، ويتغنَّى به، أن يخشع أو يحلِّق بروحه ووعيه وهو يدَّعي أنَّ العبارات والجمل التي يقرأها خالية مِن معانٍ بليغة بيِّنة واضحة له، ومِن ثمَّ فهو لا يفقهها. وقد رأيت في بعض بلاد الأعجم مِن المسلمين مَن يقرأ القرآن الكريم مجوَّدًا مرتَّلًا، وهو لا يعرف عن معانيه جميعًا شيئًا، فإذا مسَّه وجد أو رعشة أو بكى خاشعًا فلمجرَّد لحن التلاوة وترانيم الصوت والاعتقاد بقداسة ما يقرأ، دون علمه بمعاني ما يتلوه في لحظته تلك، فإذا سُئِل عن المعنى تمنَّى أن يكون عربيًّا ليعرف معاني ما يقرأه، فكيف لو علم أنَّ عربًا يقرؤون القرآن الكريم ويدَّعون أنَّ فيه مِن العبارات والجمل ما لا معنى بيِّن فيه، وإنَّما هي ألفاظ تكلَّم بها المولى ولم يبلِّغنا مراده مِنها على الحقيقة!
كيف لو ادَّعى شخص في فحول الشعراء بأنَّهم قالوا مِن الشعر ما لا يدرك معناه، فأيُّ فصاحة وبلاغة في ذلك؟! وأيُّ جمال فيما قالوه والعقل لا يدرك كنه مرادهم، مِن قريب أو بعيد، أو قليل أو كثير؟! وهل يمكن نسبة أئمَّة المذاهب وعلماء الأمَّة إلى التحدُّث بأقوال وكلام لا يدرك معناه؟! فأيُّ معرفة أو علم يحدث بذلك، وأيُّ فائدة ترتجى مِن كلام أو قول لا يدرك معناه؟!
إنَّ الفصاحة والبلاغة والبيان تتمايز بين قائل وقائل، ومتكلِّم وآخر، بقدر ما يسبك في ألفاظه وعباراته مِن المعاني المدركة والمضامين المفهومة، هكذا جرى عرف النقَّاد، نقَّاد الشعر والأدب والفلسفة والمنطق والفقه والقانون؛ وإلَّا عدُّوا الكلام حشوًا ولغوًا، لا فائدة مِن إيراده. فكيف بكلام الله تعالى الذي جاء للبيان والتبيين، والهداية والإرشاد، وإقامة البراهين والحجج، ومجادلة أهل الباطل والضلال، وإعجاز أهل اللغة واللسان؟!
ثمَّ مَن يجرؤ أن يخبر عن نفسه بكلام لا يعيه المخاطب، والمخاطب يسأله الإخبار عن نفسه والتعريف بها، فيقول له بعد ذلك الكلام المبهم.. ها قد أخبرتك وعرَّفتك؟! فإذا كان هذا لا يليق بمقام مَن هو دون الله تعالى فكيف بمَن أنطق الإنسان وعلَّمه الكلام والبيان: ((الرَّحمَٰنُ * عَلَّمَ القُرآنَ * خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ))[1]؟!
إنَّ في إدراك معنى الكلام لذَّة فوق لذَّة سماع أنغامه وسجعه وألحانه، خصوصًا عند ذوي العقول الواعية والأرواح السابحة الناشدة للعلم والمعرفة. وإذا كان المؤمن مأمور بحبِّ الله تعالى وطاعته والتعامل معه فكيف يحبُّ مَن يغلب جهله به معرفته به؟! وكيف يطيع مَن يجهل قدره لجهل أسمائه وصفاته؟! وكيف يتعامل مع مَن لا يفقه له قولًا ولا يثبت له فعلًا؟! هل يستوي هذا في حبِّه وطاعته وتعامله مع مَن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله مِن الأسماء والصفات والأقوال والأفعال بالقدر الذي يليق به سبحانه على أتمِّ الكمال والجلال والجمال؟!
في الصحيحين، أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان في سَفَرٍ، فجعَل النَّاسُ يجهرون بالتَّكبِير، فقال لهم: (أَيُّهَا النَّاسُ اربَعُوا علَى أَنفُسِكُم، إنَّكُم ليسَ تَدعُونَ أَصَمَّ ولَا غَائِبًا). فإذا لم يكن لهذا الحديث معنى، ولهذه العبارة مقتضيات ولوازم ومضامين، فأيُّ فائدة في مخاطبته لهم بها، ثمَّ أيُّ أثر يقع في نفوسهم وهم يتلقَّون هذا النصَّ على أحسن المعاني اللائقة بالله، دون تكييف ولا تحريف، ولا تمثيل ولا تعطيل؟!
وكم تهتزُّ نفس المؤمن عندما تقرع مسامعه آيات الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى وذاته وأفعاله، ويقشعر جلده، وتطمئنُّ روحه، وهو يتشرَّب معانيها، ويستشفُّ مضامينها، ويُعمل مقتضياتها ولوازمها، ويتدبَّر دلالاتها وإشاراتها؟! فيأخذه الوجد ويسوقه الحنين ويحلِّق به الشوق إلى ربِّه وباريه، إذ يحصل له مِن المعارف واللطائف ما تغيب عن الأصمِّ الأعمى، والجلمود البليد. وقد عبَّر بعضهم عمَّا يُصيبه وهو يتقلَّب بين المعارف والعلوم بقوله:
سَـــهَري لِتَنقيحِ العُـــلـــــومِ أَلَذُّ لي
مِن وَصلِ غانِيَةٍ وَطيبِ عِناقِ
وَصَريرُ أَقلامي عَلى صَفَحاتِها
أَحلى مِنَ الدَوكــــــاءِ وَالعُشَّــاقِ
وأَلَـــــذُّ مِــن نَقـــرِ الفَتـــــاةِ لِدَفِّــــها
نَقري لِأُلقي الرَملَ عَن أَوراقي
وَتَمــــايُــلي طَــــــرَبًا لِحَلِّ عَـــويصَــةٍ
في الدَرسِ أَشهى مِن مُدامَةِ ساقِ
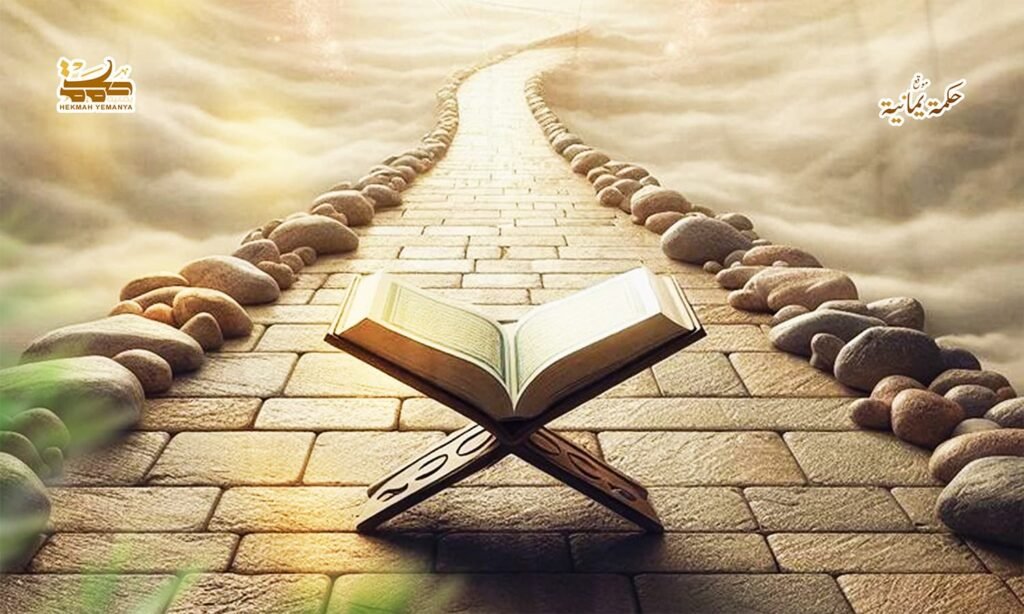
ومَن تمنَّع عن لذيذ المعاني فقد الصبابة والوجد، أو كاد، وإنَّما يظهر الجاهلون مِن التمايل والطرب على الألحان والأصوات، لهذا يغلب على كثير مِنهم الجرأة على الحرام، والبعد عن الواجبات، والإعراض عن المسئوليَّات العظام؛ أمَّا العارفون فيحملون مِن الأمانة والرسالة والمسئولية ما حمل الأنبياء، ويجدون ما وجدوا مِن تكذيب وجحود واضطهاد وإعراض.
كما أنَّ أعظم الثناء والمديح والظنِّ لا يكون إلَّا مع المعرفة الحقَّة والعلم الدقيق، فكيف يمدحُ الله تعالى بألفاظ لا معنى لها، أو بكلام أدنى مِن كلامه رتبة يُنظرُ إليه على أنَّه عوض عن كلامه سبحانه! وأحسن مِنه إدراكًا وفهمًا! لهذا لم يُثنِ ويمدح الله تعالى، ويظنُّ به ظنًّا حسنًا، أحد أعظم مِن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام، بما تلقَّوه عنه وعرفوه مِنه. قال -صلَّى الله عليه وسلَّم: (ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، و ابنُ عبدِك، و ابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا مِن خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا). فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: (بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها)[2]. ولهذا قال تعالى: ((سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الـمُرسَلِينَ * وَالحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ))[3]،
ومِن تمام القرآن الكريم وكماله أنَّ الله تعالى خاطب به أهل اللغة دون وسيط ولا ترجمان، فجعل مِنه جملًا وعبارات يفهمونها بسليقتهم وعادتهم وعرفهم، وجملًا وعبارات يحتاجون فيها لأهل فقه اللغة ليبيِّنوا لهم المراد والمعنى، وهذا في كلِّ كتب الله المنزلة. ونسبة الثاني إلى الأوَّل نسبة ضئيلة، وهي في الأمور الدقيقة والمشتبهة، أمَّا عموم كتبه، والقرآن في القمَّة مِنها، فجاءت بيانًا وتبيانًا للخلق، وخصوصًا في قضايا الإيمان والوجود والكون والحياة، وأركان الإسلام وشرائعه العظام، إذ لا يختصُّ بها أحد، كي لا يتصرَّف الأحبار والرهبان بها بمشتهى أنفسهم وأهوائهم. ومع ذلك، فما مِن أمَّة أنزل عليها الكتاب إلَّا ظهر مِن أحبارها ورهبانها مَن يدَّعي اختصاصه بفهم ما أنزل الله دون عرف اللغة وقواعدها. لهذا حذَّر الله تعالى مِن الأحبار والرهبان في أكثر مِن موطن؛ فقال تعالى: ((وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيرٌ ابنُ اللَّهِ وقَالَتِ النَّصَارَى المـَسِيحُ ابنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَولُهُم بِأَفوَاهِهِم يُضَاهِئُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالـمَسِيحَ ابنَ مَريَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبحَانَهُ عَمَّا يُشرِكُونَ * يُرِيدُونَ أَنْ يُطفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفوَاهِهِم وَيَأبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ودِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ الـمُشرِكُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحبَارِ وَالرُّهبَانِ لَيَأكُلُونَ أَموَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ))[4]. واتِّخاذ الأحبار والرهبان أربابًا هو مِن قبيل جعلهم وسائط بين الله وخلقه، كما جاء في آية أخرى: ((قُل يَا أَهلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُونَ))[5].
وحيث علم الإنسان الحقَّ وبان له السبيل، وتميَّز له الضلال مِن الهدى، والغيُّ مِن الرشد، لا ينبغي له بعد ذلك التقليد الأعمى، والإمساك بذيل الأحبار والرهبان، حيث قامت حجَّة الله تعالى عليه، وشهد عليها بنفسه.
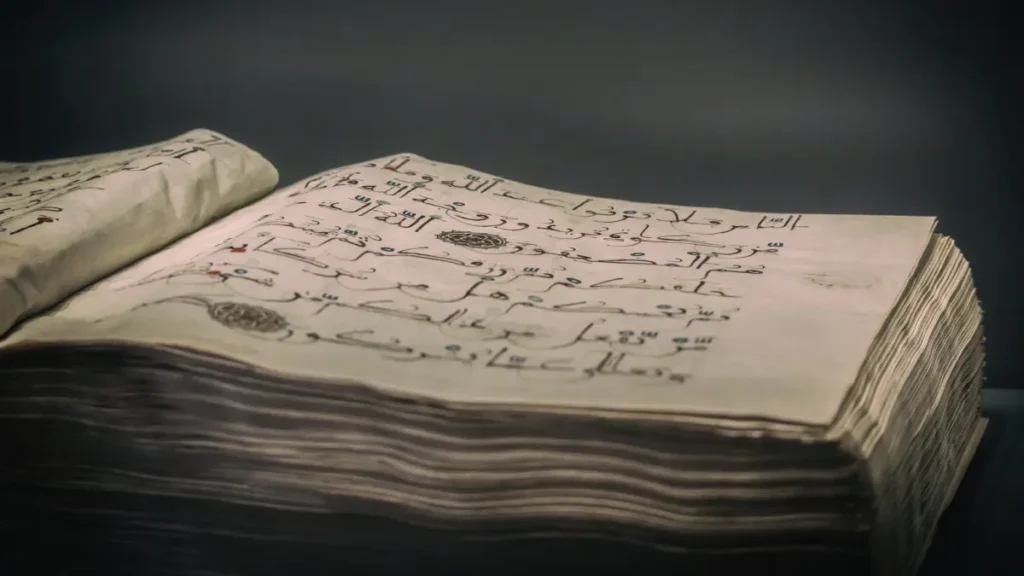
(3) تفويض الكيف وتفويض المعنى.. والحقيقة والمجاز
يخلط كثيرون بين تفويض الكيف وتفويض المعنى، وينسبون للسلف التفويض بإطلاق، والصحيح أنَّ سلف الأمَّة، مِن لدن الصحابة -رضي الله عنهم، ومَن أتى بعدهم، لم يفوِّضوا المعاني بل فوَّضوا الكيفيَّات، وكلامهم في المعاني منقول متواتر، فهم أهل اللغة وأهل الفقه الذين اختصَّهم الله تعالى لصحبة نبيِّه وتلقِّي الإيمان وتطبيقه، ليكونوا حجَّة على الناس مِن بعدهم.
ويمكن للباحث الطالب للحقِّ أن يستخدم مناهج البحث المختلفة، والتي باتت مؤصَّلة مقَّعدة مؤطَّرة منظَّمة، للتحقُّق مِن طبيعة اعتقاد السلف، إمَّا بالاستقراء أو التحليل أو المقارنة أو دراسة الحالة، وغيرها مِن المناهج التي يمكن تطبيقها في مباحث اللغة والمضمون. وهي بمجموعها لن تتناقض لأنَّ أدلَّة الحقِّ تتظافر ولا تتنافر، وتتواتر ولا تتباتر[6]، وتشير بجموعها إلى حقيقة واحدة وقصد واحد. وهذا خلاف الباطل والضلال، فأدلته تتنافر لا تتظافر، وتتدابر ولا تتواتر، وينقض بعضها بعضًا، لهذا يلجأ أهله لحيل الكلام والحيدة عند الحوار.
ومَن عرف الفرق بين تفويض الكيف وتفويض المعنى أدرك البون الشاسع بين القائلين بهذا والقائلين بذاك، فالسلف الذين أثبتوا المعاني الواردة في الآيات والأحاديث المتعلِّقة بالأسماء والصفات أثبتوا وصدروا عمَّا يلي:
- أنَّ كلام الله تعالى كلَّه جاء بلسان عربي مبين بيِّن، واضح المعاني والدلالات لعموم الأمَّة، وخصوصًا في أهمِّ قضايا الإيمان والدين. وأنَّه مفيد للمخاطب، تقوم الحجَّة والبرهان به، لأنَّ الإنسان بفطرته، وسلامة لغته إذا كان مِن أهل اللسان نفسه، يدرك مضامينه ومعانيه على الجملة والعموم، ويفوته مِن التفصيل والخصوص بحسب نقص إدراكه لعلوم اللغة وأساليب الخطاب وفقه الدين، فإذا ما عالج ذلك فيه ألمَّ بتلك التفاصيل والخصوصيَّات.
- أنَّ الشبه الحاصل بين الربِّ وعبده في الألفاظ لا يستلزم التماثل والتساوي بأيِّ حال مِن الأحوال، فهذا ليس مِن اللغة ولا المنطق، فاشتراك لفظ الجسد واليد والعين بين الإنسان وبقيَّة المخلوقات لا يستلزم التماثل أو التساوي، فمِن باب أولى ألَّا يستلزم ذلك في حقِّ الله تعالى. وأن المعنى المثبت في تلك الألفاظ المتشابهة يثبت على أكمل وجه، وأجلِّ تفسير، وأجمل إدراك، ولا يكيَّف بالمخلوقات وصفاتها وأفعالها لأنَّها أهل للنقص والخلل والقبح.
- أنَّ الله تعالى حين أخبر عن نفسه كان أعرف بما أخبر، وأعرف بمَن خاطب، وأعرف بما قال، فلا ينبغي للعبد بعد ذلك أن يستدرك على الله تعالى في أيٍّ مِن هذه الأمور، لا بلسان مقاله ولا بلسان حاله، بحيث يبدي أنَّه أعلم مِن الله بنفسه، وأخبر به بخلقه الذين خاطبهم، وأوعى مِنه سبحانه بما قال! وأن الأليق به أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم، وأن ينفي ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم، ويقف حيث لا يعلم، ويسكت عمَّا سكتوا عنه ثبوتًا ونفيًا.
- أن معرفة الله أعظم الحاجات التي لا بدَّ للعباد مِنها، فإنَّهم منشغلون بماهيَّته وذاته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله وأقواله، وقدره وشرعه، منذ وجدوا على ظهر البسيطة، فتارة ينسبون إليه ما لا يصحُّ، وتارة يشركون معه غيره فيما هو حقٌّ له دون سواه، وتارة يجسِّدونه في الأشياء أو يمثِّلونه في صور ينحتونها. ولا يتمُّ للعباد حبٌّ ولا رجاء ولا خوف ولا خشية ولا مودَّة لربِّهم حتَّى تكون معرفتهم به كافية صحيحة، تمتاز عن شبه أهل الضلال والانحراف والشرك. كما أنَّهم لن يحسنوا التعامل مع ربٍّ يجهلون تعامله معهم، وأفعاله بهم، لأنَّ إحسان التعامل مع الله مبنيٌّ على حسن المعرفة به. ولهذا كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أعظم الخلق حبًّا ورجاء وخوفًا وخشية ومودَّة له سبحانه، وأحسنهم تعاملًا مع جلاله وجماله وكماله، على جميع أحوالهم.
وما سبق لا يمنع المؤمن مَن أن يتعلَّم مباحث الحقيقة والمجاز في اللغة وأساليبها، وكيفيَّة الربط بينهما، إذ المجاز استعمال لحقيقة في غير ما وردت له لمعنى مراد، وبهذا يمكنه أن يحسن التأويل في مواطن الاشتباه النادرة، حيث تشتبك الأفهام وتختلط المدارك. وهو باب مِن أبواب الفقه الذي قال به فريق مِن الأمَّة دون مغالاة فيه ولا تطرُّف، خصوصًا ممَّن أثبتوا الحقيقة ابتداء، ولجؤوا للمجاز ضرورة. أمَّا مَن غلب المجاز بالمطلق، ونفى الحقيقة، فقد حاد عن سبيل سلف الأمَّة الأوَّلين، وبالغ في أمر لم يغمسوا فيه عقولهم ومداركهم، لأنَّ القول بالمجاز علاج للمعاني غير المقصودة، والعلاج يؤخذ بقدر في مواطنه، ولا يحلُّ محلَّ المطعم والمشرب.
ويبقى أنَّ التأويل والتفسير علم وفنٌّ بناه علماء الأمَّة على مفاتح الأوَّلين، وخطُّوا له خطوطًا كثيرة، مِنها المصيب ومِنها المخطئ ومِنها ما بين بين، وكما أدخل على نصوص السنَّة ما ليس مِنها فقد أدخل على أفهام السلف ما ليس مِنه، وكما غلبت وراجت النصوص المزيَّفة عند كثير مِن الناس، فكذلك غلب وراج كثير مِن الـتأويل الدخيل على كثير مِن الناس، والسعيد مَن وفقَّه الله بفضله إلى الهدى والرشاد، ورزقه نورًا على نور.
والحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وجلَّ عن الندِّ والصاحبة والولد، وهو المالك فوق عباده وهو العزيز الحميد.
الهوامش:
- الرحمن: 1- 4.
- أخرجه أحمد عن عبدالله بن مسعود، رقم: (3712) واللفظ له، وابن حبَّان، رقم: (972)، والطبراني، رقم: (10352) باختلاف يسير. وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم: (199).
- الصافات: 180- 182.
- التوبة: 30- 34.
- آل عمران: 64.
- أي يعود بعضها على بعض بالبتر، والبتر القطع.


الله الله
مبحث زاخر عميق رصين
زادك الله كاتبه علما ورفعة
وجزاكم الله خير الجزاء