
جليّة للعيان مكانة الشعر في سجل الإنسانية الحضاري والثقافي منذ بدء الخليقة، ولما له من سمات وعناصر تكوينية، فالشعر معتبر في لغات العالم كافة؛ أعلى الآداب شأنا وألطفها هيئة وأنبلها تعبيرا. يفتقد الإنسان في محطاته المختلفة، ذلك العالم المثالي الحافل بالقيم السامية والأفكار العظيمة، التي بدأت تتسرّب وتنحسر من مساحات كبيرة في واقعنا؛ افتقاده الشخصيات الفذة المجسدة لتلك المثل، مثل لم يَنسِج عوالمها إلا عطش فطري للأنقى والأنبل والأجمل، وهروب الإنسان إلى عالم الشعر ضربة لازب، صونا لما تبقى من ومضات العقل وشظايا الروح الناجية من أوابد الدهر، متيقنا بوقوع نظره على تلك المجردات الغائبة. يفر الإنسان من هذا الواقع البائس الذي يعزُب عن تقديم ما تهفو إليه النفس من علائق كريمة وصداقات صافية، ليجد في بلاط الخليفة المأمون من ينشد بيت أبي العتاهية القائل:
وإني لمحتاج إلى ظل صاحب
يروق ويصفو إن كدرت عليه
فيقول الخليفة لنديمه مستيئسًا: “خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب”. وكذا إن رأى الواقع يشح بأصحاب الهمم المتوقدة، والأنفس الحية التي ترفض أن تعيش كَلّا على محيطها، وعالة على من هم في طوقها؛ فيردد في نفسه مستأنسا بقول النابغة:
نفس عصام سوّدت عصاما
وعلمته الكرّ والإقدام
معلوم علم ضرورة أن الشعر قد حاز قصب السبق دون ضروب الفنون في أن يكون المستروح للذات المرهقة القلقة، ودارا كريمة يوطّن فيها المرء نفسه، منشرح البال بعالمه المفقود خارجها. وإن اقتفينا معا أثر نفس أبية تنفجر جوانبها همة وطموحا كنفس أبي الطيب المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس قديما وحديثا، والذي يستوقف كل متأمل .. ما الذي وقع للرجل حتى انثالت منه هذه الدفقة المحرقة والجوى المضني لينشد:
جَلَلا كمَا بي فَلْيَكُ التّبْريحُ
أغِذاءُ ذا الرّشأ الأغَنّ الشّيحُ
يقول أبو الطيب: تباريح الهوى يجب أن تكون عظيمة كالذي حل بي وإلا فلا. وحين قال ابن جني في هذا: (المصراعان متباينان، لذلك أفرد كل واحد بمعنى) .. قيل: (قد يفعل الشاعر مثل هذا في باب التشبيب خاصة، ليبرهن به على ولهه، وشغله عن تقويم خطابه). وهو “تبرير أو تفسير”، يضاهي بيت أبي الطيب حدة نظر ودقة خاطر، فاختلاج المعنى واضطرابه في نفس الشاعر إذ غَشيه ما غشيه من الذهول أدعى لأن يخرج بيانه مشوبا بتلك الاختلاجة وذلك القلق الموشّى بالرقة والصبوة، فالأمر كما قال الأول، وهو يضرب في مقتل مناهج نقدية “متفشّية” تعزل صاحب البيان عن بيانه بل تقتله وهو الذي بعض روحه:
إنَّ الــكلام لفي الفـؤاد وإنما
جُعل اللسان على الفؤاد دليلا
وقد أحسن شيخ المعرة في شرحه لديوان المتنبي الذي أسماه معجز أحمد، حين قال: (قد قيل في وجه اتصال المصراعين وجهان، أحدهما: أنه بيّن في المصراع الأول حاله في شدة التبريح وبالغ فيه، ثم بيّن في المصراع الثاني: أن من فعل فيه تبريح الهوى هو الرشأ الأغن المنعم الذي ربّي بالشيح. والثاني: أن معناه: إن كان في الدنيا تبريحا، فليكن عظيما مثل ما بي. ثم قال: أتظنون أن من فعل بي هو الرشأ الذي غذاؤه الشيح! ما هو إلا الرشأ الذي غذاؤه قلوب العاشقين وأبدانهم.( وقريب من هذا ذلك قول ذي الرمة:
أمنزلتيْ ميّ سلام عليكما
هل الأزمن اللائي مضيْنَ رواجعُ
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى
ثلاث الأثافي والرسوم البلاقعُ
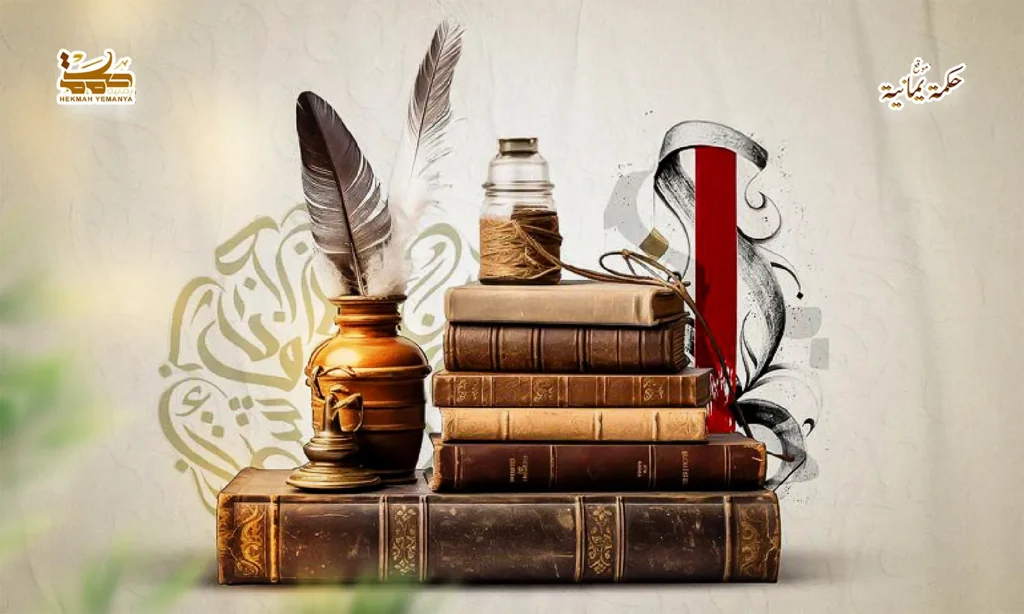
وقد ذكرت كتب الأدب، أنَّ ذا الرمة كان في الشاعرية كتفا بكتف مع الفرزدق وجرير، لولا أنه شُغِل بميٍّ، ولم يمدح. وقد سأل الوليد بن عبد الملك الفرزدق يوما: أتعلم أحدا أشعر منك؟ قال: غلام من بني عدي، يركب أعجاز الإبل، يريد ذا الرمة.. وهو القائل:
وعينان قال الله كونا فكانتا
فعولان بالألبابِ ما تفعل الخمرُ
كل ذلك مما يغسل الروح ويحفظ دهشتها ويزيد في ألقها، ويُقري سعادتها. فالتفاعل مع الحسن والجمال ومباشرته بنفس تائقة لماء السحر وكلأ الغرابة؛ يكوّن حولها جُنّة تقيها العطب والاهتراء، وأي شيء يبقى للإنسان إن خبت فيه جذوة استحسان الحسن واستقباح القبيح، كما أن الشعر_ والأدب عامة _ مع ما فيه من خطرات ولفتات نفسية باعثة على الدهشة، هو مصدر رئيس للأفكار والقيم سلبا أو إيجابا، ومرآة للمجتمعات بما تقبله أو تمجّه من أخلاق وعادات تتعاقب بتعاقب الملوان. وفي ذلك أنشد الحويدرة الذبياني يوما:
أَسُمَيّ وَيْحَك هل سمعتِ بِغَدْرَةٍ
رُفع اللّوَاءُ لنَا بِها في مَجمعِ
إِنَّا نَعفُّ فلا نُرِيبُ حليفَنَا
ونكُفُّ شُحَّ نُفوسِنا في المَطْمَعِ
مقتنصا المصطلح العبقري الذي نحته فيلسوف الحضارة مالك بن نبي رحمه الله. ينوه الحويدرة هنا بـ”عالم أفكار” الصاحبة ومنظومتها الفكرية؛ من حيث تفاخره بعلوّ همته وشهامته ومروءته.
فسمية التي صورها لنا الشاعر، امرأة ماجدة لا تراه خليقا لعاطفتها إلا إذا حقق في ذاته شروطا خاصة، فلم يكن وضيعا لا يؤمن جانبه لتنصب له راية الغدر كما كان يفعل في العهد الذي سمي ب”الجاهلية”، وما أحوجنا لقراءة ثانية لهذه الحقبة، والنظر فيها بتمعن في ظل الحقل الدلالي للفظة “الجهل”، فالشعر هنا هدهد أحاط بما لم نحط، وأتانا من أسرار المجتمعات وأخلاقها، ووعيها بنبأ عظيم. وهذا ابن الدمينة الفارس المشهور، يتواجد شجوا وفرقا من انصرام حبل الود، وانبعاث طائر البين، حتى ليكثر التسآل والتحنان، ولا يرى في انقداح العشق والتبريح؛ ما يخرم مروءته، وينال من كرامته، فيقول:
تعاللتِ كي أشجى وما بكِ علة
تريدين قتلي قد ظفرتِ بذلكِ
أبيني أفي يمنى يديكِ جعلتني
فأفرحَ أم صيرتِني في شِمالكِ
لئن ساءني أن نِلتني بمساءة
لقد سرني أني خطرتُ ببالكِ
وبنظر ناقد نافذ رأى قدوة الأدباء قاطبة “أبو عثمان عمرو بن بحر” أحوال متثاقفي عصره وكل عصر ممن يحرصون على هالة الغرابة والفوضوية في هيآتهم، ويتوسلون بهلهلة أشعارهم إلى حيازة عقول الناس، وهم بذلك أقرب للوحات الكاريكاتير منهم إلى المثقف المشحون بهموم واقعه وسياقي المعرفي، وكأن الجاحظ في رصده “كتّاب زمنه” يصف حالة الانبهار التي لم تلق رواجا كالعصر الذي نعيش، فيقول: (يتوهم الواحد منهم إذا عرّض جبّته، وطوّل ذيله، وعقص على خده صدغه، وتحذّف الشابورتين على وجهه؛ أنه المتبوع ليس التابع والمليك فوق المالك). ويضيف واصفا حظهم من الثقافة والمعرفة: (خِلَقٌ حلوة، وشمائل معشوقة، وتظرُّف أهل الفهم، ووقار أهل العلم، فإن ألقيت عليهم الإخلاص وجدتهم كالزَّبد يذْهب جُفاء، وكنبتة الربيع يُحرقها الهيف من الرياح؛ لا يستندون من العلم إلى وثيقة، ولا يدينون بحقيقة، أخفر الخلق لأماناتهم، وأشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم). يواصل صاحبنا، كاشفا اغترارهم برقّة الدين وتجاسرهم على الطعن في ثوابته بتوهّم وشغب لا يمتّ إلى الواقع بصلة: (فيكون أوّل بُدوّه الطعن على القرآن والقول بتأليفه، والحكم عليه بالزعم بتناقضه. ثم يُظهر ظرفه بتكذيب الأخبار، وتهجين من نقل الآثار وتكذيب أحاديث خير الأخيار المصطفى صلى الله عليه وسلم . فإن استرجح أحدٌ عنده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فتل عند ذكرهم شدقه، ولوى عند محاسنه كشحه. وإن ذُكر عنده شُريح جرَّحه، وإن نُعت له الحسن استثقله، وإن وُصف له الشعبيُّ استحمقه، وإن قيل له ابن جُبير استجهله، وإن قدَّم عنده النَّخعيُّ استصغره).
أحزننا أبو عثمان بنفَسه الساخر، وإن أحدنا ليغصّ بعبرة كهذه، فلا يجد ما يسيغها إلا بيت عذب رائق يستجمع ما تشتت منه، وكذلك الإنسان في مسيرة حياته، فهو متنقل في ثوبي هناء وشقاء، ويمنة ويسرة، وانقباض وبسط، ليأتي الشعر بما أُفرغ من طاقات تعبيرية مختزلة؛ ليرتفع بمتمثله إلى أفق يقارب أحوال أهل الحقيقة، بل هي على التدقيق، إشراقة معنى سارب في جذر الإنسان من لدن الزمن الأول، وقد وافقته لفظة هي مداد للتعبير عن الشجن المشترك. عديدة هي محاولات هذا الواقع المادي المخادع في سيره لأن يتحسس إنسانية الإنسان ليفتك بها، واقع يريد إخضاع أعناقنا لسلطان التجريب الذي يقدَّم باعتباره تفسيرا جامعا للحياة، وبأن العالم لا يجاوز ما نرى ونسمع ونلمس، رويدا رويدا يحاول سرقة المتجاوز الروحاني الذي هو أسّ فرادة الإنسان، والذي يمِيز به عن غيره من الكائنات القاصرة عن التخييل والتأمل، ومن هنا أجد في الشعر دفاعا يحول دون إغراق الإنسان في لجة المادية. كل ما ذكرت قد لا يعدو إلا أرقا عقليا يُعمل فيه من التعب والقصور تحت وطأة حالة السيولة والهشاشة التي أصبحت سمة العصر، فلا مناص إذا من بعض التلطف لتساس النفس، إذ لا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه كما قال ابن الجوزيّ في سِفره الجليل صيد الخاطر، مغالطة يقدمها البيت القائل:
وأكذب النفس إذا حدثتها
إن صدق النفس يزري بالأمل
فلعلك وجدتَ في بيت لبيد سلوة عن الشكوى والتحسر، ونلت بعض الهدوء والسكينة وإن كانا بحيلة ومكر.

