
الإيمان الآن في عصر المادة، وفي عصر التكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء المفتوح أشبه بجوهرة لا يعرف المؤمنون أنفسهم قدرها، ولا يدري المسلمون قيمتها الحقيقية .. فقد بات يلح الآن سؤال، أكثر من أي وقت مضى: ما قيمة الإيمان؟ وما قدر الدين؟ .. وفي الحقيقة إن الإجابة عن سؤال: ما قيمة الإيمان والدين؟ يكمن في جوهره تجديد الإيمان في نفوسنا، واستعادة الدين وحبه وهيبته في صدورنا، وهو واجب الوقت الذي ينبغي أن نعمل عليه.
ولو سألت سؤالا افتراضيا: ما وسائل تجديد الإيمان والدين في قلوبنا وحياتنا؟ وهل نحن بحاجة أصلا إلى تجديد الإيمان؟ لقلتُ: أما أننا بحاجة إلى تجديد الإيمان فنعم، خاصةً في عصرنا هذا؛ الذي لا ينكر أحد أنه عصر القسوة، واللهاث وراء المال، واتباع الهوى، وطغيان المادة المغرقة، فكأن الإنسان فيه مسلوب الإرادة مخمور العقل.
الإيمان بطبيعته يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة والخشوع، وينقص بالمعصية والغفلة. ولذلك فهو بحاجة إلى تجديده عن طريق ضخّ دماء الروحانية في القلب، واستشعار معاني العبادة وتذوقها، فإن للإيمان حلاوة في القلب يشعر المرء بها كما يشعر بلذة الشهد حين يتذوقه .. يتجدد بأن يتدبر الإنسان آخر خطاب سماويّ إلى البشر، ويدرك من خلاله: ماذا يريد الله منه؟ ولماذا خلقه؟ وما المنتهى والمصير؟ وكل هذا تحدث القرآن عنه باستفاضة لافتة.
إن الإيمان هو الحياة، وبالطبع تجديد الإيمان هو تجديدٌ للحياة، وإشاعة الطمأنينة في جنباتها، والسكينة في حركاتها، والبهجة في أركانها، فالإيمان كالبذرة الطيبة متى ألقيت في قلب طيب أثمرت أطيب الثمار وآتت أُكلها بإذن ربها.
أخرج الطبراني، والحاكم، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “إنَّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ في جَوْفِ أحدِكُمْ كَما يَخلَقُ الثّوبُ، فاسْألُوا اللهَ تعالَى: أنْ يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلوبِكمْ”. أي: يَبْلَى ويَضْعُفُ في قَلْبِ المُسْلِمِ، ويكونُ ذلك بسَببِ الفُتور في العِبادةِ أو ارتكابِ المعاصي وانغِماسِ النَّفسِ في بَعضِ شَهواتِها، “كما يَخْلَقُ الثَّوبُ”، أي: مِثْلَ الثَّوْبِ الجَديدِ الذي يَبْلى بطُولِ استخدامِهِ. وأخرج الإمام أحمد: عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: جدِّدوا إيمانَكم قيل: يا رسولَ اللهِ وكيف نُجدِّدُ إيمانَنا؟ قال أكثِروا من قولِ لا إلهَ إلَّا اللهُ.
من هنا ندرك أن وسائل تجديد الإيمان تتمحور حول: الدُّعاءِ والأعْمالِ الصَّالحةِ، والقِيامِ بالفرائضِ وأعمال التطوُّعِ التي تَعمُرُ القَلبَ بالإيمانِ، والصَّدقاتِ والنفقةِ على المحتاجِينَ، والتَّفكُّرِ في آياتِ اللهِ الشرعيَّةِ والكونيَّةِ، وكَثرةِ الذِّكرِ والاستغفارِ ولُزومِ مَجالِسِ والعِلمِ، المحاسبة القيمة على النفس، الصحبة التي تذكرك بالله وتعينك على الإستقامة، التفكر في الآخرة. ووسائل أخرى غير محصورة.
ولكن هناك وسيلة من وسائل تجديد الإيمان، قلما ينتبه إليها أحد، وهي: الوقوف أو القراءة في تجارب الذين تعرفوا على الإسلام، فآمنوا بالله تعالى. هؤلاء نشأوا في ظلال بيئة مادية محضة، وأسرية متفككة، لا تؤمن إلا بالمادة، ولا تقتنع إلا بالدليل المحسوس، ولا تعرف إلا لغة العلم والأرقام. فلما كان اطلاعهم على الإسلام وإيمانهم بالله تعالى -وحالهم هكذا- كان لا بد أن يكون وراء إيمانهم هذا سرٌّ، وسر عميق أو إن شئت فقل: أسرار عظيمة.
ولقد ظللت أبحث فترة من الزمن ليست بالقصيرة عن هذا “السر” وراء إيمانهم، وتبديل عقيدتهم، وتضحيتهم بكل شيء في سبيل إيمانهم بالله تعالى .. هذا “السر” نفسه يستطيع المسلمون -الذين ورثوا إيمانهم وعقيدتهم وإيمانهم- أن يجددوا إيمانهم متى ما تدبروه، وعرفوه، ووقفوا عليه.
إن هذا “السر”ّ هو الذي جعل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، ويدافع بإنصاف وعقلانية عن رجل يقول ربي الله، كما في الآية الكريمة: (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ). ورغم أن إيمانه كان مكتوما مخبوءا إلا أنه بالنسبة إلى أمة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان أظهر ما يكون، وأعظم ما يكون، مشهورا معروفا بالنسبة إلينا لأن الله تعالى خلده في كتابه لصدقه. فالإيمان وإن كان مكتوما إلا أن أثره لا يخفى على أحد، وقد ظهر أثره في حديثه ليكون تذكرة لنا -نحن المؤمنين- بأن الإيمان بأثره ونتائجه، لا بالفخر به ولا بإظهاره بتكبر.
وهذا “السر” هو الذي جعل السحرة الذين آمنوا بموسى -عليه السلام-، أن يتحدوا فرعون، وكل ما تلفظ به من وسائل التعذيب والإهانة والتنكيل، واستهانوا بكل هذا في سبيل ما آثرهم الله تعالى “من البينات”، ولئن كان القضاء اليوم أو غدا، فلا فرق، طالما تقضي هذه الحياة الدنيا يوما ما: (قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ). واللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى: جملة تبين شيئا من أسرار الإيمان حين يخالط القلوب.
النموذج الذي أعرضه الآن للتعرف على هذا “السر” هو نموذج عالم الرياضيات الأمريكي الذي أسلم: “جيفري لانغ”.
يحدثنا د. جيفري لانغ عن إسلامه، فيقول: “لقد كانت غرفة صغيرة، ليس فيها أثاث ما عدا سجادة حمراء، ولم يكن ثمة زينة على جدرانها الرمادية، وكانت هناك نافذة صغيرة يتسلّل منها النور… كنا جميعاً في صفوف، وأنا في الصف الثالث، لم أكن أعرف أحداً منهم، كنا ننحني على نحو منتظم فتلامس جباهنا الأرض، وكان الجو هادئاً، وخيم السكون على المكان، نظرت إلى الأمام فإذا شخص يؤمّنا واقفاً تحت النافذة، كان يرتدي عباءة بيضاء… استيقظت من نومي! رأيت هذا الحلم عدة مرات خلال الأعوام العشرة الماضية، وكنت أصحو على أثره مرتاحًا.
في جامعة (سان فرانسيسكو) تعرفت على طالب عربي كنت أُدرِّسُهُ، فتوثقت علاقتي به، وأهداني نسخة من القرآن، فلما قرأته لأول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي “يقرأني”.
وفي يوم عزمت على زيارة هذا الطالب في مسجد الجامعة، هبطت الدرج ووقفت أمام الباب متهيباً الدخول فصعدت وأخذت نفساً طويلاً، وهبطت ثانية لم تكن رجلاي قادرتين على حملي! مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف، ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية..
شعرت بالهزيمة، وفكرت بالعودة إلى مكتبي.. مرت عدة ثوانٍ كانت هائلة ومليئة بالأسرار اضطرتني أن أنظر خلالها إلى السماء، لقد مرت عليّ عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى السماء! أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع الدعاء: “اللهم إن كنت تريد لي دخول المسجد فامنحني القوة”.
نزلت الدرج، دفعت الباب، كان في الداخل شابان يتحادثان. ردا التحية وسألني أحدهما: هل تريد أن تعرف شيئاً عن الإسلام؟ أجبت: نعم، نعم.. وبعد حوار طويل أبديت رغبتي باعتناق الإسلام. فقال لي الإمام: قل أشهد، قلت: أشهد، قال: أن لا إله، قلت: أن لا إله -لقد كنت أؤمن بهذه العبارة طوال حياتي قبل اللحظة- قال: إلا الله، رددتها، قال: وأشهد أن محمداً رسول الله ، نطقتها خلفه..
لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر في الحلق المحترق لرجل قارب الموت من الظمأ، وكنت أستعيد القوة بكل كلمة منها، كنت أصحو للحياة ثانية. لن أنسى أبداً اللحظة التي نطقت بها بالشهادة لأول مرة، لقد كانت بالنسبة إليّ اللحظة الأصعب في حياتي ولكنها الأكثر قوة وتحرراً..
بعد يومين تعلمت أول صلاة جمعة، كنا في الركعة الثانية، والإمام يتلو القرآن، ونحن خلفه مصطفون، الكتف على الكتف، كنا نتحرك وكأننا جسد واحد، كنت أنا في الصف الثالث، وجباهنا ملامسة للسجادة الحمراء، وكان الجو هادئاً والسكون مخيماً على المكان!! والإمام تحت النافذة التي يتسلل منها النور يرتدي عباءة بيضاء! صرخت في نفسي: إنه الحلم! إنه الحلم ذاته…
تساءلت: هل أنا الآن في حلم حقاً؟! فاضت عيناي بالدموع، السلام عليكم ورحمة الله، انفتلتُ من الصلاة، ورحت أتأمل الجدران الرمادية! تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت لأول مرة بالحب، الذي لا يُنال إلا بأن نعود إلى الله”.
يمكن أن نقول: إن الله تعالى هو الذي هدى جيفري لانغ إلى الإيمان كما هدانا .. ولكن بعدما جرّب وذاق جيفري لانغ الإيمان، كيف نظر إلى الأشياء التي بين أيدينا، كالإيمان بالله تعالى والقرآن الكريم، وصلاة الفجر بنظرة مختلفة عما ننظر إليها الآن؟

كيف كانت حياة جيفري لانغ قبل الإيمان وبعده؟
بالنسبة لتجربته يقول في كتابه “الصراع من أجل الإيمان”: وسرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن يناجي، من خلال أعماق روحه الواحد الأحد، الذي يعرفه ويكون بمقدوره أن يشعر بالاستجابة. ولكن الملحد لا يستطيع أن يسمح لنفسه بتلك النعمة، لأن عليه أن يسحق هذا الدافع ويذكر نفسه بسخفها. إن الملحد يكون إلهه عالمه الخاص به، ولكنه عالم صغير جدا، لأن حدود هذا العالم قد حددتها إدراكاته، وهذه الحدود تكون دوما في تناقص مستمر”.
نغمة الإلحاد التي يتباهي بها البعض اليوم وراءها فراغ كبير، وخواء روحاني جبار. ولا يستطيع أن يسد هذا الفراغ وهذا الخواء كل ماديات الدنيا مجتمعة، لأن وجودها بالطبيعة لا يشبع الروح، ولكنها تختص بعمل الجسد وفقط، والحقيقة المرة أن الإنسان روح وجسد وليس جسدا فقط.
ويوم أن تجلس مع أحد يعاني هذا الداء القلبي، فإنه يبوح لك بما في خاصة نفسه من ألم ووحدة ومعاناة، ولكنك يوم توجهه إلى الفطرة الأصيلة في قلبه من الإيمان بالله والضراعة إليه كابر مكابرة عجيبة.
وهذه المكابرة للأسف الشديد ليست بنافعته في شيء، لأنها ستتكرر معاناته، وستتعدد عذاباته، ما لم يفئْ إلى حضن الإيمان، ويعرف ربه خالقا مدبرا حكيما. وهو وحده الذي يشعر بهذا لا أحد سواه كي يقدم له العون والمساعدة في طريق دنياه.
يقول: إن الرجل المؤمن يمتلك إيمانا بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكه، في حين أن الملحد لا يستطيع حتى الثقة بتلك الأشياء، وعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريبا، ولا حتى الحقيقة ذاتها. إن مفاهيم الملحد عن المحبة والرحمة والعدالة هي في تحول وتبدل حسب ميوله ونزواته، مع الشعور بنفسه وبمن حوله أنهم جميعا ضحايا عدم الاستقرار”.
ويصف لانغ بدقة متنهاهية هذا العالم الذي كان يعيش فيه قبل الإيمان بالله، فيقول: “لقد كان عالما فاتنا براقا يلتمع كالجليد من جميع اتجاهاته. كان عالما التخاطب فيه عقيم بارد لا حياة فيه، عالما كل واحد منا فيه ممثل هزيل يقوم بأدوار قبل أن تناسبه، والجميع فيه حريصون على الاستمتاع بحياتهم، وألا يفوتهم شيء من اللذة. لم يكن هناك سعادة او سرور، بل كان هناك ضحك فارغ. لم أشعر بأذى كهذا من قبل في مكان وزمان معينين”.
إنه يريد أن يقول: إن الإيمان بالله تعالى يصنع لحياة الإنسان معنى، حين يعلم أن سعيه لم يكن ليضيع، وأجر معاناته وصبره وكفاحه للتغلب عليها لم يكن ليضيع كذلك. (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا).
ونرى جيفري عند قراءته قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ).
يقول: “إن الملحد يعرف تماما حال هذا الباحث اليائس، إن حياته هي بحث سقيم عن السعادة سعيا وراء أوهام فارغة، وما كان كل إحباط إلا ليزيده عطشا ما دام يتعلق بالجهل، ويغرق في كل ما هو آنيّ”.
هذه الحيرة المظلمة الغارقة قادته إلى الارتماء بين ذراعي الإيمان، مكتشفا فيه لذة المعنى، وسمو الاستسلام: “إن حياة الإنسان هي صراع وبحث عن استسلام حلة وسامٍ ورائع، وهنيئا لأولئك الذين ينالون ذلك، لأن كل شخصية إنسانية ترنو لهذا الاستسلام، سواء أدركت ذلك أم لا، وهذا الاستسلام هو الإسلام”. هكذا انتهى من رحلة بحثه وتعبه وصراعه، أن “الإيمان بذرة الخير في الوجود”.
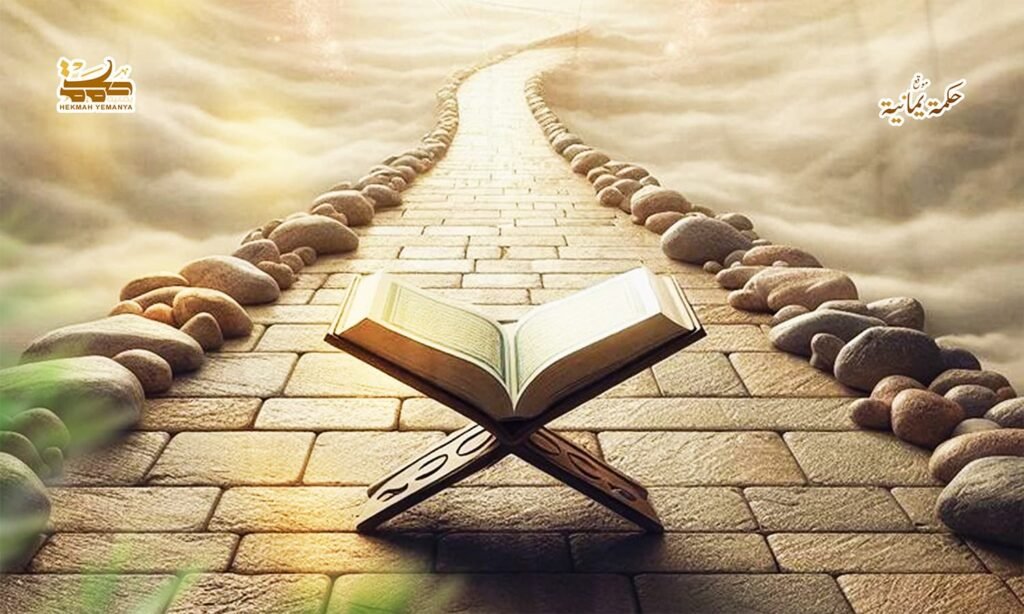
وماذا عن القرآن؟
يحكي جيفري لانغ عن تجربته في قراءة القرآن الكريم، مما يوجه أنظارنا نحن المسلمين إلى: أن نجدد إيماننا من خلال آياته المباركة، وألَّا ننظر إليه نظرة غير عادية، وكذلك أن نصاحبه في أيامنا كلها، وليس في شهر واحد فقط وهو شهر رمضان، استمع إليه وهو يقول:
“وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة، فإما أن تكون لتوك قد استسلمت له أو أنك ستقاومه، فهو يحمل عليك وكأن له حقوقا عليك بشكل مباشر وشخصي .. وهو يجادلك وينتقدك ويتحداك ويخجلك، ومن حيث الظاهر يرسم خطوط المعركة .. إذ بدا واضحا أن مبدع هذا القرآن كان يعرفني أكثر مما كنت أعرف نفسي .. إن الفنان يستطيع أن يجعل العين في أي لوحة يرسمها، تبدو وكأنها تنظر إليك حيثما كنت منها. ولكن أي مؤلف يستطيع أن يكتب كتابا مقدسا يستطيع ان يتوقع حركاتك وسكناتك اليومية؟ .. لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري، ويزيل الحواجز التي كنت قد بنيتها منذ سنوات، وكان يخاطب تساؤلاتي”.
ثم يكمل: “وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني كنت إلى حد ما أكتشف الإجابة في اليوم التالي. ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري، ويكتب الأسطر المناسبة لحين موعد قراءتي القادمة. لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن. وكنت خائفا مما رأيت.. كنت أشعر بالانقياد بحيث أشق طريقي إلى الزاوية التي لم تحتو سوى خيار واحد”.
أريد أن أقول: إن جيفري لانغ مع مشاعره الجياشة التي أحس بها تجاه الإيمان والقرآن، إلا أنه مع اهتدائه لهذا كله فقد كان يقرأ القرآن مترجما، ويعرف عن الدين بلسان غير لسانه، ومع هذا حمل قلبه كل مشاعر الامتنان والحب لهذا الإيمان الذي وقع في براثن طمـأنينته وسكينته..
إن من أجل نعم الله تعالى علينا أن القرآن نستطيع أن نقرأه باللغة العربية، وأن نقرأ عن الدين بلغتنا الأصلية، فمن الواجب أن نكون أكثر عاطفة ومحبة للإيمان من لانغ، لأننا أكثر فهما وعقلانية للدين، والعاطفة بالتأكيد تتبع الفهم، كما ينص على هذا احد الفلاسفة.
يقول لانغ: “إن أولئك الذين عانقهم الإسلام فإن أعظم شاهد على محبة الله المتواصلة والمتتابعة والداعمة والهادية لهم هو: القرآن. فالقرآن هو كالمحيط الهائل الرائع يغريك كي تبحر في أمواجه الباهرة نحو الأعمق فالأعمق حتى تنجرف في داخله، ولكن بدلا من أن تغرق في بحر لجي مظلم فإنك تجد نفسك مغمورا في بحر من النور والرحمة الإلهية”.
ويقول إنه كان يواظب بشكل رئيسي على الصلاة التي يجهر فيها كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، ولقد لفت حضوره في هذه الصلوت انتباه أحدهم فسأله بفضول:
لماذا أجهد نفسي للمجيء لهذه الصلوات، إذ عد مجيئي إليها عبئا، خصوصا وأن القراءة في الصلاة كانت تتم في لغة غريبة عني تماما؟!
انظروا، كيف كانت إجابته.. يقول:
لم أفكر في هذه المسألة قط، ولكني أجبته على نحو فطري بسؤال آخر:
لماذا يسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟
ذلك أنه على الرغم من أن الرضيع لا يفهم كلمات أمه إلا أن صوتها مألوف له ويسكته ويطمأنه.
يقول: إنه ذلك الصوت -أي القرآن- الذي عرفه هذا الطفل منذ الماضي البعيد، فكان لا بد أن يطمأن لسماعه ولو لم يفهمه..
ويضيف: لقد كان هناك لحظات كنت أتمنى فيها أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت للأبد”.
إن لانغ يحكي تجربته الدينية لكي نستفيد بها.. نقيّمُ إسلامنا، وعاطفتنا تجاهه، ولنعلم أن النعمة إذا كانت من الله تعالى ابتداء كـ”نعمة الإيمان” فإن واجبنا أن نثريها، نجددها، نشكر الله عليها نهاية وإلى الأبد، ونجعلها محاطة بالحكمة والهالة الإشراقية لكي تؤتي ثمارها الحياتية والأخلاقية مدة عيشنا المحدود على هذه الأرض.
ويقول جيفري في كتابه “حتى الملائكة تسأل”: “في لحظة من اللحظات الخاصة في حياتي، منّ الله بواسع علمه ورحمته عليّ، بعد أن وجد فيّ ما أكابد من العذاب والألم، وبعد أن وجد لدي الاستعداد الكبير إلى مَلء الخواء الروحي في نفسي، فأصبحت مسلماً.. قبل الإسلام لم أكن أعرف في حياتي معنى للحب، ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرحمة والعطف يغمرني، وبدأت أشعر بديمومة الحب في قلبي، فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لا تقاوَم”.

وعن تجربته مع الصلاة
يقول جيفري: “الصلاة هي المقياس الرئيس اليومي لدرجة خضوع المؤمن لربه، ويا لها من مشاعر رائعة الجمال، فعندما تسجد بثبات على الأرض تشعر فجأة كأنك رُفعت إلى الجنة، تتنفس من هوائها، وتشتمُّ تربتها، وتتنشق شذا عبيرها، وتشعر وكأنك توشك أن ترفع عن الأرض، وتوضع بين ذراعي الحب الأسمى والأعظم”.
ونرجع إلى كتابه “الصراع من أجل الإيمان”، فله تجربة خاصة مع الصلاة ذكرها، وخاصة صلاة الفجر، تلك التي يغفل عنها الكثير، وهي ساعة تجلٍّ لرحمة الله تعالى، وتوزيع بركاته، فهي مشهودة من قبل الحق -جل جلاله- ومن قبل ملائكته.
يقول: “أما أنا فقد وجدت في الصلاة عونا وراحة كبيرين، وصلاة الفجر كانت هي الأكثر مشقة لي من بين الصلوات -ولأجل هذا وضع خطة محكمة للاستيقاظ لها ذكرها في كتابه ويمكن الرجوع إليها- ولكن: صلاة الفجر هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة. هناك شيء ما خفيّ في النهوض ليلا -بينما الجميع نائم- لتسمع موسيقى القرآن تملأ سكون الليل، فتشعر وكأنك تغادر هذا العالم وتسافر مع الملائكة لتمجد الله تعالى بالمديح عند الفجر”.
ثم يستخلص من هذه المعاناة لقيام الفجر فلسفة حياتية خاصة، يمكن أن نسميها “فلسفة التغلب على المخاوف ومواجهة العقبات” أو فلسفة “امتحان الشخصية وبنائها” وهي نظرية عقلانية جدا.. كثيرا ما نسأل عن حكمة العبادات في الإسلام، ونتحدث طويلا في هذا، ولا شك أن في فرض العبادات عبودية للواحد الأحد، كما لها نفع عظيم يعود على حياة الإنسان، وأسرار تمكنه من العيش في سعادة وراح.|
يقول: “ولقد وجدت في تغلبي على رغبتي في النوم صباحا بعد صباح، مصدر قوة كبيرة لي، فقد كان ينتابني شعور أفضل لمواجهة مخاوفي. كنت أخبر أصدقائي أنه بغض النظر عن العقائد، إذا كان بمقدورك أن تدرب نفسك على أن تنهض من فراشك عند الخامسة كل صباح فسوف تشعر أنه ليس هناك من تحدٍّ، مهما كبر إلا بوسعك أن تتغلب عليه. وفي حين نجد أن جميع الشعائر الإسلامية تشتمل على هذا العنصر، من “امتحان الشخصية وبنائها” إلا أن هناك الشيء الكثير فيما وراء ذلك”.
فمن أهداف العبادة في الإسلام والتي اهتدى إليها جيفري بتجربته؛ امتحان الشخصية وبنائها.
فالصلاة متى أقيمت على الوجه الذي أراده الله تعالى، وقرئ فيها القرآن بتدبر وخشوع، ولم ينس المرء ذكر ربه في جميع أحواله؛ أكسبت المرء “خاصية مقاومة الفحشاء والمنكر” في نفسه ومجتمعه: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ).
ولغاية ما، ولسر عظيم اقترن الصبر بالصلاة في القرآن مرتين: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) .. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).
فالصبر أحد المعاني العظيمة التي تعين المرء على احتمال تقلبات الحياة وابتلاءاتها، وقسوتها في أحيان كثيرة، حتى أنه جعل نصف الإيمان. فاقترانه بالصلاة لم تخف حكمته على بصير. والصيام متى تمّ على وجه حفظ الجوارح ومراقبة الله تعالى أكسبت المرء “فاعلية التقوى والخشية من الله تعالى”: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
يقول: “إن المسلمين الجدد يقولون: دوما إنهم يجدون في الشعائر الإسلامية امتحانا عظيما لهم ومقويا كبيرا لإرادتهم. إن هذه الشعائر تصبح أمرا أكثر منه خبرة من الطمأنينة؛ وبدورها تصبح الباعث الأول لقيامهم بصلاتهم وصيامهم وتطبيقهم لأوامر الله. وتراهم يقولون: إن هذه الشعائر وخاصة الصلاة قد أصبحت بمثابة مقابلات روحية وعاطفية قوية جدا. وخلال هذه المقابلات يكونون متنبهين جدا لوجود الله. إنها بالنسبة للمسلمين: باب الحياة التي هي أكثر حقيقة، وأجلّ معنى من أي شيء آخر فوق الأرض؛ وفي النهاية فإن هذا التعطش للحياة وللحب المقدسين يستحوذ عليهم”.
إن الرحلة نحو الإيمان رحلة نحو السمو الروحي والأخلاقي والحياتي .. أن يدرك المرء أن في قمة خضوعه لله رفعة، وذله بين يدية عزة، واستسلامه لأمره نهاية الحرية.
هكذا انتهى من رحلته تلك الآسرة والماتعة، ليوجه أنظارنا نحن إلى إيماننا لننظر فيه من جديد بروح جديدة، فننفض عنه غبار الشك والتيه، ونزيل عنه أوضار الهوى والأنانية؛ لنتده نحو أنوار اليقين، وسعادة الدارين.
وهل العبادات والخضوع لله سبحانة قهر وإذلال لإنسان العصر الحديث؟
يقول: “إن طمأنينة الإنسان وسعادته تكمن في توجيه قدراته نحو خدمة الله تعالى، وألا يزيغ بصره عن هذا الهدف. إن المسلم لا ينظر إلى مسألة خضوعه لله على أنه قهر أو إهانة، بل إنه يرى ذلك على أنه الطريق الوحيد للحرية الحقيقية كي يصبح إنسانا بالمعنى الكامل للكلمة. وعلى هذا؛ فالإسلام للمسلم هو أكثر من ديانة، إنه نظام هداية داخلي له (نحو النفس الحقيقية)، وخارجي (نحو كافة البشر) مع رجوعه إلى ربه على أنه الهدف الأسمى له. فالمسلم من خلال صلواته اليومية يسأل ربه أكثر من سبع عشرة مرة أن (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) وهو الطريق المعتدل الذي يقودنا للطمأنينة والسلام. فإذا ما اكتشف الإنسان هذا الطريق فإنه المعبر المكشوف المؤدي إلى سعادة عظيمة آسرة تسودها السكينة في هذه الدنيا، وإلى سعادة قصوى لا حدود لها في الآخرة”.
فهل آن لنا أن نجدد إيماننا، وبين أيدينا هذا الموروث الديني والثقافي والحضاري والإنساني الذي لا ينضب معينه أبدا، ولا تبلى جدته على مر الأزمان؟ .. لقد آن الأوان أن ننظر إلى إيماننا بصدق، نزيده بالطاعة والإقبال على الله تعالى، وأن ننظر إلى ما بين أيدينا نظرة مختلفة عما اعتدناه وما ألفناه!
فالعبادات، وتدبر القرآن، والخضوع لله ولحكمته، والدعاء والتضرع، وذكر الله؛ كلها لها أثر في حياة الإنسان ببعث الروح والتجدد والأمل واكتساب اليقين، وليست أوامر مجردة صماء ميتة. إن الأعمال الميتة تبعث على الركود والخمود والكسل .. ولطالما كان الإيمان والأعمال الصالحة يوجه المرء نحو المعالي، والأخلاق الحسنة والحياة الطيبة، فهي حيّةٌ محيية للإنسان والحياة.
قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).


مقال رائع ومشاعر صادقة.
الحمدلله الذي جعلني مسلما عربيا افهم القرآن كما نزل دون حاجة الى مترجم