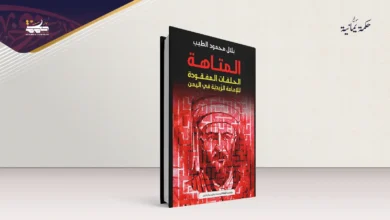يمثِّل الصَّحابة بمجموعهم المجتمع الإنساني الذي أحاط بالرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم، على سبيل الإيمان به وبرسالته، والانتماء لدينه، والولاء له. وهذا المجتمع الذي أحاط بالرَّسول الكريم كان مجتمعًا متنوِّعًا ومتباينًا، وإن كان معظمهم مِن المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية، فقد كانوا موزَّعين على بيئات اجتماعية وطبيعية متعدِّدة، ما بين حضر وريف وبدو، وما بين بيئات جبلية وأخرى سهلية وثالثة صحراوية، وما بين بيئة تجارية وأخرى زراعية وثالثة رعوية، وما بين بيئة متصالحة وأخرى متنازعة، وما بين مجتمع عَرَفَ نظام الدَّولة، كما هو في جنوب الجزيرة وشمالها، وآخر ظلَّ في فلك القبيلة. وهذا التَّنوُّع الكبير في البيئات يصاحبه ضرورة تنوُّع في الثَّقافات والعادات والسُّلوكيات، والطَّبائع الشَّخصية. والاكتفاء في النَّظر للصَّحابة -رضي الله عنهم أجمعين- مِن خلال الرُّؤية الدِّينية بعيدًا عن هذا التَّنوُّع يحدث نوعًا مِن القصور في الوعي، وبالتَّالي الضَّعف في استيعاب حركة مجتمع الصَّحابة وتفاعلاته وظواهره السِّياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إنَّ أكثر ما أكَّده القرآن الكريم لأتباع الرُّسل وهو يخاطبهم عن رسلهم وأنبيائهم هو حقيقة بشريَّتهم، وأنَّهم بشر مِن جملة البشر، مِن النَّاحية الطَّبيعية، لكنَّهم مِن النَّاحية الشَّرعية خيرة الأنفس في زمانهم ولهذا اختارهم الله تعالى لحمل رسالته وتبليغها للنَّاس، قولًا وفعلًا، بيانًا وبناءً. وعلى هذا الأساس فتزكية الله للأنبياء تقوم على اعتبار أنَّ الله اختارهم على العالمين لفضلهم وصفاتهم التي تميَّزوا بها، لا على تميُّز طينتهم البشرية وأنسابهم السُّلالية، يقول تعالى: ((قُل إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم يُوحَى إليَّ أنَّمَا إلهكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فمَن كَانَ يَرجُوا لِقَاءَ رَبِّه فليَعمَل عَمَلًا صَالِحًا ولَا يُشرِك بعِبَادَةِ ربِّه أحدًا))[1]. وهذه القضية سعى القرآن الكريم في ترسيخها سدًّا لباب الغلو في الأنبياء، وقطعًا لدابر الجفاء عنهم، وهي ذاتها ما ينبغي استصحابها في شأن أصحاب الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا ينبغي أن تضيع الرُّؤية إليهم بين نظرات الغلو المفرطة ونظرات الجفاء المنفرطة، وذلك حتَّى يمكن الاستفادة مِن سيرتهم على قدر كبير مِن الوعي والفهم والفقه، إذ أنَّ معاني الاقتداء والاعتبار والاتِّعاظ لا يمكن أن تتحقَّق مِن سيرتهم دون هذه الرُّؤية المتوازنة الرَّاشدة.
وفهم الخلافات السِّياسية بين الصَّحابة لا يخرج عن تلك الرُّؤية التي سبق وأشرنا لها، إذ هي نتاج للمجتمع الإنساني والحراك البشري، مع بقاء أنَّ شخصيَّات الصَّحابة -رضي الله عنهم- كانت في أسمى صور المجتمع الإنساني والحراك البشري، وإن وقعوا في نوع مِن الاجتهادات أو التَّأويلات الخاطئة. ومِن هنا يمكن الحديث عن القراءة المنهجية للخلافات السِّياسية بين الصَّحابة.
وراثة السِّياسة:
إحدى أهمِّ وظائف الأنبياء -عليهم الصَّلاة والسَّلام- سياسة مجتمعاتهم، لتحقيق كرامتهم الإنسانية، والقيام على مصالحهم الدِّينية والدُّنيوية، وضمان حقوقهم وحرِّيَّاتهم والدِّفاع عنها. قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (كانت بنو إسرائيلَ تَسُوسُهم الأنبياء، كلَّما هلك نبيٌّ خلَفَه نبيٌّ، وإنَّه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثُرُ)، قالوا: فمَا تأمرنا؟ قال: (فُوا ببَيعةِ الأوَّلِ فالأوَّلِ، وأعطوهم حقَّهم فإنَّ اللَّهَ سائلهم عمَّا استرعاهم)[2]. ومِن ثمَّ فالسِّياسة إحدى وظائف النُّبوَّة التي يرثها أصحاب النَّبي عنه، وهذا ما فهمه الصَّحابة -رضي الله عنهم- مِن القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية، وهم أفقه الأمَّة وأوعاها لخطاب الوحي. ومِن ثمَّ فالحرص عليها هو مِن الحرص على القيام بمهام النُّبوَّة ذاتها، بعد موت النَّبي وغيابه. ولهذا فإنَّ الصَّحابة تنافسوا عليها، لأنَّها مِن ميراث النُّبوَّة، لكنَّهم لم يتقاتلوا عليها، أو يتخاصموا ويتعادوا لأجلها. فحتَّى خلاف معاوية -رضي الله عنه- مع علي -رضي الله عنه- لم يكن في صلبه تَنازع على السُّلطة، وإنَّما التَّنازع على قضية دم عثمان -رضي الله عنه، والقصاص ممَّن قتله، وهو المحفوظ والثَّابت والظَّاهر، في الرِّوايات التَّاريخية لما جرى بينهم. فلم يثبت إطلاقًا ادِّعاء معاوية لأحقِّيته بالخلافة، أو طلبه عليًّا أن يتنازل عنها له، بل غاية ما طلب معاوية القصاص مِن قتلة عثمان، والأخذ بثأره، قبل انعقاد الأمر لمن بعده. قال ابن حزم، في كتابه (الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحل): “ولم ينكر معاوية قطُّ فضل علي، واستحقاقه الخلافة، لكنَّ اجتهاده أدَّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود مِن قتلة عثمان -رضي الله عنه- على البيعة، ورأى نفسه أحقَّ بطلب دم عثمان…، وإنَّما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك، ولا إثم عليه فيما حُرِمَ مِن الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم، الذين أخبر رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّ لهم أجرًا واحدًا، وللمصيب أجرين”. وقال الجويني: “ومعاوية وإن قاتل عليًّا فإنَّه كان لا ينكر إمامته، ولا يدَّعيها لنفسه، وإنَّما كان يطلب قتلة عثمان -رضي الله عنه، ظانًّا أنَّه مُصيب، وكان مخطئًا”[3]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ومعاوية لم يدِّع الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليًّا، ولم يقاتل على أنَّه خليفة، ولا أنَّه يستحقُّ الخلافة ويقرِّون له بذلك. وقد كان معاوية يقرُّ بذلك لمن سأله عنه. ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليًّا وأصحابه بالقتال، ولا يعلوا. بل لمـَّا رأى علي -رضي الله عنه- وأصحابه أنَّه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلَّا خليفة واحد، وأنَّهم خارجون عن طاعته، يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتَّى يؤدُّوا هذا الواجب، فتحصل الطَّاعة والجماعة. وهم قالوا: إنَّ ذلك لا يجب عليهم، وأنَّهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا: لأنَّ عثمان قُتِل مظلومًا باتِّفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم، كما لم يمكنه الدَّفع عن عثمان، وإنَّما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا، ويبذل لنا الإنصاف”[4].
فإذا أوَّل ما ينبغي إدراكه أنَّ الصَّحابة نظروا للسِّياسة كميراث نبوي ينبغي القيام به، وأنَّه مِن الأمور التي يجب قيامهم بها. فلم ينظروا للسِّياسة كوسيلة لمكاسبهم الخاصَّة، ومطامعهم الشَّخصية، ونزعاتهم الشَّهوانية، كما يفعل أهل الفجور والطُّغيان. وعلى هذا فلم يجر بينهم خصومة أو عداء أو قتال صراعًا على السُّلطة، بل اتَّحدت كلمتهم ضدَّ المرتدِّين مع اختلاف فئاتهم، وفي مواجهة الكفَّار.
التَّطلُّع للخلافة:
إذا تقرَّر لدينا أنَّ السِّياسة وظيفة مِن وظائف النُّبوَّة، وأنَّ الخلافة عليها بما تمنح الإنسان مِن سلطة تمنحه منزلة يمكنه معها تحقيق أعظم الأعمال وأجلَّ الغايات، مِن الدَّعوة، والحسبة، والقضاء، والجهاد، وإقامة العدل بين الخلق، وإيصال الإحسان إلى أهله، فقد كانت همم كبار الصَّحابة تتشوَّف لبلوغ هذه المنزلة. فإنَّ دأب الصَّحابة كان التَّنافس على أعظم الأعمال وأجلِّ الغايات، وخاصَّة مِنهم السَّابقين وأصحاب الشَّأن مِنهم. وقد حكى لنا القرآن الكريم كيف أنَّ يوسف -عليه السَّلام- حرص على مقام الولاية لإيصال النَّفع إلى الخلق. وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ: (سبعة يُظلُّهم اللَّهُ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلُّه: إِمام عادِل، وشابٌّ نشأ في عبادةِ اللَّه تعالى، ورجل قلبُه مُعلَّق في المساجد، ورَجُلان تحابَّا في اللَّه.. اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمالٍ فقال: إنِّي أَخافُ اللَّه، ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خالِيًا ففاضت عيناه)[5]. فأعظم النَّاس وأجدرهم أن ينال رضا الله، وأن يظلَّه تعالى في ظلِّه يوم القيامة، (إمام عادل)، فالحرص على هذا المقام أجدر ممَّا هو دونه. وقد قرَّر أهل العلم في ضوء نصوص الشَّرع أنَّ أعظم النَّاس أجرًا أنفعهم للنَّاس، ويدخل في هذا أصالة وابتداء الإمام العادل.
فتطلُّع بعض الصَّحابة للخلافة هو تطلُّع للقيام بأعظم الواجبات والأعمال، وأنفعها للخلق، وأكثرها ثوابًا، وأوسعها أثرًا. وفي الحديث عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -ﷺ- قال يوم خيبر: (لأُعطينَّ الرَّاية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه، يحبُّ الله ورسوله، ويحبُّه الله ورسوله)، فبات النَّاس يدوكون ليلتهم أيُّهم يُعطاها، فلمَّا أصبحوا غدوا على رسول الله -ﷺ، كلُّهم يرجو أن يُعطاها، فقال: (أين علي بن أبي طالب؟)، فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأُتي به، فبصق في عينيه، ودعا له، فبَرِأَ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرَّاية، فَقالَ عَلِيٌّ: يا رَسولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُهُم حتَّى يَكونُوا مِثلَنَا؟ فقال: (انفذ على رسلك حتَّى تنزل بساحتهم، ثمَّ ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم مِن حقِّ الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك مِن أن يَكونَ لكَ حمُر النَّعم)[6]. ففي الحديث أنَّ الصَّحابة رجا كلُّ مَن حضر مجلس الرَّسول أن ينال شرف هذا المقام وتطلَّعوا له.

نزعة القيادة والسِّيادة:
شتَّان بين شهوة التَّسلُّط والطُّغيان ونزعة القيادة والسِّيادة عند الإنسان، فالأولى استجابة للشَّهوة التي تدعو الإنسان للبطش والإجرام والبغي والعدوان، إذ غاية ما يريده تحقيق مصالحه وتلبية مطامعه، أمَّا نزعة القيادة والسِّيادة فهي استجابة للطَّاقات الرُّوحية والعقلية والأخلاقية التي تدفع الإنسان للقيام بمسئوليات النَّاس ونفعهم، وإصلاح شئونهم، وريادة مسيرهم إلى معاني التَّمكين والنَّصر والعزَّة والفلاح. ومَن خلط بين المعنيين لمجرد اشتباه الأمرين في الصُّورة لم يميِّز بين الحقِّ والباطل، وأئمَّة العدل وأئمَّة الجور، والسَّاعين في الإصلاح في الأرض والمفسدين في الأرض. قال ابن تيمية: “وأمَّا سؤال الولاية فقد ذمَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّا سؤال يوسف، وقوله: ((اجعَلنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرضِ)) فلأنَّه كان طريقًا إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين النَّاس، ويرفع عنهم الظُّلم، ويفعل مِن الخير ما لم يكونوا يفعلوه، مع أنَّهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرُّؤيا ما يؤول إليه حال النَّاس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يُوجب الفرق بين مثل هذه الحال، وبين ما نُهي عنه”[7].
وأيُّ قراءة لما ورد عن الصَّحابة في باب السِّياسة وطلب الرِّئاسة إنَّما يأتي في هذا الإطار، إذ أنَّ الإسلام لا يمنع مِن هذه النَّزعة القيادية والسِّيادية، بل يوجِّهها ويرشدها ويهذِّب سلوك الإنسان في طريق نيلها، أو حتَّى بعد بلوغها. وكمثال حيٍّ للصُّورتين نورد أمثلة على هذا وذاك.
مِن ذلك ما جاء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، قال: بلغنا أنَّ مسيلمة الكذَّاب قدم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث بن كريز، وهي أمُّ عبدالله بن عامر، فأتاه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس، وهو الذي يُقال له “خطيب رسول الله”، وفي يد رسول الله قضيبٌ، فوقف عليه فكلَّمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلَّيت بيننا وبين الأمر، ثمَّ جعلته لنا بعدك. فقال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإنِّي لأراك الذي أُرِيتُ فيه ما أُرِيت، وهذا ثابت بن قيس، وسيجيبك عنِّي)، فانصرف النَّبيُّ. قال عبيدالله بن عبدالله: سألت عبدالله بن عبَّاس عن رؤيا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- التي ذكر، فقال ابن عبَّاس: ذُكِر لي أنَّ رسول الله قال: (بينا أنا نائم أريت أنَّه وُضِع في يدي سواران مِن ذهب، ففظعتهما وكرهتهما، فأُذن لي، فنفختهما فطارا، فأوَّلتُهما كذَّابين يخرجان). فقال عبيدالله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذَّاب[8]. ويؤثر أنَّ مسيلمة عاد إلى اليمامة وادَّعى النُّبوَّة ثمَّ أرسل إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول له: “مِن مسيلمة رسول الله إلى محمَّد رسول الله.. ألا إنِّي أوتيت الأمر معك، فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكنَّ قريشًا قوم يظلمون”.
وقد جاء في الحديث أنَّ العباس بن عبدالمطَّلب -رضي الله عنه- قال لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه، بعد أن خرج مِن عند رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مرضه الذي قُبِض فيه، فقال له: أنت واللَّه بعد ثلاث عبدُ العصا، وإنِّي واللَّه لأَرى رسول اللَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- سوف يُتوفَّى مِن وجعه هذا، إنِّي لأَعرِفُ وُجُوه بني عبدالمـُطَّلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول اللَّه فلنسأله فيمَن هذا الأمرُ، إن كان فِينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنَّا واللَّهِ لئن سألناها رسول اللَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- فمنعناها لا يُعطِينَاها النَّاس بعده، وإنِّي واللَّه لا أسألُها رسول اللَّهِ[9]. فالعبَّاس وعلي -رضي الله عنهما- كانا متطلِّعين للأمر، وفي حين أراد العبَّاس سؤال الرَّسول إيَّاها، أبدى علي حكمة في التَّعامل وترك الأمر لتشاور المسلمين، والتزم عدم سؤالها والسَّعي لها، لما يعلمه مِن النَّهي عن ذلك، ولما قد ينشأ مِن حرمان الرَّسول إيَّاهم كاحتمال وارد، كما في حديث أبي سعيد عبدالرَّحمن بن سَمُرةَ -رضي الله عنه، قال: قال لي رسول اللَّه -ﷺ: (يا عبدالرَّحمن بن سمُرَةَ.. لا تَسأَل الإمارة، فإنَّك إن أُعطِيتَها عن غير مسألة أُعِنت عليها، وإن أُعطِيتَها عن مسألة وُكلت إليها)؛ وحديث أَبي هريرة -رضي الله عنه: أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إنَّكم ستحرِصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة)[10].
وقد عقَّب الله تعالى بعد قوله سبحانه: ((تِلكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرضِ ولَا فَسَادًا)) بقوله: ((والعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ))[11] ، فيما يُظهر أنَّ الفريق الذي لا يريد علوًّا في الأرض ولا فسادًا لهم العاقبة في الدُّنيا، إذ مطلع الآية يشير لشأن الآخرة، فيما قد يسأل المرء: فما لهم في الدُّنيا؟ فجاء الرَّدُّ: “والعاقبة للمتَّقين”، كما جاء على لسان موسى -عليه السَّلام- لقومه: ((استَعِينُوا بِاللَّهِ واصبِرُوا ۖ إِنَّ الأَرضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ۖ والعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ))[12].
حفظ المنزلة والمرتبة:
إنَّ مما جُبِل عليه بنو آدم حفظهم لمنازلهم ومراتبهم التي تنزلهم إيَّاها أحسابهم، مِن الأخلاق والأفعال والمواقف، وألَّا تنزع عنهم طالما أنَّهم يقومون بواجبات تلك المنزلة والمرتبة. وفي هذا الإطار تأتي الإشارة إلى سليمان بوصفه (آل داود) تعبيرًا عن الامتداد المنهجي والسِّيري، في قوله تعالى: ((وَلَقَد آتَينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ والطَّيرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ * أَنِ اعمَل سَابِغَاتٍ وقَدِّر فِي السَّردِ وَاعمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلِسُلَيمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهرٌ ورَوَاحُهَا شَهرٌ وَأَسَلنَا لَهُ عَينَ القِطرِ ومِن الجِنِّ مَن يَعمَلُ بَينَ يَدَيهِ بِإِذنِ رَبِّهِ ومَن يَزِغ مِنهُم عَن أَمرِنَا نُذِقهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ * يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكرًا وقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورُ))[13]، فإنَّ سليمان -عليه السَّلام- سار في ملكه بسيرة والده، يقول تعالى: ((وَلَقَد آتَينَا دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ عِلمًا وقَالَا الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ المؤمِنِينَ * ووَرِثَ سُلَيمَانُ دَاوُودَ وقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنَا مَنطِقَ الطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الفَضلُ المبِينُ))[14].
ومما ثبت في السِّيرة النَّبوية، أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه، وهو يقدِّم القبائل لرسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، في مواسم الحجِّ، ليعرض نفسه عليهم ليقبلوا دعوته أو يقوموا بحمايته، كان يعدِّد مآثر ومفاخر كلِّ قبيلة، عارضًا أنسابها وأحسابها ومنزلتها في العرب، لأنَّ أمر حمل دعوة الرَّسول أو الدِّفاع عنه يحتاج لسند قوي، وقوم ذوي شوكة، وهذا لا يتأتَّى دون تصدِّر القبيلة لعظائم الأعمال ومكارم الأخلاق كابرًا عن كابر، بحيث يستشفُّ مِن تاريخها وسيرتها مدى إمكانية قيامها بمسئولية استضافة الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم، والدِّفاع عنه.
ونظرًا لما تميَّزت به قبيلة قريش مِن مكانة ومنزلة جاء في الحديث: (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في هذا الشَّأنِ، مُسلِمُهُم تَبَعٌ لِمُسلِمِهِم، وكافِرُهُم تَبَعٌ لِكافِرِهِم)[15]، والمقصود بالنَّاس هنا العرب. ذلك أنَّ قريشًا كانت تتميَّز بالمكانة الاجتماعية والدِّينية والاقتصادية، ما جعل العرب تنظر لها بعين التَّقدير والاحترام والتَّبجيل في ذلك الزَّمان، فلا تتقدَّمها.
وقد أثر أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، حين اشتدَّت وتيرة المعركة على المسلمين يوم حنين، وكادوا أن يُهزموا، وفرَّ الكثيرون عنه، قال: (أنا النَّبيُّ لا كذب، أنا ابن عبدالمطَّلب)، وابنُ عمِّه، أبو سُفيان بن الحارث بن عبدالمـُطَّلِبِ، يَقُودُ به بغلته. وقد قال ابن إسحاق في هذا الشَّأن: “وكان عبدالمطَّلب مِن سادات قريش، محافظًا على العهود، متخلِّقًا بمكارم الأخلاق، يحبُّ المساكين، ويقوم في خدمة الحجيج، ويُطعم في الأزمات، ويقمع الظَّالمين، وكان يُطعم حتَّى الوحوش والطَّير في رؤوس الجبال..، وكان رئيس بني هاشم وبني المطِّلب في حرب الفجَّار، شريفًا شاعرًا، ولم يدرك الإسلام”.
وفي السِّيرة، عندما أسلم أبو سفيان -رضي الله عنه، قبيل فتح مكَّة، وجاء إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم، قال العبَّاس للرَّسول: يا رسولَ اللَّهِ.. إنَّ أبا سفيان رجل يحبُّ الفخر، فاجعَل لَهُ شيئًا. قال: (نعَم، مَن دخلَ دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومَن أغلق عليه داره فهو آمن، ومَن دخل المسجد فهو آمن).

القيام بالأمانة وأداءها:
لقد أدرك الصَّحابة -رضي الله عنهم- أنَّ المسئوليَّات والمهام والوظائف الدِّينية والدُّنيوية أمانات، والله تعالى يقول: ((إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهلِهَا وإِذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا))، النساء: 58. وهم مخاطبون بأداء الأمانات والقيام بها، قبل غيرهم، خاصَّة مِنهم السَّابقين للإيمان، والذين اعتنى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- بتربيتهم وتوعيتهم وتأهيلهم للقيام بهذه المسئوليَّات، والأجدر أن يقوموا بها مِن غيرهم. ولهذا كان مِن كلام أبي بكر في السَّقيفة أنَّ يرشِّح لخلافة الرَّسول عمر بن الخطَّاب وأبا عبيدة عامر بن الجرَّاح، وجعل عمر بن الخطَّاب العهد مِن بعده في ستَّة، هم مِن أخصِّ النَّاس بالرَّسول وأقربهم إليه، وأكثرهم حملًا للمهام والأعمال التي وكَّلهم بها.
لهذا، عندما رشَّح عمر بن الخطَّاب السِّتَّة للخلافة بعده، وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرَّحمن بن عوف، رضي الله عنهم أجمعين، فوَّض سعد ما له في ذلك إلى عبدالرَّحمن بن عوف، والزُّبير إلى علي بن أبي طالب، وطلحة إلى عثمان بن عفَّان، فقال عبدالرَّحمن بن عوف لعلي وعثمان: أيُّكما يبرأ مِن هذا الأمر، فنفوِّض الأمر إليه ليولي أفضل الرَّجلين الباقيين، فسكت عثمان وعلي، أي أنَّهما كانا حريصين على ألَّا يخرجا مِن الاختيار، خلافًا للأربعة الآخرين الذين تنازلوا عنها لإخوانهم.
وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قُلتُ: يا رسول اللَّه.. ألا تستعملني؟، فضرب بيده على مَنكبي، ثمَّ قال: (يَا أَبَا ذَرٍّ.. إنَّك ضعيف وإنَّها أمانة، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة، إلَّا مَن أخذها بحقِّها، وأدَّى الَّذي عليه فيها)[16]. إذن فالرُّسول لم ينهه عن سؤال الأمر ولكن أرشده إلى ضعفه وعدم صلاحيَّته له. وإلَّا فلو كان سؤالها ابتداء منكرًا لنهاه عن ذلك، ولهذا أشار إلى أنَّ أخذها بحقِّها هو الأليق والأنسب.
السِّياسة ميدان اختلاف لا اتِّفاق:
البعض يتصوَّر أن السِّياسة ميدان اتِّفاق لا اختلاف، وهذا مِن أكبر الأخطاء التي يقع فيها العقل المسلم عندما ينحو للمثالية الغالية. فالخلاف على القضايا السِّياسية وقع في عهد الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- كثيرًا، فوقع بين المهاجرين والأنصار، وبين أبي بكر وعمر، وبين الرَّسول وأصحابه، وبين الكهول والشَّباب، والأمثلة على حضور الخلاف في مسائل الحكم والحرب والصُّلح والإدارة والعطاء والتَّعيين كثيرة. وهذا أمر طبيعي جدًّا، لأنَّ الخلاف حقيقة ظاهرة في البشر في كثير مِن أحوالهم.
وقد وقع الخلافات السِّياسية بين الصَّحابة بعد وفاة الرَّسول مباشرة، وذلك كالخلاف على مَن يخلفه، ثمَّ الخلاف مع أبي بكر على قتال المرتدِّين، ثمَّ الخلاف مع عمر على تقسيم سواد العراق، ثمَّ الخلاف مع عثمان على بعض اجتهاداته في الحكم، وكذلك مع علي أيضًا. ومِن هذه الخلافات ما حُسم نظريًّا وعمليًّا، ومِنها ما ظلَّ قائمًا نظريًّا وإن تباين الموقف العملي مِنها. ومِن هذه الخلافات ما ألجأ للقضاء، وبعضها للسَّيف، وهكذا.
إذن الظَّنُّ بأنَّ عالم السِّياسة الذي تتنافس عليه همم الرِّجال وعزائمهم وتطلُّعاتهم، وتتصادم فيه مسائل النُّفوذ وقضايا المصالح، وتتدافع فيه الولاءات والعصبيات، هو عالم ساكن وهادئ ومحلَّ إجماع، يخالف حقيقة الأمر في ذاته، خاصَّة وأنه عالم معقَّد ومضطرب. وبالتَّالي فما صدر عن الصَّحابة في هذا الشَّأن يطَّرد مع طبيعة المجتمعات البشرية والفطرة الإنسانية، فلا ينبغي الإنكار المطلق أو الاستياء مِنها. ولولا تلك التَّجارب والخبرات التي خلَّفها لنا الصَّحابة لما عرفنا شمول الشَّريعة وحقيقة التَّديُّن، فالتَّديُّن جهد بشري لا ملائكي.
عقيدة وإيمان:
وينبغي لنا، ونحن نتحدَّث عن الخلافات السِّياسية التي جرت بين الصَّحابة -رضوان الله عليهم أجمعين، أن نقرِّر مجموعة قضايا ثبتت بنصوص الوحي، مِن الكتاب والسُّنَّة، وبما ثبت مِن سيرتهم العطرة وتاريخهم المشرق. ومِن ذلك أنَّهم خيار الأمَّة، وأفضلها وأرفعها منزلة، على الإطلاق، فلا يدانيهم أحد ممَّن جاء بعدهم فضلًا عن أن يتجاوزهم. وأنَّ الله تعالى شهد لهم بالإيمان والهجرة والنُّصرة والولاء والعبادة والدَّعوة والجهاد وبالجنَّة كذلك. وأنَّ الله تعالى أخبر أنَّه قد غفر لهم ذنوبهم، وعفا عن سيِّئاتهم، وتجاوز عن أخطائهم، ورضي عنهم، بل وأحبَّهم. وأنَّ التَّطاول عليهم، والإساءة لهم، طعن في الدِّين، وانحراف عن الهدى. وأنَّهم رغم كلِّ ذلك غيروا معصومين، فيصِّح مِنهم الذَّنب، والخطأ، والتَّقصير، والهوى، باعتبار جبِّلتهم البشرية. وأنَّ هذا لا يقلِّل مِن شأنهم، ولا ينزع عنهم فضلهم وسبقهم ومكانتهم.
يقول ابن تيمية، في مجموع الفتاوى: “وممَّا ينبغي أن يُعلم أنَّه وإن كان المختار الإمساك عما شَجَرَ بين الصَّحابة، والاستغفار للطَّائفتين جميعًا، وموالاتهم، فليس مِن الواجب اعتقاد أنَّ كلَّ واحدٍ مِن العسكر لم يكن إلَّا مجتهدًا متأوِّلًا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء، وفيهم المقصِّر في الاجتهاد لنوع مِن الهوى، لكن إذا كانت السَّيِّئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. وأهل السُّنَّة تحسن القول فيهم، وتترحَّم عليهم، وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة مِن الإقرار على الذُّنوب، وعلى الخطأ في الاجتهاد، إلَّا لرسول اللّه -صلَّى الله عليه وسلَّم، ومَن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذَّنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى: ((أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنهُم أَحسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم..)) [17]الآية”.
وأفضل ما ينبغي في مثل هذا المقام ما يلي:
أوَّلًا: التَّثبُّت فيما روي عن الفتن والخلافات التي وقعت بينهم، وعدم اعتماد المصادر التَّاريخية على علَّاتها، خصوصًا ونحن نتعامل مع جيل التَّلقِّي والفهم والتَّنزيل والنَّقل إلينا. وبالتَّالي ينبغي أن يتمَّ التعامل مع تلك المرويَّات بمنهج المحدِّثين في التَّدقيق والتَّحقيق في سند الرِّوايات ومتنها.
ثانيًا: وضع المرويات في سياقاتها الزَّمانية والمكانية والظَّرفية، مع تغليب جانب إحسان الظَّنِّ، وتلمُّس العذر، ودون تهويل أو مبالغة.
ثالثًا: تحكيم ما عُلم عنهم في فضلهم وسابقتهم وخيريَّتهم فيما فعلوه، باعتباره امتدادًا لسيرتهم وتاريخهم، إذ لا يمكن أن يتَّهموا بانحراف أو نكوص أو ارتداد، والعياذ بالله عن الهدى والرُّشد. ووضع ما وقع مِنهم في دائرته الإنسانية البشرية، رضا وغضبًا، حبًّا وبغضا، إذ هم غير معصومين.
رابعًا: لا شكَّ أنَّ ما حدث بينهم تسبَّبت فيه عوامل عدَّة، بعضها يتعلَّق بفقه النُّصوص وتأويلها أو تنزيلها، وبعضها يتعلَّق بفهم مواقف الطَّرف الآخر ومقاصده، وبعضها يتعلَّق بالمؤامرات والدَّسائس التي كانت تحاك خفية بينهم، وبعضها يتعلَّق بتبدُّل الأحوال وتغيُّر المجتمع، وبعضها يتعلَّق بطبيعة الخلافات السِّياسية ومَن يدخل فيها طلبًا لمصلحة أو لثأر أو لعصبية. ولا ينبغي الوقوف في هذا الخلاف على سبب واحد، وعلَّة واحدة، لأنَّ هذا مِن سذاجة الفكر وضحالة الوعي.
خامسًا: التَّمييز بين المرويات التي لا تعطي إلَّا جانبًا مِن المشهد وبين المشهد الذي وقع فعليًّا، فإنَّ ما روي هي قصَّة مِن جانب واحد لا مِن كلِّ جوانبها. وهذا يتطلَّب الرُّجوع إلى المصادر المختلفة والرِّوايات المتعدِّدة، الثَّابتة والصَّحيحة، وجمع بعضها إلى بعض، وتفسيرها على ما ذكره أقرب النَّاس للأحداث التي جرت، فهم الذين خبروها وعايشوا أهلها.
سادسًا: التَّمييز بين التَّقييم العاطفي، والمستند للميول النَّفسية أو المشاعر، وبين التَّقييم المستند للأدلَّة والشَّواهد وللشَّرع الهادي والعقل الرَّاشد. فكثير ممَّن يتكلَّم عن أمثال -علي أو معاوية- في الظُّروف التي تمرُّ بها الأمَّة في ظلِّ غلبة التَّشيُّع وآثاره المدمِّرة يخلط بين الموضوعية والعاطفية، وردَّات الفعل والمنهجية العلمية، إذ هو يقرِّر ابتداء ثمَّ يستدلُّ بكلِّ ما يمكنه، ويرفض كلَّ ما يعارض طرحه ووجهة نظره، أو يغفل عنه.
سابعًا: التَّمييز بين الصَّحابة وتفاوتهم في الفقه والإيمان والعمل، وعدم استصحاب المثال الأعلى فيهم على الجميع، فليسوا جميعًا في منزلة أبي بكر أو عمر، بل هم درجات ومراتب، يختلف بعضهم عن بعض. فقياس النَّاس في مجتمع ما على حال المثل الأعلى هو غمط لهم، وغلو يؤدِّي إلى الظُّلم والجور في الأحكام.
ثامنًا: البحث والقراءة والاطِّلاع لمعرفة الصَّواب مِن الخطأ، وأخذ الدُّروس والعبر والعظات، لا لمحاكمة جيل مضى إلى ربِّه واستقبل ما وعده ربُّه، لأنَّ الله تعالى يقول: ((تِلكَ أُمَّةٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت ولَكُم مَّا كَسَبتُم ولَا تُسأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعمَلُونَ))[18].
التَّشكيك والطَّعن:
هناك نفسيَّات خبيثة، تجمع بين الجهل والحمق والحقد والمرض القلبي، لا ترى في الأشياء إلَّا جانبها السَّيِّء، مهما صغر وانحسر، لتقذف بذلك الآخرين وتسقطهم عن مكانتهم، سعيًا وراء إشباع غليل نفوسها المريضة وتشويه الحقِّ وأبطاله، والعدل ورجاله، والخير وأهله. ولهذا فإنَّ الدَّعوة للإمساك عمَّا جرى بين الصَّحابة تواكب مع ظهور فرض الرَّافضة الذين أطالوا ألسنتهم على مقام الصَّحابة قدحًا وذمًّا وشتمًا. وهو المنهج الذي ينبغي اتِّباعه مع كلِّ سفيه وطائش وخبيث، لأنَّ طبيعة الحديث مع هؤلاء عمَّا لا تبلغه عقولهم ولا تقف عليه قلوبهم بالأدب والإنصاف والتَّوقير، فتنة لهم وللمتكلِّم معهم أو المجادل لهم.
والعلم ليس لسانًا بذيئًا، أو تتبُّع للعورات والزَّلات بهدف إسقاط النَّاس عن مقاماتهم العالية، أو تشكيكًا في الثَّوابت مِن خلال المشتبهات، بل هو اعتماد على القضايا اليقينية، والأدلة الواضحة، والمناهج المنطقة الموضوعية، بغية العظة والاعتبار، ومعرفة الصَّواب مِن الخطأ، والممكن مِن المستحيل، والحقيقة مِن الكذب.
اعتراف الصَّحابة رغم خلافهم بفضل مخالفيهم:
قال إمام الحرمين، أبو المعالي الجُويني: “ومعاوية -وإن قاتل عليًّا- فإنَّه كان لا يُنكر إمامتَه، ولا يدَّعيها لنفسه، وإنَّما كان يطلب قتلة عثمان -رضي الله عنه، ظانًّا أنَّه مصيب، وكان مخطئًا”[19]. بل قد ورد عن أبي مسلم الخولاني أنَّه قال لمعاوية: أنت تنازع عليًّا أم أنت مثله؟ فقال: “لا والله، إنِّي لأعلمُ أنَّ عليًّا أفضلُ منِّي، وأحقُّ بالأمر منِّي، ولكن ألستُم تعلمون أنَّ عثمان قُتِل مظلومًا، وأنا ابن عمِّه؟! وإنَّما أطلب بدمه، فأتوا عليًّا فقولوا له فليدفع إليَّ قتلة عُثمان، وأسلِّم له”[20].
وقد كتب عليٌّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى أهل الأمصار كتابًا يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل صفِّين: “وكان بدءُ أمرِنا أنَّا التقينا والقوم مِن أهل الشَّام، والظَّاهر أنَّ ربَّنا واحد، ونبيُّنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتَّصديق برسوله -صلى الله عليه وسلَّم، ولا يستزيدُوننا، الأمر واحد، إلَّا ما اختلفنا فيه مِن دمِ عُثمان، ونحن مِنه براء”[21].
وكان علي يقول لأتباعه: “إنَّا لم نقاتلهم على التَّكفير لهم، ولم نقاتلهم على التَّكفير لنا، ولكنَّا رأينا أنَّا على حقٍّ، ورأوا أنَّهم على حقٍّ”[22]. بل كان يقول عنهم: “إخوانُنا بغَوا علينَا”[23].
ولا يثبت أبدًا أي نصٍّ صحيح صريح عنهم في طعن بعضهم في بعض، وشتم بعضهم لبعض، أو اتِّهام بعضهم لبعض بالكفر أو النِّفاق أو الفجور، بل إنَّ الخوارج استنكروا على عليٍّ عدم استباحة أموال خصومه وفروج نسائهم! لمـَّا رأوه يعاملهم معاملة الإحسان ويصلِّي على قتلاه وقتلى معاوية جميعًا، ويدعو لهم!
الهوامش:
- الكهف: 110.
- متفق عليه.
- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: ص١٢٩.
- مجموع الفتاوى: ج35/73.
- متَّفق عليه.
- البخاري: 4210.
- مختصر الفتاوى المصرية: ص564.
- صحيح البخاري: 4378.
- صحيح البخاري: 4447.
- صحيح البخاري: 7148.
- القصص: 83.
- الأعراف: 128.
- سبأ: 10- 13.
- النمل: 15- 16.
- صحيح البخاري: 3495.
- رواه مسلم: 1825.
- الأحقاف: 16.
- البقرة: 134.
- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: ص129.
- سير أعلام النبلاء، للذهبي: ج2/523.
- نهج البلاغة: ج3/85- 86.
- قرب الإسناد: ص313.
- قرب الإسناد: ص318.