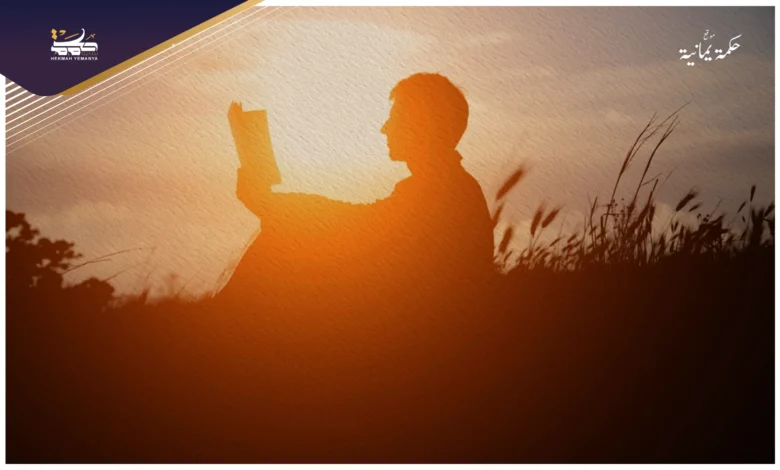
نتعلم القراءة في طفولتنا؛ فهي تصبح مهارة لفك طلاسم الكلمات التي يراها الأمي غامضة. نستخدمها في المدرسة، ثم الجامعة، وتمضي الأعوام دون أن ندرك أن لدينا مهارة تحتاج إلى عناية وتطوير، في القانون العسكري يُعاقب القائد الذي يرسل الجندي إلى الحرب دون سلاح، بينما لا يُعاقب القانون التَّعليمي المعلم حين يرسل تلميذه دون سلاح إلى الحياة. وسلاح التِّلميذ هو القراءة، والكتابة، والإلقاء.
سندردش هنا عن القراءة، أمَّا الكتابة والإلقاء فلها مقام آخر. القراءة تؤثر على من يستخدمها باستمرار؛ إذ تسهم في تشكيل الوعي، وتوسيع أدوات الإدراك، وفتح آفاق العقل. لكن الأمر يختلف من قارئٍ إلى آخر بناءً على القدرات العقلية، والأساليب، والعادات التي يتبعها القارئ أثناء القراءة.
يقول علي عزت بيجوفيتش: “على القارئ أن يكون مثل النَّحلة تهضم ما تأكل لتنتج لنا العسل.” يقصد بذلك أن قراءة الكتب تحتاج إلى تحليل واستيعاب، وأن يكون هناك أثر ملموس لما نقرأه. أما الفيلسوف الإنجليزي جون لوك فقد تحدَّثَ في كتابه “مسلك الفهم” عن آلية القراءة الصحيحة، وخلص إلى خمسِ نقاط:
1. القراءة في كل شيء لا تعني فهم كل شيء؛ فالقراءة تزود الذهن بمواد المعرفة، لكن التفكير هو الذي يجعل ما نقرؤه ملكًا خاصًا لنا.
2. ليس كل ما هو موجود في الكتب صحيحًا؛ فلا بد من الدراسة والتمحيص لكل ما نقرأ.
3. التفحص العميق ضروري لاكتشاف الحقيقة، فلا تُسلّم عقلك لأي كتاب.
4. انتقاء الكتب المفيدة، إذ يقول جون لوك: “إن من يمضي بخطوات ثابتة راسخة في المسار الذي يشير إلى ما هو صحيح، سرعان ما يصل إلى الغاية من رحلته، وعلى نحو أسرع بكثير من ذلك الذي يجري وراء كل ما يلفاه في الطريق، رغم أنه يعدو طوال النهار بأقصى ما لديه من سرعة.”
5. عندما تعتاد على التفكير فيما تقرأ، سيعتاد ذهنك على الاستنتاج السريع وإعادة تدوير الأفكار.
من خلال هذه النقاط، يمكن للقارئ بناء ملكته النقدية الخاصة واستغلال مهارة القراءة بشكل أمثل. لكن البعض يقرأ دون تفكير أو تأمل، وإنما مجرد مرور على الصفحات. في هذا السِّياق، يذكر الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل في كتابه “تاريخ القراءة”: “القراءة ليست عملية أوتوماتيكية لحصر النَّص، مقارنة بانتقال الصورة إلى الفيلم عند إجراء التَّحميض الضوئي، بل إنها عملية استنساخ معقَّدة ومُحيّرة ومذهلة تحدث بصورة متشابهة عند جميع النَّاس. لذا فإنَّ القراءة عملية خلاَّقة وإبداعية تُعبِّر عن محاولة القارئ المنتظمة لإنشاء وتكوين معنى واحد أو أكثر ضمن أحكام اللغة وقواعدها.” فالقراءة سلاح إبداعي إذا أحسنا تطويره.
دومًا ما يُصنِّف القرَّاء الكتب إلى صنفين: جيد ورديء. لكن ماذا لو عكسنا الأمر ليصبح التَّصنيف مرتبطًا بنوعية القراءة ذاتها (قراءة جيدة، قراءة رديئة)؟ حينها ستختلف نظرتنا للكتب، وسنزيد اهتمامنا بتطوير مهاراتنا القرائية. بذلك، نستخلص الفائدة حتى من الكتب الرديئة.
إضافة إلى ذلك، القراءة الجيدة لا تقتصر على الكتب فقط، بل تمتد إلى قراءة المواقف، والشخصيات، والأحداث من حولنا. مع مرور الوقت، سندرك أننا صنعنا فلترًا ذهنيًا من خلال مهارة القراءة.
من جهة أخرى، وبعد إتقان آلية القراءة الصحيحة، يغيب عنا أحيانًا الهدف الحقيقي منها. في كتاب “اللغة والتفسير والتواصل” للدكتور مصطفى ناصف، وهو من إصدارات عالم المعرفة (كتاب أنصح به عشَّاق القراءة)، تحدَّث المؤلف عن القراءة وضياع الهدف الحقيقي منها. يقول: “لقد جعلنا الجدل حول الكتاب والنص صناعة ماهرة مغرية، وفي خضم هذه الصناعة ضاع قدر من الاهتمام الإنساني الحق، واختلط البحث عن الدراسة بقراءة الكتاب. إننا نتحدث عن الكتاب أحيانًا حديث من يريد أن يفسح لنفسه السبيل في الدنيا. إننا حتى الآن لا نعرف يقينًا كيف يمكن أن تكون القراءة أداة نمو وكمال، أداة كسب للإخلاص، والتواضع، وحسن الإصغاء”.
لقد وضع ناصف يده على جرح القُرّاء الخفي؛ فنحن غالبًا نقرأ للاستعراض أو النقد، نقرأ لحفظ المعلومة وإعادة طرحها. أي أننا نحب أنفسنا لا القراءة، وندّعي الثقافة متناسين أصل الكلمة.
عند بداية قراءة أي كتاب، علينا أن نتساءل: ما الهدف الحقيقي من قراءتنا؟ الإجابة تكمن في فهم أعمق لطبيعة القراءة كعملية تحويلية، القراءة ليست مجرد تلقي سلبي للمعلومات، بل هي حوار مستمر بين القارئ والنَّص.
فالقراءة الإنتاجية، على عكس الاستهلاكية، تحول النص إلى معرفة حية تتفاعل مع واقع القارئ وتجاربه، وتجعل منه منطلقًا لإنتاجِ المعنى، ومع وفرة المعلومات في عصرنا الرَّقمي، نواجه تحديًا في تحقيقِ القراءة الواعية التي تجمعُ بين السَّرعة والعمق.
أخيرًا، تبقى القراءة رحلة مستمرة نحو اكتشاف الذَّات والعالم، كل قراءة جديدة هي فرصة لإعادة اكتشاف أنفسنا وتجديد فهمنا للحياة، ولعل مولانا جلال الدين الرومي كان مصيبًا حين قال: “لا يزال المرء أميًا حتى يقرأ ذاته، ولن يقرأ المرء ذاته حتى يُقال لقلبه: اقرأ”.

