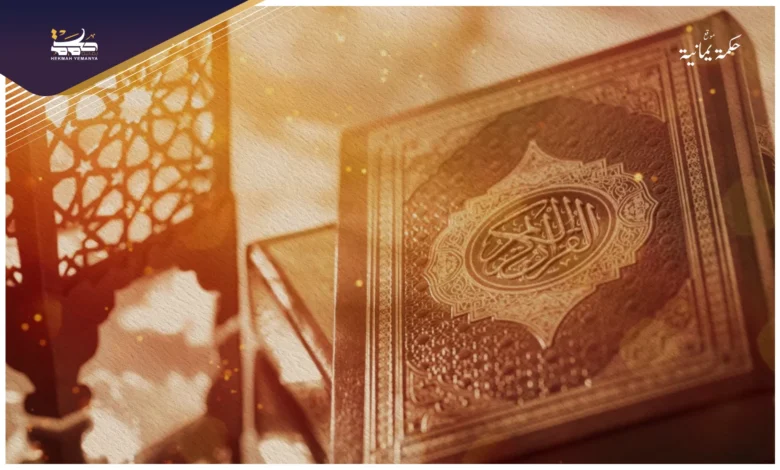
ما فتئت المكتبة القرآنيَّة تزداد تشعُّبًا مع مضيّ الأحقاب، وتتولَّد فيها الكثير من المجالات والحقول والفروع البحثيَّة والدرسيَّة؛ ناهلةً من هذا النص المدهش الفريد، الذي لولا تفرُّده ما كان قيام كل هذه العلوم بتشعُّباتها. وفي العصر الحديث، نهضتْ عدة مجالات جديدة للجهود العلميَّة في الدراسات القرآنيَّة. مثل مجال التفسير المَوضُوعي الذي استولى على جزء ضخم من جهود المُحدثين، ومِثل مجال الوحدة البنائيَّة القرآنيَّة الذي بدأه د/ محمد عبد الله دراز، في كتابه “النبأ العظيم”، ومِثل مجال المقاصد الذي بدأ بإعادة نشر كتاب “الموافقات” للشاطبيّ (ت 790هـ)، ثم تفريع الجهود البحثيَّة المقاصديَّة بين التشريع والقرآن.
ولقد قامت هذه الأشكال الجديدة -ذات الأصول القديمة- برفد الواقع المعيش بالكثير من الرؤى المُساعدة والداعمة في استمرار التواصل الحضاري مع النص القرآني، وتجديد تعلُّق وفهم الأجيال الأحدث بهذا النبع الإسلامي الأعظم، بصور أشد تلاؤمًا وأوسع قبولًا من الأنماط التفسيريَّة التحليليَّة المُعمَّقة المَوضِعيَّة، لا المَوضُوعيَّة -حسب تعبير الشيخ/ محمد الغزالي-؛ التي تشمل الكثير من التفاصيل التي تهم ذوي الاختصاص وأصحاب الصنعة، ولا تتكامل مع الدرس الحديث لسائر الفروع الإسلامية.
ومن بين تنوُّعات فرع المقاصد القرآنيَّة، تبرز مقاصد القصص القرآنيَّة مجالًا شديد الأهمية على صعيدَيْ الدرسِ القرآني في تكامله المعرفي مع المقاصد العامة للإسلام، والقارئِ العامِّ في تثقيفه الإسلامي. وهذا الصعيد الأخير تتعالى أهميته في ظل ما يتسم به العصر من عوامل مُشتتة مُبعِدة عن نظرية القيم والأخلاق الإسلامية إلى كثير من الرؤى والمشارب المُغايرة، التي تغلب عليها النوازع الماديَّة المحضة.
ولقد كان لقصة أهل الكهف، التي وردت في الآيات (9 : 26) من سورة الكهف، والتي سُميت باسمها السورة؛ أهمية عظمى في ترسيخ المنظومة العقديَّة والقيميَّة التي تتعلق بالعقيدة، وفي مواجهة هذا العصر المليء بالفتن والضلالات والمُنتجات الحضارية التي تشوب الصفاء العقدي الإسلامي، بل تصيبه في عمقه. فالقصة تحمل تعضيدًا واضحًا للإيمان الصحيح في زمن فتنة، ومناقشةً لمنهج التحرِّي العقدي، ونبراسًا لأخلاق المؤمنين في أزمان الفتن.
ولهذه الأهمية، ولمساوقة مقاصد القصة للعصر المعيش؛ تبرز إشكاليَّة البحث في فحص المقاصد القرآنيَّة في القصة، وإبرازها، وتجلية الأغراض العقديَّة والأخلاقيَّة التي بثَّها القرآن بين ثنايها. ولا يستقيم هذا الفحص إلا بالتهيئة التعريفيَّة بالمقاصد القرآنيَّة، وبالمقاصد العامة لسورة الكهف -التي تمثل السياق- للقصة الواردة فيها.
وقد اعتمدتُ في تجلية الأمر كله منهجَيْنِ مُلائمين لطبيعة الموضوع؛ هُما المنهج التحليلي والتأمُّلي، بما تقتضيهما طبيعة الموضوع المبحوث. مع الاعتماد على مصادر التفسير الموثوقة الواردة في جريدة المصادر والمراجع.

في المقاصد القرآنيَّة
أولًا: نبذة عن تاريخ الدراسات المقاصديَّة
لقد كان[1] نشر كتاب “المُوافقات” للإمام الشاطبي المالكي (ت 790هـ)، على يد الشيخ/ عبد الله دراز؛ فاتحة خير على الدراسات المقاصدية في العصر الحديث. فقد تلاها كتابة الشيخ/ الطاهر بن عاشور لكتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية”، ثم علال الفاسي في كتابه “مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها”، وكتاب “نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي” د/ أحمد الريسوني. لتنتقل هذه السمة المقاصدية إلى الدراسات القرآنية، مُستعينةً بالفرع الذي اشتدَّ عوده “التفسير الموضوعي”، ومجال الوحدة الموضوعية القرآنية التي شارك فيها د/ محمد عبد الله دراز -ابن الشيخ دراز- بكتابه “النبأ العظيم”، وسيد قطب في تفسيره “في ظلال القرآن”، والشيخ محمد الغزالي في كتابه “نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم”، وكتابه “المحاور الخمسة للقرآن الكريم”. وأخيرًا بالفرع الذي انتشر بشدة في السنوات الأخيرة، والذي يشترك تحت اسم “تدبُّر القرآن” وما هو إلا نشاط تأملي ذاتي للقرآن، مثل كتاب “أول مرة أتدبر القرآن” لعادل محمد خليل.
هذا، وقد انتشرت الدراسات المقاصدية، وتوزَّعتها المشارب المختلفة؛ المخالفة للمنهج الإسلامي العام، والمتفقة معه. ودُشِّنت للدراسات المقاصدية أقسام في الجامعات العربية المختلفة، وأقيم عدد من المعاهد المتخصصة فيها.
ثانيًا: في التأصيل للمقاصد القرآنيَّة
لقد حثَّ القرآن الكريم على ضرورة تأمل آيات القرآن وتدبرها من العباد المؤمنين، فذكر -من بين آيات كثيرة- (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)[2]؛ غير ما دعا إليه من ضرورة النظر المتأمل في آيات الله الكونية (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ)[3]. مما يؤكد على أن الوصول إلى مقاصد الله في الكون مطلب شرعي أصيل.
ففرع المقاصد القرآنية -نشاطًا تأمليًّا تدبُّريًّا- ليس مُستحدثًا في شيء، إلا في الإفراد بالتصنيف. فهو متواتر في التصنيف التفسيري الاعتيادي؛ حيث يُعرِّف السيوطي التأويل بقوله: “والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون لمعاني الخطاب، الماهرون في آلات العلوم”[4] فهو ينضوي -كما هو واضح- تحت لواء التأويل وإعمال الفكر في القرآن. بل إن الإمام الزركشي يقول في “البرهان”: “أصلُ الوقوف على معاني القرآن التدبُّرُ والتفكُّرُ … إذا كان العبد مُصغيًا إلى كلام ربه، مُلقِيَ السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، ناظرًا إلى قدرته، تاركًا للمعهود من علمه ومعقوله، متبرئًا من حوله وقوته، مُعظمًا للمتكلم، مُفتقرًا إلى التفهُّم، بحالٍ سليمة وقلب سليم، وقوة علم”[5].
وهذا الفرع يتناصّ مع الفروع الجديدة، فنرى باحثًا يُعرِّف “التفسير الموضوعي” بقوله: “جمع الآيات المتفرِّقة في سور القرآن الكريم، المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حُكمًا، وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية”[6].
والمقاصد القرآنية -كما سبق- تنضوي تحت الإطار التفسيري العام. وأرى أن دعامتها ومُسلَّمتها هي الإعجاز القرآني؛ فالاستقرار على فكرة الإعجاز وعلى أن نص الشارع حكيم أصَّلَ لمشروعية استنباط المقاصد من الآيات بتوسُّع؛ حيث لا يصحُّ هذا الإجراء على غيره من النصوص الإنسانية التي تتصف بالمحدودية والقصور.
ويخالف التفسيرُ المقاصدَ القرآنيَّةَ في الهدف والآليات. فالتفسير هدفه تحليل الآيات في كامل هيئتها، والتعامل مع أدق بنائياتها تدرُّجًا، معتمدًا على منظومة ضخمة من العلوم والمعارف. أما المقاصد فهدفُها إدراكُ المُرادِ والغرضِ من الآيات دون البنية المُوصلة، مُعتمدةً على التفسير نفسه والعمل العقلي في الربط بين المقاصد العامة للإسلام، والمعاني الدقيقة للآيات. فالمقاصد نشاط ما بعد تفسيريّ.
فالمقاصد القرآنية فرع عن تفسير الآيات، يستهدف المرامي الكلية والجزئية التي وردت بها. وهي نشاط تحليليّ تأمُّليّ، يتغيَّى الوصول إلى الأغراض المحضة التي قصد إليها القرآن في خطابه إلى البشر. وعليه، فالمقاصد هي زُبدة التفسير وقمته، لا كل التفسير.
وبالنظر في الآيات الحكيمة، تبرز -في نظري- صلاحيةُ تقسيم المقاصد إلى مقاصد مباشرة أو سمعية: وهي التي أوردها النص القرآني صراحةً دون مواربةً، بل نصَّ على أنها مقصده، ومقاصد غير مباشرة أو مُستنبَطَة: وهي المقاصد الخفية أو الواردة بين ثنايا وتضاعيف الآيات نفسها، دون تصريح بها.
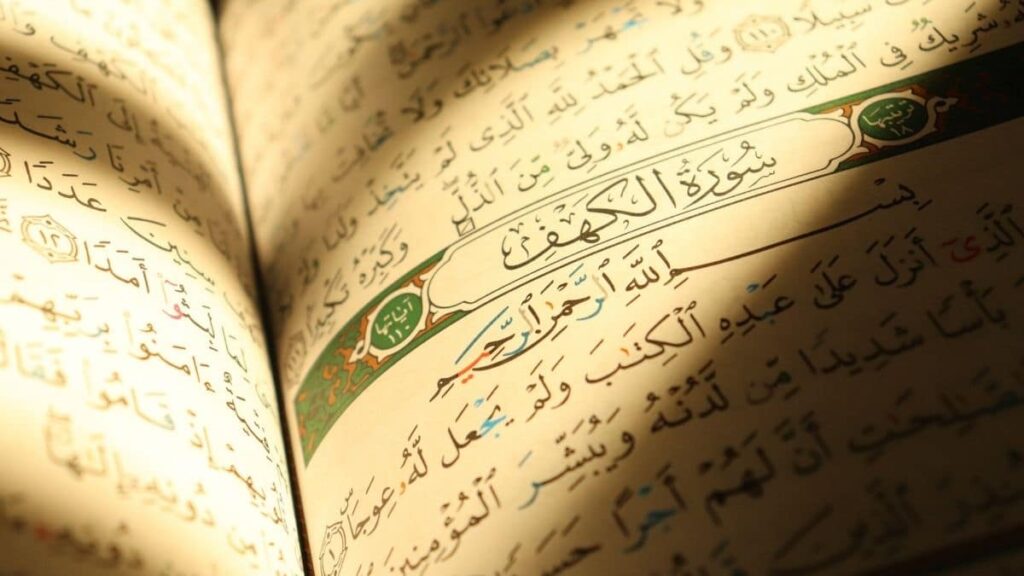
المقاصد القرآنيَّة العامة في سورة الكهف
قصة أهل الكهف وردت في سورة الكهف، فهي جزء من السورة، والسورة سياقٌ للقصة حاوٍ لها. سورة الكهف سورة مكية، آياتها 110، نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي السورة الثامنة والستون في ترتيب النزول. وتعدُّ السورة سورة قصصيَّة؛ حيث تضمنت خمس قصص. ولتمامِ النظرِ فيها والخُلُوصِ لمقاصدها؛ تتعيَّنُ معرفة شيء عن مقاصد القصص في القرآن، وشيء عن المقاصد العامة في سورة الكهف.
أولًا: مقاصد القصص في القرآن
القصص في القرآن شديد الأهمية، ولا أدلَّ على أهميتها من تلك المساحة الشاسعة التي أُفردت لها في جنبات النص القرآني؛ مما يؤكد أنها لم ترد عَرَضًا، أو لهدف قليل الأهمية؛ بل هي من صُلب الخطاب القرآني للعباد، على جانبين: تصحيح الوارد في شأن الأنبياء من موروثات الأمم السابقة، وتضمين الرسائل والعِبَر المباشرة من خلال القصة الحقيقيَّة المعروضة. وبهذا تصير من أهم أدوات صلاحية القرآن لمخاطبة البشر على امتداد الأعصُر. يقول القرآن (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ)[7].
والقصص في القرآن تكتسب هذا السمت الساحر من النظم القرآني الفريد، الذي لا مثيل له؛ مع كونها لا تعدو الحقيقية في شيء -والقصص غير الأمثال القرآنية التي تخاطب العقل دون تقيُّد بالحدث الواقع-، وهذا ما أكَّدتْ عليه آيات كثيرة. ومنها (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)[8]، وقد أدان القرآن رأي المشركين الذين وصفوا قصص القرآن وما ورد فيه بأنها محض أحاديث دون استنادات واقعية، فقال (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)[9]. وتوعَّد مَن يقول ذلك بالعذاب الشديد، فقال (وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ)[10].
ويؤكد سيد قطب أن القصة في القرآن ذات أغراض دينية محضة، ومن أهم أغراضها إثبات الوحي والرسالة، وبيان أن الدين كله من عند الله، وأنه موحد بين الرسل جميعًا، وأن الله ينصر أنبياءه في آخر الأمر، وضرورة تصديق التبشير والتحذير من خلال النموذج التاريخي الواقعي الذي حدث بين الناس، وبيان غواية الإنسان من الشيطان، وبيان قدرة الله على كل شيء[11].
أما عن تصنيف قصة أهل الكهف -خاصةً-؛ فهي من النوع الثاني من القصص القرآني -كما يصنفها أحد الباحثين-: فإن النوع الأول هو قصص الأنبياء، والثاني قصص أشخاص ليسوا أنبياء، والثالث قصص ما حدث أيام الرسول ﷺ. ومن حيث شكل وُرُودها في القرآن فتتبع الشكل الأول؛ فالأول ما ورد كاملًا مرةً واحدةً، والثاني ما ورد مُجزَّأ مُكرَّرًا، والثالث ما ورد قصيرًا مرةً واحدةً[12].
وقصة أهل الكهف تحكي معجزة خارقة للعادة؛ فقد كان فتية في الزمن الأقدم، اختلف في أمر دينهم المفسرون، فذهب بعضهم أنهم كانوا يهودًا، وذهب آخرون إلى أنهم كانوا نصارى[13]. وقد رجَّحَ “ابن كثير” أنهم كانوا يهودًا من سبب النزول؛ فلولا أنهم يهود ما اهتمَّ بهم أحبار اليهود الذين أرسلوا في السؤال عنهم[14]. آمن هؤلاء الفتية بالله الواحد الأحد، وسط مجتمع وثني، فافتُضِحَ أمرُهم، فحاججوا الملك في أمر دينهم، ثم رأوا أنهم هالكون إنْ لم يهربوا. فهربوا إلى كهف في جبل -اختلف المفسرون في تحديده-، حيث أنامهم الله أكثر من ثلاثمائة سنة. ثم ردَّ عليهم اليقظة، ليخرجوا إلى مجتمع جديد مؤمن، ويُكشف أمرُهم في هذا المجتمع، ويعجب أهلها من قدرة الله -تعالى- على بعث اليقظة في أناس، مما يؤكد على بعث الأرواح في الأجساد، ومما يؤكد على ثبوت يوم القيامة والحساب. وهي قصة محشودة بالمعاني السامية العقدية والأخلاقية.
ثانيًا: في مقاصد سورة الكهف
من أَوْلَى الأسباب التي تكشف عن معاني آيات أو سورة معرفةُ سبب نزولها في وقتها، ولهذا أقام المفسرون فرعًا مستقلًا لأسباب النزول. وفي سبب نزول سورة الكهف، أورد السيوطي هذا الخبر: “بعثتْ قريشٌ النضرَ بن الحرث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما: سلاهم عن محمد، وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة، فسألا أحبار اليهود عن رسول الله ﷺ، ووصفا لهم أمره وبعض قوله. فقالوا لهم: سلوه عن ثلاثٍ، فإنْ أخبركم بهنَّ فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؛ فإنه كان لهم أمر عجيب. وسلوه عن رجل طوَّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح، ما هو؟ فأقبلا حتى قدما على قريش، فقالا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. فجاؤا رسول الله ﷺ، فسألوه. فقال: أخبركم غدًا بما سألتم عنه، ولم يستثنِ[15]. فانصرفوا ومكث رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحيًا، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة، وحتى أحزن رسول الله ﷺ. مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله (ويسألونك عن الروح)”[16].
فهي سورة مثَّلتْ أحد التحديات والاختبارات التي واجَهَ العربُ بها النبي ﷺ في صدر دعوته في مكة. ومن هنا تكتسب تلك الأهمية العظمى؛ ففيها يأتي البرهان على صدق الدعوة المحمدية التي يخبر فيها رسولها بما لم يشهد، ولم يُنقل له.
سورة الكهف -كما سلف- تنبني على قصص خمس وتعليقات وتعقيبات عليها. وهي: قصة أصحاب الكهف، قصة صاحبي الجنتين، قصة آدم وإبليس، قصة موسى مع العبد الصالح، قصة ذي القرنين. ويتضح من هذه القصص مجتمعةً تلك المقاصد العامة التي تكتنف السورة. وأهمها إثبات الوحي بإيراد تلك القصص ردًّا على سؤالات اليهود إلى النبي -التي سلف ذكرها-، وكذلك تثبيت قلب النبي والمؤمنين الأوائل بهذه القصص المُشابهة لهم ولحالهم، من صراع المؤمنين مع الكافرين والظالمين.
ويرى الأستاذ سيد قطب أن سورة الكهف تتمحور في أهداف عامة، هي: تصحيح العقيدة، وتصحيح منهج النظر والفكر، وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة[17].

المقاصد العَقَديَّة في قصة أهل الكهف
محور العقيدة هو أهم محور في القرآن كله، بل يكاد يهيمن على كامل النص القرآني -إجمالًا أو تفصيلًا-. وقد سيطر المقصد العقدي على القصص القرآني -كما سلف-، وليست قصة أهل الكهف من الأمر بدعًا؛ فهذا أهم محور سيقتْ له هذه القصة، وتمحورت حوله. وسأسوق ما جاء فيها من مقاصد تحت عناوين فرعية، بها الآية أو الآيات الدالة على المقصد القرآني، وأهم ما فيه من حديث.
أولًا: التدليل على صحة الدعوة المُحمديَّة
وقد ورد هذا في سبب نزول القصة، بل السورة كلها، من سؤال اليهود النبي ﷺ عن هؤلاء الفتية، وخبرهم وما جرى لهم. وقد أكدَّتْ الآيات على هذا المقصد في آية (نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ)[18]. والمقصد من هذه الآية التقرير الكامل لهذا المعنى؛ فقد ساقت الآيات وقوع الاختلاف في تفاصيل هذه القصة (لِنَعۡلَمَ أَيُّ ٱلۡحِزۡبَيۡنِ أَحۡصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدٗا)[19]. يقول القرطبي: “لما اقتضى قوله تعالى (لِنَعۡلَمَ أَيُّ ٱلۡحِزۡبَيۡنِ أَحۡصَىٰ) اختلافًا وقع في أمد الفتية؛ عقب بالخبر عن أنه -عز وجل- يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع”[20].
وتتعاضد هذه الآية مع غيرها من الآيات المذكورة في القصص القرآني، التي تخبر أن النبي ﷺ ما كان يعلم هذه القصص، وما كان حاضرًا ساعةَ وقوعها؛ فالخيار المنطقي الوحيد أنها وحي من إله الكون العالِم بكل شيء. ومن هذه الآيات (ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)[21]، وكذلك (ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ)[22].
ثانيًا: إثبات البعث يوم القيامة
وقد ورد هذا المقصد في آية (وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ)[23]. وهنا يوضح الإمام البيضاوي المعنى في صورة مشرقة بارعة. يقول: “(وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ) وكما أنمناهم وبعثناهم لتزداد بصيرتهم أطلعنا عليهم (لِيَعۡلَمُوٓاْ) ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم (أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ) بالبعث أو الموعود الذي هو البعث، (حَقّٞ) لأن نومهم وانتباههم كحال مَن يموت ثم يُبعث (وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيهَآ) وأن القيامة لا ريب في إمكانها؛ فإن مَن توفَّى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنين حافظًا أبدانهم عن التحلل والتفتُّت، ثم أرسلها إليها قادرٌ أن يتوفى نفوس جميع الناس مُمسكًا إياها إلى أن يحشر أبدانهم فيردُّها إليهم”[24].
وهنا نجد الآيات تستعمل القياس المنطقي في إثبات البعث يوم القيامة، وتأييد البعث بالأجساد والأرواح لا الأرواح فقط. فتقيس إمساك اليقظة عنهم بإمساك الرُّوح عن الميت، ثم بثّ اليقظة إليهم ببث الروح في الأجساد. وقد قَرَنَ القرآن من قبل حالتَيْ الموت والنوم في قوله (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[25]. وهذا، ومثل هذه الآيات تفصل في الاختلاف الذي دار بين بعض الطوائف -مثل الفلاسفة المَشَّائين المسلمين-، التي مالتْ إلى ردَّ بعث الأجساد، وأن البعث للأرواح وحسب.
ثالثًا: ضرورة التأمل في إشارات الله، والتساؤل عنها
وقد ورد هذا المقصد في آية (وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ)[26]. فكما يرى الناظر في الآية؛ فقد عُبِّر عن “العُثُور” بصيغة “الإعثار” التي تدلُّ على القصد والإرادة المخصوصة، فإن الله يبث آياته في الكون ليتأملها الناس، وقد ترك الكثير من الآيات الخاصة -فالآية العامة هو الوجود نفسه- ليظل الناس متأملين في هذا الخلق العجيب الذي لا تنضب عجائبه. كما قال تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)[27]. وكذلك نلحظ أن الآية قَرَنت بين الإعثار وبين العلم؛ في إشارة واضحة لضرورة التأمل في تلك الآيات الربانية.
وقد ورد هذا المقصد أيضًا في قوله (وَكَذَٰلِكَ بَعَثۡنَٰهُمۡ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيۡنَهُمۡۚ)[28]. يقول المفسر “عبد الرحمن السعدي”: “(وَكَذَٰلِكَ بَعَثۡنَٰهُمۡ) أيْ من نومهم الطويل. (لِيَتَسَآءَلُواْ بَيۡنَهُمۡۚ) أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة”. ويقول في الموضع نفسه: “وقد دلَّت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك”[29].
رابعًا: استئثار الله بالعلم والتدبير في الكون، بالأسباب ودونها
ومن أعظم مقاصد هذه القصة إبراز التأكيد على تفرُّد تصرُّف الله في الكون، وعلمه بما هو كائن وما يكون -يُقصد هنا من جهة البشر-. وورد هذا المقصد في عدد من الآيات. هي: (أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا)[30]. وهنا نجد خرقًا للعادة، أيْ تقرير أن أهل الكهف في المعجزات التي تخرق المستحيل العادي، لا العقلي. فهي خرق لمعتاد الناس ومألوفهم، وهي خرق للأسباب التي وضعها الله في الكون؛ فإنَّ ما جرى للفتية في الكهف من تعاقب الدهور مُفضٍ -حتمًا- في العادة الإنسانية إلى الهلاك. لكن الله كما يضع أسباب الكون، يصرفها أنَّى شاء.
ومن تصرفه في أسباب الكون (وَتَرَى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمۡ فِي فَجۡوَةٖ مِّنۡهُۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ)[31]؛ حيث منع الشمس في شروقها وغروبها أن تمس فجوة الكهف؛ حتى لا تمتدَّ إليهم عوامل الفناء. فيغير الله في كونه ما شاء من أسباب ظاهرة، فهو صاحب هذه الأسباب وصاحب الخلق جميعًا. وكذا (وَتَحۡسَبُهُمۡ أَيۡقَاظٗا وَهُمۡ رُقُودٞۚ وَنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِۖ وَكَلۡبُهُم بَٰسِطٞ ذِرَاعَيۡهِ بِٱلۡوَصِيدِۚ لَوِ ٱطَّلَعۡتَ عَلَيۡهِمۡ لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارٗا وَلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبٗا)[32]؛ حيث قلَّبهم الله ليحفظ أجسادهم، وجعل في منظرهم الرعب كي يحتموا من تطفُّل المُتطفلين.
وكذلك في الآية (نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ)[33]، التي تدلُّ على كمال علم الله بكل شيء. وكذلك في الآية (وَكَذَٰلِكَ بَعَثۡنَٰهُمۡ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيۡنَهُمۡۚ)[34]، التي تبين سطوة الخالق على مخلوقاته. وكذا في (وَكَذَٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ)[35]، التي تزيد بيان تصرف الله في الأسباب. وكذا في خطاب الله للنبي ﷺ (قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم)[36]، وفي الآية (قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا)[37]؛ وكلتاهما تدلان على أن الله متصرف في كل شيء، وأن من مفردات أصول الإيمان رسوخ ذلك الاعتقاد في نفوس المؤمنين.
خامسًا: الهداية والإيمان لا تتمَّانِ إلا بإذن الله وتوفيقه
وقد ورد هذا المقصد في الآية (فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا)[38]، التي تبين طلب الفتية الهداية والرشاد من الرحمن. يقول ابن كثير: “أيْ اجعل عاقبتنا رشدًا، كما جاء في الحديث: “وما قضيتَ لنا من قضاء فاجعلْ عاقبته رشدًا”، وفي المُسند من حديث بشر بن أرطأة، عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو: “اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة”[39]. ويظهر أثر هذه الدعوة والطلب في آية (إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى (13) وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ)[40]. يقول البيضاوي: “( ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى) بالتثبيت، (وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ) وقويناهم بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال، والجُرأة على إظهار الحق والرد على دقيانوس الجبار”[41]. وكذلك في آية (مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيّٗا مُّرۡشِدٗا)[42] تدلُّ على توفيق الله للعباد، وأنه الهادي الحق، وأن هدايته هي الهداية. وقد تعاضد هذا المعنى كثيرًا في القرآن الكريم، ومنه قوله (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)[43].
سادسًا: تأكيد الحاجة إلى علم بُرهاني بالعقائد
وهذا من أهم ما ساقته الآيات من مقاصد خفية، ومن أطلى ما جال إليه نظري، أثناء تأملي في الآيات. وقد ورد هذا المعنى في عدد من آيات القصة. أولها (هَٰٓؤُلَآءِ قَوۡمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗۖ لَّوۡلَا يَأۡتُونَ عَلَيۡهِم بِسُلۡطَٰنِۭ بَيِّنٖۖ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا)[44]. فالآية تصرح بوجوب الدلائل البرهانية في العقائد، وأنها لا تُساق سوقًا خاليًا من دليل، بل لا بد من وجود دليل، يرقى إلى البرهان، الذي عُبِّر عنه بالسلطان. يقول الزمخشري “(بِسُلۡطَٰنِۭ بَيِّنٖۖ) وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان مُحال، وهو دليل على فساد التقليد، وأنه لا بد في الدين من الحُجَّة حتى يصح ويثبت”[45]. ويقول ابن كثير “أيْ هلَّا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلًا واضحًا صحيحًا”[46]. وتكمل الآية في تأكيد معنى الحجيَّة في العقائد بوصفها التقوُّل على الله بغير دليل بالكذب والبُهتان والزور، وأنه ادعاء على الله ومُنازعة له في مُلكه.
ومعروف عناية العلماء المسلمين بهذه الحُجج البرهانية، وتحذيرهم -تبعًا ووفقًا وتأسيًا بالقرآن- من التقليد. ومنه قول الإمام السنوسي: “ويُخشى على صاحبها -أيْ صاحب التقليد- الشكُّ عند عُروض الشبهات، ونزول الدواهي المُعضِلات؛ كالقبر ونحوه. مما يفتقر إلى قول ثابت بالأدلة وقوة يقين وعقد راسخ لا يتزلزل؛ لكونه نُتِجَ عن قواطع البراهين”[47].
والآية الثانية (سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٞ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ وَيَقُولُونَ خَمۡسَةٞ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ رَجۡمَۢا بِٱلۡغَيۡبِۖ)[48] وهنا نجد استئنافًا للغرض نفسه، وإثباتًا لضرورة وجود الدليل في الإيراد، والنهي عن التقوُّل في الغيبيات.
والآية الثالثة (فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗا)[49] على الرأي الذي يرى أن “ظاهرًا” تعني ثابتًا قويًّا داحضًا. يقول السعدي: “(فَلَا تُمَارِ) أيْ تجادل وتحاج، (فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗا) أيْ مبنيًّا على العلم واليقين، ويكون فيه أيضًا فائدة”[50].

المقاصد الأخلاقيَّة في قصة أهل الكهف
“يتضمن القرآن الكريم دستورًا كاملًا للأخلاق الإسلامية. وهي تأتي إما في صورة نصائح وتعاليم، وإما في صورة نماذج وقصص ذات مغزى ودلالة”[51]. والقصص القرآني مَعين أصيل لاستقاء الأخلاق والقيم الإسلامية؛ فنرى صبر النبي أيوب -عليه السلام-، ومجاهدة سيدنا نوح -عليه السلام- لقومه عقودًا بلا كلل، ودرس التواضع في قصة موسى -عليه السلام- مع العبد الصالح، وإفناء الحياة في مرضاة الله كما في قصة ذي القرنين، وغيرها الكثير. هذا، وتتضمن قصة أصحاب الكهف الكثير من القيم الأخلاقية التي تتعلق بالعقيدة عند المؤمن، وكيفيات التعامل معها، غير قيم أخرى صريحة لقَّنها القرآن للنبي ﷺ وجماعة المؤمنين. كلها مثَّلتْ مقاصد قرآنية، وجب استجلاؤها وتمحيص النظر فيها للإفادة منها.
أولًا: قيمة المُجاهدة في العقيدة
ويظهر هذا المقصد العظيم في صلب القصة، في الآيتين (وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ إِذۡ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا (14) هَٰٓؤُلَآءِ قَوۡمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗۖ)[52]. حيث لم يكتفِ الفتية بالإيمان الخفي في قلوبهم حين افتضح أمرهم بين قومهم، بل وقفوا وقوفًا ثابتًا راسخًا أمام جماعتهم، مُعلنين إيمانهم الصحيح الصريح، بل مُدينين أهلهم وجماعتهم، بمن فيهم الملك نفسه. يقول ابن كثير: “ويُقال إن ملكهم لمَّا دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم، وتهدَّدهم وتوعَّدهم، وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجَّلهم لينظروا في أمرهم؛ لعلَّهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه”[53]. ويقول الزمخشري: “(إِذۡ قَامُواْ) بين يدي الجبار؛ وهو دقيانوس من غير مُبالاة به، حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم”[54].
ومن عُلُوّ قيمة المُجاهدة في القصة أن الفتية قد ضحَّوا بكل غالٍ في سبيل عقيدتهم، ويكاد يتفق المفسرون أن أصل الفتية كانوا من الأغنياء المُترفين، بل كانوا من ربائب القصر الملكي. يقول الزمخشري: “وممن شدَّد في ذلك دقيانوس، فأراد فتية من أشراف قومه على الشرك، وتوعَّدهم بالقتل، فأبوا إلا الثبات على الإيمان”[55]. وقال ابن كثير “ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم”[56].
ثانيًا: جواز الفرار في الأرض خوفًا من الفتنة
ومن أنصع ما جاءت به القصة من مقاصد؛ تحذيرها المؤمنين من الفتن. فأصحاب القصة ما هُم إلا مؤمنون يعيشون في عصر فتنة عقديَّة عظيمة. ولأن العقيدة أهم قيمة لدى الإنسان ثمَّنَ القرآن فرارهم من قومهم خوفًا من الفتنة في الدين، كما ثمَّنَ وقوفهم ومواجهتهم للعدو الغاشم. وذلك في آيتين، أولاهما (وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأۡوُۥٓاْ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ يَنشُرۡ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ وَيُهَيِّئۡ لَكُم مِّنۡ أَمۡرِكُم مِّرۡفَقٗا)[57]. يقول ابن كثير: “توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفرَّ العبد منها خوفًا على دينه. كما جاء في الحديث “يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنمًا يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن”. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها … (وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ) أيْ وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله؛ ففارقوهم أيضًا بأبدانكم”[58].
أما الآية الأخرى، فهي (فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا)[59]. فبعد أن ردَّ الله عليهم اليقظة خافوا أن يكشف أمرهم، فطلبوا من صاحبهم التلطُّف والتخفي أثناء البحث عن الطعام. وعللوا طلبهم (إِنَّهُمۡ إِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يَرۡجُمُوكُمۡ أَوۡ يُعِيدُوكُمۡ فِي مِلَّتِهِمۡ وَلَن تُفۡلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدٗا)[60]. فإن خوفهم الأكبر كان الإعادة في ملة الضلال، أو أن الرجم حتى الموت والإعادة في ملة الضلال متساويان عن أولئك الفتية المؤمنين؛ فالأولى موت للجسد، والأخرى موت للنفس الزكية المؤمنة.
ثالثًا: الابتعاد عمَّا ليس من شأن المرء العلم به
للمعلوم أنواع كثيرة[61]؛ من حيث إمكان معرفته، وطريق معرفته أو ما يُسمَّى بسبب المعرفة. وبالعموم فمن حيث سبب العلم؛ فمنه ما يمدنا به الحسّ، ومنه ما يمكن علمه بالخبر الصادق، ومنه ما يمكن علمه بالعقل. ومن حيث إمكان المعرفة؛ فمنه ما يمكن معرفته بالطاقة الإنسانية، وما لا يمكن معرفته بالطاقة الإنسانية، وطريق الأخير الوحي فقط. وهو كل ما غاب عنا غيابًا لا يمكن إدراكه إلا عن طريق عالِم الغيب والشهادة، وخالق كل شيء. وقد نهى الإسلام عن تتبع ما لا يمكن العلم به إطلاقًا، وأوله ذات الله -تعالى-، وما لا يمكن العلم به إلا من طريق الوحي والسمع، مثل تفاصيل يوم القيامة، والنبوات الصحيحة من الزائفة.
وقد بينت الآيات هذا المقصد بطريق الإشارة، في آية (فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا)[62]، ففيها تلويح بالنهي عن تقفِّي ما لا يمكن العلم به، ولا معرفته؛ وأنه ضرب من التخرُّص والكذب. كما صرَّحت به الآيات في (رَجۡمَۢا بِٱلۡغَيۡبِۖ)[63] فأدانت التدخُّل فيما لا يمكن علمه. يقول ابن كثير عن هذا السلوك: “ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه، ولا قصد شرعيًّا”[64]. كما نهت الآيات عن المُماراة بغير علم في أمر لا يمكن علمه إلا بالوحي في آية (فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗا)[65] على الرأي الآخر في تفسير “ظاهرًا”. يقول البيضاوي: “فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالًا ظاهرًا غير متعمق فيه، وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم ولا رد عليهم”[66]. وهذا خُلُق قرآني ثابت، تكرر في كثير من الآيات تصريحًا وتلميحًا أيضًا، ومنها (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[67].
وقد تكرر الحث على هذه القيمة في القصة، في آية (قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم)[68]، وكذا في (قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ)[69]. كما أظهرت أن هذا الخُلُق من دأب المؤمنين، فنرى أصحاب الكهف في الكهف يقولون (قَالُواْ رَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثۡتُمۡ)[70].
رابعًا: عدم القطع بأمر إلا بالمشيئة الإلهيَّة
وذلك المقصد من المقاصد المباشرة الواردة نصًّا، التي خاطبت النبي الكريم ﷺ، في آيتَيْ (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا (23) إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا)[71]. يقول القرطبي: “عاتب اللهُ نبيه -عليه السلام- على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدًا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثنِ في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يومًا، حتى شقَّ ذلك عليه وأرجف الكفار به”[72]. قال السعدي: “الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة “إني فاعل ذلك” من دون أن يقرنه بمشيئة الله. وذلك لما فيه من المحذور” … (وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) الأمر بذكر الله عند النسيان؛ فإنه يزيله، ويذكِّر العبد ما سها عنه … (وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا) فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد”[73].
الهوامش:
[1] لا يُقصد بهذا السرد تتبعًا ولا تقصيًا؛ إنما مقصده الإشارة والإعلام.
[2] ص، 29.
[3] آل عمران، 190.
[4] الإتقان، السيوطي، ج4، صـ160.
[5] البرهان، الزركشي، صـ435.
[6] دراسات في التفسير الموضوعي، زاهر الألمعي، صـ9.
[7] يوسف، 111.
[8] يوسف، 111.
[9] الفُرقان، 5 ، 6.
[10] النحل، 24،25.
[11] التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، صـ144، وما بعدها.
[12] بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي، محمد نبيل غنايم، صـ180.
[13] انظر اختلافهم -مثلًا- في تفسير القرطبي لآية “إذ أوى الفتية إلى الكهف”، ج6، صـ3975.
[14] راجع تفسيره، ج5، صـ106.
[15] يقصد لم يقل: سأخبركم إنْ شاء الله.
[16] لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي، صـ183، على هامش “تنوير المقباس من تفسير بن عباس”.
[17] في ظلال القرآن، سيد قطب، ج4، صـ2257.
[18] الآية 13.
[19] الآية 12.
[20] تفسير القرطبي، ج6، صـ3981.
[21] آل عمران، 44.
[22] يوسف، 102.
[23] الآية 21.
[24] تفسير البيضاوي، ج2، صـ7.
[25] الزمر، 42.
[26] الآية 21.
[27] فُصلت، 53.
[28] الآية 19.
[29] تفسير السعدي، صـ473.
[30] الآية 9.
[31] الآية 17.
[32] الآية 18.
[33] الآية 13.
[34] الآية 19.
[35] الآية 21.
[36] الآية 22.
[37] الآية 26.
[38] الآية 10.
[39] تفسير ابن كثير، ج5، صـ105.
[40] الآيتان 13 ، 14.
[41] تفسير البيضاوي، ج2، صـ5.
[42] الآية 17.
[43] الأنعام، 125.
[44] الآية 15.
[45] تفسير الزمخشري، ج3، صـ199.
[46] تفسير ابن كثير، ج5، صـ107.
[47] شرح العقائد السنوسية، السنوسي، صـ173.
[48] الآية 22.
[49] الآية 22.
[50] تفسير السعدي، صـ474.
[51] الفكر الأخلاقي في الإسلام، حامد طاهر، صـ26.
[52] الآيتان 14 ، 15.
[53] تفسير ابن كثير، ج5، صـ107.
[54] تفسير الزمخشري، ج3، صـ199.
[55] السابق، صـ202.
[56] تفسير ابن كثير، ج5، صـ106.
[57] الآية 16.
[58] تفسير ابن كثير، ج5، صـ107.
[59] الآية 19.
[60] الآية 20.
[61] راجع في القضية: شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، باب الكلام على أسباب المعارف.
[62] الآية 15.
[63] الآية 22.
[64] تفسير ابن كثير، ج5، صـ108.
[65] الآية 22.
[66] تفسير البيضاوي، ج2، صـ8.
[67] الإسراء، 36.
[68] الآية 22.
[69] الآية 26.
[70] الآية 19.
[71] الآيتان 23 ، 24.
[72] تفسير القرطبي، ج6، صـ4002.
[73] تفسير السعدي، صـ474.

