
«وجهُ الوقُوفِ علي شَرف
الكلام أنْ تَتَأمل»!
[أبو بكر الباقلاني]
تذوُّقُ الكلمةِ الشّاعرةِ، والوُقوف على مواطنِ اللُّطفِ فيها= غاية يتفاوتُ فيها أهلُ هذا الشَّأنِ والساعينَ فيه، بقدرِ تفاوُتِ أدَواتِ التَّذوُّقِ وما يتَحَصَّلُ به إثارة مواطنِ الجمالِ والإِشراقِ! فأنتَ غيرُ مسْتَطيعٍ كشفًا عن سِرِّ الكلام المُبينِ الذي إنْ طَرَقَ سمعكَ أخذَتكَ منه هزَّة، وسرَى في عروقِكَ منه لذَّةً، وأحدثَ في قلبِكَ طربًا، ولحقَكَ منه أريَحيَّةً؛ إلا إذا أحكَمتَ أصولَ الأدواتِ التي بها تطَّلِعُ على الخَبأِ الذي كان سببًا في حصولِ ذلكَ. وعلى قدرِ الإحكَامِ يكونُ مِقدارُ التَّذوُّقِ وما يَكشفُ عنه من أسرارٍ ويُبدِي. وهذا الذي قصَدَ إليه عبد القاهر الجرجانيِّ في قولهِ:
«فإِذا رأيتَها قد راقَتْك وكثرتْ عندك، ووَجدْتَ لها اهتزازًا في نفسك»، «فعُدْ فانظرْ في السَّببِ واستقْصِ في النَّظر»، «فإِنك تَعلمُ ضرورةً أنْ ليس إلاَّ أَنه قدَّم وأخَّر، وعرَّف ونَكَّر، وحذفَ وأضمرَ، وأعادَ وكرَّر، وتوخَّى على الجُملةِ وجْهًا منَ الوُجوهِ التي يَقْتضيها «علْمُ النحو»، فأصاب في ذلك كلِّه، ثم لَطُفَ مَوضعُ صَوابه، وأتى مأتًى يُوجِبُ الفضيلةَ».
وبذلكَ العلم تَقِفُ على سرِّ تصَرُّفِ المُبِينِ في كلامِه، وتهْتدي إلى الموطنِ التي يرُوقُ فيه الأُسلوبُ ويُورِقُ، وإلى الموطِنِ الذي يغِثُّ فيه نفسُ الأُسلوب ويَقبحُ؛ في تفاريق دقيقةٍ لا تُعطِيكَ من نفسها إلا بِقَدْرِ ما تُقيمُهُ في نفسكَ لها، وتجمَعُهُ في سبيلها؛ من دقَّةِ نظَرٍ، ولُطْفِ فِكرٍ، وصفاء قَلبٍ، وإحكامِ أصلٍ، وضبطِ فَرعٍ. وهذا عينُ ما عنَاه عبد القاهر بِقولِهِ أيضًا:
«وإِذ قد عرفْتَ أنَّ مدارَ أمرِ «النظْم» على مَعاني النحو، وعلى الوجُوهِ والفُروق التي من شأْنها أَنْ تكونَ فيه، فاعلمْ أنَّ الفروقَ والوجوهَ كثيرةٌ ليسَ لها غايةٌ تقفُ عندها، ونهاية لا تجد لهال ازدياداً بَعْدها «ثم اعْلَمْ أنْ ليستِ المزيةُ بواجبةٍ لها في أنْفُسِها، ومِنْ حيثُ هي على الإِطلاق، ولكنْ تعرضُ بسببِ المعاني والأغراضِ التي يُوضعُ لها الكلامُ، ثم بحَسَبِ موقعِ بعضِها من بعضٍ، واستعمالِ بعضِها معَ بعضٍ».
وتعظُمُ الحاجَةُ لإحكَامِ أُصولِ هذا العلمِ ، والارتياضِ بأدوَاتهِ؛ إذا كان الكلامُ في سَنَاءٍ من البَيانِ، وفي الصَّميمِ مِن ذُؤابتة؛ ككلامِ الفُصحاءِ الأوائلِ، أو حين تَسريح مجالِ الفكرِ بُغيَة استِنطاقِ الكلامِ العزِيزِ المُعجِزِ المُكتَنِزَةِ حُروفه بكلِّ معنًى جليلٍ؛ إذ لا تنقادُ وتبِينُ إلَّا لمَن عرفَ قدرَ ما يصمُدُ إليه، فيعَدُّ له عدَّتهُ، ويتَّخِذُ لهُ ما يعينه على ذلك.
هذه الحقيقَةُ التي لا مريةَ فيه= «يترتب عليها استحقاقات منهجية وإجرائية لا بد من الوفاء بها في دارسة هذا البيان القرآني، ولا سيّما دراسةً ما يكون حضوره في غير بيانِ الوحي حضورًا غير فاعل: حضُورًا غير منتج الدَّلالة على المعنى، ومن هذا ما يُسمى عند البلاغيين بالأساليب البديعية، تلك التي كثر القولُ بأنَّ حضورها في غير قليل من البيان الإبداعي شعرًا ونثرا مما لا ينتج الدَّلالة على المعنى، وأنّها لا تكادَّ تعدو أن تكون حليةً؛ وإن كنت أرى أنْ قَوْلَ هذا في شأن البيان العالي البديع غير قويم، فليس فيما أذهب إليهِ أنَّ هنالك في البيان العالي فضلا عن البيان العلي المعجز ما هو إلا للحِلية، وليس له في إنتاج الدلالة على المعنى نصيب.
كلّ عنصر وإن دقّ في البيان القرآني على أي من القراءات العشر المتواترة إنّما هو ذو أثر بالغ في تكوين الصورة وتشكيلها، وفي دلالتها على المعنى التي هي مجلاه ومشهده ومرآته، وذو أثر بالغ في تمكين هذا المعنى في القلب وتوطينه وتفعيله.
يتجلّى هذا لمن اتخذ لتلقي هذا البيان العلي العظيم المعجز عدته، واكتسب من الزاد العلمي والثقافي ومهارات التبصر وأدواته ومن اتقاء صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين ما يمكنه أن يُحسن البصر بفاعلية هذا العنصر، فإن عجز فأمر يرجع إليه هو، ولا يرجعنَّ الأمر إلى عُقم هذا العنصر عن تحقيق شيء في تكوين الصورة وتشكيلها وفي إنتاجها الدلالة على المعنى» [د/ محمد سعد، القول البلاغي في بديع القرآن، ص١٦]
قلت: ومدارُ الوصول إلى الرتبة التي تجد فيها مس سحر الكلمة وما راع منها، بعد إحكام تلك الأصول والارتياض بها= حسنُ التأمل، وطول النظر، ثم تكرار الحرف المبين المرة بعد المرة؛ في صبر وتأن شديدين حتى تقع على سرِّه، وتكشف المخبوء تحته، وتهتدي إلى المعرفة الواضحة؛ إذ كانت قبل ذلك مكتسية برداء من الغموض، «والمعرفة الغامضة ليست بعلم» كما يقول شيخ البلاغيين محمد أبو موسى -مدَّ الله في عمره وأمتع به-.
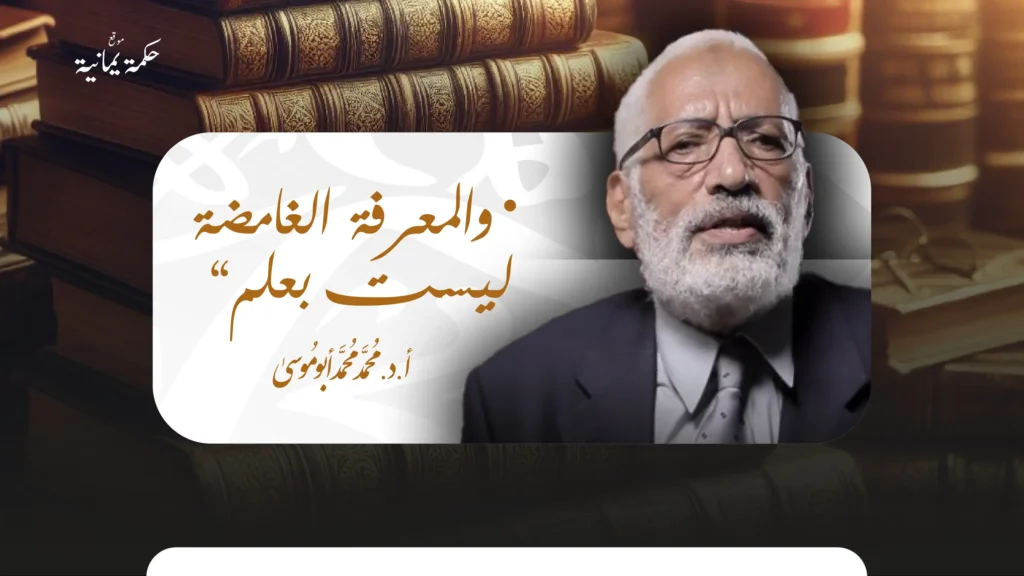
وألا تقنع بتدبر غيرك وتفاسيره، فتقف همتك دون مطاولة ما طاول، ومعالجة الأمر الذي عالج؛ فيكون قصار أمرك قراءة رأي غيرك ثم لا تعدو! بل «راجع ذلك وراجع نظائره لتفهم..، واحذر أن تكتفى بقراءة كلمة من وجدَ لأنه يحدثك عما وجد، ويجب أن تدخل أنت هذه التجربة، وأن تقلب بلسانك، وفؤادك، كل لفظ، وكل خبر، حتى تجـد ما بهر في مساق الخبر، ومـا قهـر. وأنـا أعيذك مـن أن تكرر كـلام الذين استحسنوا من غير أن تستحسن سواء كنت في شعر أو في نثر. وراجع أنت واجتهد في أن تقلل الوسائط بينك وبين ما تدرسه..» [شيخ البلاغيين، مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص٣٠٩]
وهذه السبيلُ السليكَة تَصلُ بكَ إلى حدٍّ تَشْفي الغُلَّة و تنْتهي بكَ إِلى ثلجِ اليقينِ، وهي الحالُ التي إن وفِّقتَ إليها تجاوزَت بكَ حدَّ العلمِ بالشيء مجملًا، إِلى العِلْم به مفصَّلًا، وهي التي تبعث في نفسك روحًا شغوفًا بتتبع منابت العلم، وقصِّ ينبوع النُّكتة؛ «حتَّى لا يُقْنِعَك إِلاّ النظرُ في زواياهُ، والتَّغلغلُ في مكامنه، وحتى تكون كمَنْ تتَبَّع الماءَ حتى عرَفَ منْبَعهَ، وانتهى في البحثِ عن جوهرِ العُود الذي يُصْنَع فيه إِلى أنْ يعْرِفَ منْبِتَه، ومَجرى عُروقِ الشجرِ، الذي هو منه».
ومجملُ ما أقمت له هذا الكُليمَة، وما أردته من ورائها «أن أبين لك: أنَّه لا بدَّ لكلَّ كلامٍ تستحسنُه، ولفظٍ تستجيدهُ، من أن يكونَ لاستحسانِك ذلك جهةٌ معلومةٌ وعلَّةٌ معقولةٌ وأن يكونَ لنا إِلى العبارةِ عن ذاك سبيلٌ، وعلى صحةِ ما أدِّعيناه من ذلك دليلٌ.
وهو بابٌ منَ العلمِ إذا أنتَ فتحتَه اطَّلعْتَ منه على فوائدَ جليلةٍ، ومعانٍ شريفة، ورأيتَ له أثراً في الدين عظيمًا وفائدة جسيمة، ووجدْتَهُ سببًا إلى حَسْم كثيرٍ منَ الفساد فِيما يَعودُ إِلى التنزيِل وإصلاحِ أنواعٍ منَ الخَلل فيما يتعلقُ بالتأويل، وإن ليُؤمِنُكَ مِن أَنْ تُغَالَطَ في دَعواك، وتدافَع عن مَغْزاك ويرْبأ بك عن أن تستبينَ هُدًى ثم لا تهدي إليه، وتُدِلَّ بعرفانٍ ثم لا تستطيعُ أن تَدُلَّ عليه وأنْ تكون عالِماً في ظاهرِ مُقَلِّدٍ، ومُستبيناً في صورةِ شاكٍّ وأن يسألك السائلُ عن حُجة يَلْقى بها الخصمَ في آية من كتاب الله تعالى أو غيرِ ذلك، فلا ينصرفُ عنك بِمقْنَع وأن يكون غاية ما لصاحبك منك تحيله على نفسه، وتقول: قد نظرتُ فرأيتُ فضلاً ومزيَّةً، وصادفتُ لذلك أَريحيَّة، فانظرْ لتعرِفَ كما عرفتُ، وراجعْ نفْسَك، واسْبُرْ وذُقْ، لتجدَ مثلَ الذي وجدْتُ، فإنْ عَرفَ فذاك، وإلا فبينكما التناكر، تنبيه إلى سوءِ التأمُّل، ويُنْسِبكَ إلى فسادٍ في التخيل» كما يقول شيخنا عبد القاهر في كتابه الفحل [دلائل الإعجاز، الفقرة ٣٣]
قل أبو عبد الرحمن:
هذه قضيَّةٌ شريفةٌ من قضايَا العُقولِ المُنتجَةِ، التي أعلتْ منارَ العلمِ، ورَفَعَتْ بُنيانَ المعرِفَةِ، التَّزَمتَها يومَ التَّزَمتَها طريقًا مفرُوضًا، وشرعَةً ومنهاجًا، فأقامَت لنا بُنيانًا من العلمِ مَكينٍ، وأورثَتْنَا ذخائِرَ من المعرفةِ تَحَارُ فيهَا العُقولُ، وتقِفُ منها موقِفَ المأخُوذِ ؛ إجلالًا وإِكبارًا!
وهذه القضيَّةُ هي أولى القضايَا التي يجِبُ علينَا أن نلتَزِمَها التزامًا جادًّا إن ابْتَغينَا «تجديد حياتنا العقلية، وتجديد علومنا تجديدًا تظل به هذه العلوم عربية خالصة، يتلقفها القلب المسلم فتزدهر به ويزدهر بها، وتنمو به وتنمو بها، ويسقيها وتسقيه، ويظل بها عربيًّا مسلمًا، ولا يتحول بعجمتها إلى أرجوحة بين العروبة والعجمة» [أبو موسى، مناهج علمائنا في بناء المعرفة ص٢٠٦]
فإذا عرفَتَ هذا، وانتهيتَ به إلى ثلجِ اليقينِ= وقفتَ على سُوءِ قولِهِم: إنَّ هذه العلوم -النَّحو وطرائِقَه، والبلاغةَ وأَفانينَها- المُعينَة علَى اجتلَاءِ أوجُهِ البيانِ، وإثارَةِ مكامِنِ الإعجازِ= علوم آلةٍ، يكفيكَ منهَا اليسير الذي يَعصِمُ لِسانَيكَ من الخطَأِ، وينهَضُ بكَ للوُقُوفِ على حاقِّ الصوابِ في المسَائلِ التي تصمدُ لمعالجَتِها!! وعلمتَ أنَّه باطلٌ من القولِ وبِدعَة؛ جرت على مسامِعِ النّاسِ فانخدَعوا لها، وتلبَّسوا بهَا!! ونسُوا أنَّها علومٌ تعصِم الفكرَ (1)، وترقَى به إلى مواطنٍ من التَّحقيقِ عجيبَةٍ، وتَقِفُ بصاحِبِهَا على مَدرَجِ الحِذْق والأستاذيَّة وسَعَةٍ من الذَّرْع وشدَّةِ المُنَّة، فانظُر هذا واعلمْهُ، فإِنَّه قد ظلَّ بسبَبِهِ أقوامٌ، أُعيذُكَ أن تكونَ منهم، واللَّهُ يقولُ الحقَّ وهو يهدي السَّبيل.
وتعلَمَ الخفيَّ البديعَ من مُرادِ أبي الفتحِ ابن جِنّيّ، وهو يقُولُ كلمَتَهُ التي أَحسَبُها من لُمعِ الفكرِ وشائِقه، في عُرَضِ حديثِهِ عن علمِ النَّحوِ ومنازِعِه [الخصائص ١/١٩١]:
«وإنما هو علم -أي النحو- منتزع من استقراء هذه اللغة. فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه، وأبا عمرو فكره. إلا أننا -مع هذا الذي رأيناه وسوغناه مرتكبة- لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها، وتتالت أواخر على أوائل وأعجازًا على كلاكل والقوم الذين لا نشك في أن الله -سبحانه وتقدست أسماؤه- قد هداهم لهذا العلم الكريم وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم خادمًا للكتاب المنزل وكلام نبيه المرسل وعونًا على فهمهما ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقلان منهما إلا بعد أن يناهضه إتقانًا ويثابته عرفانًا ولا يخلد إلى سانح خاطره ولا إلى نزوة من نزوات تفكره. فإذا هو حذا على هذا المثال وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه غير معاز به، ولا غاض من السلف -رحمهم الله- في شيء منه. فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه. وشيع خاطره وكان بالصواب مئنة ومن التوفيق مظنة. وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئًا»

وتهتَدي إلى الوسيلَةِ الحَقَّةِ التي امتَطاها الكبارُ من عُلمَائِنَا يومَ صمَدُوا لاستخرَاجِ ذخائِرِ البُلغَاءِ، ودُرَرِ القُرآنِ المُعجِزِ، في منهجٍ عجيبٍ، ومَسلكٍ لاحبٍ، مهد لهم صُنعَ المعرفة، وإِثارَةِ مكامِنِ الإعجازِ،كـ«الشيخ عبد القاهر الذي شرح كثيرًا من الغوامض، أو وضع الأساس لشرحها وبيانها، كما شرح كلام العلماء في البلاغة، والذي وصفه بأنه كالرمز والإيماء، والإشارة في خفاء، كل ذلك بضربة واحدة، أو بَخَفْقَة برق واحدة، أضاءت كل جوانبه وذلك حين هدي إلى النظم، وتوخى معاني النحو على وفق الأغراض والمقاصد، وهو على صواب فيما قال وأن هذا الأصل يكشف كل غوامض الشعر والبيان ، والإعجاز بشرط أن يكون مفهوما على وجهه الصحيح ، الذي كرر الشيخ بيانه، وأن يكون أداة في يد خبير طالت ممارسته للكلام، وأحكم سننه، وطرائقه، حينئذ يستطيع الاهتداء بهذا النجم وأن تكون استضاءاته به راجعة إليه بمزيد من التفصيل، ومزيد من الوعي بجوهر صياغة الكلام ، وحسن تأليفه، لأن هذا المفهوم الجليل الذي هو النظم كغيره من أصول المعرفة إنما يستضيء هو نفسه بمـقـدار ما يضىء، ويستفيد هو بمقدار ما يفيد ، ويزداد صقلا كلما ازداد الواعي الخبير اليقظ به توغلا في أدغال البيان، وبهذا تتراحب المعرفة، وتربو في يد من هم من أهلها، وإذا قلنا إن عبد القاهر أزال كل هذا الغموض بتجليته وإصابته لمفهوم توخي معاني النحو وفق الأغراض فإنما نريد أنه وضع الأصل الذي لا ينقضه من له بصيرة، وأبان عن الطريق الذي يهدي من يهتدي، ويجب أن يربو هذا الأصل في مباحث كـل عـالـم بمقدار وعيـه، وبمقدار يقظته، حتى إذا صادف من هو من طبقة عبد القاهر يكون قد صادف من يضيف إليه، مقدار ما أضافه عبد القاهر» [انظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص٣١٣]
فانظُر هذا وتأمله تجدهُ النُّور الذي يُضِيءُ لكَ طريقَ تذوُّقِ الكلامِ، ويرقَى بِكَ حيثُ تقِفُ على سِرِّهِ، وتضعُ يدكَ على موطِنِ الجمالِ فيه، وتعلَمَ السَّبَبَ الذي كان الكلامُ لأجْلِهِ استحَقَّ وصفَ الحُسنِ، وسرَى في عُروقِهِ ماء الحياةِ.
وبعد؛ هذه قضيَّةٌ من العلمِ مستَطيلَةٌ مَرضيَّةٌ، يَغفُلُ عنها جمهَرَةُ النّاسِ، ولا يَرعَوها حقَّ رعايَتِهَا؛ رغمَ حديثِ أئِمَّتِنا عنها، وتمَثُّلهم لها، وإِشاراتهم الكثيرَةِ إليها، وهذا عجبٌ من العَجَبِ!! ولا أُجاوِزُ إن قلتُ: إنَّ هذه التَرِكَة العظيمة التي ورَِّثُوهَا لنا، كانت لها تلكَ القضيَّةٌ رُكنًا وقاعِدةً= بُنِيَتْ عليه بعدُ! فتأَمَّل ذلك تجدُ صدقَهُ -إن شاءَ اللَّهُ-.
ورأيتُ أن أختمَ هذه الكُليمَة بِحرفٍ مُشرِقٍ من حُروفِ أبي القاسمِ الآمِديِّ -أنارَ اللَّهُ جَدَثَهُ- يجمَعُ أصلَها ، ويُترجِمُ عنها ترجَمَةً صادِقَةً، إذ يقُولُ: «..ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان، ولا إظهاره إلى الاحتجاج، وهي علة ما يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة، وبهذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قريحته، وقلت دربته، بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبلٌ لتلك الطباع وامتزاج به»
الهوامش:
- لذلك كان من عريق قولهم ونفيسه: «النحو منطق العربيَّة» [انظر: الإمتاع والمؤانسة، للتوحيدي/ص٨٤]
وفي هذا نفس المعنى يقول الدكتور مصطفى ناصف في [كتابه النقد العربي نحو نظرية ثانية]: «في وقت متقدم من حياة الثقافة العربية بدا أن النحو أكبر من أن يكون طائفة من القواعد التي تضمن سلامة اللسان وفى وسط التنافس الغريب بين النحو العربي والمنطق اليوناني رأى الباحثون أن ثمة علاقة بين النحو وقواعد التفكير، وبدا أن التفكير لغة وأن اللغة على مقربة من استقامة الخلق، بل خيل إلى غير واحد أن الإعراب يعادل الخروج من الظلمات، وعلى هذا أعان النحو على تحسين الأداء الذهني، بل أعان على مواجهة التفكك والعجز بوجه عام، لقد تمثل النحو في الأذهان قوامًا أو رباطا لكينونة، وكان هذا كله إيذانًا بأن التفلسف والنحو سيان، والواقع أن الاهتمام بالنحو كان على خلاف ما نظن في شئون التبسيط ضد السفسطة والبراعة غير المسئولة».
وثمَّة كلمة ذاهبة في الحسن كل مذهب، أبان فيها الدكتور البارع محمد الخطيب عن هذا الأمر، وأوضحه بها إيضاحًا لا مزيد عليه، أعلِّقها لك لمسيس الحاجة لها، فاصبر على قرائتها فإنها من دُرَر القول وعلَقِه [الصناعة النحوية والمعنى عند السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص٦٥/٦٧]:
«جرت العادة على عدِّ هذا الكتاب كتابًا في «النحو» هذا صحيح، ولكن ليس النحو كما نفهمه نحن اليوم بوصفه مجموع القواعد التي تمكن من اتبعها من النطق على نحو صحيح! كلا فإن النحو العربي كما نقرؤه في مرجعه الأول (الكتاب) ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم فحسب بل هو أكثر من ذلك قوانين للفكر داخل هذه اللغة، وبعبارة بعض النحاة القدماء: «النحو منطق العربية» وهو ما كان يعيه تمام الوعى علماؤنا – رحمهم الله- حينما كانوا يعدون كتاب سيبويه كتابًا في (علم العربية) نحوا وبلاغة ومنطقا، كتابا يمكن من استوعبه من الإمساك بمقاصد العلوم البيانية كلها، بما في ذلك الفقه !! يذكر أبو إسحاق الشاطبي أن الجرمى قال:«أنا منذ ثلاثين سنة أفتى الناس من كتاب سيبويه»
ثم يشرح الشاطبى السر في ذلك فيقول: «وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، بل هو بين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ في المعاني».
والسؤال هنا: كيف تتصرف الألفاظ في المعاني؟! يجيب سيبويه عن هذا في أبواب من الكتاب.. من ذلك مثلا باب بعنوان: «باب اللفظ للمعاني» يقول فيه: «واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» يليه باب آخر بعنوان «باب ما يكون في اللفظ من الأغراض» يقول فيه: «واعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء» وتتوالى الأبواب حول علاقة اللفظ بالمعنى في كتاب سيبويه، فهذا «باب في وقوع الأسماء ظروفا وتصحيح اللفظ على المعنى< وهذا «باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لا تساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار» ثم إن مسألة«تصرف الألفاظ في المعاني» ووجوه هذا التصرف ليست مطروحة في كتاب سيبويه في الأبواب التي تحمل مثل هذه العناوين وحدها، بل هي حاضرة في كل باب من أبواب الكتاب تقريبا، إذ ما من مسألة نحوية يتناولها بالتحليل إلا وكان يربط فيها بين التغيرات التي تحدث على مستوى اللفظ وما ينتج عنها من تعديل أو تحوير على مستوى المعنى من ذلك مثلا – قوله : «هذا باب يختار فيه الرفع، وذلك قولك: له علم علم الفقهاء، وله رأي رأيُ الأصلاء؛ وإنما كان الرفع في هذا الوجه؛ لأن هذه خصال تذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل ولم ترد أن تخبر أنك مررت برجل في حال تعلم وتفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه، وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له حسب حسب الصالحين؛ لأن هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات، وعلى هذا الوجه رفع الصوت، وإن شئت نصبت فقلت: علم علم الفقهاء، كأنك مررت في حال تعلم وتفقه وكأنه لم يستكمل أن يقال له: عالم» وواضح أننا هنا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفية النطق، بل بإزاء تقرير جهات الكلام ومعايير التفكير بتحديد المعنى الذي يقصده المتكلم. والمهم في سياقنا هذا أن أؤكد أن الدرس النحوي عند سيبويه كان في جوهره دراسة لأسرار التفكير فهو يرى أن النحو ليس نطقا بالعبارة على نحو صحيح فحسب وإنما هو مع ذلك وعى بما تحتويه العبارة من فكر وحس ومعنى دقيق؛ حيث تحتك الكلمة بالكلمة وما وراء هذا الاحتكاك من فيوضات معنوية وملابسات سياقية وعلائق منطقية، يمكن تجريدها من خلال حديث النحاة عن ثنائية «المعاني» «والأغراض< وما يقتضه «السياق، ومواقف الخطاب» وما تتطلبه «مقاصد الاستعمال».

