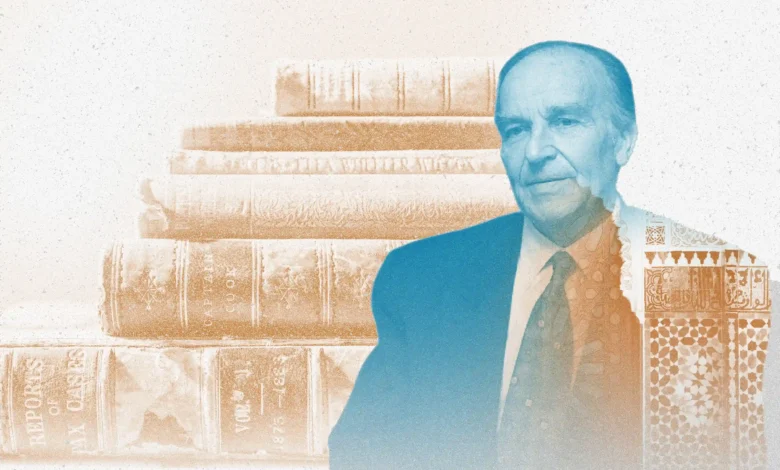
يطارد الفكرة فيظفر بها، ويحلّل الظاهرة ليردَّها إلى منبعها، ويغوص في الحقيقة إلى باطنها، وهو في سيره ذاك يتطلَّب تحت كل اختلاف ائتلافًا، ويبحث من وراء كل كثرة وحدة، يأبى الوقوف عند التفسيرات الجزئيَّة، وينفر من الجمود على المقاييس الشكليَّة.
لم يكن في عرضه لنفائسه باردًا محايدًا، مُستأْسِرًا للعباءة الأكاديميَّة السَّوداء، التي تفسد الإلهام، وتحاصر الحريَّة الفكرية، فلذلك صفت أفكاره من التصنُّع الزائف، وتحرَّرت أبحاثه من الرَّتابة الغثَّة، فكانت ممزوجة بين العلم والفن، مخلوطة بالرُّوح والعقل، يتعانق فيها المنطق والوجدان!!.
على يديه وبقلمه تذوب التُّخوم الفاصلة بين العلوم، فيولّد منها نظرية ذات روح واحدة، تنصهر فيها المعارف، فلا تكاد تميّز الفيزياء من السياسة، والتصوف من الاقتصاد، والفن من الَّلاهوت، والأنثروبولوجيا من أسرار الشريعة، كل أزهار الدُّنيا في فناء قصر واحد، شيَّده لنا الدكتور علي عزت بيجوفيتش لننعم به!.
يتحدَّث عن معانٍ حاضرة غائبة، سهلة ممتنعة، متماسكة منفتحة، ولا يخلو حديثه من مفاجآت معرفية، تُدهش عقل القارئ، فكم من مفاهيم استلَّها سلاً من غير مظانها ! و كم من لطائف فكرٍ انتزعها بعذوبة من شباكها ؟!، و علَّة ذلك – في نظري – تمكُّنه من القبض على ناصية المعاني الفلسفيَّة العميقة، بكل هدوء ووداعة وانسيابية.
له فضاءاته المعرفيَّة، وآفاقه الفلسفيَّة، ومَنْجَمه الثقافي المتنوع الذي به يغذّي رؤيته، وعليه يشيّد أسس نظريّته، وبثرائه استطاع أن يعيد القراءة لحقائق الكون والإنسان والحياة، لن أقف على نهايات آفاقه، ولكن سأتطلَّع إلى بداياتها، فمقام المقالة وطبيعتها تجبرني على الكشف عن حقيقة بعض قراءاته الفلسفية، بالإشارة والإيماءة، والرمز والإيعاز، وتحرمني من السياحة والغوص، والحفر والتنقيب في منجمه الذي لا يكاد ينضب ولا يغيض!.
رؤية فلسفيَّة للإسلام من الخارج:
يدور لباب وجوهر فلسفة الدكتور بيجوفيتش على إعادة فلسفة الإسلام من الخارج، تهدف تلك الفلسفة للإسلام إلى اكتشاف موقعه في إطار خريطة الفكر العالمي الجديد، المشتملة على ثلاث رؤى عالمية، يمكن إليها ردُّ جميع الأيديولوجيات الفكرية، والنُّظم الفلسفية، والتعاليم العقدية، وهي:
الأولى: الرُّؤية الماديَّة، التي تستند في مفاهيمها إلى “الطبيعة و المادة “.
الثانية: الرُّؤية الدينيَّة المجرَّدة، أو الرُّوحية الخالصة، التي تستلهم رؤاها من “الضمير و الروح”.
الثالثة: الرُّؤية الإسلاميَّة، التي تعتمد على ثُنائية “الروح والمادة “، وتستهدف الإنسان. (1)
ترتكز تلك الفلسفة على أبرز خصائص التَّصور الإسلامي، وهي “الوحدة المعرفية”، التي تتناغم داخل سورها الثنائيات المتعارضة، وتتضافر في محيطها الحقائق المتنافرة في الظاهر، الدين والمادة، الروح والجسد، الإنسان والطبيعة، العقل والوجدان، الفن والعلم، الحضارة والثقافة … تتجانس تلك الثنائيات في مركَّب لا يحسن تأليفه إلا الإسلام.(2)
وبهذا تتميز الرُّؤية الفلسفية الإسلامية عن تلكما الرُّؤيتين الفلسفيتين المتطرفتين: الرُّؤية الماديَّة الرَّاسبة في مستنقع الحسيَّات، والرُّؤية الدينية المحضة الغارقة في الروحانيات، وكلتاهما ترفعان راية الإخفاق عندما تصطدمان مع منطق الحياة وضروراتها.
ليس الإسلام ” مجرد دين أو طريقة حياة فقط، وإنما هو بصفة أساسية مبدأ تنظيم الكون”(3)، بتلك الرؤية النافذة يتفهم الدكتور بيجوفيتش الإسلام، وبهذه النظرة البعيدة يفلسف أعمدته وتعاليمه وشرائعه، فالشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمران والمسجد والأوقاف … وراء كل هذا فلسفة تنسجم مع الحياة السَّامية المصمَّمة على ثنائية الروح والبدن، والنفس والمجتمع “فلا غرابة أن الجسم و النفس .. القلب و العقل .. العلم والدين .. علم الطبيعة والفلسفة، تجتمع كلها عند نقطة واحدة تمثّل قمة الحياة”.(4)
النقد الجديد للإلحاد:
ظاهرة الإلحاد تلازم الرُّؤية المادية للحياة، تتجلَّى في نتائجها، كما تبرز في دوافعها، لم يتناول الدكتور بيجوفيتش تلك الظاهرة بالنقد من النَّاحية التقليديَّة: من زاوية البراهين العقلية، والحجاج الفلسفي والشواهد العلمية، ولكن أعاد القراءة النقدية للإلحاد، فكانت “قضايا الإنسان ” هي مدخله النقدي، تلك القضايا التي تضطرُّنا إلى الاعتراف بالضَّرورات الباطنية، في فنائها تتشكل حقيقة الإنسان: شوقه، وتطلعاته، وأخلاقه، وتضحياته، وأمله، ولذته …
أمدّه منجمه الثقافي ومخزونه المعرفي، بأدوات الحفر النقدي، والمعمار الفلسفي، لإنجاز نقده، من علوم الانثروبولوجيا، مرورًا بعلوم الأديان والاجتماع والتاريخ والنفس، فبدأ ببيان التعارض بين الإنسان والحيوان، ووقف عند فكرتي التضحية والحرية، اللتين انفرد بهما الإنسان (5)، ثم فَلْسَف التعارض بين طبيعة الحياة وطبيعة المادة. (6)
ليس للإنسان تاريخ واحد، بل له تاريخان: تاريخ مادي يتعلق بحضارته وحروبه وصناعته وعمرانه وأدواته، وتاريخ باطني فيه الدَّراما والتراجيديا والدين والثقافة والأخلاق. (7)
وبتأمل عميق يقف الدكتور عند ظاهرة ” اغتراب الإنسان ” في هذا العصر، ويكشف عن دوافع الفلسفة العدميَّة، المتمثلة في ثوران القلق النفسي، الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن معنى وجوده وحقيقة إنسانيَّته، وبذلك يظهر عمق تلك الفلسفة المعبّرة عن اغتراب الإنسان، واستلاب إنسانيته، والمتمرّدة على الحضارة المادية ذات البعد الواحد، لكنها عدمية يائسة، لا لأنها أنكرت الاله ابتداءً، بل لأنها لم تجد الطريق إليه كما وجده “الدين”، فهي صرخة تعرب عن خيبة أمل، واحتجاج على غياب الإله والإنسان في الحضارة المادية (8).
في ظاهرة الفن، وفي قضية الأخلاق، وبين ثنائية الخلق والتطور، والثقافة والحضارة، والدَّراما والطوبيا، تتجلَّى حقيقة الإنسان، وتتهافت خرافة الإلحاد.
تعانق الدين والفن:
عبر أفقه الواسع واستخلاصه الَّلطيف توصل الدكتور إلى لحظة التقاء الفن بالدين، والمراد به: نزعة التدين الفطرية التي لا تنفك عن الإنسان، وتلك مسألة غاية في العمق والإثارة، فإنَّ جذور التدين والفن ترجع إلى وحدة مبدئية، تتشخص في حقيقة جوّانية واحدة، وهي “الإلهام الإنساني”، يعبر عنها الدين بالخلود والمطلق، ويفصح عنها الفن بالدَّراما الإنسانية، والإحساس الجُوَّاني بمصير الإنسان، وكلاهما ببساطة شعور بالتَّسامي، وشوق الإنسان إلى عالم مجهول التفاصيل !.(9)، ففي عبارة فلسفية يقول: “عندما ننحي جانبًا كل ما هو عرضي وغير جوهري في الأخلاق والفن والدين، وإذا اختزلناها إلى جوهرها فحسب، فسنجد الإلهام والرغبة والنية …”.(10)
الفن والدين مناقضان للإلحاد، لأنهما ــــ برسالتهما الروحية ــــ يتجاوزان بالإنسان محدوديَّته، ويمدانه بآفاق تتخطَّى به ماديَّته النسبيَّة، فالإلحاد يتجافى مع الفن، كما ينأى عن الدين، لأنه عدوٌّ لشوق الإنسان ورغبته، وتساميه الروحي إلى عالم مجهول، يتجاوز شؤم المادة الضيّقة، بتلك الرؤية فسَّر الدكتور ظاهرة تراجع الفن والأدب وتقهقرها في الاتحاد السوفيتي البائد.(11)
ومن خلال تلك الرؤية الشَّفَّافة للفن، يُسطّر لنا الدكتور ملاحظاته اللطيفة في فلسفة الفن، فإن الفن ــــ باعتباره شوقًا ورغبة في عالم الروح ــــ ليس إبداعًا للجميل المناقض للقبيح، وإنما إبداع في البحث عن الحقيقة، وبذلك يمكن أن يكون القُبح فنًَّا عميقًا كما في الأقنعة “الأزتية” أو أقنعة ساحل العاج، فنقيض الجمال – في منطق الفن – ليس القُبح، وإنما الزَّيف الذي لا يعبر عن حقيقة الروح ومتطلباتها ! (12)
الرواية والتَّوظيف المعرفي:
لم يحبس الدكتور نفسه في معتقلات النصوص العلميَّة، بل إن حريَّته قادته إلى تتبُّع تجلّيات الحقيقة خارج “النص العلمي”، لا سيَّما تبدّياتها في “الرواية الأدبية “، التي وظَّفها لبناء رؤيته الفلسفية أحسن توظيف.
تتراقص بين أعيننا في كتاباته أنواع من عناوين الروايات وأسماء الروائيين، من “دستويفسكي” من رائعته “الأخوة كارمازوف”، و”تولتسوي” في جوهرته “الحرب والسلام” إلى “فيكتور هيجو” في فريدته “البؤساء” مرورًا بـ “هرمان هيسه” و”كافكا” و”ديكنز” … إلى آخر تلك الأسماء في عالم الرواية و القصة.
لم يكن ذلك الوَلَع بالروايات ترفًا فكريًا، بل حاجة ملحة لفهم الإنسان، فإن الإنسان ــــ على حد تعبير الدكتور ــــ “ليس بما يفعل، بل بما يريد، بما يرغب فيه بشغف “(13)، وبهذا تتميز “الرواية” عن الكتابة التاريخية المعتمدة على السَّرد الزمني للأحداث، بينما الحبكة الروائية تقوم على الغوص في نفسيَّة البطل، ووصف حوافزه الخفيَّة، وهذه هي الإنسانية، وغالبًا ما يكون ذاك البطل من الطبقات الاجتماعية المهمَّشة أو الوسطى، ذلك لأن الفضائل الإنسانية لا تتقيَّد بالمقامات الاجتماعية!.
وإذا أراد الباحث التعرُّف على شعب أو عصر معين، فلا بد له من أن يلوذ بـ “الرواية” التي تكشف تاريخه الباطني، فإن الاكتفاء بتاريخه الخارجي – السياسي والاجتماعي والثقافي والتشريعي – لا يوصل الباحث إلى اكتمال تصوره عن الحقبة أو الشعب، ولا يساعده على تفسير ماضيه، إنه يجب عليَّ ــــ باعتباري باحثًا ــــ ” أن أعرف كيف عاش الفرد في بيته ؟ وكيف تصرف مع زوجته وأولاده وخدمه والسلطان؟.”،(14) وهذا ما لاتجده إلا في الرواية الأدبية.
علي عزت والفيلسوف كانط:
قرأ الدكتور علي فلسفة ” كانط “، وعلَّق على جوانب منها في كتابه ” هروبي إلى الحرية ” إبَّان سجنه، واستفاد منها في إعادة قراءته لبعض الحقائق الفلسفية، ولكن هل استطاع أن ينفك عنها ؟!.
يبدو لي أن تأثير “كانط” في فكر الدكتور كان قويًا، بحيث إنه ذهب بعيدًا في سياق تمييزه بين المادة والوجدان، إلى تصنيف الدين والأخلاق في دائرة الوجدان الذي لا يخضع مطلقًا لمنطق العقل القائم على المعطيات الحسيَّة، فمجاوزة المادة والطبيعة من وظائف الوجدان والروح، والعقل عاجز عنها،
ففي عبارة صريحة يقول: “ينبذ العقل كل ما يستلزم تفسيرًا ( فوق طبيعي )، ولا يستبقي إلا ما يستند إلى سلسلة من الأسباب الطبيعية ومسبباتها، التي يتم إثباتها بالتجربة والملاحظة كلما كان ذلك ممكنًا … “. (15)، وفي كتابه “هروبي إلى الحرية ” يقول: “لا توجد براهين عقلية على وجود الله، ولكن توجد ضرورة إنسانية إلى الله …”.(16)
بناءً على تلك الرؤية الكانطيَّة التزم الدكتور بلوازمها في فلسفته الخلقية، حيث مال إلى المثالية الخلقية، بحيث جرَّد الأخلاق من المصلحة، ومن مفهومي الَّلذة والألم.(17)
لكن الرؤية الفطريَّة الواقعيَّة تعطي العقل القدرة المعرفيَّة على مجاوزة المادة والطبيعة عبر مبدأ العقل الأوليَّ “مبدأ السببيَّة”، كما أنها تربط الأخلاق بمصلحة المنفعة الملائمة، والمضرة المنافرة، وتلك حقيقة فطرية تحسين العقل وتقبيحه.
تلك أبرز الملاحظات الفلسفيَّة على فكر الدكتور بيجوفيتش، ولكن أثرها لم يمتد إلى بنيته الفلسفية، القائمة على الحس والعقل والوجدان والمفاهيم الإسلامية، وحَسبُنا أننا أمام عقل فلسفي ذي أغوار بعيدة، وعين من الفكر ثرَّة غزيرة، ومائدة ذي يسار مترعة بالَّلذائذ الفكرية، ذاخرة بالَّلطائف الثَّقافيَّة، حافلة بالتَّأمُّلَّات الفلسفيَّة، أخذنا من حلوها ومالحها ما وسع به المقام، و اقتضاه الحال.
الهوامش:
- انظر: الإسلام بين الشرق والغرب، دار الشروق، ص 49.
- انظر: المصدر نفسه، ص 55.
- المصدر نفسه، ص 61.
- المصدر نفسه، ص 303.
- انظر المصدر نفسه، ص 71 ـــــ 82، 95 ـــــ 104، وانظر: هروبي إلى الحرية، دار الفكر، ص104.
- انظر: المصدر نفسه، ص 83-95.
- انظر: المصدر نفسه، ص 107.
- انظر: المصدر نفسه، ص 138- 140.
- انظر: المصدر نفسه، ص 150 ، 154 ، 80 .
- انظر: المصدر نفسه، ص169.
- انظر: المصدر نفسه، ص 155-159.
- انظر: المصدر نفسه، ص154.
- المصدر نفسه، ص180.
- هروبي إلى الحرية، ص 116، وانظر: ص44 .
- الإسلام بين الشرق والغرب، ص 189.
- هروبي إلى الحرية، ص 101.
- انظر: الاسلام بين الشرق والغرب، ص 197-198.

