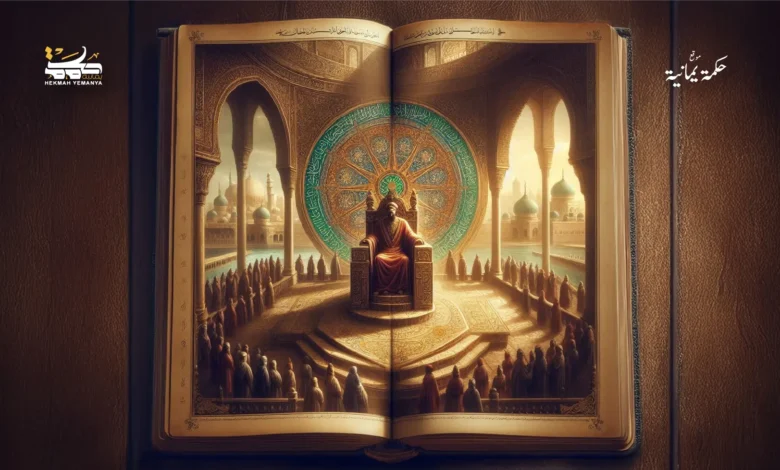
في قلب الجبال، حيث تشق الطيور طريقها بصعوبة، وتتصادم الغيوم بخشونةٍ ناعمة فوق رؤوس القرى، نشأت قصةٌ مختلفة. ليست من فصول الفقر ولا الحروب، بل من تلك الحكايات التي تتوارى خلف المعتقد، وتختبئ في الزوايا الحادة للتاريخ.
نحن هنا في اليمن، البلد الذي لا يَكُفُّ عن تَوْلِيدِ الأسئلة، حيث تسير الطوائف والمذاهب على الحواف، وتكتب وجودها بالحيلة والتأويل، ومن هنا تميز بلاد اليمن بتعدد مذهبي مبكر، خاصة من فرق الشيعة الباطنية(1).
لم يكن هذا التعدد وليد اللحظة، فقد دخل الفكر الباطني إلى بلاد اليمن منذ عهد مبكر، بل إن المؤسس الأول للشيعة بعامة هو عبد الله بن سبأ وهو من اليمن.
وقد أولى أئمة الدعوة الباطنية بلاد اليمن اهتماماً خاصاً، فهذا أحد أئمة الباطنية يوصي الداعي الباطني ابن حوشب عند توجهه إلى اليمن قائلاً له: “إلى عدن لاعة فاقصد، وعليها فاعتمد، فمنها يظهر أمرنا، وفيها تعز دولتنا زمنها تفترق دعاتنا”(2).
نصوص الظل وتأويلات الباطن
منذ أن بدأ الإنسان يحاول فهم السماء، وجد من يخبره أن الحقيقة ليست فيما يُقال، بل فيما يُخفى، وهذا بالضبط ما فعله الباطنيون: علّقوا مصابيحهم في ممرات النصوص، ومضوا يقرؤون القرآن بعيون أخرى. كل ما هو ظاهر خادع في أعينهم، وكل من يؤمن بالحرف مجرّد ساذج، النص عندهم سلمٌ، ولكن للداخل، لا للسماء.
ولأن النصوص المقدسة عندهم مجرد أقنعة، فإنهم أعادوا كتابة الدين وفق شفراتهم الخاصة، حيث الإمام المعصوم ليس راشدًا فقط، بل متفرّدٌ في الفهم، وحيث العقيدة ليست كما يُقال، بل كما تُهمس.
في كتاب “راحة العقل”(3) يُصوَّر الله -جل جلاله- بأنه: ليس موجود فيوصف، ولا غائب فينعت” وهي عبارة تكشف ضلالًا عميقًا، بلغ حدّ نفيهم لصفة الذات عن الله تعالى، بزعم أن كل ذات لا بد لها من صفات، كما صرّح الحامد في كنز الولد(4) ويمضي الباطنيون في تأليه الأمام؛ فهو عندهم الواحد الفرد الصمد الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الله تعالى التي أطلقوها على ما يسمّونه “العقل الكلي”؛ لأن الإمام مَثَل له.
ويعتقد الباطنية أن لكل عصرٍ إماماً معصوماً يُرجع إليه في تأويل ظواهر نصوص الكتاب والسنة، وحل الإشكالات منها.
أما النبي -صلي الله عليه وسلم- فليس عندهم خاتم النبيين، إذ يرون ويعتقدون أن النبوة مكتسبة، لا وحي فيها واختيار من الله تعالى، ولذلك يعتقد الباطنية بأن إمامهم محمد بن إسماعيل هو “الناطق السابع”، وأن شريعته -كما يزعمون- ناسخة لشريعة نبينا محمد -صلي الله عليه وسلم-(5).
المؤسسون الأوائل.
تجمع المصادر التاريخية على أن بداية دخول المذهب الباطني إلى اليمن تعود إلى شخصيتين بارزتين هما: علي بن الفضل الجُدَني الحِمْيَري، والحسن بن حوشب، الملقب بـ “منصور اليمن”. فهذان الداعيان كان لهما الدور الأساس في نشر الدعوة الباطنية في ربوع اليمن، وتأسيس قواعدها الأولى هناك، ويُعدّان المؤسِّسين الحقيقيين لهذا التيار في البلاد.
متى نزل الوحي في اليمن؟
لم تبدأ القصة من الصحابي الجليل، علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وإن حاولوا إلصاقها به. الرواية الأصدق تقول إن الباطنية هبطوا على تضاريس اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري، متأخرين قليلًا، لكن بحماسة المبشرين، في عام 268هـ – أو ربما بعده بقليل – بدأوا يتسللون من الأبواب الخلفية للقبائل، هامسين بما يصفونه: بــــ”الحقيقة الأخرى”.
منذ نشأتها، ادعت فرق الباطنية -على اختلاف طوائفها- امتلاكها للمعرفة الخاصة بالمعاني الباطنية لنصوص الوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية، واعتبرت نفسها وحدها المخوّلة بفهمها. في نظرهم، الظاهر من النصوص لا يعكس الحقيقة، بل يُعد حجابًا عن المعنى العميق الذي لا يبلغه سوى “الخواص”، لأنهم على زعمهم اختصوا بعلم الباطن للنصوص.
أما من يتمسكون بالظاهر ويفسرونه على معناه المباشر، فقد كانوا في نظرهم أهل جهل وقصور علمي.
ورغم محاولاتهم الإيحاء بأن دعوتهم ضاربة في القدم، فإن الدعوة الباطنية مِلَّةٌ دخيلة على بلاد اليمن، كما كانت على غيرها من بلاد المسلمين. لم تنشأ من بيئة اليمن، ولم تتجذر في تاريخه الديني أو الثقافي. لذا فإن دخولها إلى اليمن كان متأخرًا نسبيًا، ويُعد عام (268ه) علامةً لبداية ظهور دعاة الباطنية فيه، وبدء نشاطهم العلني في نشر أفكارهم.
ومع ذلك، يرى بعض المؤرخين أن ظهور الدعوة الباطنية في بلاد اليمن وقع في عام (284هـ)، وذلك في زمن حكم أسعد بن أبي يعفر الحوالي(6)، مما يعكس اختلافًا في توثيق بدايات الدعوة.
وقد أقرّ بعض دعاتهم بهذا التأخّر، مثل إدريس عماد الدين الذي قال: “وأقام الداعي أبو القاسم رضوان الله عليه عامين في التقية، ثم ظهرت الدعوة باليمن سنة سبعين ومائتين”(7).
لكن رغم هذه الشهادات، يصر باطنية اليمن على زعمهم أن دعوتهم تمتد إلى عهد الصحابي الجليل، علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأنها استمرت متسلسلة حتى وصلت إلى ما يُعرف بـ”منصور اليمن”(8)، الذي قيل إنه أُرسل بتكليف من إمامه المزعوم. ويستدلون على ذلك برواية عن شخص يُدعى أحمد بن عبد الله بن خليع، يُقال إنه كان داعية قبل “منصور اليمن”، بل وتزوج الأخير ابنته(9).
غير أن هذه الروايات تفتقر إلى الإسناد الموثوق، ولا تُسند إلى مصادر معتبرة، ما يجعلها أقرب إلى الأساطير المؤسسة منها إلى الوقائع التاريخية.
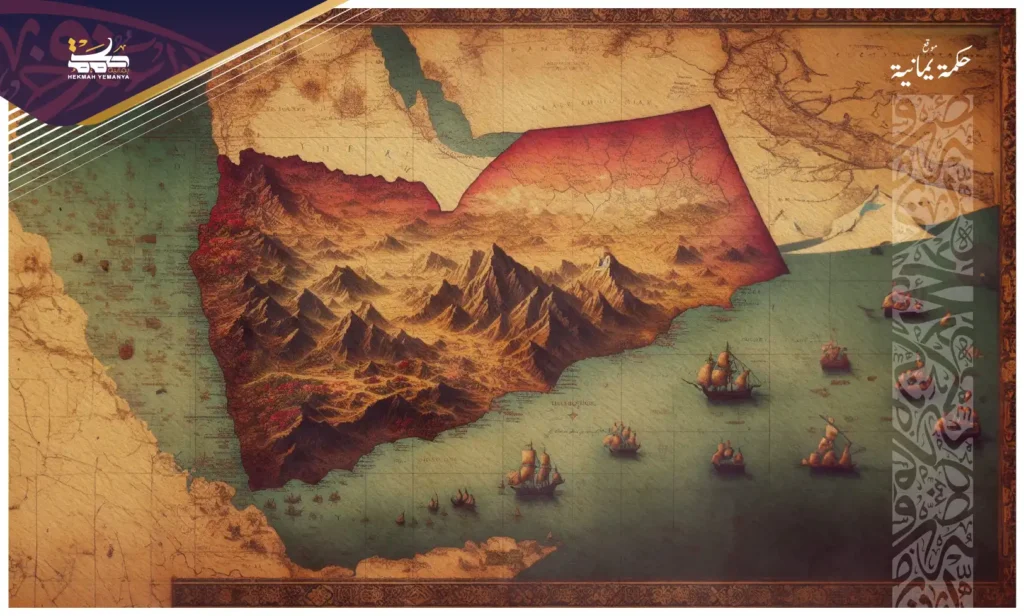
الجغرافيا بوصفها عقيدة:
لم تكن الجغرافيا في يومٍ من الأيام عنصرًا محايدًا في اليمن، بل كانت عقيدة تُمارَس وتُستثمر، ولهذا اختار الباطنيون التضاريس الوعرة ملاذًا ومركزًا لدعوتهم. فجبال اليمن، الشاهقة المنيعة، لا تحمي فقط من الهجمات، بل تحجب الرؤية، وتُبطئ الزمن، وتُخفي ما لا يُراد كشفه.
ومن بين تلك الجبال، اختار الباطنيون حَرَاز(10). لماذا؟ لأن الجبال هناك تعرف كيف تحمي وتُخفي وتؤوي من يلجأ إليها، ولأن اللغة في تلك المنطقة الجبلية لا تنتقل سريعًا، ولأن التاريخ يُكتب في كهوفها ببطء وصبر.
تقع مديرية حَرَاز على بُعد (110) كم غرب مدينة صنعاء، لكنها أبعد من ذلك بكثير في الوعي الجمعي، وكأنها جزء منفصل من الزمن والجغرافيا.
في تلك الجبال، اختبأ طائفتان باطنيتان: الإسماعلية المستعلية الطيبة (البهرة)(11)، والإسماعيلية المستعلية السليمانية (المكارمة)(12)، تحمل كلٌ منهما ولاءً لزعامةٍ بعيدة؛ إحداها في الهند، والأخرى في نجران، ويُقدّر عددهم بنحو (25) ألفًا، أي بنسبة (20%) من إجمالي سكان مديرية حَرَاز البالغ عددهم (112656) كما في دليل التعداد السكاني التابع للجهاز المركزي للإحصاء لعام (2004م)(13). المهم أنهم هناك، في قلب جبل، يعرف كيف يصمت حين تكثر الأسئلة.
ولم تكن اختيارهم لهذه المنطقة مصادقة؛ فقد وصفها الهمداني -رحمه الله- في صفة جزيرة العرب بأنها: “حَرَازْ الـمـِسْتَحْرِزة”، أي: المنيعة الحصينة، لما فيها من جبال شاهقة هائلة صعبة الـمرتقى، وقد اتخذها الصليحي منطلقاً لدعوته وبدأ ثورته منها، وبالتحديد من منطقة مسار فيها(14)، لتبدأ من هناك الدولة الصليحية، التي شكّلت المرحلة الثانية من الحضور الباطني المنظم في اليمن، وهم أيضاً متواجدون في منطقة منَاخَة(15) إحدى القرى التابعة لمنطقة حَرَاز.
كانوا يؤسسون ما يُعرف بــ “بيت الدعوة”، في الـحـُطَيْب(16)، إحدى أهم مراكزهم الفكرية، لم يكن مجرد مبنى، بل كياناً يحمل معنى، مكان يُزرَع فيه الأبناء في مدارس سرية، يتعلّمون فيها كيف لا يُقال كل شيء، وكيف يُخفى المعنى تحت المعنى. ففي عام (2000م)، كان يدرس في أحد هذه البيوت نحو (130) طالبًا(17)، يتلقّون ما لا يُقال علنًا، بل يُهمَس به خلف الأبواب المغلقة.
اليوم تُعد حَرَاز من أشهر المناطق التي يتواجد فيها الإسماعيلية في اليمن، حيث يشكلون الغالبية في المنطقة، يليهم الزيدية، ثم الشافعية، وفي وقتنا الحاضر تسلل مذهب الرافضة الحوثيين متستراً بالمذهب الزيدي، فاستمالوا عددًا كبيراً من أتباعه
وهذه المنطقة هي دولة الباطنية الثانية وهي: الدولة الصليحية، ولذلك يُكِنُّ لها الباطنية الحب والتقدير، لأن منها كان انطلاق الدعوة الباطنية الثانية(18).
ولا تزال منطقة حَرَاز تحتفظ بمكانة رمزية عالية لدى الباطنية، فهي في نظرهم مهد الدعوة الثانية، وموطن الصليحيين، ولذلك تحظى بزيارات متكررة من دعاتهم داخل اليمن وخارجها. من أبرزهم الداعي الباطني الهندي محمد برهان الدين، الذي زارها أكثر من مرة، وكان يُستقبل بحفاوة كبيرة من أتباعه، وسط إجراءات أمنية مشددة تحيط به من كل اتجاه.
ليسوا من الماضي فقط!
الظن بأن الباطنية صفحة قديمة في تاريخ اليمن، أو حدثًا عابرًا انقضى، خطأ كبير. إنهم هناك، وإن تغيرت الأسماء والرايات، والشعارات. الدعوة ما تزال قائمة، لا تصرخ لكنها تتنفس، وحيثما وُجدت فجوة عقدية، أو ارتباك سياسي، دخلوا منها كأنهم الحقيقة.
هم لا يحتاجون إلى إعلان، يكفيهم أن ينشأ الطفل في منَاخَة وهو يردد أن الإمام ليس كالبشر، وأن العلم شيء آخر غير ما في المعاهد والمدارس. هكذا تتكون العزلة، لا عبر الأسلاك الشائكة، بل عبر الأفكار.
خاتمة الجبل:
من حراز إلى الحُطيّب، ومن منصور اليمن إلى آخر داعٍ يتسلل ليلاً إلى عقيدة طفل، تمتد الحكاية. ليست مسألة تاريخ، بل مسألة وعي، والذين يتصورون أن العقائد الباطنية تنتهي بموت الداعية، لم يقرأوا التاريخ جيدًا.
فالمعركة لا تُخاض في الكتب فقط، بل في المساجد، وفي المعاهد، وفي المدارس، وفي البيوت، في الحكايات التي تُروى قبل النوم. وما لم تُسترجع العقيدة إلى قلب المجتمع، سيظل دعاة الظل يسيرون على الجبال، حاملين مصابيحهم الصغيرة، مطمئنين إلى أن الظلام لن يخونهم.
الهوامش:
- الباطنية: قال عنها الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد الحسني اليمني من أئمة الزيدية (ت: 566ه): “انتسبت الباطنية إلى الإسماعيلية، وهم فرقة أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وقالوا: لكل ظاهرٍ باطنٌ، وجحدوا الرب والبعث والحساب والجنّة والنار، واستحلوا المحرمات…” ينظر: طبقات الزيدية الكبرى: ص(132، 135)، والبدر الطالع للإمام الشوكاني: (2/47)، وأعلام المؤلفين الزيدية: ص(114، 116).
- ينظر: افتتاح الدعوة: للقاضي النعمان
- راحة العقل للكرماني، ص (129).
- كنز الولد: للحامدي، ص (13-14).
- ينظر: إثبات النبوات: للسجستاني، ص (179)، ومقدمة مصطفى غالب على تحقيقه لكتاب راحة العقل للكرماني، ص (23).
- ينظر: قرة العيون: ابن الديبع، ص (147)، ولعل المراد ظهور دعواتهم للعلن، وإلا فدخولهم إلى اليمن كان قبل ذلك.
- ينظر: عيون الأخبار: ص(37).
- هو أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي. ينظر: افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص(3-4).
- ينظر: الصليحيون والحركة الباطنية في اليمن: حسين بن فيض الله الهمداني، والدكتور، حسن سليمان، ص(33).
- حَرَاز: منطقة واسعة مركزها الرئيسي مناخة، الواقعة على الطريق بين صنعاء والحديدة، وفيها جبال شاهقة، ويزرع فيها البن بكثرة، وهي تتكون اليوم من منطقتين، منطقة مناخة، ومنطقة صعفان، وفي منطقة مناخة عدة عُزل بعضها تحمل أسماءها القديمة إلى اليوم، مثل لهاب وهوزن ومسار. ينظر: الموسوعة اليمنية، (2/1054).
- الإسماعيلية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، والمستعلية: نسبة إلى الإمام أحمد المستعلي، والطيبة: نسبة إلى ولده الطيب، وكلمة بهرة معناها التاجر بلغة الكجراتية الهندية.
- السليمانية: نسبة إلى سليمان بن الحسن، والمكارمة: اسم لطائفة السليمانية من الإسماعيلية المستعلية الطيبة، واختلف المتكلمون عن المكارمة في أصل تسميتهم بهذا الاسم، قيل، نسبة إلى المكرم الصليحي زوج السيدة أروى. وقيل غير ذلك.
- ص (383-384)
- ينظر: صفة جزيرة العرب للهمداني، (1/68)، والصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: حسين الهمداني، ص(65).
- منَاخَة: منطقة تقع غرب مدينة صنعاء بمقدار (120)كم، وتقع في رأس جبل حراز، وهي منطقة مرتفعة عن سطح البحر (2200م)، وتشتهر بزراعة البن، وجمال الطبيعة، ويُزرع في منحدراتها الموز والشمام، وتتميز ودياناها بتدفق السيول على مدار السنة. ينظر: معجم البلدان للمقحفي، (1/1643).
- الحُطَيْب: قرية تقع في جبل حراز، وكان الصليحيون يتخذون هذه القرية حصناً لهم، ويسكنها في العصر الحاضر طائفة البهرة. ينظر: معجم البلدان للمقحفي، (1/482).
- ينظر: الشيعة الإسماعيلية رؤية من الداخل: علوي طه الجبل، ص(27).
- ينظر: إسماعيلية اليمن السليمانية المكارمة: حمود زيد نزفل ص(58).


المقالات العلمية لا ينبغي لها أن تكون في ثوب لغوي صحفي أدبي مجازي،اللغة الصحفية الإعلامية مناسبة للأخبار وبالتقارير الاستقصائية وما في حكمها، وكاتب هذا المقال نسي هذه الاعتبارات وانغمس في استعراض قدراته في الصياعة أو ربما هو لا يعرفها.
(العقل الأول) و (العقل الكلي) هي من المقولات الفلسفية اليونانية الأصيلة، وليست من ابتداع الإسماعيلية بتاتاً، ومن المعيب على باحث يكتب في علم الكلام والفِرَق والمذاهب وليس لديه خلفية عن أصل المقالات ومنشأ التأثيرات المتبادلة في فضاءات العقائد ومضمار التصورات وتسرباتها بين البشر.
الإسماعيلية في اليمن ليست فرقتين كما أشار المقال، وليست (طيبة) بل (طيبية) والفرق كبير، و الـ(بُهَرَة) ليس إلا مسمى هندي شاع في الوسط الصحفي وتبادله الناس للإشارة إلى ذلك الطيف الإسماعيلي الذي أذعن بالولاء وبذل التبعية للقيادة الهندية، إذ أن إسماعيلية اليمن كما أسلفت ليسوا فرقتين بل طيفين مشتركين في كل شيئ، ما عدا القيادة، طيفٌ {{الإسماعيلية الطيبية المكارمة الداودية}} لا يرى بأساً في الإذعان لقيادة هندية كانت غصناً صغيراً من أغصانهم ذات مدة، وطيف (وطني) {{الإسماعيلية الطيبية المكارمة السليمانية}} يصر بعودة القيادة إلى اليمن بعد زوال سبب انتقالها إلى الهند ذات عهد، فكلا الطيفين (مكارمة) وكلا الطيفين (طيبية) وكلا الطيفين (إسماعيلية مستعلية).
أصل إطلاق تسمية (المكارمة) على هذه الطائفة ليس محهولاً وليس محط اختلاف ولا نقاش حوّله إلا عند كاتب المقال لأن معرفته محدودة حول هذا الميدان، المكارمة هو اسم قَبَلي يحمله قسم كبير من قبيلة همدان الواقعة غرب صنعاء فيما بينها وبين حصن ثلا التاريخي ومدينة شبام كوكبان، ينتسبون إلى أحدٍ أجدادهم (مَكْرَم) وليس (المُكَرَّم)، وإلى يوم الناس هذا لا يزال المنتمون إلى هذا الفرع من قبيلة همدان يسمون بني مكرم حتى لو كانوا من أهل السنة والجماعة أو ممن يتبعون الزيدية فروعاً وأصولاً، والسبب هو أن أسلاف الإسماعيلية الأوائل كانوا ينتسبون إلى هذا البطن من قبيلة همدان ولكنهم بعد انمحاء سلطتهم السياسية حاولوا الابتعاد عن صنعاء كونها موطن الثقل السياسي الذي تدور حوله معظم الحوادث العظام فانتقلوا إلى جبال حراز في الغالب وإلى نجران وواديها، ولم يتبق لهم في مناطقهم الأصلية بهمدان إلا قرية وحيدة فقط هي قرية (طيبة) في أعالي وادي ضهر بضواحي صنعاء.
أتفق مع كاتب المقال حول خطورة الغفلة والتغافل عن الإسماعيلية وأدوارها الخفية، ولاسيما ذلك الطيف الذي يتبع القيادة الهندية، ولكنني استغربت من اهتمامه بالكتابة عن (فرسان الظل) وخلو مقاله تماماً من الحديث عن أنشطتهم المعاصرة الخطيرة التي برزت للعلن وأصبحت ذات صوت عال يصدح في منابر التواصل الاجتماعي ولاسيما الفيسبوك ويوتيوب حيث اشتروا جهود مئات الشباب من صناع المحتوى وهواة التصوير ليجعلوا مناطقهم كلها وقبلتهم (الحطيب) على وجه الخصوص مزاراً مرغوباً وتقديمه للجمهور على أنه المنطقة الوحيدة المثالية في اليمن الجديرة بالزيارة والتي تنطوي على أعظم معالم التميز السياحي والبنية التحتية الحديثة المتكاملة، غير الجهود السياسية المتمثلة في الاصطفاف مع الحوثيين وأحزاب الوسط واليسار في آن واحد كون جميع هذه الأحزاب -بسذاجة مفرطة وحمق مستفحل- لا تنظر إليهم نظرة ريبة وشك ولا تراهم مختلفين عن جموع الشعب اليمني.
د. سامي حفظكم الله ورعاكم استفدت كثير من مقالكم أحسن الله إليكم
بالنسبة لـ د. عبدالغني
لقد طرحت جملة من الملاحظات التي في بعضها حق، لكن المشكلة الحقيقية ليست في المعلومة التي أوردتها، بل في الأسلوب الذي استخدمته في النقد، والذي تجاوز حدود الأدب العلمي إلى التهكم والتجريح الشخصي، وهو أمر لا يليق بمقام النقاش العلمي المحترم.
إن من أبجديات النقد العلمي أن يُفصل بين مناقشة الفكرة والتطاول على كاتبها، وأن يُقدَّم التصحيح بلغة هادئة مؤدبة، تحفظ لصاحب المقال مكانته، مهما اختلفنا معه في بعض التفاصيل، أما استعمال أوصاف كـ “الصياعة” و”لا يعرفها” و”المعيب على باحث” فهذا في حقيقته لا يعبر عن عمق علمي بقدر ما يكشف عن ضعف في أدب الحوار وافتقار لأبسط قواعد النقاش العلمي.
ثم إن المقال المطروح ليس ورقة بحثية متخصصة حتى تُلزم كاتبه بلغة المختصين الدقيقين في علم الكلام والفرق، بل هو مقال ثقافي موجه للجمهور العام، استخدم فيه صاحبه أسلوبًا يجمع بين الطرح العلمي والتوصيف الأدبي التحليلي، وهو نهج معروف وله مساحته في الكتابة الفكرية والثقافية.
لو أن أسلوبك في النقد التزم بآداب العلم وأخلاق البحث لكان لما ذكرته من التصحيحات قيمة مضافة، أما حين يُطرح التصحيح بهذه الصورة المتعالية الحادة، فإنه يسيء لصاحبه أولاً قبل أن ينتقص من الكاتب.
فرق كبير بين من ينقد ليصحح، ومن ينقد ليُشهر ويتعالى.
وفقنا الله وإياك لحسن الخلق، والإنصاف في القول والعمل
شكرًا للدكتور سامي منصور على مقاله القيم، الذي تناول فيه موضوعًا حساسًا وشائكًا عن الإسماعيلية في اليمن، بأسلوب رصين وتحليل متوازن، جمع بين رصد الواقع، واستقراء السياق التاريخي والاجتماعي، في طرح يثير الأسئلة ويستحق التقدير، ويُحسب له فتح نافذة على ملف طالما ظل طيّ الإهمال أو التحفظ.
أما ما يؤسف له في تعليق الدكتور عبد الغني – مع التقدير لشخصه الكريم – فتلك النبرة الفوقية، واللغة القاسية التي لا تليق بمقام النقاش العلمي، إذ من غير اللائق أن يُسفّه أحدٌ رأيًا آخر أو يُسقطه بتعابير جارحة، كقوله “نسي هذه الاعتبارات”، و”استعراض قدراته في الصياغة”، و”من المعيب على باحث…”، فالعلم لا يليق به الغرور، ولا تُبنى المعرفة بجلد من يكتب أو ينتج فكرة.
ثم إن المقال – كما هو واضح – مقال رأي وتحليل اجتماعي/ثقافي، ولم يُقدَّم على أنه بحث فلسفي أو دراسة مذهبية معمقة، فمحاكمته بمنهج الفلاسفة أو مدارس علم الكلام هو خلطٌ بين أجناس الكتابة، ولو أن كل كاتب في الصحافة أو المنصات الفكرية عومل بهذا المعيار، لما بقيت مساحة للرأي أو إثارة الأسئلة.
وأما ما ورد من اجتهاد في المصطلحات أو التقسيم، فيُرد عليه بلغة العلم وهدوء الأكاديميين، لا بمنطق الإقصاء أو التحقير، خصوصًا حين يكون الكاتب قد أحسن في تسليط الضوء على ملف غائب عن الكثيرين، وفتح باب النقاش حول موضوع مسكوتٍ عنه.
العلم لا يُحتكر، ولا يُنصر بالعنف اللفظي، بل بالبيان والتواضع والرفق، ﴿ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾.
شكرًا للدكتور سامي منصور على مقاله البديع، الذي جمع بين رصانة الفكرة وجمال العبارة، وأحيا ملفًا غائبًا بأسلوب يوقظ الذاكرة ولا يستفز العقول.
أما تعليق الدكتور عبد الغني، ففيه علم غزير لا يُنكر، لكنه جاء في ثوب من التعالي لا يليق بمقام البحث ولا أدب الخلاف، فالمقال لم يُكتب كمبحث فلسفي، ولا سُوِّق كمرجع عقدي، بل هو مقال رأي، يفتح نافذة للنقاش، لا بوابة للتقريع.
ولنا أن نختلف، لكن لا يصح أن نُقصي، فليس من الإنصاف أن يُقابل جهدٌ بالحطّ، ولا فكرةٌ بالازدراء، والناس مأجورون على ما اجتهدوا فيه، إن أحسنوا أو أصابوا.
الأستاذ عيسى عبدالواسع
(الصياعة) لفظة نابية مشحونة بكم هائل من سوء الأدب، ومثلها لا يصدر إلا عن (عيال السوق) ولستُ منهم، وسياق الكلام لا يحتمل إلا اليقين الجازم بأن خطأً طباعياً قد حصل سهواً، وهو حلول العين بدلاً عن الغين، لأن المقصود هو (صياغة) التراكيب اللغوية لا غير، ولكنك دخلت متوشحاً (بعين السخط) فلم تر غير ما تخيلتها عيوباً.
أشرت إلى أن ملاحظاتي معي حق في بعضها، وهذه العبارة تقتضي أن هناك ملاحظات أخرى ليس لي الحق فيها، ولأنك كنت معنياً بالردح لا العلم، بالمناكفة لا المثاقفة، فأنت قد تجنبت تحديد أيٍّ منها هي التي معي فيها الحق أو الأخرى، وإغفالك إياه ذاته كالتصريح بدافعك على تعليقك أو بعجزك عن تحديدها أساساً.
قصدت عمداً عدم الرد على تطاولك وسوء الأدب الذي طفحت به لغة تعليقك بصورة مريعة لم أستطع فهمها، وهي تجعلك جديراً بقائمة من الاتهامات تبلغ ضعفي ما اتهمتني وبهتني به؛ لأنني لا أبادل المسيئ الإساءة بمثلها.
شكرًا لكاتب المقال على هذا الطرح الجريء والواعي في ملف مسكوت عنه طويلًا، أما ما قيل من قِبل الدكتور عبد الغني، فمع حفظ مكانته، إلا أن حدّة التعليق، وتعالي العبارة، وتحقير الجهد، لا تليق بمقام العلم ولا بأهله.
العبارات من قبيل: “نسي الاعتبارات”، و”استعراض قدرات”، و “من المعيب على باحث”… ليست من لغة النقد الأكاديمي، بل منطق وصاية وسلطة فوقية، تُسقط الرأي لا تناقشه، وتهاجم الكاتب لا الفكرة، والعلم أوسع من ذلك وأكرم.
أما تقسيم الإسماعيلية، فليس أمرًا مبتدعًا في هذا المقال، بل هو متداول بين الباحثين، وقد قسمها بعضهم إلى ما هو أكثر مما ذكره صاحب المقال، بحسب الزوايا والمرجعيات، فليس من اللائق الطعن في المعلومة لمجرد أنها لم توافق اختزالًا معيّنًا.
وأما “الطيبة” فظاهر أنها سهو طباعي لا يُلام عليه الكاتب، ولا يصح أن يُبنى عليه استخفافٌ بمضمون المقال، الذي اجتهد أن يوقظ الاهتمام حول جماعة لها حضور مؤثر، وأدوار متشابكة، وتاريخٌ ليس بالسهل.
لكن المؤسف حقًّا أن يخرج النقد من عباءة العلم ليصبح أداة للتأنيب والتقليل، وكأن صاحبه لا يكتب لبيان حق، بل ليُشعر القارئ أن العلم وُلد بين يديه وحده، وأن غيره مجرد مجتهدٍ لا يُجيد القراءة ولا الكتابة! هذه النبرة لا تُنبت معرفة، ولا تفتح نقاشًا، بل تُشيِّد جدارًا من الترفع لا يصلح للبناء عليه.
وما يُؤسَف له أكثر أن تصدر هذه النبرة المتعالية من رجل يحمل لقب “أستاذ دكتور”، إذ كان المنتظر من أهل العلم أن يكونوا أوسع الناس صدرًا، وألينهم عبارة، وأقربهم إلى التواضع، لا أن يتحوّل العلم في صدورهم إلى زينة لفظية وألقاب جامدة، لا تؤثّر في سمتهم، ولا تهذب أسلوبهم.
ويا للأسى حين يُصبح التخصص سيفًا مسلطًا على رقاب من يكتب، لا ليقومه، بل ليُخرسه، وكأن باب الرأي لا يُفتح إلا بإذن من جهة أكاديمية أو شهادةٍ عليا! إن العِلم لا يزهو بالتحقير، ولا يسمو بالإقصاء، ومن المؤلم أن نرى من يحملونه لا يحملونه أثرًا وخلقًا، بل يجلسون عليه كما يجلس المتكبر على عرش لا يراه سواه.
والسلام
يا سيد النقد العالي، يا من تتربع على عرش التصحيح بتعالٍ يُعمي البصر! ردك، بكل صخبه وتهكمه، أشبه بمسرحية هزلية تحاول إثبات العلم بفجاجة اللسان بدل دقة البرهان. تنتقد لغة المقال الأدبية وكأنك حارس العلم الوحيد، لكنك تغرق في استعاراتك المتفخمة مثل “فضاءات العقائد” و”مضمار التصورات”، فأين حيادك العلمي الذي تتبجح به؟ تنعى على الكاتب جهله بجذور “العقل الكلي”، لكنك تُلقي الحكم بغطرسةٍ وكأنك أنت مؤسس الفلسفة اليونانية بنفسك!
تصحيحك لـ”طيبية” و”المكارمة” دقيق، نعم، لكنك تقدمه بتكبرٍ يجعل القارئ يتساءل: هل تُريد النقد أم استعراض عضلاتك المعرفية؟ تتحدث عن الأنشطة المعاصرة للإسماعيلية بذكاء، لكنك تُغرقها في سخريةٍ مُفرطة مثل “حمق مستفحل” و”بسذاجة مفرطة”، فتُحيل نقدك إلى هجاءٍ شخصي بدل تحليلٍ علمي. أسلوبك الفج، يا عزيزي، يُنفر أكثر مما يُقنع، وتهكمك يُضعف حججك التي كان يمكن أن تكون جواهر لو نُظمت بلغةٍ أرقى.
فنصيحتي لك: انزل من برجك العاجي، وكف عن رمي الاتهامات كأنك قاضي العلم الأوحد. النقد لا يحتاج إلى صوتٍ عالٍ أو لسانٍ سليط، بل إلى عقلٍ رزين يُقدم الحقائق دون أن يُصم الآذان. وإن كنتَ تكره الأدبيات الصحفية، فلا تُلبس ردك ثوب الخطابة المتعجرفة، لأنك بذلك تُسقط نفسك في الحفرة التي حذّرت منها!
اشياء جميله جدا ومعلومات جميله اشكرك يا دكتورنا الغالي حفضك الله ورعاك 🥰 🫂
د. سامي منصور
أتابع ما تكتب، وقد سرّني هذا المقال كما سرّني غيره من نتاجك العلمي والفكري.
وللتنويه، فالدكتور سامي كان من طلابي في مرحلة الدراسات العليا، وهو من الباحثين المجتهدين المتقنين، وكان الأول على دفعته في مرحلة الدكتوراه، وقد نال أطروحته بدرجة كاملة (100 من 100) مع مرتبة الشرف الأولى. وقد كانت بعنوان: “تاريخ الدعوة الإسلامية في اليمن من عام ٣٠٠ إلى ٥٦٩هـ”. أبدع فيها في تسليط الضوء على حقبة مهمة من تاريخ اليمن، وامتدحها المناقشون لما اشتملت عليه من مادة علمية ثرية، واقتربت صفحاتها من السبع مئة. كما تناول في رسالة الماجستير موضوع “جهود الدولة الرسولية في الدعوة إلى الله في اليمن”، ونال فيها أيضًا درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وهو كما أعرفه: باحث متميز، دقيق في عمله، جادّ في بحثه، يكتب بعناية، ويشتغل على مادته العلمية باهتمام وحرفية.
غير أن العتب – وهو عتب محب – يبقى على بعض الأكاديميين اليمنيين، إذ ما إن يبرز أحد أبنائهم أو تلوح له موهبة، حتى تُسلَّط عليه الأقلام لا لِشيء إلا لأنه أبدع وظهر. وقد أعجبني في هذا السياق مقالٌ للدكتور سامي نُشر في هذا الموقع بعنوان “أضيع من تاريخ اليمن”، واستحضر فيه قول الإمام الشوكاني رحمه الله:
“ومع كثرة فضلائهم ووجود أعيان منهم في كل مكرمة على تعاقب الْأَعْصَار، لهم عناية كاملة ورغبة وافرة في دفن محاسنهم…”
لكن أكثر ما أثار استغرابي في هذا المقال، هو تعليق الدكتور عبد الغني، وأسلوبه الجاف الذي خلا من هدوء الباحث، وتواضع العالم.
كان الأولى أن يكون نقده علميًّا متزنًا، لا مائلًا للتعالي أو محمَّلًا بنبرة استعلاء لا تليق بأهل الفكر والمعرفة.
فالنقد لا يُبنى بالتقليل، ولا يكون بالتجريح، بل بالبيان، والعدل، والرفق، وهذه هي سِمة العلماء المعتبرين.
أشكر د. سامي منصور على هذا الطرح، والعنوان الرائق للمقالة، كما أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ د. عبد الغني الأهجري، المعلقين الأكارم حقيقةً تهجّمكم على د. الأهجري من آفات هذا العصر، دعوا النقد يأخذ طريقه والصبر عليه صبرٌ على العلم وذلك فرضٌ على المتعلمين ضمّتهم مظلة “د, ” أم لم يدركوها بعد!
لقد أبرد د. الأهجري عليَّ بتعليقه إذ ضجرتُ من كثرة المحسنات التي استعملها د. سامي، وقد جاوز الحدَّ حتى طغت على النص، ولاشتغالي بالتحرير فلا أشك أن للذكاء الصناعي نصيبًا في صياغة هذا المقال، وأنا أكرم كاتبًا ينشر ويعتدُ بما ينشر عن أن يخوض في وحل الصياغات المكررة والبيان الجاف المصنوع الذي يُمليه الذكاء الصناعي.
مع فائق الاحترام.