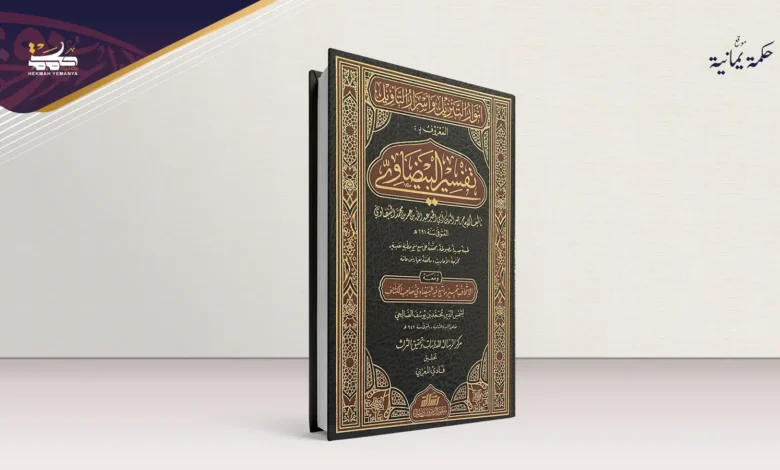
تفسير “أنوار التنزيل وأسرار التأويل” للإمام البيضاويّ عُمدة التفاسير المتأخرة، وأحد أهم التفاسير، وأنفعها. وقد سيطر بصحبة تفسير “مدارك التنزيل وحقائق التأويل” للإمام أبي البركات النسفي (ت 710هـ) على زمن المُتأخرين؛ ليُمثِّلا معًا دُرَّتَيْ زمانهما. وللإمام البيضاويّ قصة حياة، وقعت من نفسي موقعًا مؤثرًا؛ فلا تُزايلها. احترمتُ في قصته رُجلًا صادق النفس، صريح الطويَّة؛ سلك طريقًا ثم عدل عنه إلى طريق أخرى؛ قد تبدو لعين الناظر العابر غير المُدقِّق طريقَ مَذهُوبِ العقلِ، مُضيَّعِ الفِكر.
حياة الإمام البيضاوي
يختلف المؤرخون في تحديد مولد الإمام البيضاوي ما بين أواخر القرن السادس الهجري، والعقود الأولى من القرن السابع؛ فيقول البعض إنه وُلد عام 585هـ -على رأي من قال إنه عُمِّر مائة سنة-، وآخرون يحددون مولده بعدها بعشرات السنين. وكذا اختلفوا في وفاته، ما بين 685 و691هـ. وكان مولده في مدينة صغيرة تُدعى “البيضاء”؛ لذا كانت نسبته لها بالبيضاويّ. ولقبُه ناصرُ الدين، وكُنيتُه أبو الخير، واسمُه عبدُ الله بن عُمر بن محمد. وكان أبوه وجدُّه قاضيَيْنِ للقضاة في مدينة “شيراز”، في بلاد فارس. فهو حسيبٌ، من بيت علم مشهور في بلاده. تلقى العلم على يد كثيرين، منهم أبوه؛ الذي كان مثلًا أعلى له، حتى استقرَّ في مُخيلة ولده حُلمُ تولي القضاء، بل أن يصير قاضي القضاة كأبوَيْهِ، وسَلَبَ هذا الحلمُ لُبَّ الشيخ البيضاوي شطرًا من حياته طويلًا.
ولم يقصِّر البيضاوي صبيًّا في التأهُّل لينال حُلمه؛ فبرع في العلوم بشقيها (النقلي والعقلي)، ولعلَّ ريادته بدت في علوم المعقول، يدل على هذا حِذْقُه الشديد في العلوم التي تقتضي الذكاء والفطنة، مثل النحو والبلاغة والأصول والكلام والمنطق. وقد كان في الفقه شافعيّ المذهب، وفي أصول الفقه على مذهب المتكلمين، وفي أصول الدين على المدرسة الأشعرية. وله في العلم مؤلفات رصينة مباركة، أذكرها بإذن الله.
وحَصَلَ -بعد أن أحكَمَ البيضاوي العلوم- أنْ تولَّى القضاءَ بشيراز، لكنه عُزل منه بعد ستة أشهر؛ حيث كان شديدًا في الحق صارمًا. وتاقت نفسه أن يتولى قضاء “تبريز”، تتبعًا لحُلم القضاء الذي استلب خياله. فرحل إليها، ودخل إلى مجلس الوزير في حادثة مَحكِيَّة. وكان من سُنن الخلفاء والوزراء والولاة والمشاهير والأعيان أن يعقدوا مجالس للعلم وللمسامرات وللغناء في لياليهم. يُضيِّفون فيها العلماء والأدباء والمُغنيين، بصنوفهم المختلفة. وكانت هذه المجالس على مراتب في أماكن الجلوس؛ فكان صدرُ المجلس، الأقربُ لصاحب المجلس، معقودًا لأهم الحاضرين، ثم الذي يليه في الترتيب أبعد شيئًا، ثم الذي يليه في أقصى المجلس (يتفاوت الترتيب حسب المجلس ومكانه وفخامته).
فكان أنْ دخل البيضاوي مجلس الوزير وقعد في أواخر الصفوف. وقدَّرَ الله له أن زها أحد الجالسين بمسائل من عويص العلم (وهذا كان من عادات هذه المجالس)، وتحدى أن يحلها أحدهم. فحلَّها البيضاوي في براعة لفت بها الأنظار. فكان أنْ أجلسه الوزير في مكانه (أقصى درجات التقدير في هذه المجالس أنْ ينزل صاحب المجلس عن كرسيه لمَن حظي بالإعجاب والثناء). وهذا دلَّ على براعة البيضاوي المشهودة له، وأشار إلى إرادة البيضاوي للظهور والبيان بين الناس، وصولًا إلى غايته الدنيوية المَرجوَّة.
في أثناء سعي البيضاوي لتولي القضاء بتبريز، فكَّر أن يستعين على مسعاه بالشيخ العارف بالله “محمد الكتحتائي”، وهو شيخ مقرب من الأمير؛ فقد كان شيخًا مهيبًا يحب الأمير لقياه والتبرك به. وكأن الله أراد به الخير كل الخير حينما أرشده للشيخ، أو أرشد الشيخ إليه. فاقترح الشيخ على الأمير رغبة البيضاوي، قائلًا: إنَّ عالِمًا فاضلًا يريد أن يشاركك سِجَّادةً في جهنم! .. فوقعت الكلمة موقعها في نفس البيضاوي الساعي إلى المناصب، ونالتْ منه كل مَنَال، وأحسَّ أنها رسالة على لسان الشيخ، لا رسالة الشيخ، ألقيت في روعه وأُجريت على لسانه.
فنفر من رغبته النفور كلَّه، وتنكَّبَ عن طريق القضاء والمناصب، ولازَمَ الشيخ العارف بالله الكتحتائي حتى تُوفِّي. فسبحان مَن أمر العباد بالتأمُّل، ثم مدَّ لهم تلابيبه؛ فأنعم الله على بعض عباده بالتشبث بها، والتنبُّه لمكنونها، والفطنة لمُستقرِّها ومُستودعها.
ومنذ ترك البيضاوي طريق السعي وراء المناصب القضائيَّة، بارك الله في عمله كل المباركة. ووفقه إلى طريقٍ ما أغناها وأوفرها! .. فقد ألَّفَ ثلاثة من أهم كُتب المتأخرين؛ أولها المتن العُمدة في الأصول على طريق المُتكلمين “المنهاج”، واسمه بالتمام “منهاج الوصول إلى علم الأصول”. ومنذ ألَّف هذا المتن الصغير وأهل العلم يتعاضدون على التأليف عليه واستنفاد شرحه وتعليله، واستخراج أسراره واستنتاج معاني تعابيره. أما الكتاب الثاني فهو “الطوالع”، واسمه بالتمام “طوالع الأنوار من مطالع الأنظار”، وقد اعتبره أجلاء أهل العلم أجود المختصرات في أصول الدين. أما الكتاب الثالث فهو تفسيره للكتاب العزيز، وهو موضوع الحديث.
ومن توفيق الله -تعالى- على عبده؛ أنْ عوَّض البيضاوي ما تركه لرضاه، فما من شخص حتى اللحظة يذكر البيضاوي إلا ويقول: “قال القاضي البيضاوي” أو “ذكر القاضي البيضاوي”. قد أرادها البيضاوي في حياته الفانية، فكتبها الله له بعد موته قرونًا. فسبحان المُقدِّر!
تفسير البيضاوي درة تفسيرية
تفسير الإمام البيضاوي من التفاسير الممتازة عن غيرها؛ ومن إرهاصات هذا الامتياز ابتداءُ المؤلف بتقدير خطورة ما أقدم عليه من تفسير القرآن، فقد قال في المقدمة الموجزة عن فن التفسير: “لا يَليق لتعاطِيْه، والتصدي للتكلُّم فِيْه إلا مَن برع في العلوم الدينية كلها -أصولها وفروعها-، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها”. ثم يرى نفسه غير أهل لهذا العمل “إلا أن قُصور بضاعتي يُثبِّطني عن الإقدام، ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام”. ووقوف المؤلف على ما هو عليه من شأن يذكي حس الحذر في نفسه، ويحشد التجهُّز لإمكاناته كلها.

ينابيع الأنوار الثلاثة
لعل عنصر تميز هذا التفسير يكمن في زمنه المتأخر نسبيًّا، وتقدُّم فطاحل لا يُجارون موهبةً ومهارةً في مجال التفسير؛ كالطبري والزمخشري والرازي. فهنا نقف على نكتة من رُوح تفسير البيضاوي؛ ألا وهي إرادته تقديم الجديد من وراء هذا التراث الضخم. ولعلَّ ما مثَّل لديه الجدَّة هو عنصرا الانتقائية والشمول. شموله لما يُسمى بالمأثور من التفسير بالحديث الشريف، وآثار الرعيل الأول في التفسير، والانتقائيَّة من جهابذة المفسرين بالرأي السابقين له، المُعملين ما وقر لديهم من خبرة تفسير القرآن بالقرآن، وبأدوات اللغة الواسعة والمنطق السديد الفسيح وآثار التاريخ المنشورة. ولعلَّ هذا ما عبَّر هو نفسه عنه بقوله: “يحتوي على صفوة ما بلغني من عُظماء الصحابة وعلماء التابعين، ومَن دونهم من السلف الصالحين؛ وينطوي على نُكتٍ بارعة ولطائف رائعة، استنبطتها أنا ومَن قبلي من أفاضل المتأخرين، وأماثل المُحققين”.
فمتى خلصنا من هذه الأوصاف السابقات وقفنا على الينابيع الثلاثة التي دبَّج منها البيضاوي تفسيره: المأثور في التفسير، أفانين السابقين في التفسير، ما أضافه هو نفسه -كما صرَّح-؛ لكونه مُحققًا في النحو والبلاغة وأصول الفقه وأصول الدين. ومتى حقَّق المرء هذه العلوم صار أهلًا للإدلاء برأيه في التفسير.
منهج البيضاوي في التفسير
أمَّا السمة الحالَّة في تفسير البيضاوي التي جعلته عُمدة تفاسير المتأخرين؛ فهي كونه تفسيرًا خالصًا، سَمتُه الخُلُوص من كل شائبة وزائدة تَحُولُ دون المعنى المُبين، حتى مع تعدُّده. فهو -في نظري- استقرَّ في منهجه على دعامتين: إنتاجُ المعنى من الآية والإبانة عنه، خاصةً إذا كان المعنى واضح الطريق الاستدلالي، وتبيينُ طريق المعنى الاستدلالي متى خفي أو تعدد. والأمر يحتاج لبعض البسط والتوضيح؛ فالبيضاوي يركز على تبيين المعنى المراد هدفًا أصيلًا، وهذا ما يُصنَّف عادةً بالتفاسير الإجماليَّة، أيْ التي تُخلِّص بنية التفسير من كل آليات توليد المعنى، وتُبقي على المعنى النهائي وحده. لكنَّ تفسير الأنوار ليس من التفاسير الإجمالية؛ لأن البيضاوي أودع مع المعاني طرائق استدلالها، بل رتَّبها؛ فهو يبدأ تفسير الآية بطريق الاستدلال (ويكون غالبًا دلاليًّا أو صرفيًّا أو نحويًّا أو بلاغيًّا أو أصوليًّا أو عقديًّا)، فيُردفه بالمعنى الناتج عن الطريق الذي أورده، وقد يقدم المعنى ويُردفه بطريق استدلاله على صورة التعليل له. وعند تعدُّد الوجوه يوردها جميعًا أو يُورد أهمها. مع الترجيح أو الكفّ عنه.
مثال من أول تفسيره سورة “الأعراف”، يقول: “{كِتَابٌ} خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب، أو خبر {المص} والمراد به السورة أو القرآن. {أَنزَلَ إِلَيْكَ} صفته. {فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ} أي شك، فإن الشك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه مخافة أن تكذب فيه، أو تقصر في القيام بحقه، وتوجيه النهي فيه للمبالغة كقولهم: لا أرينك ها هنا. والفاء تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. {لِتُنذِرَ بِهِ} متعلق بأنزل أو بلا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار، وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه. {وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ} يحتمل النصب بإضمار فعلها أي: لتنذر وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكير، والجر عطفاً على محل تنذر والرفع عطفاً على كِتَابٌ أو خبراً لمحذوف”.
هذا مثال ركَّز فيه على آليات اللغة، خاصةً الدلالة والنحو؛ وهو في تفسيره عامةً يغلب عليه استخدام النحو المُعمَّق، الذي هو الجسد المُكوِّن للبلاغة، كما أشار “عبد القاهر الجرجاني” في نظرية النظم. لكنَّه ينوِّع من طريق الاستدلال وآليَّات إنتاج المعنى، بما توفَّر لديه من علوم. وقد يعرض طريق أداء المعنى بإظهار الأصل والتغيُّر الداخل على الصيغ. يقول: “{عَمَّ يَتَسَاءلُونَ} أصله عما فحذف الألف لما مَرَّ. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه؛ كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه. والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم، أو يسألون الرسول ﷺ والمؤمنين عنه استهزاء كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم، أو للناس”.
وهذا مثال لتعدُّد وجه المعنى وطريقه “{إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا} تكرير للتأكيد أو استئناف وعده بأن {ٱلْعُسْرَ} متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة، كقولك: إن للصائم فرحةً، إن للصائم فرحةً أيْ فرحة عند الإِفطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله ﷺ” لن يغلب عسر يُسرَيْن “فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس، واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول”.
ولعلَّ هذا الجمع بين المعنى وطرائق أدائه هي التي خصَّتْ البيضاوي بخاصيَّة فرادته، فلَمَع تفسيرًا خاصًّا لأهل العلم؛ يقدم لهم خلاصةً متى أرادوا الخلاصة الجامعة بين المعنى وطريقه. وكذا لطلاب العلم المُترقِّين فيه ليشهدوا هذا الجمع الفريد مع وجازةٍ قلَّ مثالها. ولعلَّ هذا الجمع مع الوجازة في العبارة هو العامل الذي جعل أهل العلم يتوفرون على تفسير الأنوار؛ ليشرحوا العِلَّة في طريق أداء المعنى، ويناقشوا مسلك البيضاوي فيها، ويُرجحوا بين وجوه المعاني الواردة، وينقلوا للطلاب خلاصة ما أتى به.
فكان تفسير الأنوار صالحًا أشد الصلاح للشرح والتدريس، بل هو الكتاب الأمثل للشرح والتدريس؛ بما أدوعه فيه صاحبُه من طرائق توليد المعنى. فإن غايةَ طالب العلم المُؤهل الجمعُ بين المعنى ودليله، واستحضارهما سويًّا في صعيد واحد. فما الحال وهُما بين دفَّتَيْ كتاب!
ومن طرائق توليد المعنى وتشقيقه في الأنوار اهتمامُه بالقراءات ووجوهها؛ بما تضفيه هذه الوجوه من إمكانات فسيحة في إدراك المغازي القرآنية. وقد قيَّدَ البيضاوي هذا المسلك له في المقدمة، واصفًا تفسيره: “ويُعرب عن وجوه القراءات المشهورة المَعزوَّة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، والشواذ المَرويَّة عن القرَّاء المُعتَبَرين”.
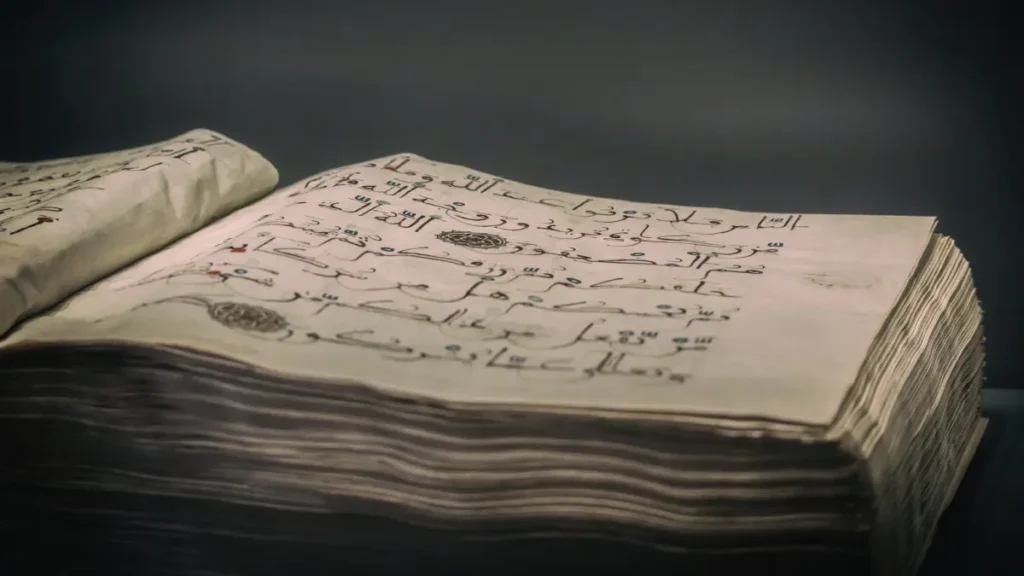
وسطيَّة تفسير الأنوار
تفسير الأنوار وسط من حيثيَّات كثيرة؛ فهو من حيث المصادر راعى المأثور والرأي، ومن حيث وجه المعنى وسط بين التفسير والتأويل، ومن حيث وجه الدلالة وسط في طريق إيراده الوجه الدلالي بين الإطالة والاستطراد واستحضار القواعد والحذف الكُلِّي لها، ومن حيث الحجم وسط بين البسط والاختزال. هذه الوسطية أهَّلتْه ليصير عُمدة تفاسير المتأخرين.
ولفظة “المتأخرين” وصف يُصوِّر حال اكتمال العلوم العربية والإسلامية ونضجها عند المتأخرين، على الهيئة والصورة التي استقرت عليها. أمَّا صفة “المتأخرين” من حيث الزمان، فهي مقيدة بالنسبة؛ فإن عصر البيضاوي في نظر عصرنا مرحلة وسطى بين المتقدمين والمتأخرين الذين هُم نحن ومَن سبقنا، بما تغير لدينا من صفة للعلوم وهيئة لها من حيث الزمان والشخوص.
وجه إجراء تفسير الأنوار
يبدأ البيضاوي باسم السورة، ونوعها من المكي والمدني، وعدِّ آياتها حسب العد الكُوفيّ. ثم يشرع في إيراد السورة آية بعد أخرى. وهو لا يُعزب في تفسيره عن شيء من كلمات القرآن، كما فعل الزمخشري قبله بإغفال ما هو واضح أو متعلق بما جرى عليه حديثه؛ فتفسير الأنوار يشمل كل كلمة من القرآن. وتفسير الأنوار تفسير مَوْضِعيّ؛ يُورد الموضع في الآية متبوعًا بتفسيره (أيًّا كان نوع التفسير نفسه أو طريقه). لكنه في بعض الآيات يتبع طريق المزج؛ وكأنه تفسير مزجي.
وفي آيات الأحكام يتبع طريق الشافعية الذين ينتمي إليهم، وقد يزاوج بين رأيهم ورأي الأحناف مع الترجيح؛ خاصةً لما كان بين الشافعية والأحناف من مُنافرة. وقد سمح طريقُ الاختصار للبيضاوي بالتخفُّف من روايات الإسرائيليات في التفسير، والإبقاء على القليل المُوضِّح لبعض وجه المعنى. وفي آيات الصفات يراوح طريقي التفويض والتأويل، والأخيرة أشد فُشُوًّا عنده على رأي مدرسة المتأخرين. وهو يهتم بالرد على المعتزلة فقط، ويُهمل مناقشة الحشويَّة والمُجسِّمة على خلاف ما كان عليه الإمام الرازي (ت 606هـ) في “مفاتيح الغيب”؛ حيث اهتمَّ بالرد على المُجسِّمة والكرَّاميَّة.
وهنا نكتة أصيلة في هذا السفر المُقدَّر؛ فرغم اعتماده على الإمام “الزمخشري” (ت 538هـ)، واشتهار القول بأن البيضاوي محض “اختصار” للكشَّاف؛ إلا أنه خالفه في مسلكه الاعتقادي الاعتزالي، وخالفه في مذهبه الفقهي الحنفي، وخالفه -جزئيًّا- في وجه إيراد المعنى. فقام الإمام البيضاوي بحذف الاعتزاليَّات التي في تفسير الزمخشري، أو إعادة توجيه المعنى فيها إلى وجهة سُنيَّة. وكان يصرِّح بمخالفة الاعتزال وتمييز مذهبهم عن المذهب السني. كما خالف سمت “الكشَّاف” في الإقلال من المعالجة البلاغية، باختصار المعالجة والاقتصار على المعنى المقصود، أو الإشارة إلى مسلك المعنى دون الإفاضة فيه وتوفيته. خلاف ما انفرد به البيضاوي نفسه من أنظارٍ خاصةٍ بوصفه أحد أمهر النظَّارين في الأمة. وآية تلك المخالفة هو تفاوتهما من حيث التصنيف؛ فإن “الكشَّاف” تفسير بلاغي لا شك في ذلك، أما تفسير الأنوار فتفسير أعمّ وأشمل سمتًا، لا يُقيد بقيد البلاغية.
الحواشي عليه وطبعاته
لقد تعاضد على تفسير البيضاوي أمةٌ من الخلق، منذ زمن كتابته حتى اللحظة. وقد تكاثرتْ حواشي البيضاوي إلى درجة تجعله صاحب أكثر تفسير كُتبت حوله حواشٍ في التاريخ. فقد اهتمَّتْ به المدارس السنيَّة جميعًا؛ إمَّا لسُنيَّته واختصاره، وإمَّا لشرح ما فيه من إشارات واختصارات تعليمًا وتفهيمًا. فكما سبق المقال من قبلُ إنه خير مثال للدرس والشرح. ومن أهم الحواشي عليه حاشية الإمام السيوطي (ت 911هـ) من الشافعية كالمؤلف، وحاشية ابن التمجيد (ت 880هـ)، وحاشية محيي الدين شيخ زاده (ت 950هـ)، وحاشية الشهاب الخفاجي المصري (ت 1069هـ) وهي من أعظم وأجل كُتب التفسير، وحاشية إسماعيل القُونوي (ت 1195هـ) والأربعة من الأحناف. وحاشية الشهاب حاشية رائقة عالية القدر، اسمها “عناية القاضي وكفاية الراضي”.
أما تفسير الأنوار نفسه فله طبعات قديمة، وطبعات منسوخة عنها في لبنان. وله طبعة حديثة، جمعته مع حاشية السيوطي، في دار اللباب، حققها السيد/ ماهر أديب حبُّوش. وقد اطلعت عليها فاستحسنتها ووجدت فيها وفاء بالغاية والقصد، وجهدًا مشكورًا.
وبعدُ، فهذه صفحة سُطرتْ بماء الذهب وزُيِّنتْ باليواقيت؛ ثُمَّ سُميت تفسيرًا. ويا لها من صفحة!

