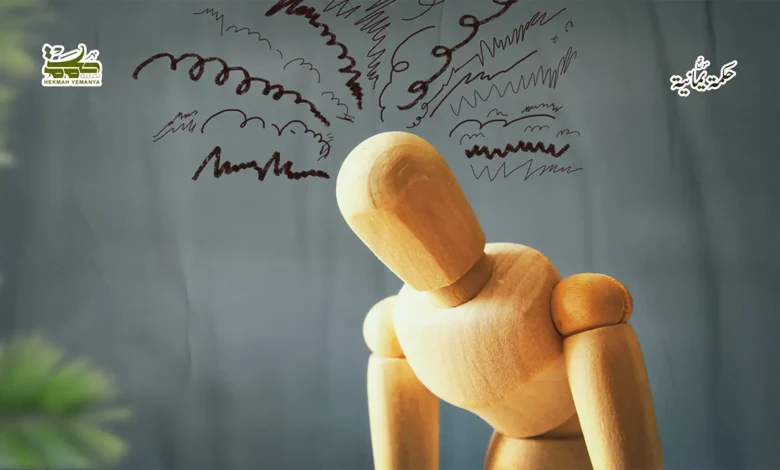
قد يتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى أننا بصدد الحديث عن أيديولوجية سياسية، أو قضية فلسفية، وهذا أمر يُعذر به؛ لا سيما وأن عنوان المقال تضمن كلمة “فكرة”، وهذه بدورها مفردة شائعة الاستعمال في ميادين الفلسفة والسياسة، ولا تكاد تصغي أو تشاهد مفكرًا ولا سياسيًا إلا وتجد لسانه يَلُوك هذه الكلمة دون فتور. عمومًا، لن أتوسع أكثر في هذه الجزئية، وسوف أفرد الحديث عن معنىً آخر تتحول فيه الأفكار من كونها وسيلة للتعبير عن القناعات التي يتبنّاها الفرد إلى نماذج قهرية يعمل بمقتضاها، ويجد نفسه أسيرًا في شرنقتها، وهذا وصفُ لما اصطلح على تسميته لدى علماء النفس “باضطراب الوسواس القهري” (OCD).
إن هذا الاضطراب قادر على الفتك باليقظة الذهنية للفرد، خاصة إذا لم يسعَ إلى طلب العلاج النفسي، وأول ما يبدأ بفكرة غير منطقية تمامًا، تتسلل إلى عقله، وتستحوذ على اهتمامه، وتدفعه بعد ذلك للقيام بسلوكيات قهرية لا يقوى على مقاومتها، وهذه الأعراض عادةً ما تأتي مصحوبة بمزيج من مشاعر القلق، والخوف، والتوتر، وتأخذ هذه الأفكار القهرية أشكالًا متنوعة مثل: غسل اليدين بشكل مفرط، التحقق المتكرر (التأكد من قفل الباب)، وتوهم المرض، والاكتناز (hoarding).
وسوف أُبيّن حجم المعاناة التي يعيشها المريض من خلال حالة أحد الطلاب الذين قمت بتدريسهم قبل سنوات؛ ففي أحد المحاضرات، وبينما كنتُ أتحدث إلى الطلاب عن بعض الأمراض النفسية (العُصابية) التي إن أُهمِل علاجها؛ فإنها قد تتحول مع مرور الزمن إلى أمراض ذُهانية، وكان الوسواس القهري من بين الأمثلة التي ذكرتها، تفاجأت بأحد الطلبة وهو يُلَوّح بيده طالبًا الخروج من القاعة، وقد بدت عليه علامات الذهول، والهلع. في الحقيقة لم أستفهم منه عن سبب استئذانه، وأذنِتُ له بالخروج، وبعد انقضاء وقت المحاضرة، انفضت جموع الطلبة، وشرعت في ترتيب أوراقي استعدادًا للمغادرة، فإذا بطالبٍ هزيل يتقدم إليّ ببطء قائلًا: يا دكتور أنا استأذنت قبل قليل (غصب عني)، سألته: خير إن شاء الله، وماذا بك؟ أجاب بأنه منذ فترة ليست بالقصيرة، شاهد مقطعًا مسجلًا في أحد منصات التواصل الاجتماعي عن الأعراض الأولية لأحد الأمراض المرتبطة بالجهاز التناسلي، وبدأ بعدها يتفحص جسده في دورة المياه، واعتقد أنه -بناءً على ما سمعه وشاهده- مصاب بهذا المرض، وبدأت بعدها رحلة “توهم المرض” التي بسطت سلطانها على مجمل حياته الشخصية، وجعلته يعيش في حالة من القلق والخوف. ثم ساءت حالته النفسية، وتعطلت أنشطته اليومية، وارتفع معدل السلوكيات القهرية التي يمارسها يوميًا، وتعرض الجهاز التناسلي لديه إلى ضررٍ بالغ، وهذا عائد دون شك إلى إفراطه في تفحص تلك المنطقة. ثم سألته: ولماذا لم تتوجه لأحد المختصين حتى تطمئن وتذهب مخاوفك التي لا يدعمها أي سند علمي، أفادني أنه فكّر مرة في الذهاب إلى المستشفى، ثم عدل عن الفكرة، معللًا ذلك بخوفه من أن يكون مصابًا بالمرض. وأردف قائلًا: يا دكتور أنا أعلم أنني مصاب بالوسواس القهري، وأدرك أن هذه الأفكار التي تحاصرني غير منطقية، إلا أنني لا أقوى على مقاومتها، وأجدني مضطرًا إلى الاستسلام لها، والامتثال لأوامرها، وأنا أعيش الآن في قلقٍ مستمر، ولم أعد أقوى على الانتباه والتركيز، وقد أصبت بالرعب قبل قليل، عندما سمعتك تقول أن الوسواس القهري إذا لم يعالج في مراحله الأولى؛ فإن احتمالية أن يتطور إلى مرضٍ ذهاني قائمة وبقوة.
بعد ذلك طلبت منه أن يهدأ ويجلس، وأبلغته بأن إدراكه وإحاطته بحالته، واتصاله بواقعه المحيط؛ دليل على عدم إصابته بالذهان، وأن كل ما يعتريه من أفكار حول إصابته بالمرض مجرد وساوس وأوهام وجدت بيئة عقلية ترعاها وتحتضنها، حتى عَظُمَ أمرها، واشتد تأثيرها، وأضفت بأن الشيطان يقتنص هذه اللحظات التي يضعف فيها الإنسان، وتخور قواه الذهنية، فيعمل على تضخيم وساوسه القهرية، ثم قمت بتوجيهه إلى أحد المختصين الأكفاء في علاج اضطراب الوسواس القهري.
وختامًا يجدر بنا أن نبين للقارئ العزيز أن معظم الناس قد تظهر لديهم بعض التصرفات الوسواسية في مرحلة ما من حياتهم، أو قد تكون جزءًا من شخصياتهم، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم مصابون باضطراب الوسواس القهري، حيث إن أهم ما يُميّز المرض أنه يعوق أداء المهام اليومية ويهدر الكثير من الوقت. وتُعد تقنيات العلاج المعرفي السلوكي (CBT) من أنجع المداخل العلاجية للوسواس القهري؛ حيث تعتمد على تقنية التعرض ومنع الاستجابة (ERP)؛ حيث يتم تعريض المريض تدريجيًا للمواقف أو الأفكار التي تثير الوسواس، مع منعه من ممارسة الطقوس القهرية للتخفيف من القلق.

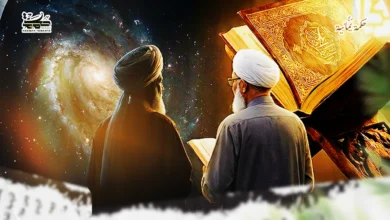
مقالة باذخة… كعادة د وليد