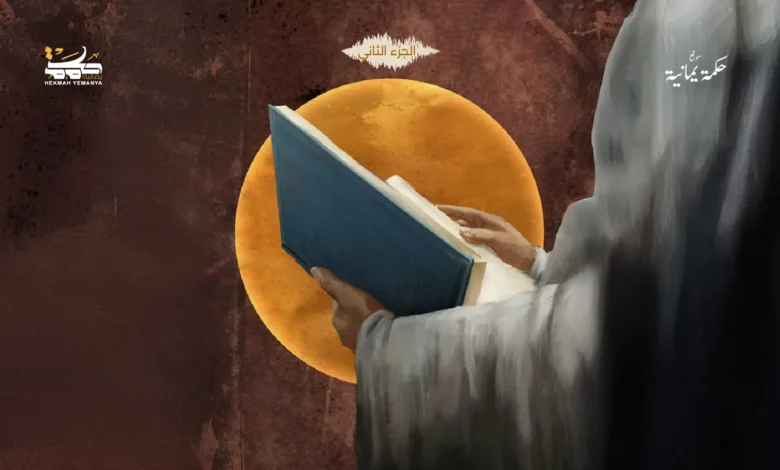
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: هل تمكّنت تلك التنظيرات البديعة في المذهب الهادوي؛ من شق الأرضية المعرفية المتسامحة معها عند التطبيق الفعلي؛ في حال اتخذ المجتهد قراراً جريئاً برفض تقليد جملة المسائل العملية في المذهب، والبحث عن خيار آخر خارج المذهب، كما سنرى حال هؤلاء المجتهدين المجدّدين؟
الواقع أن حال علماء الزيدية اليمنيين الذين درسوا المذهب الزيدي الهادوي، وأخذوا بتشجيعه النظري على الاجتهاد ونبذ التقليد، فحقق بعضهم ذلك؛ لم تمرّ دائماً بسلام، إذ وجد أولئك المجتهدون أنفسهم غالباً في مرمى اتهام عنيف، من قِبَل علماء الزيدية الآخرين الذين آثروا التقليد. وهؤلاء الأخيرون وإن كان فيهم مجتهدون – بلا ريب- أمثال الشيخ مجد الدّين المؤيدي (ت: 1428هـ-2007م)، والشيخ بدر الدين الحوثي (1431ه/2010م)، من المعاصرين، بيد أنّهم باجتهادهم لم يتجاوزوا إطار مذهبهم، إذ نبذوا مسلك الاجتهاد الذي يفضي إلى نتائج كليّة، تتيح التحرّر من ربقة المذهب، على نحو ما قام به أمثال الوزير والجلال، ثم المقبلي، ومن بعدهم الأمير والشوكاني- على سبيل المثال- وذلك إنما يؤكّد أن سمة إتاحة الاجتهاد المطلق لدارسيه المؤهلين، تلك التي كان قد اشتهر بها المذهب الزيدي الهادوي، وشهد بها عديدون في القديم والحديث(1)؛ ظلت نظرية، كأيّة نظرية تبحث عن بيئة مناسبة للتطبيق، ويظهر أن ذلك كان في الأزمنة المتقدّمة، من تاريخ المذهب الزيدي أكثر وضوحاً وتطبيقاً، لا أن ذلك استمر عبر تاريخ المذهب ومراحله، كعملية منهجية متصلة مطّردة، بدليل حجم المعاناة والأذى الذي طال كل من رام التحرّر الفعلي، من ربقة التقيّد باجتهادات المذهب الهادوي الزيدي، من أولئك المجدّدين موضوع الدراسة.
إننا إذا جئنا إلى التطبيقات الفعلية لنظرية الاجتهاد في المذهب الزيدي الهادوي فإننا نجد الإشكالات الفعلية فيها تتمثل فيمن رام تطبيق تلك النظرية من أبناء المذهب، في القرون المتأخرة.
ولعلّ من أكثر المجدّدين الذين توسّعوا في إيراد جانب من تلك المعاناة التي لاقاها هو وسلفه ما سجله؛ الإمام محمد بن علي الشوكاني، ولا سيما في رسالته الموسومة بـ” أدب الطلب ومنتهى الإرب”، في هذا الباب، حيث أفصح عن ذلك بما يفي بالمراد، فأشاد بجهود كبار رموز أهل السنّة في العالم الإسلامي، في الفقه والحديث والفكر، وما أصابهم من محن مختلفة، جرّاء ذلك، غير أنّه لم يحُل دون أن تنتشر مذاهبهم وأطاريحهم في العالم الإسلامي، كهبة إلهية عاجلة لهم، حيث نالت القبول، دون إكراه من سلطان، أو فرض لها بالقوّة، وذكر منهم مالك بن أنس (ت:179هـ)، وأحمد بن حنبل (ت:241هـ)، ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256هـ)، وأبا محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت:456هـ)، وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت:728ه). ثمّ عاد الشوكاني بعد ذلك إلى البيئة اليمنية قائلاً:
” وانظر في أهل قطرنا، فإنه لا يخفى عليك حالهم، إن كنت ممن له اطّلاع على أخبار الناس، وبحث عن أحوالهم، كالسيّد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، فإنّه قام داعياً إلى الدليل في ديارنا هذه، في وقت غربة، وزمان ميل من الناس إلى التقليد، وإعراض عن العمل بالبرهان، فناله من أهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنّفاته، حتى ترسّل عليه من ترسّل من مشايخه، برسالة حاصلها الإنكار عليه، لما هو فيه، من العمل بالدليل وطرح التقليد، وقام عليه كثير من الناس، وثلبوه بالنظم والنثر، ولم يضرّه ذلك شيئاً، بل نشر الله من علومه، وأظهر من معارفه، ما طار كل مطار.
ثمّ جاء – مع طول فصل وبُعد عهد- السيّد العلّامة- الحسن بن أحمد الجلال، والعلّامة صالح بن مهدي المقبلي، فنالهما من المحن والعداوة، من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في هجرة الجِراف، منعزلاً عن النّاس، وحمل الثاني على الارتحال إلى الحرم الشريف، والاستقرار فيه، حتّى توفاه الله فيه، ومع هذا فنشر الله من علومهما، وأظهر مؤلّفاتهما، مالم يكن لأحد من أهل عصرهما ما يقاربه، فضلاً عن أن يساويه.
ثمّ كان في العصر الذي قبل عصرنا السيّد العلّامة محمّد بن إسماعيل الأمير، وله في القيام بحجّة الله والإرشاد إليها، وتنفير النّاس عن العمل بالرأي، وترغيبهم إلى علم الرواية، ما هو مشهور معروف، فعاداه أهل عصره وسعوا به إلى الملوك، ولم يتركوا السعي عليه بما يضره جهداً، وطالت بينه وبينهم المصاولة والمقاولة، ولم يظفروا منه بطائل، ولا نقصوه من جاه ولا مال، ورفعه الله عليهم، وجعل كلمته العليا، ونشر له من المصنّفات المطولة والمختصرة، ما هو معلوم عند أهل هذه الدِّيار، ولم ينتشر لمعاصريه المعادين له، المبالغين في ضرره بحث من المباحث العلمية، فضلاً عن مؤلَّف بسيط، فهذه عادة الله في عباده فاعلمها وتيّقنها”(2).
أما عن العلامة الإمام صالح بن مهدي المقبلي؛ فقد أورد الشوكاني في ترجمته له، في البدر الطالع ما يفيد بعلوّ مقامه وسعة علمه وجهاده وتحرره وشجاعته في قول ما يعتقد، داخل بلاده أو خارجها، لكنه لم يسلم من المقلّدة ،حتى داخل مكة، بعد فراره من أشباههم في اليمن، كما أشار إلى منازلته لمن ينال من الصحابة، ويفرّق بينهم وبين قرابة النبي – صلى الله عليه وسلم- بحيث يسيء إلى الصحابة، بدعوى حبّ القرابة، ولذلك قال:
قبّح الإله مفرِّقًا
بين القرابة والصحابة
وأشار الشوكاني أيضاً إلى أن بعض غلاة الجارودية وجّه للمقبلي من الاتهام واللمز والتحقير لنسبه ما عبّر عنه نظما فقال في أول بيت في القصيدة (3):
أطرق كرا يامقبلي
فلأنت أحقر من ذبابة
والمقصود بقائل ذلك الشاعر الهادوي الجارودي الحسن بن علي الهبل (ت:1079هـ) الذي قال في المقبلي أيضاً (4):
المقبلي ناصبي
أعمى الشقاء بصره
فرّق مابين النبي
وأخيه حيدره
لاتعجبوا من بغضه
للعترة المطهره
فأمّه معرفة
لكن أبوه نكره

لقد دفعت جملة تلك المحن بالمقبلي إلى أن يقرّر الفرار من بلده والهجرة القسرية إلى مكة المكرمة، حتى توفي فيها. وهو القائل في صدر كتابه (العَلَم الشامخ في إيثار الحق على الإباء والمشايخ) :” هيهات لقد أعمى التعصّب البصائر، وأفسد التمذهب السرائر، غير أنّي سائر إلى ربي سيهدين، واقفاً موقف الجهل الذي خرجت عليه من بطن أمي، حتى يهجم بي على المطالب، ويضطرني إليها برد اليقين، فارّاً إلى الله تعالى، ممن قال تعالى فيهم :”إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثمّ ينبئهم بما كانوا يفعلون”… فأقول اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام، فمن شمله فهو صاحبي وأخي، ومن كان قدوة فيه، عرفت له حقّه، وشكرت له صنعه، غير غالٍ فيه ولا مقصِّر، فإن استبان لي الدليل، واستنار لي السبيل، كنت غنيّاً عنهم في ذلك المطلب، وإن ألجأتني الضرورة إلى الرجوع إليهم وضعتهم موضع الأمارة على الحق، واقتفيت الأقرب في نفسي إلى الصواب، بحسب الحادثة، بريئاً من الانتساب إلى إمام معيّن، يكفيني أنني من المسلمين، فإن ألجأني إلى ذلك الله، ولم يبق لي من إجابتهم بدّ قلت مسلم مؤمن، فإن مزّقوا أديمي، وأكلوا لحمي وبالغوا في الأذى، واستحلّوا البذا، قلت: “سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا ضير أنا إلى ربنا منقلبون” (5).
وقد سجّل جانباً مما لاقاه من بعض المتعصبة؛ بعض الذين ترجموا له من كُتاب الرحلات أمثال مصطفى فتح الله الحموي، وذكر أن من أبيات المقبلي(6):
قبّح الإله مفرّقاً
بين القرابة والصحابة
من كان ذلك دينه
فهو السفيه بلا استرابه
الجمع بين ولائهم
ياطالباً عين الإصابة
ما إن قرنت به في الدعا
إلا توقعت الإجابه
إذا كان ذا في عصرنا
متجاوزاً حدّ الغرابه
ونعود إلى الشوكاني ليتحدث عن نفسه وتجربته وما عاناه من كثير من المتمذهبين بالمذهب الهادوي، لكونه أراد تطبيق نظرية المذهب في التحرّر للمجتهد المؤهّل، فصار حريصاً على الدليل من الكتاب الكريم والسنّة النبوية، بالدرجة الأساس، لكنه وجد نفسه خارجاً عن الترحيب والرضا، بل منبوذاً محارباً، لولا أن الله قيّض له من الأسباب ماحال دون البطش الفعلي به.
وقد استهل معاناته بقوله:” وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي، وعن الحوادث الجارية، بيني وبين أهل عصري ليزداد يقينك، وتكون على بصيرة فيما أرشدتك إليه…”، وراح يسرد جانباً من حكايته مع المتعصّبين المتمذهبين، ومع بعض المتسلّطين من الحكّام والوزراء والدهماء من العامّة، ومما جاء في ذلك” فكنت إذا سمعت بشيء من هذا، لاسيما في مواقف المتعصبين ومجامع الجاحدين، تكلّمت بما بلغت إليه قدرتي، وأقل الأحوال أن أقول استدلّ هذا بكذا وفلان المخالف بكذا، ودليل فلان أرجح لكذا، فما زال أسرى التقليد يستنكرون ذلك ويستعظمونه، لعدم الفهم به، وقبول طبائعهم له، حتّى ولّد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم… لقد اشتدّ بلاؤهم وتفاقمت محنتهم في بعض الواقعات، فقاموا قومة شيطانية، وصالوا صولة جاهلية، وذلك أنّه ورد إليّ سؤال في شأن مايقع من كثير من المقصِّرين من الذمّ لجماعة من الصحابة صانهم الله، وغضبت على من ينتهك أعراضهم المصونة، فأجبت برسالة ذكرت فيه ما كان عليه أئمة الزيدية من أهل البيت وغيرهم، ونقلت إجماعهم من طُرق، وذكرت كلمات قاله جماعة من أكابر الأئمة، وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية، ويردّهم من طرق الغواية، فقاموا بأجمعهم وحرّروا جوابات زيادة على عشرين مسألة، مشتملة على الشتم والمعارضة، بما لا ينفق إلا على بهيمة، واشتغلوا بتحرير ذلك، وأشاعوه بين العامّة، ولم يجدوا عند الخاصّة إلا الموافقة، تقيّة لشرهم، وفراراً من معرّتهم، وزاد الشرّ وتفاقم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم، وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر حفظه الله…” (7).
ويمضي الشوكاني في رواية جانب من محنته مع المتعصبّة، وما شحنوا به حاكم البلاد في ذلك الحين وهو المنصور علي بن العبّاس الذي حكم البلاد من 1189-1224هـ، ليعمل على نفي الشوكاني من موطنه، أو حبسه، لكنه لم يلتفت إلى أيّ من تلك الوشاية، رغم كل ما بذله بالخصوص وزير في دولته وصفه الشوكاني بـ” الرافضي”، حتى نصح الشوكاني بعض المحبّين له بالفرار أو الاختفاء أو الانقطاع عن تدريس العلم في جامع صنعاء الكبير، نظراً لما كان يحيق به من مخاطر جمّة، وفتنة بلغت في إحدى الليالي إلى حدّ تهديد حياته، جرّاء التربص به عند تدريسه في الجامع، وعند خروجه منه، مع قدوم مجاميع من الأجناد والعبيد المدججين بالسلاح، دفع بهم ذلك الوزير، ليثيروا الفتنة، فحضروا درسه، وهم بهيئة منكرة، يقعقعون بسلاحهم، ويضربون سلاح بعضهم ببعض؛ إلا أن الشوكاني استعان بالله ومضى في إلقاء درسه، وكان وافق أن الدرس كان في تلك الليلة من صحيح البخاري، والله يحفّه بلطفه، فلم يصبه شيء، مما كان يبيّت له، لكن التحريض عليه ظل يتواصل إلى المقام الإمامي من قبل ذلك الوزير، ومن يوافق هواه، حتى من المحسوبين على أهل العلم، فأرسلوا رسائل إلى الإمام حاصلها” أني قد أردت تبديل مذهب أهل البيت -عليهم السلام – وأنّه إذا لم يتدرك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه، ونحو هذا من العبارات المفتراة، والكلمات الخشنة، والاحاديث الملفّقة”(8).

قبل أن نغادر مساحة حديث الشوكاني عن نفسه؛ لاينبغي أن يغيب عن البال أن أبرز خصوم الشوكاني الذين جاهروا بعدائهم السافر له، من طبقة فقهاء المذهب في زمنه؛ كان الشيخ محمد بن صالح السماوي المعروف بابن حريوه(ت:1241هـ)، حيث خصص له كتاباً كبيراً بلغ ستة أجزاء في ثلاثة مجلدات (محققاً)، سمّاه” الغطمطم الزخّار المطهّر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرّار”، حيث لم يبق لفظاً من ألفاظ القدح والذمّ والإساءة، بأبشع دلالاتها؛ إلا استعمله في تحقير الشوكاني وتسفيهه، ولا يكاد يذكره في كل فقرة إلا مقروناً بشتيمة أقلها صفة “المهين” ، أما إن سألت عن السبب فتجده سافراً في كون الشوكاني، تجرّأ وطبق نظرية المذهب في التحرّر وتحريم التقليد على المجتهد، وراح يطبقها في نقد واحد من أهم مصادر المذهب الهادوي، وهو ” متن الازهار” لأحمد بن يحيى المرتضى (ت:840هـ)، بأسلوب علمي وأدبي ينبئك عنوانه عن مضمونه ” السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار”، وهب أن الشوكاني قسى في بعض العبارات والألفاظ في المحتوى، فهذا وارد من كبار الأئمة والمحققين في عالم البحث والتأليف والنقد؛ فهل يستحق- بالمقابل- كل تلك الحملة غير الأخلاقية بالدرجة الأساس؟ الواقع أن ابن حريوه لم ينطلق في ردّه العنيف الخارج عن اللياقة وأخلاق العلماء، لأن الشوكاني أخطأ في مسألة أو مسائل أو عبارة أو عبارات أو نحو ذلك، بل لأنه من دعاة التحرر ورافضي التقليد الذين أرادوا بعملهم هذا ” إبطال الأزهار، بل إبطال مذهب العترة الأطهار”(9)– وفق تعبير ابن حريوه-. وذكر أيضًا أنه لم يقم بعمله – أي السماوي- من تلقاء نفسه، أو من جماعة محدودة من متعصبة المذهب، بل لأن الشيعة طلبوا منه القيام بذلك، وكأنه يشير بذلك إلى جمهور علماء الشيعة الزيدية الهادوية – وهو أمر يبدو مستبعداً على ذلك النحو -، فقال:” غير أن الشيعة الكرام راموا مني إرسال خليج من “الغطمطم الزخّار”، مطهراً لكل تلك الآثار، فكتبت لهم ما تطمئن به النفس وتقرّ به العين”(10) .
وكل هذا إنما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه أشرنا إليه في مستهل هذا المحور ، من أن نظرية التحرّر، وكفالة حق الاجتهاد للمؤهل؛ ظلت نظرية يعوزها التجسيد الفعلي، لدى الزيدية الهادوية.
وإلى هذا المعنى في كون الاجتهاد المطلق ظل نظرية أكثر منها تجسيداً وواقعاً عملياً معاشاً، إلا من فترة سابقة محدودة، قال الشوكاني:
” وما ذكرنا فيما سبق من أنه كان في الزيدية والهادوية في الديار اليمنية أولوا إنصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد فذلك إنما هو في الأزمنة السابقة، كما قرّرنا فيما سلف. وأمّا في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشدّ تعصباً من غيرهم، فإنهم إذا سمعوا برجل يدّعي الاجتهاد، ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وآله وسلّم- قاموا عليه قياماً تبكي عليه عيون الإسلام، واستحلوا منه ما لا يستحلونه من أهل الذِمّة من الطعن واللعن والتفسيق والتنكير والهجم عليه إلى دياره، ورجمه بالأحجار، والاستظهار، وتهتك حرمته. وتعلم يقيناً لولا ضبطهم سوط هيبة الخلافة أعزّ الله أركانها، وشيّد سلطانها؛ لاستحلّوا إراقة دماء العلماء المنتمين إلى الكتاب والسنة، وفعلوا بهم ما لا يفعلونه بأهل الذِمَّة، وقد شاهدنا من هذا مالا يتسع المقام لبسطه” (11).
ومع تأكيد القاضي المؤرّخ إسماعيل الأكوع (ت: 1429ه/ 2008م)، لعلى مزية فتح باب الاجتهاد في المذهب الزيدي لمن حذق علومه وأتقن فنونه، على خلاف غيره من المذاهب الإسلامية (12)؛ إلا أنه يعود ليقول:
“على أنه وإن صار الاجتهاد مبدأً معروفاً في المذهب الزيدي؛ إلا أن من أخذ به، ومال إليه، وحقَّقه في نفسه؛ لم يسلم من شرور غائلة علماء الزيدية المقلّدين وأتباعهم، لأنه يشق عليهم ترك التقليد، وخروج المجتهد من مذهبهم، والاشتغال بأحكام الكتاب والسنة النبوية، ولهذا فإنهم يجعلونه هدفاً يفوقّون إليه سهامهم، فيرمونه بالنّصْب وبُغض أهل البيت، ليثيروا عليه سخط عامة الناس، ويلفِّقون عليه تهماً لا أساس لها من الصحة والواقع، ليجعلوا منه عبرة للمعتبر، فيردعوا به من عنده الرغبة للعمل بالكتاب وصحيح السنة، فيكفّ عن ذلك”(13) ، ثم استشهد بسلسلة المجتهدين المجدّدين اليمنيين بدءاً بمحمد بن إبراهيم الوزير، مروراً بالأمير الصنعاني، وانتهاءً بالشوكاني(14) .ش
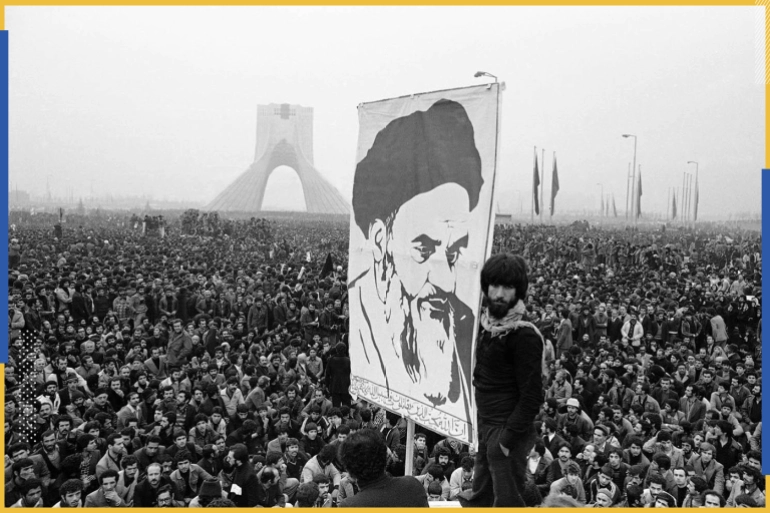
كل ما تقدّم لا يؤذن بالخلوص إلى نتيجة أن الاجتهاد والتجديد في إطار المذهب الزيدي الهادوي توقّف أو انقطع تماماً، حتى لو تعرّض المذهب لحالة انكفاء وضمور، طيلة العقود الماضية، التي أعقبت ثورة 1962م، لكنه نهض بعد ذلك، وتحديداً من بعد انتصار ثورة الخميني في إيران سنة 1979م، وقامت عملية إحياء مذهبية واسعة واستقطاب حادّ، ساعد في ذلك بعض العوامل الأخرى، ناهيك عن ما قام به الحوثيون من بعد سيطرتهم على السلطة في 14/9/2014م، من إعادة فرض المذهب بالقوّة في مختلف المؤسسات العسكرية، والمدنية، ولا سيما مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءاً بالمدارس والجامعات، مروراً بالإعلام، وكل المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرتهم، وانتهاء بالأسرة، ومع كل ذلك فيمكن القول بأن حالة بروز شخصيات علمية وفكرية متحرّرة، لم تزل متصلة، على نحو أو آخر، ولكن في صورة أفراد محدودين للغاية، يمكن تصنيفها في إطار مدرسة التجديد الفكري، التي نحن بصدد دراستها، مع التأكيد على أن الصورة اختلفت إلى حد كبير غالباً، بعضهم ينتمي إلى البيئة المذهبية الزيدية الهادوية في الأساس، ولعل أبرزهم القاضي محمد بن إسماعيل العمراني (ت:1442ه/2021م)، بل بعضهم ينتمي عرقياً إلى السلالة الهاشمية، ولعلّ من أشهر هؤلاء الأخيرين الدكتور عبد الوهاب الديلمي(ت:1442ه/2021م)، الذي ردّ على شقيقه أحمد، على نحو صريح ولافت، في مؤلّف كامل له بهذا الشأن، عنوانه ( جناية أدعياء الزيدية على الزيدية)(15)، وتمحور في معظمه، حول بعض تلك القضايا التي أثيرت من قبل، لكن الإشارة جديرة هنا بالتأكيد على أنه ليس بالضرورة، أن هذا أو ذاك ممن تابع مدرسة التجديد في اليمن، قد درس المذهب الزيدي الهادوي ابتداء، دراسة تخصصية تقليدية، وبرّز فيه، وبلغ به درجة الاجتهاد المؤهل للتحرّر، على نحو ما تمّ مع سلسلة المجدّدين المشار إليهم، بل غدا الانتماء تحرّراً فكرياً ومذهبياً، ذا دوافع أخرى، مرتبطة بثقافة المرحلة وطبيعة العصر، لا أنه مرتبط- بالضرورة- بدراسة المذهب على نحو ما كان سابقاً، وذلك بحكم جملة المتغيّرات التي وقعت في اليمن المعاصر وأبرزها بإطلاق انتصار ثورة 1382ه- 1962م، على النظام الإمامي، وما صحب ذلك من جملة متغيرات فكرية ومعرفية وتربوية وثقافية وسياسية، أبرزها تحوّل التعليم إلى نظام حديث، توقفت معه كل حواضن التعليم المذهبي التقليدية، الرئيسة أو الرسمية، بما فيها المدرسة العلمية في صنعاء، فاتصل ذلك المسار في التحرّر ورفض المنزع السلالي والتقليد المذهبي، وصارت له الغلبة في البيئة الزيدية، منذ ما بعد ثورة 1382ه- 1962م، ولكن على نحو من هذه الصورة التحرّرية الجديدة، هذا رغم كل العوائق، المشار إليها، بما فيها عنف جماعة الحوثي وغلوّها المذهبي “المسيّس”؛ تلك التي غدت تسابق الريح في محاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، في شأن التربية والتعليم والخطاب المسجدي خاصة، والسعي نحو القضاء على كل منزع سنّي، ونَفَس تحرري، لاسيما حين ينبع من داخل البيئة الزيدية، والعائلات الهاشمية بالخصوص، ووصم كل خارج عن تقاليدها المذهبية بقاموس شتائم متعصّبة العهود السابقة، مع إضافة تهم معاصرة ، وشيطنة عامة، تواطأ عليها خصوم الفكر الإسلامي، من كل اتجاه، في الداخل والخارج – وليس الخصوم المذهبيين فحسب- ، تُجاه الفكر الوسطي بعامّة، من مثل الوهابية، والتكفير، والإرهاب، والانتماء إلى منظمات عنف شهيرة كالقاعدة وداعش!
الهوامش:
- انظر- على سبيل المثال-: إسماعيل الأكوع، مقدمته لكتاب العواصم من القواصم في الذب عن سيرة أبي القاسم (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)، 1412هـ-1992م، ط الثانية، جـ1، ص10.
- محمد بن علي الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب (تحقيق: عبد الله السريحي) ، 1419هـ- 1998م، الطبعة الأولى، بيروت: دار ابن حزم وصنعاء: مكتبة الإرشاد،ص75-79.
- محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،د.ت، د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، جـ1، ص 291.
- البيت الأول أورده الشوكاني في ترجمته للمقبلي. انظر: البدر الطالع، المصدر السابق (طبعة دار الكتاب الإسلامي)، جـ1، ص 291، وبقية الأبيات في: إسماعيل الأكوع، الزيدية، 1428هـ-2007م، ط الثالثة، صنعاء: مكتبة الجيل الجديد، ص 44.
- صالح بن مهدي المقبلي، العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، 1328هـ، ط الأولى، د.ن: القاهرة، ص 3.
- مصطفى فتح الله الحموي، فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر (نقلاً عن: المقبلي، العلم الشامخ، المصدر السابق، ص774).
- الشوكاني، أدب الطلب، مصدر سابق، ص 79-81.
- الشوكاني، أدب الطلب، المصدر السابق، ص 79-81.
- محمد بن صالح السماوي، الغطمطم الزخَّار المطهِّر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرّار (تحقيق: محمد يحيى عزّان)1415هـ/1994م، ط الأولى،عمّان: مطابع شركة الموارد الصناعية الأردنية،جـ 1، ص19.
- محمد بن صالح السماوي، الغطمطم الزخَّار، المصدر السابق، جـ 1، ص 5.
- الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ضمن الرسائل السلفية للشوكاني) ،1348هـ-1930م، د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، ص 29-30.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية، مرجع سابق (طبعة دار الفكر المعاصر) ، مرجع سابق، ص 34.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية (طبعة دار الفكر المعاصر)، المرجع السابق، ص 35-36.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية (طبعة دار الفكر المعاصر)، المرجع نفسه، ص 36-37.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية (طبعة دار الفكر المعاصر) ، نفسه، ص75-79.

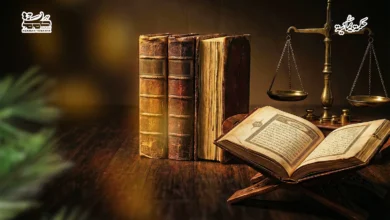
طرح جيد، لكن لا جديد فيه.
«قَبَحَ» بتخفيف الباء، لا تشديدها.