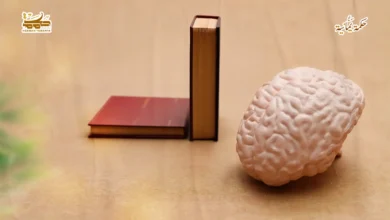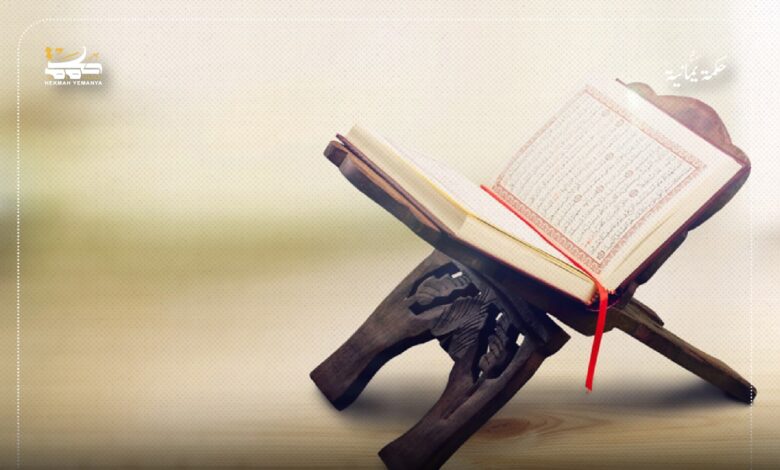
أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم وحي من الله أوحاه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر أي اختلاف بين الصحابه حول طبيعة الوحي.
بدأ الاختلاف مع ظهور المعتزلة، فإنهم رأوا أن القرآن الكريم لم يتكلم به الله بحرف وصوت، وإنما هو ظاهرة كونية، أي أن الله قال له كن فكان، مثل ما خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار وسائر المخلوقات.
استلهم المعتزلة قولهم هذا من طبيعة المسيح عليه السلام، فإن الله وصف المسيح بأنه كلمة الله، قال له كن فكان، والمسيح مخلوق، فقاسوا عليه القرآن الكريم.
هذا القول المعتزلي تبنته الدولة العباسية في عهد المأمون والمعتصم، وألزمت الناس به، فخضع لها الناس تقليدا أو رغبة في الحظوة أو خوفا من سطوة الدولة وإرهابها، ولم يثبت إلا أربعة، أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل، وقد تراجع اثنان ومات الثالث تحت التعذيب، وحفظ الله لأحمد حياته مع أنه عُذِّب تعذيبا شديدا كاد أن يموت منه استمر أثره على جسده إلى أن توفي.
ثبت الإمام أحمد بن حنبل على معتقد السلف، وهو أن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وسمعه جبريل من الله وأداه إلى رسول الله كما سمعه.
وهذه العقيدة انتصر لها الخليفة المتوكل العباسي الذي جاء بعد الواثق، والإمام أحمد لا زال حيا، فأبطل القول بخلق القرآن، وأثبت عقيدة أحمد بن حنبل، وألزم الناس بها، وعامل المعتزلة بنفس طريقتهم التي عاملوا بها أحمد بن حنبل وأصحابه، وفي هذه الفترة التاريخية سطع نجم الإمام أحمد، وكثر أتباعه في كل مكان، وصار لهم سطوة كبيرة.
ومن أثر هذا الاختلاف بين الحنابلة والمعتزلة ظهر في القرآن قولان جديدان:
الأول: قول الأشاعرة والماتريدية، وهو قول وسط بين الحنابلة والمعتزلة، فذهبوا إلى أن القرآن كلام الله تعالى معنىً وليس لفظا، أي أن الله تعالى لم يتكلم به بحرف وصوت، وإنما هو معنى علمه جبريل من الله، فأداه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ وصوت، وبلّغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما سمعه من جبريل.
والقول الثاني: مسألة اللفظ بالقرآن الكريم، وهذا الخلاف ظهر عند الحنابلة أنفسهم من أثر النقاش بينهم وبين بقايا المعتزلة، فإن المعتزلة أمام سطوة سيف المتوكل سلموا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكنهم قالوا إن أصوات قارئي القرآن مخلوقة.
وهذه المسأله منع أحمد بن حنبل أتباعه من الخوض فيها منعا باتا، وحكم على من خاض فيها بالبدعة، غير أن التنافس بين أتباعه بعد وفاته أثارها من جديد، فإن محمد بن يحيى الذهلي وهو عالم من كبار المحدّثين، وله مكانة رفيعة بالدولة، وله فضل غير أنه تكوّن عنده حسد للإمام البخاري صاحب الصحيح على مكانته الرفيعة من علم الحديث التي أثّرت على مكانته، فاتجه إلى إسقاط البخاري عن تلك المكانة الرفيعة، ولم يجد مدخلا إلا مسألة اللفظ بالقرآن، فطلب من بعض أتباعه أن يسألوا البخاري عنها: هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟
حاول البخاري أن يتهرب من الإجابة لما يعلم من آثارها، ولكنهم كرروا عليه، فاجأب أن أصوات قارئي القرآن مخلوقة، ومن أثر هذا السؤال ألف كتابه (خلق أفعال العباد) وعلى إثرها حُكم عليه من الذهلي وأتباعه وبمساعدة سطوة الدولة في نيسابور وبخارى بأنه معتزلي جهمي مبتدع ضال يجب هجره وعدم اعتماده في جماعة المحدّثين، ثم ضُيِّق عليه تضييقا تاما إلى درجة أنه ضاق بالحياة فكان يدعو الله أن يقبض روحه، ومات وهو مظلوم مقهور.
ما سبق الحديث عنه من ناحية توصيف الوحي، أما من الناحية التاريخية فقد اتفق المسلمون جميعهم سُنّةً وشيعة على أن المكتوب في المصحف العثماني هو قرآن كريم أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل فيه أي تحريف أو تبديل.
واتفقوا أيضا تقريبا على أن المكتوب في المصحف العثماني ليس هو كل القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك قرآن نُسخ وقرآن أُنسي قال الله تعالى: (ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [البقرة106]
ولم يدّعِ الشيعة أن في القرآن الذي لم يُكتب في المصحف العثماني وصية لعلي بن أبي طالب بالإمامة، لأنهم لو ادّعو ذلك سيكذّبون عليا نفسه، فإن علي رضي الله عنه قد أحرق مصحفه الشخصي بعد توزيع المصحف العثماني، وكان يترضى على عمل عثمان رضي الله عنه، ولهذا فإن من يقول من الشيعة أن القرآن الذي لم يكتب في المصحف فيه وصية لعلي بالإمامة هم جهلة الشيعة الذين لا يدركون أثر هذا القول على مذهبهم نفسه.
واتفق المحققون في علوم القرآن على أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي أُنزل بها القرآن الكريم، وإنما هي قراءات متعددة لمصحف عثمان، والذي يقول إن القراءات السبع هي الأحرف السبعة وصفه العلماء بالجهل بتاريخ القرآن الكريم وعلومه.
نتيجة لاختلاف قراءات المصحف العثماني الذي كتب بدون نقاط ولا حركات، وبعد مداولات طويلة عبر القرون اتفق المختصون في علوم القرآن على أن القراءة تكون قرآنا بثلاثة شروط:
الأول: موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا.
الثاني: أن يكون لها سند صحيح مسموع.
الثالث: أن توافق اللغة العربية ولو بوجه.
وما لم يتوفر في القراءة هذه الشروط الثلاثة فإنها ليست قرآنا، حتى وإن قرئت من السبعة أو من العشرة، وما توفر فيها هذه الشروط فإنها قرآن حتى وإن كانت خارج العشرة أو العشرين أو ما فوق ذلك.