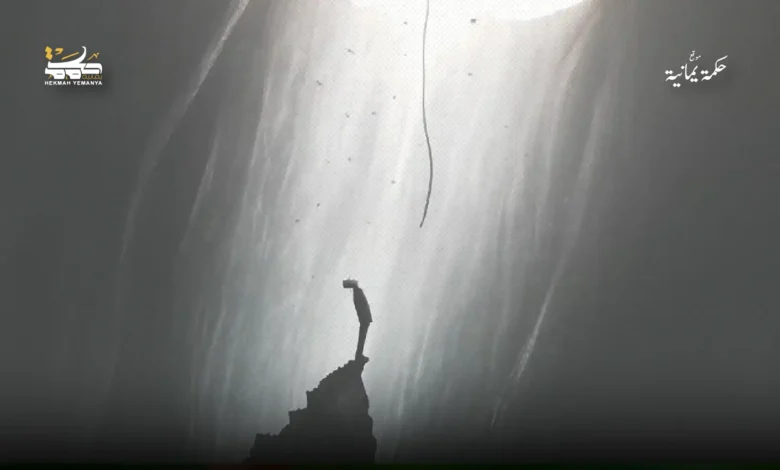
يحكى أن نمرًا جائعًا رأى في أحد الأيام ظِلَّه على الأرض مع شروق الشمس، فوجده أكبر من المعتاد، فقال لنفسه بثقة: (أنا كبير بما يكفي لألتهم أي فريسة). لكنه مع غروب الشمس، رأى ظله يتضاءل تدريجيًا حتى صار صغيرًا، فاعتقد بأنه بات ضعيفًا وهزيلًا، ولا يستطيع أن يمسك بأي حيوان مهما صغر ليفترسه، وفي النهاية، مات النمر جوعًا، ليس لأنه لم يجد طعامًا، ولكن لأنه انخدع بمظاهر زائفة وأوهام صنعها بنفسه، وكانت سببا في هلاكه.
هذه الأقصوصة الرمزية البسيطة تختصر مأساة الإنسان مع الجهل والعلم الزائف. فالجهل، في حقيقته، ليس نقص المعرفة فقط، بل هو الاعتقاد الوهمي الذي يمنح صاحبه ثقة زائفة أو شكوكًا مدمرة. ومن هنا يبدأ الإنسان في هدم نفسه وحضارته دون أن يدرك أنه يحمل في يده معولًا لا يصلح للبناء. إن الجهل أكبر عدو حتى للجاهل نفسه، والعلم الزائف هو صنو الجهل، بل أشد ضررا منه، الجهل آلة تدمير جهنمية للحاضر والمستقبل، ومن يظن أنه سيبني المستقبل بالجهل فهو واهم، لأن الجهل أداة هدم وليس أداة بناء، وكيف يمكن للإنسان أن يبني بآلة مهمتها ووظيفتها الأساسية الهدم.
ما يبلغُ الأعداءُ من جاهلٍ
ما يبلغُ الجاهلُ من نفسهِ
والبيت الشعري يعبر عن خطورة الجهل على صاحبه، حيث يكون الجاهل أحيانًا ألدّ أعداء نفسه، فيوقعها في المهالك دون أن يدرك.
ولك أن تتخيل -عزيزي القارئ- بنّاءً يحاول أن يبني منزلاً بمعول الهدم، فهو في كل مرة يضع فيها لبنة، يهوي بمعوله عليها دون وعي فيفتتها، يظن أنه يبني بينما هو في الحقيقة يهدم، ومع هذا يستمر في هذا العمل بلا توقف، حتى يحوّل المكان الذي يعمل فيه إلى أنقاض، ثم يرفع رأسه متسائلًا: لماذا لم يكتمل البناء؟ هذا البنّاء هو صورة رمزية للإنسان حين يستبدل المعرفة الحقيقية بالجهل أو بالعلم الزائف، معتقدًا أنه يصنع تقدمًا، وهذا يقودنا إلى القول بأن الجهل ليس مجرد فراغ ذهني، بل هو قوة هدّامة تتسلل بخبث إلى الفكر والمجتمع، فتُربك مساراته، وتعيده إلى الوراء بينما يظن أنه يتقدم.
إن الجهل ليس مسألة شخصية، كما يظن البعض، بل هو مرض اجتماعي يتجاوز الفرد ليضرب الحضارات في عمقها. إنه حالة فكرية تُعطل القدرة على رؤية الأمور كما هي، وتُضفي على الحقيقة ظِلالًا زائفة تجعلها تبدو مريبة أو معادية. أسوأ ما في الجهل أنه لا يُدرك ذاته؛ الجاهل لا يعلم أنه جاهل، بل قد يظن أنه أدرى الناس، وبهذا يصير الجهل أداة للثقة العمياء التي تفتك بكل ما حولها ومن حولها. والجهل هو العدو الخفي الذي يعمل بصمت، يهدم دون أن يُلاحظ، ويُدمّر دون أن يعلن الحرب. الجهل لا يعادي صاحبه فقط، بل يهدد البشرية بأكملها. ومن يظن أنه يستطيع بناء مستقبل بيد تمسك بمعول الجهل، فإنه يبني وهمًا مصيره الانهيار.
لقد وضع القرآن الكريم تصورًا عميقًا للجهل بوصفه ظلمة داخلية تمنع الإنسان من معرفة الحق، كما يمثل العلم الزائف انحرافًا عن طريق الحقيقة باستخدام معارف مغلوطة أو مدّعاة لتحقيق مصالح دنيوية، وفي المقابل يُبرز القرآن أهمية العلم الحقيقي الذي يقود إلى الإيمان بالله والاهتداء بنوره، كما في قوله تعالى: “قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ” (الزمر: 9)، ليبين أن العلم الصادق يرفع الإنسان في مدارج الحكمة. أما العلم الزائف، فيكشف القرآن الكريم زيفه بوضوح، كما في قول الله تعالى عن المشركين: “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ” (الحج: 3)، حيث يربط بين الجهل المدعي للعلم وبين اتباع الهوى والشيطان.
كما يؤكد القرآن الكريم على أن الجهل هو الذي دفع أعداء الأنبياء إلى مقاومتهم. ولك أن تتأمل في موقف اتباع بعض الأنبياء من أنبيائهم حين رفضوا دعوتهم بحجة أنهم وجدوا أنفسهم على دين أبائهم، فاعتبروا اتباع الحقيقة خروجًا عن المألوف، وهؤلاء لم يكن جهلهم مجرد عدم معرفة، بل كان رفضًا إراديًا للتفكير والانفتاح على ما يخالف أهواءهم.
وكما هو الحال مع القرآن، فقد كان للسنة النبوية رؤية واضحة حول الجهل باعتباره حجابا يعمي البصيرة، واعتبار العلم الزائف انحرافا يؤدي إلى الضلال، وكلاهما مصدر فساد للأفراد والمجتمعات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل بقوله: “مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ” (متفق عليه)، مشيرًا إلى أن الفهم الصحيح للدين هو النور الذي يرفع الإنسان من ظلمات الجهل. أما العلم الزائف، فقد حذر منه بقوله صلى الله عليه وسلم: “سيكون في آخر الزمان رجالٌ يحدِّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم” (مسلم)، حيث يحذر من المتقولين بغير علم.
وفي تاريخ البشرية الممتد عبر القرون، كان الجهل أشبه بنيران كامنة تحت الرماد، تنتظر الرياح لتهب فتساعد على انتشار تلك النيران كي تلتهم كل ما يعترض طريقها. الجهل، في جوهره، ليس مجرد نقص في المعرفة، بل هو موقف ذهني يقاوم الحقيقة ويسعى لتثبيت الأوهام، متنكّرًا في أحيان كثيرة بعباءة العلم الزائف الذي لا يقل خطرًا عن الجهل البحت. هذا الجهل لم يكن يومًا أداة بناء، بل كان معولًا يهدم حاضر المجتمعات ومستقبلها، ويعيق تطورها الفكري والثقافي والعلمي.
وعبر التاريخ، نشهد نكبات كبرى كان الجهل عاملًا رئيسيًا في تأجيجها، من محاكم التفتيش في أوروبا، حيث قُمع العلم والمنطق لصالح الخرافة والتعصب، إلى العصور الأوروبية المظلمة التي خيمت فيها سيطرة العقائد الجامدة على عقول الناس، التي صار فيها الجهل ليس مجرد غياب للمعرفة، بل موقف عدائي تجاه أي محاولة لاكتشاف الحقيقة. كان العلماء والفلاسفة يُحارَبون لأنهم هددوا أسسًا قائمة على جهل مقدس. ولك أن تتخيل – عزيزي القارئ- لو أن جاليليو لم يصرخ في وجه الظلام العلمي الزائف بتحديه لفكرة مركزية الأرض، كيف كان شكل التقدم العلمي اليوم؟
وحين ازدهرت الأندلس بالعلم والثقافة، كانت قبلة للعلماء والمفكرين من شتى أنحاء العالم. ولكن مع تراجع الاهتمام بالعلم الحقيقي وتصاعد الجهل المؤدلج، انهارت حضارتها. الجهل لم يكن غياب الكتب والمكتبات، بل غياب الرؤية التي تجعل من العلم قوة بناء.
وفي ذروة الحضارة الإسلامية، كانت العلوم والمعرفة هي الركيزة الأساسية التي قادت الأمة نحو التقدم، ولكن عندما تراجعت أهمية الفكر والعقل، تسلل الجهل ليهدم ما بناه العلماء. مثال ذلك محنة ابن رشد، الذي كان رمزًا لمن يستخدمون العقل والمنطق في زمن أصبح فيه التقليد الأعمى – عند بعض من ينسبون أنفسهم إلى العلماء – سيد الموقف. ابن رشد لم يكن فقط ضحية للجهل، بل كان شاهدًا على صراع بين تيارين: تيار يدعو للمعرفة والابتكار، وآخر يتمسك بالتقليد والخوف من التجديد. حين سُجن ابن رشد ونُفيت أفكاره، كانت أوروبا في المقابل تتبنى فلسفته لبناء نهضتها. وهكذا، بينما أغلقت الأمة الإسلامية أبوابها أمام العقل، فتحت أوروبا أبوابها أمام نور العلم.
وفي التاريخ الإنساني، يكشف لنا سقوط الحضارات الكبرى أثر الجهل كقوة مدمرة، فالإمبراطورية الرومانية، على سبيل المثال، لم تسقط فقط بفعل الحروب أو الغزوات، بل بسبب جهلها بتجديد نفسها ثقافيًا وفكريًا، حيث اعتمدت على أنظمة بالية وأفكار جامدة، حتى أُنهكت وسقطت تحت وطأة الانحطاط.
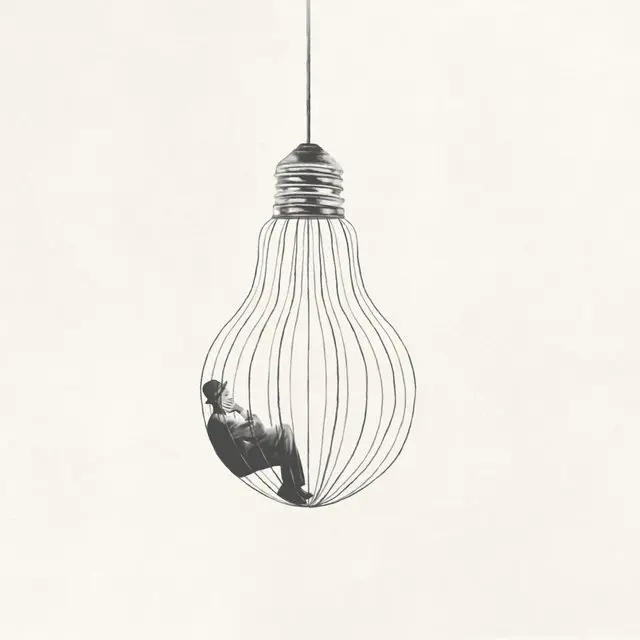
العلم الزائف امتداد للجهل.
المتأمل ببصيرة نافذة يتبين له أن العلم الزائف ليس إلا امتدادًا للجهل، ولكنه في الحقيقة أكثر ضررًا منه لأنه يخلق وهم المعرفة. إنه مثل مبنى مشيد على رمال متحركة؛ يبدو ثابتًا من الخارج لكنه ينهار عند أول اختبار حقيقي. وإذا كان الجهل هو غياب المعرفة، فإن العلم الزائف هو المعرفة المشوهة التي تضلل العقول وتسبب كوارث أشد. العلم الزائف يمنح صاحبه وهم الفهم، فيتمادى في قراراته دون إدراك عواقبها. والعلم الزائف ليس مجرد جهل بسيط، بل هو الجهل الذي ارتدى قناع المعرفة، ولهذا كان أكثر خطرًا. إنه الفخ الذي يقود صاحبه إلى اتخاذ قرارات كارثية ظنًا منه أنه على صواب. في عصرنا الحالي، يشكل العلم الزائف تهديدًا خطيرًا للبشرية لأنه يعتمد على تزييف الحقائق باستخدام لغة تبدو علمية.
ودعني -عزيزي القارئ – أورد لك هذه الأقصوصة الرمزية لترى كيف يصنع الجهل والعلم الزائف بمن يتبناه، والأقصوصة تتحدث عن رجل كان يملك دبًا وفيًّا يصاحبه ويخدمه، وذات يوم، وبينما كان الرجل نائمًا، أراد الدب أن يحمي صاحبه من ذبابة كانت تحوم حوله. أمسك الدب بحجر ضخم وألقاه على الذبابة ليقتلها، لكنه أصاب صاحبه وقتله دون قصد. ترمز هذه الأقصوصة إلى خطورة الجهل، حتى لو كان صاحبه مخلصًا أو حسن النية. فالجهل، مهما كان دافعه نبيلاً، يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية إذا لم يكن مقترنًا بالحكمة والعلم.
نعم، أقصوصة الدب الأحمق تحمل في طياتها فلسفة عميقة تتعلق بطبيعة الجهل وأثره، حتى لو كان مدفوعًا بحسن النية. إنها تطرح تساؤلاً وجوديًا حول العلاقة بين النية الصادقة والعمل الواعي، مؤكدة أن النية وحدها لا تكفي إن لم تكن مصحوبة بالعلم والبصيرة. الجهل هنا ليس مجرد نقص في المعرفة، بل هو قوة عمياء يمكن أن تقود إلى تدمير ما نحاول حمايته. والفلسفة المستخلصة من الأقصوصة تدعو إلى التأمل في قيمة الحكمة والتروي. فهي تُظهر أن الخير غير المدروس قد يكون أسوأ من الشر المتعمد، وأن الجهل لا يصبح فضيلة، حتى لو تزين بالمحبة أو الولاء. كما تلقي الضوء على مسؤوليتنا في اختيار من نصاحب ونمنحهم التأثير على حياتنا، فالنية الطيبة دون عقل واعٍ قد تكون قاتلة. كما تختزل الأقصوصة في رمزيتها تحذيرًا شديدا مفاده: لا يكفي أن نرغب في فعل الخير، بل يجب أن نعرف كيف نفعله. وهنا يحضر العلم والبصيرة ويغيب الجهل والعلم الزائف.
وفي العصر الحديث، نجد أمثلة عديدة على كوارث العلم الزائف، فخلال القرن العشرين، اعتمدت حركات الاستعمار على ترويج نظريات علمية زائفة لتبرير استغلال الشعوب، (نظرية الأعراق العليا)، التي زعمت أن هناك أعراقًا متفوقة أعلى وأخرى أدنى، كانت أحد الأعمدة التي استندت إليها سياسات الإبادة الجماعية، مثل تلك التي نفذها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وينفذها الصهاينة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين في غزة. حتى في وقتنا الحاضر، تُظهر كارثة تغير المناخ أثر العلم الزائف، فبعض الشركات الكبرى، التي تقف خلف تدمير البيئة، تروّج لمعلومات مضللة تنكر تغير المناخ أو تقلل من خطورته، مما يعيق الجهود العالمية لإنقاذ الكوكب، كما أدى الجهل بقوانين الطبيعة إلى كوارث بيئية مدمرة، فقطع الغابات، وإلقاء النفايات السامة في البحار، دون مراعاة العواقب، كلها أمثلة على كيف يمكن للجهل أن يهدد مستقبل البشرية.
والحروب التي لا تنطفئ في مكان حتى تشتعل في مكان آخر، ليست وليدة الطمع وحده، كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هي غالبًا نتاج الجهل الذي يحجب رؤية الآخر كإنسان، الجهل بالآخر يجعل من الاختلاف سببًا للصراع بدلًا من أن يكون دعوة للتفاهم. ومعظم الحروب الكبرى لم تكن فقط نتيجة لصراعات القوى، بل كانت مدفوعة بالجهل الممنهج. الجهل بحقائق الآخر، والجهل بالتاريخ، والجهل بتبعات القرارات العسكرية والسياسية كلها كانت وقودًا لصراعات أودت بحياة الملايين.

كيف نقاوم الجهل والعلم الزائف؟
الجهل، وإن كان قويًا، ليس قدرًا محتومًا. إنه ظلام يمكن تبديده بنور المعرفة، لكن هذا يتطلب وعيًا وفعلًا مشتركًا على مستوى الفرد والمجتمع. الجهل، كما قال سقراط، هو “الجريمة الوحيدة التي لا ينجو صاحبها من عواقبها”. إنه طاغية خفي يهدم الحضارات ويُسقط الأمم، ليس بفعل قوته، بل بفعل تراخي الإنسان في مواجهته.
والجهل لا يزول بالصراخ في وجهه، بل بالتنوير التدريجي الذي يبدأ من الفرد وينتشر إلى المجتمع. وفي عالمنا الرقمي اليوم، يصبح نشر المعرفة الصحيحة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الجهل لم يعد يُسجن في حدود الأمية، بل أصبح إلكترونيًا، يزحف عبر الشاشات والهواتف الذكية. والجهل، سواء كان صريحًا أو متخفيًا في شكل علم زائف، هو العدو الأكبر للتقدم. والمجتمعات التي تعتقد أنها قادرة على بناء المستقبل وهي تمسك بمعول الجهل بدلًا من أدوات العلم والمعرفة ستجد نفسها في النهاية تطأ بأقدامها على أنقاض حلمها. علينا أن ندرك أن البناء الحقيقي يبدأ بنزع هذا المعول من أيدينا، واستبداله بنور الفكر الذي يقودنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا ووعيًا.
أما السبيل إلى النجاة فهو أن نستلهم من الماضي دروسه، ومن الحاضر تحدياته، وأن ندرك أن النور الوحيد الذي يبدد الظلام هو نور العلم، وأن الحقيقة، مهما كانت مؤلمة، هي دائمًا أقل خطرًا من الجهل. الحل يبدأ من الفرد. أن يتعلم الإنسان كيف يشك بذكاء، كيف يسأل عن المصدر، وكيف يبحث بنفسه عن الحقيقة. في عصر الإنترنت، حيث تنتشر المعلومات بسرعة تفوق قدرة الإنسان على استيعابها، يصبح التحقق من المعلومة ضرورة أخلاقية. وفي عصر الإنترنت، حيث تنتشر المعلومات بسرعة الضوء، يصبح من الضروري تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحقق من المصادر، فمواجهة العلم الزائف ليست مجرد معركة علمية، بل هي معركة أخلاقية تهدف إلى حماية العقول من أن يتلاعب بها أولئك المتلاعبون بالعقول.
ثم يأتي دور المجتمعات، المجتمعات التي تحارب الجهل، ليست فقط تلك التي تبني المدارس والجامعات، بل تلك التي تزرع في أبنائها حب المعرفة وتقدير قيمة السؤال. المجتمعات التي تُعلي من شأن العلم الحقيقي الذي يطمس الخرافة ويصيبها في مقتل، والتي تدرك أن المستقبل لا يُبنى إلا بالعقول الواعية، لا بالخيالات المضللة.
والجهل، سواء كان صريحًا أو متخفيًا في قناع العلم الزائف – كما أسلفنا -، لا يُهزم إلا بسلاح التعليم والمعرفة. لكن التعليم وحده لا يكفي؛ لا بد أن يُصاحب ذلك إحياء لثقافة التساؤل والنقد. التاريخ يعلمنا أن التلقين بدون فكر نقدي لا يصنع إلا نسخًا متكررة من عقول خاملة. ولمواجهة هذا المعول الخفي الهدام (الجهل والعلم الزائف)، لا بد من إشعال نور العلم والمعرفة في كل زاوية. التعليم هو الجدار الأول في الدفاع عن مستقبل الإنسانية. ولكن ليس أي تعليم، بل تعليم يشجع على التفكير النقدي والبحث الحر، فليس هدف التعليم إلقاء الحقائق على عقول الطلاب، بل تعليمهم كيف يسألون الأسئلة الصحيحة، وكيف يتعرفون على الحقيقة في بحر المعلومات المغلوطة.
إنه التعليم الناقد بدلًا من التعليم التلقيني، ذلك التعليم الذي يزرع في الأجيال أسئلة أكثر مما يمنحهم إجابات، إنه هو السلاح الأقوى ضد الجهل. يجب أن نعلم الطلاب كيف يفكرون، لا بماذا يفكرون، لأن العقل القادر على التساؤل هو العقل الذي يرفض الاستسلام للأوهام. كما لا بد من بناء ثقافة الحوار الحقيقي، الذي يقوم على الإنصات والتفكير، لأنه هو الجدار الأول في مواجهة الجهل، فالمجتمعات التي تشجع على النقاش المفتوح والتعددية الفكرية قادرة على تجاوز قيود الجهل وإطلاق العنان لإمكاناتها.
اليوم، نحن في مفترق طرق، إما أن نختار طريق العلم والمعرفة، حيث نبني مستقبلًا قائمًا على الوعي والإبداع، أو نسمح للجهل بأن يقودنا نحو الهاوية، ونحن نظن أننا نسير في الاتجاه الصحيح. الخيار لنا، ولكن علينا أن ندرك أن الجهل لا يرحم، وأن مواجهته ليست خيارًا بل ضرورة وجودية.

