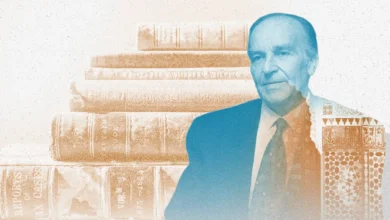مدخل تمهيدي:
يمثِّل الإسلام دين الإنسانية، ونظامه نظامٌ شاملٌ لجميع نواحي الحياة، يربطُ بعضها ببعضٍ ربطًا عضويًّا منطقيًّا؛ منطلقًا من واقع الحياة الإنسانية وخصوصياته لمعالجة قضاياها بشتَّى مستوياتها، وبما يتناسب مع تطلعات الإنسان الروحية / المعنوية، والمادية في هذه الحياة، والحياة الأخرى. ونظرًا إلى اكتناف الإنسان للكينونة الاجتماعية منذ أن فطَرَه الله وبرأه، ونظرًا إلى أنه يولد اجتماعيًّا؛ كان الإسلام دين المجتمع كما هو دين الفرد، والقرآن الكريم كتاب المجتمع الإنساني كما هو كتاب كل فرد من أفراد هذا المجتمع بلا استثناء. لذلك، كان لا بدَّ للحياة الإنسانية من قانونٍ يحميها من التفلت والاختلال في موازينها، بحيث ينظم الاجتماع البشري، كما ينظم الحياة الداخلية للإنسان من التشتت، وينشر العدل، والخير، ويحقق أسس التكافل والتَّخالق بين أفراده، ويحقق له أهدافه السَّامية، وهو ما تكفَّلت به الشرائع السماوية التي تتطابق بمبادئها وأهدافها مع الفطرة الإنسانية، وتستوعب حاجات الإنسان كافّة، وتنظمها تنظيمًا دقيقًا. يقول الله تعالى:(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)، وهذا ما يوحي بأن التوحيد هو القاعدة التي يرتكز عليها الدين، وتنطلق منه كل الخطوط العريضة في حركة الإنسان في الحياة الباحثة عن الله في الأعماق، وفي مدارج السموّ، وفي خط الامتداد للتعالي والتكامل الإنساني.
والوجود البشري في الإسلام لا يعرف الفوضى أو العبث، قال الله تعالى:(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ)، وهذه الآية تعيد ضبط قضية الوجود البشري، بحيث لا تمثل حركةً في الفراغ، بل حركةً يتحول فيها العدم إلى وجودٍ حيٍّ يتحرك فيها الإنسان بالتَّكليف المنوط به، فهذه الحياة ليست لحظاتٍ زمنية ضائعة في الفراغ، تبحث عمّن يستهلكها ويعيدها إلى العدم ضمن منطق اللاّمعنى واللاّمسؤولية. لهذا، كان كل تشريع إلهي مهما كان نوعه، قد أوجبه الله تعالى، أو ندب إليه، أو نهى عنه، والأوامر الإلهية تهدف إلى تربية الإنسان وتهذيبه والارتقاء به وحفظ حقوقه العامة والخاصة، وهذه الأوامر تختص بمناحي الحياة كلّها، لأنَّ الدِّين في تعريف الإسلام هو صناعةُ الحياة وتحريك التَّاريخ في الزَّمان والمكان.
إنَّ الإنسان في طريقه إلى التّكامل يحتاج إلى ما يطهر نفسه ويزكيها فيخرجه من سلطان ذاته إلى معنوية وضَّاءه تقربه إلى الله تعالى، وإلى حلول حب الله – تعالى – في قلبه. ولا يحلُّ هذا الحب إلا في نفسٍ لها من الكمال نصيب، ولا كمال إلا بما يبعد الإنسان من أدران نفسه وتسيد الآفات عنها.
فالصوم كذلك فيه معنوية عالية، لو قصد به التقرب إلى الله تعالى، تقربًا لا شائبة فيه، وأريد به إطاعة الله تعالى وابتغاء مرضاته، فإنه كافٍ لإذابة الأدران التي تعارض معنوية النفس وسير تقدمها نحو الكمال المنشود.
ومما لا ريب فيه أن الصِّيام يشكل مدرسة متكاملة، تهتمُّ بجوانب عديدة من جوانب الشخصية المسلمة، فتجد الصيام يربي فيه عبودية السر، والاستسلام لله سبحانه وتعالى، والامتناع عن المحبوبات من أجل رضا الله تعالى، وكبح النفس عن المعاصي، والسُّمو الأخلاقي والسلوكي، كل ذلك وغيره من معاني الصيام الذي شرعه الله على الأمم من قبل، وعلى أمَّة محمَّد – عليه الصَّلاة والسلام- بالطريقة المُشرعة التي نصوم بها. والصيام فُرصة لتقوية العزيمة والإرادة والاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى، ولا شكَّ أن شهر رمضان مليء بالقدرة على الإنجاز، وأداء المهام، وهو وحده كاف في شحذ الهمم، وبثِّ الفأل والأمل، ومن ثمَّ الانطلاق نحو إعمار الأرض، بيد أن بعض الناس قد جعلوا شهر رمضان شهر كسلٍ وخمول، وتلقَّف ذلك الواقعَ أعداءُ الدين فقالوا: إنَّ الصيام يبعث على كسل المسلمين وخمولهم، فهو مضرٌّ بالإنسان، ومعرقل للتقدم الإنساني لإعمار الأرض، وهُم بذلك يغفلون رحمة الله تعالى وحكمته من تشريع هذه العبادات، فهو أرحم بعباده بهم من أنفسهم، وقـد شرع العبادات لحكمة قد يُدركها الخلق، وبعضها لا يكون للعقلِ سبيلٌ إلى إدراك المصالح المقصودة بها؛ لأنَّ الله سبحانه استأثر بعلم حِكمتها ليختبر إيمان خَلْقه، وإذعانهم وامتثالهم لأوامره.
عندما تناول القرآن الكريم المقاصد الرئيسة من خلق الإنسان وعَناهُ وميزه بصفات وأسرار عن غيره؛ إنما كان ذلك لتبصرته بالغاية من وجوده واكتشاف حقيقته في هذا الوجود، وليصل بعد ذلك إلى إدراك كمال إنسانيته، من خلال ترقيتها وتزكيتها وتربيتها التربية السوية، لترتقي في معارج الكمال الإنساني الذي لا يتحقق إلا بقدر ما يحقق الإنسان من مقاصد خلقه/وجوده، وهي: تحقيق العبودية لله تعالى، والإذعان لأوامره، و الإصلاح بكافة أشكاله؛ ليُحقق بذلك وحدة الأمة، ووحدة الجنس، ووحدة الدين، ووحدة التشريع بالمساواة والعدل، ووحدة الأخوة الروحية والمساواة في التعبد، وبناء الضمير الوجداني الاجتماعي للأمة المُسلمة. والعبادات تحتل أول مقاصد القرآن الكريم، وهو أسلوب صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، حيث قصر في الآية الكريمة علة خلق الله الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه، والعبادة هي العلاقة بين هذا الكون بكل ما فيه من جمادات وأحياء وبين الخالق سُبحانه وتعالى وهي الغاية من الوجود الإنساني، بل من وجود المُخلوقين المُكلفين إنسًا وجنًا. والغاية هنا، ليست معنى قائمًا في الخالق ذاته، بل هي أمر متصل بالدور الذي يُراد للمخلوق القيام به، بالمستوى الذي ترتفع به حياته عن العبثية، فلم يخلق الله الجن والإنس، ليعيشوا اللهو الذي يجعل الحياة فرصةً للعبث، بل لعبادته، وتأكيد إحساسهم بالعبودية المطلقة لله تعالى، تلكم العبودية التي تعطي لكل مسؤوليات الحياة معنًى يتحرك في وجودهم، فإن الحاجة إلى خضوع الناس وإلى ما يقومون به من فروض العبادة، تمثل حاجة إلى إكمال نقص يحس به المعبود ويجد في العبادة لونًا من ألوان التعويض. وفي حديثه عن الآية السابقة، يبين سيد قطب مفهوم العبادة، فيقول: “إنَّ النصَّ الصغير- الآية السابقة- ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة، من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقانها، سواء كانت حياة فرد، أم جماعة، أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها، وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعانين والمرامي، تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة، التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة”. وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس، تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده، وأصبح بلا وظيفة، وباتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل، إن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل من مُجرد الإقامة الشكلية للشعائر، فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر، بل كلفهم ألوانًا أُخرى من النشاط تستغرق مُعظم حياتهم. وقد لا نعرف نحنُ ألوان النشاط التي يُكلفها الجن، ولكننا نعرف حُدود النشاط المطلوب من الإنسان، نعرفها من القرآن الكريم، يقول الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)، فهذه الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني، وهي تقتضي ألوانًا من النشاط الحيوي وعمارة الأرض والتعرف إلى قواها وطاقاتها وذخائرها ومكنوناتها وتحقق إرادة الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها، كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام. والعبودية لله تعالى والامتثال للأوامر الإلهية، هي غاية الوجود الإنساني، ووظيفة الإنسان الأولى. والعبودية في المصطلح القرآني مفهوم كلي تتكامل فيه عناصر العمران؛ عمران الأرض بحياة الإنسان، وعمران حياة الإنسان بالخير والعمل الصالح، والارتقاء بأسباب الحياة ومقوماتها بإنجازات عمرانية مادية ومعنوية، وعمران قلب الإنسان بتقوى الله، ورجائه، ورحمته، وغفرانه. ويتعزز هذا المعنى بمعرفة ما يقابله، فهو حياة مقابل الموت، وصلاح وبناء مقابل الخراب والدمار والهلاك، كما يتعزز معنى العمران بمعرفة الأصل الذي يتفرع عنه، فالإيمان-عقلًا وقلبًا، وإقامة الحياة على أساس الهدى عملا وتطبيقًا- هو الأصل، والعمران بالنعيم الدنيوي والأخروي نتيجة(1). ويتجلى مفهوم العبودية لله بشكل أوسع وأشمل من مُجرد الإتيان بالشعائر، واقتصارها على الأداء الشكلي للشعائر دون تثوير معانيها في النفس الآدمية.

إنّ حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين:
الأول: استقرار معنى العبودية لله في النَّفس، والشعور أنَّ هناك عبدًا وربًّا، عبدًا يَعبد وربًّا يُعبَد، وأنه ليس في هذا الوجود إلَّا عابد ومعبود، ورب واحد يعبد على من سواه والكل له عبيد.
الثاني: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير وبكل حركة في الجوارح وكل حركة في الحياة، التوجه بها إلى الله خالصة والتجرد من كُل شعور آخر ومن كل معنى يُنافي معنى العبودية له تعالى. وهذا الذي يعكس لنا روح العبادة ومقاصدها، وبأنها لا تنحصر في الحالات والتصرفات الشكلية، بل تتعداها إلى الخروج للعمل في مِحراب الكون والفعل الكوني، بعد استقرارها في نفس ووجدان الإنسان بحيث يُصبح بعد ذلك تَنْبِضُ بحياة الروح والوجدان، فهي -العبادات- مفتاح لغوامض أسرار الكون، وعلى قدر اجتهادنا في أدائها وتمثل معانيها في أنفسنا، وإيغالنا في مكنونات أسرارها، تتكشف لنا بعض أسرارها، يومًا بعد يوم، حتى إذا استضاء الكون بنورها وتخلقت جميع الموجودات بمعانيها وعظيم عطاياها ومِنَحِهِا، فعندها سنجد أرواحنا تَصَّعَّدُ في نحو آفاق المعالي ومعارج الكمال فتصفى بها أرواحنا، فلا نعد نخشى الغرق في بحار الدنيا وسفاسفها. كما أن المقصد الأعلى من العبادات، تزكية النفس وحملها على الاستقامة التي هي الغاية من التَّكليف، ومتى كانت العبادات وَفْقَ المنهج الرباني الخالص بعيدة عن العادة التي تجعلها مجرد أشكال بلا جوهر؛ فإنها تُثمر في حياة الفرد والمُجتمع، ولكن يظل تحقيق هذه المعاني والقيم مربوط بدرجة أساسية بتزكية وتربية العبد لنفسه باعتبارها شرطًا أساسيًا للقيام بأمانة الاستخلاف.
قد جعل الله – سُبحانه وتعالى – لكُّل عبادة من العبادات هدف تتصل بالجانب التربوي للإنسان، فالصيام مثلاً وسيلة من الوسائل التي تربي في الإنسان عندما ينفتح سر موقفه من روح شعيرة الصيام، فيُمارس أثناء صيامه العديد من العبادات مثل الذكر والصلاة وقراءة القرآن الكريم وتدبره، بحيث تتحول بعد ذلك شعيرة الصيام إلى مدرسة مُتكاملة يتعلم فيها كيف يُطهر نفسه من كل ما يُسخط الله من جميع الأقوال والأفعال، ويُخلقها بجميع أنواع العبادات التي تُقربه من الله تعالى. وهذا ينطبق على سائر العبادات، والتي تمثّل بالأساس الطريق إلى تحقيق غايات قصوى في ترقية الإنسان، كما في قوله تعالى:(يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون). (سورة البقرة، الآية 183). وفي هذا التشريع العبادي، الذي أراد اللّه لعباده أن يتعبّدوا له فيه، هو من أجل أن يحقّقوا لأنفسهم البناء الروحي والعملي من خلال ممارسة هذه العبودية، كما هو الحال في العبادات الأخرى التي لم يجعلها اللّه استغراقًا وانهماكًا على الذات، والهروب من المسؤولية الحياتية، وإنما شرعت هذه العبادة ليبتعدوا بذلك عن حياتهم، بل جعلها انطلاقة في وعي الإنسان لعلاقته بربه، من حيث هي عبودية ومسؤولية وانفتاح، وتأكيد على إنسانيته الصافية النقية البعيدة عن كلّ خبث وزيف ورياء، وعن كلّ ضعف وحقد وانحراف، والقرب والتحقق بالمعاني الروحية التي تبني للإنسان حياته على الصورة التي يحبها اللّه ويرضاها، فهي تلتقي بالحياة من خلال التقائه باللّه. ولهذا، كانت التقوى هي الأثر والثمرة الكبيرة الذي ينبغي لشعيرة الصوم أن تحقّقه، وللصائم أن يجعلها منهجًا يستنير بها الإنسان، وطريقة تهذيب لكلِّ الأمراض المعنويّة والروحيّة في الإنسان لتهيئته للاستخلاف وعمارة الأرض. وقد ختمت الآية بيان الصوم بقوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ للإيحاء بأنَّ “التقوى”، هي غاية للصوم أو نتيجة له، نظرًا لما تُثيره في داخل الإنسان من الرقابة الذَّاتية الداخلية التي تمنعه من ممارسة كثير من الأشياء المعتادة له من شهواته ومطاعمه ومشاربه، انطلاقًا من وعيه التام للإشراف الإلهي عليه في كلّ صغيرة وكبيرة، وبما تمثّله من الانضباط أمام الإرادة الإلهية.
والتقوى في المصطلح القرآني، من المفاهيم التي تعيد للإنسان تصوره السليم لعلاقته مع بقية الخلائق في الوجود، أثناء سيره لبناء المجتمع الإسلامي الإنساني، ففي الآيات القرآنية نجد أنَّ “التقوى” تأتي للدلالة على النهي عن أكل مال الحرام، والتسلط على الضعيف، وما يدخل في هذا المعنى من الأعمال التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن في المُجتمع. ومعنى التقوى لا يقتصر على الجانب الوجداني للإنسان، إنما تتعدها إلى وزن الأفعال على ضوئها، فجميع الأخلاق والأفعال الحميدة تابعة التقوى وتدل عليها.
إن كل عبادة في الإسلام لها دورها، وأهميتها، ووظيفتها، في بناء الشَّخصية المسلمة المعتدلة، وبناء المجتمع التراحمي، فنجد أن كل عبادة تحقق دورا ما في المجتمع المُسلم؛ إذا تمَّ استثمارها وتفعليها بالشكل الصحيح، فجميع أنواع الوقاية، مركوزة في العبادات، التي هي في الحقيقة، وسيلة للارتقاء بالإنسان وحماية إنسانيته، أو استعادتها. وهذه الأوامر الإلهية/العبادات تشكل بالأساس مجموعة متكاملة تتكفل بتربية المجتمعات البشرية، وتنظيمها وإدارتها على أسس وأنظمة مستمدة من وحي السماء. وفي ضوء ذلك كلّه، نجد أنَّ كلمة: “التقوى” توحي بالإتمام من النَّاحية الروحية التي يعيش الإنسان فيها أجواء الصيام، بالمستوى الذي يرتفع فيه إلى الآفاق العالية التي تمثّلها هذه الفريضة، ويتحرك معها بأخلاقية إسلامية كاملة؛ فلا يكتفي بالشكل ويبتعد عن المضمون، لأن عمله بهذه الطريقة يمثّل الإتمام الشكلي إلى جانب النقص الواقعي المضموني؛ ما يجعل عبودية الصيام غير مقرّب للّه وغير مقبول عنده، لأن اللّه لا يقبل من الأعمال إلا ما أقبل الإنسان فيها بكل كيانه وروحيته.
وفي هذا الإطار، يمكننا أن نفهم الغرض من التشريع الإلهي للعبادات، فجميعها تزكيةً للنفس والبدن؛ فهي المبدأ في الطهارة والنقاء من العيوب التي تُدنس الفطرة، وتخلقها بالأخلاق الحميدة. والنفس حيث تلتزم بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وتنقلها إلى ميادان التطبيق بعد تثوريها في النفس وتشرب معانيها، فإن ذلك يُسهم في تزكية النفس وتطهر الفطرة من أدران الغفلة، وتنمي الروح والإرادة، وتصحح النشاط الجسدي والغريزة، وتحقق القرب إلى الله تعالى. وهي بمثابة مصفاة للنفس من العلائق الحيوانية الملازمة لها، ومنهج في الترقي للمنازل الإنسانية الكاملة، وتغذيتها بالمعاني السماوية الطاهرة، وفتح الطريق أمامها للملأ الأعلى. كما أنها بمثابة معراج تتدرّج به النفس البشرية، حتى يتمّ لها الصفاء والنقاء، واستشفاف حقيقة الوجود، فتُشكل للإنسان فكرة واضحة عن وجوده ورؤيته للعالم، فيتدرج بهذه العبادات ويتعالى عن مكاسب الحياة الفانية، لكي يسموّ إلى مقام الآخرة وعلوّ غاياتها، ويدخل في التحدي لوراثة الأرض وتمثيل الحق. وليست هذه العبادات قهرًا للنفس، ومشقة وعنتًا للجسم، بل إنها وسائل لتهذيبها، والمشقة تجلب التيسير، وإن مع العسر يسرًا، وإذا عزم الأمر، واشتد التكليف، جاءت الرخصة. لذلك، كان لزامًا العمل على تصحيح التصور المنحرف للعبادة، وتصحيح الوسيلة في الدعوة إليها، وحمل المكلف على إدراك معانيها وأهدافها. والمتأمل في حكمة العبادات التي شرعها الإسلام يجد أن الإنسان هو موضوعها الأول، فهي ما شُرعت إلا من أجل إعادة صياغته وتكوينه، وفق المنهج الرباني الذي جاءت به النبوة. والإنسان في المنهج النبوي، مخلوق خلقه الله تعالى قبضة من طين ونفخة من روحه، مكرم ومفضل، جعله الله تعالى خليفة في الأرض، وسخر له ما في الأرض جميعًا لخدمته في تحقيق الرسالة المنوطة به، وهذا المنهاج النبوي هو منهاج فطرة، يُعيد تشكيل معرفة الإنسان عن نفسه والكون والحياة.

الإعلام وتسليع عبودية الصَّوم:
إنَّ قدسية الحياة البشرية تعني صونها من كلِّ الآفات، وكل عبث إنساني، فكل شيء مخلوق بفعل الإرادة الإلهية طيبًا جميلًا، وتدخل الإنسان فيه لسوء جهله هو الذي يفسده. والحياة البشرية أغلى وأثمن ما يمتلكه الإنسان؛ إذ أنها تفقد قداستها، وينكشف سترها عندما توضع تحت مجهر الفعل الإنساني من أجل الربح المالي من خلال التطويع لأجل مصالح مادية منسلخه عن العمل الأخلاقي أو ما بات يعرف بـ “تسليع الإنسان”. وبهذا، فإنَّ وسائل الإعلام الحديثة، فرضت “نمطًا جديدًا للحياة” لم يسبق له نظير في تاريخ البشرية، حياة مؤسسة على إقحام الإنسان في رحى اللاضروري في الحياة والتحكم فيه وبأذواقه، وتشكيل هويته الدينية والثقافية، وبناء رؤية للعالم مطابقة للقيم والمعتقدات التي تقوم عليها وسائل الإعلام، وبما يخدم مصالحها الدنيوية ونزع سلطان المقدَّس عن الوعي الإنساني وإقصاء كل ما هو ديني بشكل كلّي أو جزئي، وتذليل طرق اللذة والمنفعة للإنسان بهدف السيطرة والتحكم به وبأذواقه.
وهذه الرؤية للآلة الإعلامية، لا يمكن تفسيرها إلا من خلال معرفة البنية/النموذج الإرشادي لها، فخلف هذه الآلة الإعلامية رؤية معرفية تفسيرية محركة للصيرورة عملها في التأثير على المتابعين. والغرض الأساسي وراء هذا كله كما يسميه أدورنو “صناعة ثقافة المتابعين”، لهذه المواد الإعلامية، وتعزيز معتقد وتثبيت فكره، وتمريرها كمعطى بديهي، وإقصاء أي موقف مخالف للنموذج الإرشادي لوسائل الإعلام، وتكميم الوعي الجماهيري تجاه القضايا الكبرى للوجود البشري. فخلف كل مادة إعلامية مبثوثة للجماهير مضامين أيدولوجية، ورسائل ضمنية، تحملها تلك المنظومة المكثفة التي تقدمها الشاشة.
لقد عمدت الأجهزة الإعلامية بفضائياتها على تعميق الاستهلاك في عقول وقلوب المتلقين لها، والتشجيع التمرد على القيم والأخلاق، والعادات المجتمعية والدينية، والأعراف المميزة للمجتمع عن غيره. وهذا البعد المعرفي للآلة الإعلامية يدرك مغزاه القائمين على هذا النظام الإعلامي. لذلك، تستخدم وسائل الإعلام في التغير الثقافي والديني للمجتمعات، وتوجيههم صوب القيم المنبثقة من رحم هذه الآلة، والعمل على طمس القيم والأخلاق والمبادئ المتعارضة مع القيم المحركة للآلة الإعلامية. وهذا ما لاحظه الفيلسوف الكندي ماكلوهان صاحب النظرية الإعلامية الأشهر، من أن هذا التغيير التي تمارسه الآلة الإعلامية ووسائلها مقصود، ولا يقف عند حدود الأفراد، واستجابتهم لرسائل معينة، بل هو تغير كاسح، يشمل كل الجوانب الثقافية والاجتماعية للمجتمع(2).
بالعودة إلى الدين الإسلامي، فإنه قد جعل حفظ قدسية الحياة والكرامة الإنسانية من أجل مقاصده. وبناء عليه، تكون الكرامة الإنسانية والحياة البشرية حياة مقدسة لا ينبغي المساس بها، أو العبث بها تحت أيّ حجج علمية أو نفعية، حيث قد بات التدخل في صياغة الحياة البشرية هدف أساسي للآلة الإعلامية الحديثة. ومن ثمَّ لا يكون انتهاك قدسيّة الحياة مرهونًا بالقتل أو التعذيب، ولكن بمعنى مختلف تمامًا، وهو تحريف مقصد الوجود البشري، ونزع المقدس/الوحي عنه، وهذه الآلة تسليع الإنسان، ودفعه للاستهلاك اللامتناهي قد انتهكت حرمته وقدسيته. ولذلك، فإن التدخل التقني والآلة الإعلامية في إعادة صياغة الحياة البشرية بات يشكل تهديدًا وخطرًا مهولًا لا مرد له من حيث هو تدنيس متعمد لقداسة الحياة، ونفي المقدس من الذات الإنسية. وفي هذا السياق، يمكننا رصد دور الآلة الإعلامية في تحريف المقصد الرئيسي للصيام، وحكمة العبادات في شهر رمضان الكريم، حيث دفعت الكثير للاستهلاك باعتباره السمة المميزة للصيام، وبات الغرض من الصيام هو تنويع المآكل والمشارب في ليالي رمضان. ومع غياب المؤسسات الثقافية والدينية في المُجتمعات الإسلامية عن القيام بدورها في عملية التنشئة والتوعية في هذه النقطة، أصبح لهذه الوسائل القدرة الكبيرة على تشكيل الفكر الوجداني للشخصية المسلمة، وتوجيه سلوكه والتحكم به، حتى باتت شخصيته في مهب التغييرات الثقافية الغربية العلمانية.
لقد تجاوز الإعلام الجديد/ الحداثي المعلمن، دوره الأصلي، وانخرط في سياق تشكيل رؤية كلية إلى العالم، تعكس في مضمونها مخصوصًا عن الإنسان، ونسقًا مخصوصًا من القيم، ومقاصد تتسقُ مع هذه النظرة الإعلامية للعالم، فقد أضحى العالم نمطًا استهلاكيًّا والإنسان كائنًا نرجسيًا غرائزيًّا، والقيم نسبية متغيرة لا تتأسس على قوام ثابت، وإنما قيم تحتفي بالحياة الحيوية، وتمجد المؤقت والعابر. لهذا كان انفصال الآلة الإعلامية عن القيمة يجوز لنا وصفه بخلوِّه من المضامين القيمية والتوجيهية، واستنادها إلى قيم مادية، لا تأبه لحاجات الإنسان الروحية وهمّته في الارتقاء الأخلاقي بهذه المضامين، وإنما تنخرط في النسق القيمي التجاري والإعلاني، وتحويل العالم إلى أشكال دون مضامين، وفصل الكلام عن دوره في النفع والخير أو قول المعروف، وانفصال التواصل عن التعارف؛ أي القول الخيّر الذي ينشئ علاقات تعارفية أخلاقية تشترك في التكريم الإنساني، وفي وحدة أصلها وفي تكامل وجودها(3).
إنَّ من بين الآفات الاجتماعية التي تسوغها الآلة الإعلامية اليوم، تحريف حالة التدين السوية للإنسان، وعدم مراعاة القيم الأخلاقية في المجتمع، وتوسيع نطاقها في المجتمع بهدف تغيير الهوية الثقافية والدينية للأفراد، وتشكيل صورة شاذة للتَّدين، وقطع الصلة بالمقدس أيًّا كان نوعه. وهذه الرؤية الاستهلاكية للعالم التي تسعى وسائل الإعلام إلى تأثيثها في الوعي البشري، همشت من دائرة القداسة ورسخت المعنى المادي للحياة، وأفرغت الوجود من غاياته ومقاصده الإيمانية. بل إنها عظمت الوسائل ورفعتها إلى مرتبة الغايات، ولا “تنفك هذه الإرادة الجامحة- للإعلام- تصطنع أسباب الاحتياج والطّلب بغير انقطاع، جاعلة المستهلك لا ينفك يركض وراء البضائع التي لم يكن يجد الحاجة إليها، تحت ضغط سيل جارف من الإعلانات والإشهارات تبثها وسائل الاتصال ووسائط الإعلام التي أضحت تحقق طيّا للزمان والمكان لم يعهد له سابق”(4).

كما أنَّ الإعلام المعاصر لم يكتف بإماتة الحقيقة واختزال المعرفة في القوة والمصلحة، وتغيير طبيعة الأشياء، وإنّما زحف إلى قلب الإنسان؛ أي العمق الأخلاقي للإنسان والقوة الروحية التي تمكنه من امتلاك القدرة على التمييز بين محمود الأقوال والأفعال ومذمومها، “فليس المقصود في الرؤية الإعلامية الحديثة نمو الإنسان الروحي، وإنما تطويعه للاستهلاك المتجدّد للمنتجات، وليس ثمة طموح آخر سوى التّرفيه، والمتعة، والسماح بهروب سهل يدركه الجميع”(5). وبالتالي انعكست هذه الرؤية الإعلامية سلبيًّا على الأخلاقيات الإيمانية، وضاعفت من اغترابها عن روحها الأصلية. وإذا كانت القيم الفطرية الهادية موصوفة بالثبات؛ لأن مستندها نصوص الوحي، فإن قيم الإعلام المنفصلة تجد مستندها على التغيّر والموضة. ومن أهم تبديات الحداثة المنفصلة عن القيمة، التقاليع، أي الموضة، التي تعني الرغبة الدائمة في التغيير، فهي تجسد رؤية العالم كمادة متحركة، وأن الهدف من الوجود الإنساني هو الاستهلاك المستمر(6).
وعلى الرغم من الإقرار بأنّ المدرسة والأسرة والمجتمع يمثّلان دورًا كبيرًا في عملية التنشئة الاجتماعية، إلا أنّ الجدال الكبير اليوم ما زال قائمًا حول الآثار التي تخلفها التنشئة لوسائل الإعلام، والتقنية الحديثة. وبالرغم من الشعار الذي رفعته التقنية في “تحقيق رفاهيّة الحياة”، والتخفيف من المعاناة التي تعيشها البشرية، مغريةً بذلك الإنسان بغدٍ أفضل- تحت ما يُسمى “بوهم الفردوس الأرضي”-، وبمستقبلٍ أكثر إشراقًا تتحقق فيه الأمنيات فيسعد بذلك الإنسان في الحياة، انتهكت كرامته الإنسانية، وقدسية الحياة البشرية التي جاء الإسلام لتحقيقها وتنميتها في النفس البشرية تحت قناع “تحقيق رفاهية الحياة”، وتحويل الإنسانيّة من الكرامة إلى التشيّؤ، وتفريغ العبادات التي جاء بها الدين الإسلامي من مضمونها الحقيقي، وهي ضبط موازين وقيم الحياة. إلا أننا نجد حالات متعددة للتشوية الذي طال الفطرة الشرية، وذلك بفعل الغلو في الإثارة، وفي صناعة الرغبات: والتي أصبحت مرتكزًا أساسيا لوسائل الإعلام المرئية، حيث تتجلى هذه الإثارة في الكثير من البرامج الإخبارية والمسلسلات والأفلام التي تركز بالأساس على المشاهد التي تعزز من حالة الفردانية، وتحدي جميع أشكال السلطة الأخلاقية والدينية والسياسية وغيرها، ساعية بذلك إلى النفاذ إلى أكبر عدد ممكن من الناس، عبر برامج التسلية والإثارة بكافة أشكالها، والعمل على بناء عالم من المتعة والانشراح واللذة الذي تنحرف بالإنسان عن حقيقة وجوده الأساسية، ودفعه للاهتمام بسفاسف الأمور، والاشتغال بالقضايا الهامشية بعيدًا عن القضايا المركزية الوجودية.
إضافة إلى ذلك عملت وسائل التقنية التي أنتجتها الحداثة، على علمنة كل شيء، فلم يعد لأي شيء متعال أي حضور في منظومتها المتشابكة بدءًا بالإنسان وانتهاءً بعلمنة الحياة وعلمنة وتشييء العبادات، وهنا تكمن خطورة هذه الرؤية التي جاءت لها الحداثة الغربية، والتي بدأت كتحولٍ انعطافي انطلق مع هيمنة العقل دون الإفساح للوحي للمشاركة في صنع الحياة. حيث طمحت وسائل الإعلام المختلفة، من خلال هذا النقلة الجديدة التي أحدثتها في الحياة المعاصرة إلى استيعاب شامل لكافة مناحي الحياة، وإلغاء المتعالي حيث ظهرت هذه الفكرة عند إسقاطها على الإنسان، فأصبح الإنسان في المنظور الحسابي والعلماني كائن عديم الخصوصية، بحيث يتميز بخائص تُميزه عن غيره من المخلوقات في هـذا الوجود، وهو ما أدى في النهاية إلى التسوية بين الإنسان والحيوان، وبعدها إلى المطابقة بينه وبين الشيء، فتجاوزت تركيبة الإنسان، واختفى بعد ذلك الفرد الواعي المسؤول أخلاقيًا واجتماعيًا، حتى غدا كائنًا أحادي البعد، متشيئًا مفرغًا من “نفخةِ الرُّوح” التي جعلت لبني آدم اعتبارات خاصة تُميزه عن غيره من الخلائق في الوجود وهي: إسجاد الملائكة، والتَّكريم والتفضيل، والاستخلاف والتسخير، والشهادة بالحق، وحمل الأمانة، وعمارة الأرض. وهذه هي الأصول والمبادئ الأساسية التي من رحمها تتولد الثَّقافة، وتشيد الحضارة، وتنشأ منها جميع العلوم والمعارف، وتحقق إنسانية الإنسان. ولكن مع ظهور هذه التقنيات المختلفة، والإعلام بشكل خاص، أصبح الإنسان أسيرًا ومرتهنًا بيد هذه الأدوات، باعتبارها تشكل له الرفاهية في الحياة، وتقدم له الكثير من المعلومات دون مشقة وعناء. وهي على العكس من ذلك، فقد أصبحت هذه التقنيات ترسم للإنسان صورة حياة مرتبطة بدرجة أساسية بالاستهلاك، وهذه هي ثقافة واقع العولمة. وليس من مجال للشك في أن فن الترفيه الإعلامي اليوم قـد ألغى خصوصية الإنسان، وفرغه من إنسانيته وقيمه وأخلاقه التي تعمل على تماسك المجتمع من قيم الحياء، والصدق، والتراحم، والتَّخالق وبناء آواصر المحبة، والألفة والتعايش وغيرها من القيم التي تُبنى عليها المجتمعات. كما أن هذه التقنيات أحد أهم الأساليب تأثيرًا في مجال التوجيه الفكري وصناعة الثقافة ونمط الحياة للإنسان، إذ تتوافر الكثير من الإعلانات التي تُقدمها وسائل الإعلام والشركات التجارية على عناصر تستنبطن رسائل فكرية، يجعلها تنفذ بقوة وتؤثر على العقول والقلوب على حد سواء، وهذا ما أدركه المفكر “إريك بارن” ، حينما قال: “إنَّ مفهوم الترفيه التي تسوقه الآلة الإعلامية، مفهوم شديد الخطورة، إذ تتمثل الفكرة الأساسية للترفيه في أنه لا يتصل من بعيد أو قريب بالقضايا الجادة للعالم وإنما هو مجرد شغل أو ملء ساعة من الفراغ، والحقيقة أن هناك أيديولوجية مضمرة بالفعل في كل أنواع القصص الخيالية، فعنصر الخيال يفوق في الأهمية العنصر الواقعي في تشكيل آراء الناس”. وهذه هي معضلة الإعلام المعاصر الذي تحول إلى أداة لبيئة بعض الأفكار، ودفع الناس إلى التشيؤ والحط من قيمهم الأخلاقية، والتسريع من عَلمنة الحياة، حتى أصبحت ثقافة الاستهلاك بكافة أنواعها هي سمة العصر بلا أدنى منازع، فقد توسعت قائمة الطلبات للفرد، حتى أصبح الجشع سمة الأفراد والمجتمعات؛ وهذا يُجسد النمو الشَّاذ لمراحل تفشي الوباء الاستهلاكي وسيطرته، وتحول الهدف الوجودي للحضارة الغربية التي تتحكم في كل شيء في العالم، من تعظيم اشباع الحاجات الإنسانية الأساسية إلى اختلاق وابتكار حاجات جديدة -لم تكون موجودة من قبل- لدفع عجلة الاستهلاك، ومن ثَّمَ الانتاج؛ اعتمادًا على بئر الثروة البشرية اللامحدودة= وهي إحدى الشهوات التي يعمد عليها الوحي الإلهي إلى تقويمها وتهذيبها وكبح جماحها.
كما تمَّ التوظيف الرأسمالي الإعلامي للأفكار الدينية توظيفًا مقلوبًا، وسياقة النفس الإنسانية وراء الشهوات والاستهلاك واستثمارها بغرض تحقيق أهداف مادية تتعلق بالربح على حساب إنسانية الإنسان. وبدلاً من الإمبريالية القديمة، التي كانت تتفتح الأسواق لتصريف سلعها أُفقيًّا في بلدان جديدة؛ فإن الإمبريالية الجديدة، التي تُهيمن فعليًّا على كل الأسواق العالمية؛ شرعت بتوسعة الأسواق رأسيًا داخل الإنسان نفسه، وذلك من خلال الدعاية المكَّثفة. وهذا يكشف حجم السُعار الاستهلاكي الذي أصيب به العالم، والغاية منه هو تسخير العالم بأسره لصالح جهات معينة، من خلال اقناع الإنسان بأنَّ الخلاص يتم من خلال السلع والكثير من الاستهلاك، كما يقول جاك بيرك:” إن المُجتمع الاستهلاكي هو المجتمع الذي لا يبحث عن المعنى، ولا يُحس بضرورة المعنى، ولذا يبحث الإنسان عن معنى حياته، وعن خلاصه من خلال السلعة”. لقد تعدت النزعة الاستهلاكية تأثيراتها البيئية والاقتصادية، إلى جوانب أبعد عمقًا في حياة الإنسان المعاصر، والناتج هو إنسان استهلاكي لا يشبع أبدًا، يعيش في حالة جوع ونهم شديد للاستهلاك فتصبح عندئذ السلعة هي مركز الكون، وتهمش القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، وتُهيمن أخلاقيات السوق وقوانين العرض والطلب على الوجدان الإنساني حتى يُصاب بتشيؤ وفقدان كامل لإنسانيته وحقيقة وجوده. وهذا ما أدركه عدد من المفكرين في العالم الإسلامي والغربي، فهذا المفكر عبدالوهاب المسيري-رحمه الله- قبل وفاته كتب مقالة بعنوان “الإمبريالية النفسية”، تحدث فيها عن ظاهرة الاستهلاك المادي، التي خلقت إنسانًا ذا بعدٍ واحد، يبتغي الربح لتعظيم نزعة الاستهلاك وإشباع ملذاته التي لا ترتوي، وأسماها “حضارة الفوارغ Disposable Civilization”، وهي حضارة تستهلك كل شيء، وتبدد كل شيء من أجل الاستمتاع بالاستهلاك، فالمادية أصبحت عبارة عن رؤية مُستبطنة في الحياة، وصار الاستهلاك هو أبرز تجلياتها ومعالمها الأساسية، حتى صارت السلعة هي البداية والنهاية والغاية من الوجود، وأصبح الربح والمنفعة هي القيم الحاكمة لحركة الحياة. وفي كتابه المعنون بــ “بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها”، يؤكد الروائي الفرنسي “باسكال بروكنرPascal Bruckner”، أنَّ الاستهلاك المحموم أصبح الهدف الأسمى للحضارة الغربية، وهو ما ترتب عليه انكفاء الأفراد على أنفسهم، وضعف اهتمامهم بالعالم.

لقد عمدت وسائل الإعلام إلى تشييء الإنسان والحط من إنسانيته، وذلك باستغلال المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات التي تحتل مكانة في وجدان الإنسان، ودفعه للاستهلاك، مما أدى إلى خلل كبير في تكوينه الروحي والنفسي، بعدما باتت النظرة المادية هي الحاكمة لسلوكه ومعاييره، وصنع الاستهلاك منه نموذجًا ذو بعد واحد؛ وهو إنسان بات يأخذ قيمته مما يقتنيه، وقد لعبت وسائل الإعلام دورًا في دفع الإنسان إلى ذلك النموذج التعويضي وتخليته من كافة القيم والأخلاق الإنسانية ونفخة الروح، وأصبح “الإنسان المتشيء، الذي جرى تفريغه تجويفه، ونزع هويته وتنميطه-بعد إسقاط سماته الشخصية- وباعتباره كائنًا براغماتيًا متكيفًا؛ فقد وجد في التمركز حول عالم الظاهر “بديلاً تعويضياً” قد يخفف من وطأة معاناته الجوانيَّة، فسقط في الاغتراب ، في وجدانه ومشاعره، وهو أخطر تحريف مارسه الإعلام الحداثي/الإمبريالي على الإنسان، فأفسد بذلك قيم الباطن والمعاني للإنسان، مما أدى بعد ذلك إلى فقدان الميزان والمعيار القيمي المسدد والمصوب لحركته في الحياة.
إنَّ القفص الحديدي الإعلامي الذي أُدخل فيه الإنسان إدخالاً، يسميه طه عبد الرحمن بـ: إهدارِ كرامة الإنسان، التي تتزايد، بقدر ما يتزايد هذا الانتشار الانفصالي للإعلام عن القيم، الذي يوهم غيره بصلاحية شعاراته كالديمقراطية أو عيش الحياة السعيدة وبيان ذلك من وجهين: أحدهما أن المرء هنا تقدّر قيمته بحسب استحقاقه، واستحقاقه يعني إسهامه في الدّفع بعجلة التسليع، إما نجاعة إنتاجية أو مردودية مالية، وواضح أن التسليع والتكريم ضدان لا يجتمعان. والوجه الثاني، أن القيم التي يتسامى بها تتفرع أصلًا على وجود الكرامة الإنسانية.. هذا الانتشار المسلّع لا يعرف إلا لغة الأثمان، أما لغة القيم التي تتأسس عليها هذه الكرامة، فهي مفقودة فيه”(7). وهذه الظاهرة التي ميزت المجتمعات المعاصرة، قد اتسعت دائرتها حتى غدت المجتمعات الإسلامية اليوم جزء رئيسي في هذا السياق الاستهلاكي، فقد تأثرت بفعل الِمنصَّات الإعلامية الغربية أو المنصات المتأثر بفلسفة الثقافة الغالبة للعصر الحديث، التي حاولت نشر الثقافة الاستهلاكية في المجتمعات الإسلامية وذلك باستغلال المناسبات الدينية والمواسم التعبدية، ومن أهمها شهر رمضان، حيث تحول رمضان في الممارسة الاجتماعية الإسلامية إلى حالة اجتماعية وثقافية قصوى لتمثل هذه السيولة الاستهلاكية والتكلف الاجتماعي والإرهاق المادي للأسر، في تناقض صارخ مع كل القيم التحررية والتحريرية والتكافلية والروحية التي شُرع من أجلها الصوم فلسفة ومقصدًا وتزكيةً، وتغييب لفلسفة الإسلام الكونية المستندة إلى نقد قيم الأنانية والفردانية والمادية والاستهلاكية وتفكيك القيم السلبية والانحطاطية في تفكير المسلمين وسلوكياتهم. وفي هذا دلالة واضحة على نجاح الإعلام الرأسمالي في التأثير على المُجتمعات الإسلامية، وتشكيل رؤية الإنسان المسلم للحياة، بأن جعلت منه كائنًا استهلاكيًّا، تتراجع لديه الأبعاد القيمية والروحية لصالح أفكار الرفاهية والإشباع المادي. وربط السَّعادة بالاستهلاك المادي، فأصبحت كل زيادة في الاستهلاك والاستمتاع المادي مؤشرا لتحقيق درجات أعلى من السعادة . كما نجحت وسائل الإعلام الإمبريالية في إقناع الإنسان المعاصر مخاطبة الغرائزيِّ، مستأثرةً في تحريكِه بوسائل الإغراء، والتّرغيب في الاستهلاك، وأن حاجاته غير محدودة، متفننًا في تقديم المعروض المُغري إليه على نحوٍ يقتنع فيه المستهلِك بأنّه أمام المعروض المناسب – قيمةً وسِعرًا- الذي يرغب فيه ويرى فيه ما سيُشبع حاجَته.
وهكذا، نجد كيف جعلت وسائل الإعلام، الإنسان المعاصرة يعيش “حالة استرقاقية”، في حين كانت هذه التقنية وسيلة يتوسل بها في أعماله صارت هي التي توجِّه الإنسان وتملي عليه ما ينبغي أن يقوم به، والعيش في حالة من العبوديَّة التَّامة لهذه الوسائل، والمقصود بهذه الحالة الاسترقاقية، التعاطي المغالي للتقنية من قِبَل الإنسان، وتحويل الوسيلة إلى غاية، والمقصود إلى ضده، ومن هذا المنظور فالتقنية لم تحرِّر الإنسان، بل على العكس من ذلك استرقته، وسلبت منه حريته، وبتعبير الفيلسوف طه عبدالرحمن، فإنَّ انقلاب التقنيات على الإنسان إلا لأنها أخذت تستقلّ بنفسها وتسير وفق منطقها بغيرة بصيرة من الإنسان”(8). ومن الراجح أنَّ طه عبد الرحمن استمدَّ صياغة مفهوم “الاسترقاق” هذا، بالإضافة إلى ما هو مشاهد في الواقع، من المرجعية العرفانية التي ترى في كل ما يطغى على القلب صنمًا لا بدَّ أن يقع الإنسان في عبوديته، حيث نجد في شرح الإمام ابن عجيبة لإحدى الحكم العطائية: “القلب إذا أحبَّ شيئًا أقبل إليه وخضع له وأطاعه في كل ما يأمره، إن المحب لمن يحب مطيع، وهذه حقيقة العبودية: الخضوع والطاعة”(9). ورغم الطابع العرفاني لهذه الفكرة فإن أصولها قرآنية، فالإمام ابن قيم الجوزية حين يفسر كلمة “الطاغوت” في قوله الله تعالى:(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ) [البقرة: 256]، يقترب من هذا المعنى حيث نفهم من كلامه أن “الطاغوت” من الجذر “طغى”، أي إن الطاغوت هو ما يطغى على وجدان الإنسان، حيث يختلُّ النظام الباطني للإنسان بتقديم محبة الأشياء على محبة الله تعالى، يقول ابن القيم: “الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم… [ما] يتبعونه على غير بصيرة من الله”(10) والحاكم الطاغوتي في كل عهد هو الذي يرتكز حكمه على القاعدة الثقافية والذهنية لأفراد مجتمع معين، فإنه يكون أكثر قوَّة من الحاكم الذي ينطلق بالقوة وحدها في فرض سيطرته وقيمه على الناس. وكما يلاحظ طه عبد الرحمن، فالتقدُّم الهائل الذي حقَّقته التقنية الحديثة قد أغرى الإنسان بوضع مبدأين: أحدهما لاعقلاني، والآخر لا أخلاقي. أما المبدأ العقلاني فهو الاعتقاد بإمكانية كل شيء، وأما الأخلاقي فهو مكمل لهذا الأخير؛ إذ يغدو كلُّ ممكن واجبَ الصُّنع. فكلما أسعفت التقنية أمكن للإنسان أن يفعل، وهنا تصير التقنية هي المعيار الأخير المطاع في الفعل والنهي؛ ولهذا استباح الإنسان المعاصر فعل كثير من الأمور التي يعافها الضمير الأخلاقي تحت تأثير الاستراقاق التقني للآلة الإعلامية، واستحوذت على إرادة الإنسان، والعمل على تغيب آفاقه في الوجود(11). ولهذا كانت ضرورة أن ينطلق الإيمان التحقيقي من انفتاح القلب أو العقل على الله بحيث لا يكون في داخله أيّ موقع لغيره، ولا تأثير عليه بفعل المداخل المتنوعة، حتى يكون الإيمان صافيًا نقيًّا خالصًا في إيحاءاته وخلفياته ومعطياته، لئلا يسيء الجو الداخلي في زحف المشاعر الخفية للزواحف التقنية وغيرها من المؤثرات.
مما سبق، نخلص إلى نتيجة مهمة مفادها: أنَّ التغيير للكثير من القيم الدينية، والأخلاق مرتبط بدرجة أساسية في تعزيز وسائل التقنية والإعلامية الحديثة لمبدأ الاستهلاك في الذات الآدمية، واستنباته فيها، والهدف من ذلك، تحويل البشر إلى مادة استعمالية إنتاجية استهلاكية، يتم عن طريق الإعلانات، وعن طريق إنشاء مدن الاستهلاك واللذة، وهذه الرؤية في ظاهرها مركّبة، حيث يمكن للإنسان المستهلك أن يقيم العبادات، ويحافظ على الشعائر الدينية بالمعنى الأداتي الوظيفي، غير أن أحلامه وغاياته وسلوكه تستوعب تمامًا ضمن النظام الاستهلاكي العالمي. فهذه الآلة الإعلامية، التي تقود هذه المنظومة الاستهلاكية، هي من أخطر وسائل العلمنة في المجتمعات، والاستهلاكية هي من أهم شكل من أشكال الاختراق العلماني، فهي تقوّض الأخلاق وتقوض كل شيء إيجابي في المجتمع، وحين يصبح الاستهلاك هو القيمة الأساسية في المجتمع فإنها ستهمِّش كل القيم الأخرى(12).

خلاصة القول:
ليس الدمار المادي والاستهلاك المفرط وحده أسوأ ما تولده التقنية الحديثة، لأنَّ العالم في حد ذاته لا معنى له إلا في ضوء المُثل العليا التي ينتظم وفقًا لها، لهذا فالدمار الأسوأ هو ذلك الذي ينجم عن انهيار المُثل التي تسعى الآلة الإعلامية من أجلها. فعلى مدار التَّاريخ، كان أفول نظام إيماني أو أخلاقي معين يتبعه انحطاط هائل على أرض الواقع، لأن هذا النظام هو ما كان يحدد للناس كيفية وجودهم في العالم ومنه تأتي غاياتهم وترتسم آفاقهم، لكن على الرغم من ذلك، لم يحدث أبدا أن هيمن نظام محدد بصورة حيّدت كل ما سواه كما حدث مع أنظمة الإعلام المعاصرة ذات الطبيعة الشمولية، لهذا فإن ظهور الكثير من الآفات الأخلاقية، وفساد القيم الإيمانية وانتهاك قدسية الحياة البشرية سيكون أمرًا وخيم العاقبة، فبانهياره ستنهار الحياة الشخصية للأفراد انهيارا تامًا، طالما وأن والفرد الحديث معتمد بصورة أساسية على السرديات والقيم التي تقدمها الآلة الإعلامية والتقنية المعاصرة، فهذه السرديات مرتبطة على نحو مباشر بوجود النظام العالمي الحالي وبأسسه الأيديولوجية وخلفيته الروحية والأخلاقية، لذا فإن انهيار هذا الحياة البشرية، لأي سبب كان، سيتبعه انهيار آفاق البشرية المعاصرة برمتها، وبروز القيم الشاذة والأخلاق القائمة على مبدأ المنفعة. وليتَ الأمر يتوقف عند هذه النقطة، أي الانهيار الكلي بالصورة المعهودة للانهيار الذي سبق للعديد من الأنظمة والمذاهب الفكرية؛ لكن الطامة الكبرى هي أن الإعلام المعاصر قائم على تعظيم الذات البشرية واعتبارها أساس كل شيء.
وكذا اعتقادهم بأنَّ هوية الإنسان تنشأ بفعل حتميات متعددة، ومداخل متنوعة أهم هذه المداخل هي المنظومة الإعلامية، ودورها في تشكيل المبادئ النَّفسية والأخلاقية والقيمية للإنسان؛ وذلك لما للإنسان من قابليات وأوضاع ورغبات طبيعية مكنونة في ذاته منذ لحظة ولادته قبل أن يلج في مضمار الحياة، حيث تلعب التقنية ووسائل الإعلام دورًا كبيرًا في التأثير في سيكولوجيا الإنسانية العامّة والتوجّهات النفسية التي تنشأ في رحاب الحياة العامّة إثر الأثر في تشكيل المخيال الاجتماعي والثقافي والقيمي للإنسان. لهذا، فإن الآلة الإعلامية من أكبر المبادئ الثابتة في تغيير رؤية الإنسان للعالم. ومن الطبيعي أنّ نجد للآلة الإعلامية دور في عملية التغيير الثقافي والقيمي للإنسان، وصياغة الرؤية الكونية/ رؤية الإنسان للحياة تجعل الإنسان دومًا في مهبّ رياح ظروف مشوّشة وأحيانًا غامضة بالكامل بحيث لا يمكنه تحديد المصير الذي ستؤول إليه حياته، حيث ينشأ لديه شكّ بكلّ شيء ولا يبقى له أيّ مجال للاعتقاد بوجود معنى ثابت ومستقلّ عن الظروف الاجتماعية التي يعيش في رحابها، وهذه الظروف بطبيعة الحال في تذبذب متواصل ولا استقرار لها على الإطلاق.
ومما سبق يمكننا معرفة دور الإعلام ووسائله، فهو يقدمُ أدورًا بنائية من جهة وتدميرية من جهة أخرى، وعلى الرغم من منافعة العديدة إلا أن له مساوئ كثيرة. وفي النهاية، تعود المشكلة الخطيرة للإعلام ووسائله المتنوعة استغلالها للفرد والمجتمع، وتعبيدهم لهذه الوسائل بحيث يستقي كل ما يريده منها، مدسيًّا نفسه ومفرغها من كل معاني السمو، ومحرفًا للذات ومفرغًا لها من الفهم الحقيقي للوجود، والاهتمام بالقضايا الهامشية في حياته، والانسياق وراء كل ما ينافي تطوره الشخصي والارتقاء الداخلي، وتحقق الوعي والإدراك المعنوي.
الهوامش:
- [١] فتحي ملكاوي: منهجية التكامل المعرفي، ص٢٨٨.
- الاتصال الجماهيري وسؤال القيم، د. هشام المكي، ص١٢٥.
- عبدالرزاق بلعقروز، الحداثة الفائقة ومظاهر انفصال الإعلام المعاصر عن القيمة، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ٨١، ص١٣٥-١٣٨.
- طه عبد الرحمن، سؤال العمل، بحث في الأصول العملية في الفكر والعمل، ص٢١٠.
- مارك جيميناز: مالجمالية؟ ترجمة: شربل داغر، ص٣٧٦.
- عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ص٢٦٠.
- طه عبد الرحمن، سؤال العمل، بحث في الأصول العملية في الفكر والعمل، ص٢١١.
- طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، ص٤٥.
- ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ج٢، ص٣٧٩.
- ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج١، ص٤٨.
- طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، ص٤٥.
- عبد الوهاب المسيري، الهوية والحركة الإسلامية، سوزان حرفي، ص٢٩.